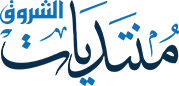كتاب جديد يفضح العسكري السابق والهارب في فرنسا حبيب سوايدية
29-10-2007, 11:13 AM
في الزنازين القذرة 1 

 كتبه خصيصا لـ "وطن": الكاتب الصحفي: أنور مالك
كتبه خصيصا لـ "وطن": الكاتب الصحفي: أنور مالك
1) الطريق نحو المجهول
صباح يوم الأحد 08 جوان 1997 انطلقنا من الرغاية وبالضبط من مركز القيادة (PC) للمجموعة 14 للوسائل المضادة للطيران (14em GMAA)... وفي سيارة رونو 4 ذات اللون الأزرق الغامق، ترأس المهمة النقيب زرارقي حمود والسائق رقيب لا أذكر اسمه... راودني الخوف من مجهول بات ثمان ليالي قضيتها في محل التأديب بالثكنة يطاردني ويقلّم أظافري، بل يثقب رموشي بأرق متوحّش، فالتفكير حول مستقبل يمر على عتبة محكمة عسكرية أمر مفجع ومخيف، إلا أن الأمل في العودة كان يدغدغ مشاعري ويعزف على أوتاري... النقيب زرارقي حمود بدوره من حين لآخر يزرع الطمأنينة داخلي بكلماته المتشبّعة بالأمل، وببسماته العفراء يجتثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ أشواك الخوف من أعماقي... كنت في الطريق غارقا بأوهامي وشاردا فيما تخبؤه الأيام من مفاجآت... الحقيقة أنني في بعض الأحيان أصل إلى شاطئ اليقين بدخولي السجن وتذوق مرارته، وهذا بسبب ما أعرفه عن طبيعة المؤامرة التي ستحاك في الخفاء والتهديد الذي أطلقه الرائد بن علال حسين قائد الوحدة التي أعمل بها... ولكن لما أعود إلى الحقيقة الساطعة كالشمس في وضح النهار وما تحمله العدالة من معاني أعود وأطمئنّ من جديد، كنت كالزورق تتقاذفه الأمواج والعواصف الهوجاء من كل جانب... الطريق نحو البليدة متعب وشاق، ليس لطول المسافة وبعدها عن الرغاية، وليس للظروف الأمنيّة العصيبة التي تقصف بالوطن وتذبح الفرحة على شفاه صغاره، ولا البليدة التي تحولت من مدينة الورود إلى مدينة البارود، لكن لما أنا عليه من بأس وشقاء وانهيار نفسي لم يصبر عليه سواي... وصلنا المحكمة على العاشرة صباحا تقريبا، وقد شدّ انتباهي هذا البناء السامق المتميز الذي يحكي أساطيرا سجّلها ونقشها التاريخ على صخور صلدة، يصعب الوصول إليها كما يصعب معرفة نوعها... الكل يعرفه مما روّجت له وسائل الإعلام منذ محاكمة شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ، في الحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي أزوره فيها وقد شاهدته وتجولت في أروقة محكمته ذات عام وأنا شاهد في قضية وتمثلت في عملية سطو وقعنا ضحيتها والمتهم فيها جندي يؤدي الخدمة الوطنية، حيث أغتنم فرصة غيابنا ونحن طلبة السنة الأولى بالمدرسة العليا للدفاع الجوي للإقليم(ESDAT ) بالرغاية (ولاية بومرداس)، وكنا حينها في مهمة تدريبية استغرقت أربعة أيام في غابة بمحاذاة منطقة بودواو وقام بسرقة غرفنا... ووقفت في قاعة جلساته متهما بالفرار عام 1994 لمّا كنت طالبا في السنة الثالثة بالمدرسة نفسها، حيث حكم عليّ بثلاثة أشهر حبس مع وقف التنفيذ (توجد صورة من الحكم في ملحق الوثائق)، ولكن الفرق بين هذه الزيارات مختلف إلى حد بعيد وشتّان بين هذا وذاك... دخلت قاعة الانتظار ووجدتها مكتظّة بالناس بينهم العسكري وبينهم المدني، اختلفت الأسباب من واحد لآخر المهم أن كل واحد تراه كالثمل في همومه... تركني النقيب وذهب إلى مكتب النائب العام لدى المحكمة العسكرية يتأبط ملفّ الشؤم تحت إبطه، وبقيت أنا كالطير نتف ريشه وصار يرتمي بين أحجار حادّة لا يقدر على الطيران ولا على المكوث في مكان واحد، هكذا كنت مرة أقف لأمشي وأجيء وأخرى أطل على النافذة كأنني أحمل في ذاكرتي صورا قد تعيش معي أياما طويلة، وعن عالم مآله النسيان من وراء أسوار لا ترحم، نجوت منها بأعجوبة من قبل بفضل العقيد عوار محنّد إيدير قائد المدرسة وبشفاعته لي، لأنني كنت طالبا نشيطا على مستوى العمل الثقافي وشفعت لي ما قدمته من مسرحيات وحفلات خلال المناسبات التاريخية (في ملحق الوثائق صورة من شهادتين شرفيتين الأولى من طرف العقيد عوار محند إيدير والثانية من طرف الرائد لعيمش احسن وهو قائد المدرسة الآن تحت الرقمين المتتاليين 11و12).
... لم يمكث النقيب زرارقي حمود سوى بضعة دقائق وعاد يحمل في يده ورقة عرتها ملامحه المتجهّمة من سطورها... اقشعرّ جلدي وأرتعش من برودة سرت في جسدي كالكهرباء، وقف النقيب قبالتي كالتمثال فاندفعت نحوه كالأسد الجريح يتقي شرّ صياد مترصد... بدت عليه علامات تثير التساؤلات العقيمة... خاطبته ولساني لم يحتمل ثقل الكلمات من الشك الذي عصف بي:
- خيرا إن شاء الله!
حاول أن يلملم شتاته مظهرا القوة وان كانت أعماقه تتمزق حسرة وألما... فرد:
- أمر إيداع...لأنها المرة الثانية لك!
هوى كلامه كالقبضة الثقيلة على رأسي... وأرد الصدى كجدار خرب:
- أمر بالإيداع من دون أن يتحدث معي ويعرف أسبابي... مستحيل!!
أول مرة في حياتي أواجه هذا الموقف ... لم أصدق ما سمعته... جرت في أوردتي دماء باردة وأحسست بقشعريرة تخدّر كياني، ولكن الذي لم أكن أتوقّعه أنني أتمتع بكل ذلك الصبر، فقبلها راودني الظن أنني لو أسجن قد أموت في قاعة الانتظار... من دون تفكير قلت له:
- ألا يوجد حل لورطتي؟!!
في غمرة هذه الحالة البائسة تذكرت أفرادا أعرفهم علهم ينتشلونني من هوة لا قرار لها، فأثناء وجودي طالبا بالمدرسة العليا للدفاع الجوي للإقليم وفي العام الدراسي (1993-1994) أشرفت رفقة زملاء دفعتي أذكر منهم:عسة نورالدين وبن أحمد عبد الحميد وغضاضبة كمال وقوادري رضوان وغيرهم –كلهم الآن برتب رائد - على تدريب كتيبة الطلبة الجدد وهو نظام المدارس العسكرية، حيث يشرف طلبة السنة الثالثة على تكوين وتدريب وجمهرة الطلبة المستجدين - السنة الأولى - وكان من بينهم طلبة التكوين الخاص (FS) وهم تابعون لمديرية القضاء العسكري، ويحملون شهادة الليسانس في الحقوق والعلوم الإدارية، وقد تخرجوا معنا برتبة ملازم أول، ثم توزعوا بين المحاكم العسكرية عبر كامل التراب الوطني... وكنت أعلم من قبل بوجود الملازم الأول بن ضو محمد –رحمه الله- والملازم الأول بوريش خالد في هذه المحكمة كقضاة تحقيق، استأذنت النقيب بالذهاب إلى الغرفة التي يرأسها أحدهما، وكانت القريبة منا غرفة الملازم الأول بن ضو محمد، دخلت عليه وقصصت له مأساتي، ثم طلبت منه النظر فيها ومعاونتي إلا أنه أخبرني بما أوجعني، فهو لا يمكنه فعل أي شيء ولا يستطيع أن يتدخل في صلاحيات الادعاء المباشر ولا عنده علاقة وطيدة تسمح له بذلك، تأسف أنه لو كانت القضية بين يديه لأفرج عليّ فورا، للتذكير أن القاضي بن ضو محمد توفي في ظروف غامضة قيل انه إنتحر بغرفته في المحكمة العسكرية، وإن كانت مصادر أخرى أكدت لنا تصفيته بسبب ملفات فساد وإرهاب كان يحقق فيها... ولكنه لما رآني منهارا لدرجة تثير الشفقة وهو الذي يعرفني جيدا، ويدرك أحلامي يشهد لها حضوري الثقافي والإعلامي بالجيش الوطني الشعبي... قال بلهجة الواثق:
- تجلّد... وأصبر... توكل على الله... أعدك أنني سأسعى بكل ما أملك من جهد لتعجيل محاكمتك...!
كان النقيب في أمانة الغرفة ينتظرني، وإن كنت اقترحت عليه الدخول معي إلا أنه فضّل البقاء حتى نكون على راحتنا في الحديث، ولم أتأخر عليه وخرجت أقتلع أقدامي من البلاط كمن يمشي في الوحل بل أتمايل كالثمل... وإن كنت من قبل أدرك أن الأمر تجاوز الجميع ودخولي السجن صار قاب قوسين أو أدنى، ولما كنت أعرفه عن هذا السجن، والذي كنّا نخوّف به أثناء مرحلة التكوين، فكرت في الهرب وكان بوسعي ذلك ولكنّني عدلت عنه في آخر لحظة، حتّى لا أزيد القضية توريطا وأفتح المجال لمن كان همّه الإساءة لي، ليزيد في غيضه شررا، وشفقة بالصديق الذي كنت أكنّ له كل الاحترام، ولما سوف يلحقه من متابعات وأذى، وهو الذي وثق بي وقبل تسليمي لإدارة السجن فتح لي فرصة حتى يطمئن قلبي ليس إلا، بالرغم من يقينه بعدم الوصول لأي منفذ، ولا أحد بوسعه إلغاء قرار الإيداع سوى من وقّعه ولن يتراجع أبدا... وأنا منكسر الخاطر... سيء الحال... وجهي غزته تجاعيد الألم وأنا أفكر في أهلي عندما يبلغهم خبر ورطة ضابط، كانوا يعوّلون عليه كثيرا، وها قد صار نزيل مؤسسة لإعادة التربية... فبدل أن يعيل أسرته تحوّل لسجين... خاطبني النقيب قائلا:
- أعرف جيدا أنه لا حل الآن ولكنني فعلت ذلك لتطمئن فقط ولا تظن السوء بي...!
بالفعل كان الرجل يدرك ما يقول... فسألته:
- والحل الذي تراه الآن!
يجيب:
- لا تقلق لن تمكث كثيرا سوف تحاكم محاكمة خفيفة فقضيتك بسيطة... لو لم تكن للمرة الثانية تدخلها متهما وبالفرار لما سجنوك اليوم أبدا...!
- في تلك المرة كنت طالبا... اليوم أنا مظلوم!
- هذا هو القضاء... توكل على الله!
تنقلنا بخطوات وئيدة نحو إدارة السجن، الذي يقع على بعد أمتار من المحكمة... خرجنا من باب لم ندخل منه أول مرّة، ومشينا في رصيف معبّد تحفه الأشجار وتتوزع على جوانبه، شاهدت بعض الأشخاص يلبسون زيا بنيّا عرفت من النظرة الأولى أنهم مساجين، يقومون بالتنظيف وتطهير الحديقة من الحشيش المتطفل والأشواك... عندها تخيّلت نفسي وأنا في مثل حالتهم، جاثيا على ركبتي أجمع الزبالة... حينها توقف قلبي عن الوجيب، أحس بي رفيقي وبما كان يراودني من خيال لا يشبهه إلا الكابوس... وعيناه متغضنتان بدموع الحنق المشوب بالشفقة والإستجداء حدثني قائلا:
- أراك خائفا...!
ويشير بسبابته إلى شاب كان يجمع القمامة في أكياس، ويتسول لفافات التبغ ممن يمرون عليه وبطريقة كلها حذر وترقب وخوف ربما كان يخشى أن يتفطّن له الحارس المكلف بمراقبتهم... ويستأنف كلامه:
- إنهم جنود... أما أنتم الضباط فلا يمكن أن تشتغلوا أبدا!
تنفست بعض الصعداء حتى طار الدخان من صدري الملتهب... غير أني أجبته ساخرا على ما وصلت إليه:
- ما دمت أوصلت نفسي لهذه الحال وسألبس لباسهم فأضرب بالهراوة ولا ضير في ذلك!!
ونحن نمشي ونتبادل الحديث لفتت نظري يافطة كبيرة تزيّن مدخلا مصبوغا بالدهن الأصفر وجملة بالبنط العريض:
- "المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية"!!
نزلت على صدري كحديد منصهر، وجف لعابي في حلقي كدت أن أختنق... لقد تخيّلت نفسي مجرما خطيرا تترصد آثاره عيون البحث، وإن كنت لا زلت متهما، وأنا على يقين ببراءتي من تهمة تواطأ في تلفيقها الرائد بن علال حسين الذي كان قائدا للمجموعة 14 للوسائل لمضادة للطيران التي كنت أعمل بها وربما بتحريض من صديقه الدكتور محمد لعقاب، الذي كان صحفيا في أسبوعية "الحرية" وكتب عنّي مقالا وقد سمّاه "بورتريه" وضع له عنوانا مثير:
- "الشاعر ابن قصر العطش:متمرد على شعراء الحانات والقبلات " - صحيفة "الحرية" العدد 73 والصادر في الأسبوع:من27/05 إلى 02/06/1996 ونسخة منه في ملحق الوثائق تحت رقم 7.
وابن قصر العطش هو اسمي الأدبي سيأتي الحديث فيه لاحقا، وقد سبب لي المقال الكثير من المتاعب، سبب لي الإعتقال من طرف مركز التحري والإستنطاق ببن عكون وقضيت يوما كاملا في زنزانة تحت الأرض سيأتي الحديث فيها مستقبلا، وخاصة أن الرجل نشر المقال من دون إذني ومعه صورة ساقتها الأقدار إلى أرشيفه الخاص... كانت جملة "المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية" قاصمة للظهر وتردد صداها في أعماقي كما يسمع صوت حجر وهو يرمى في بئر عميقة... ودفعت أسئلة لتطفو على سطحي وتخامر عقلي، بل تشلّ جسدي، وتدفعني إلى ما لا يحمد عقباه من الأجوبة المتعبة...
- هل أنا عديم التربية؟!
- هل أنا خطير على المجتمع حتى يوقى منّي؟!
- ما الذي يحدث لي؟!
- ما مصيري لمّا أخرج من هنا؟!
كان النقيب يحاول شد أزري ورفع معنوياتي التي نزلت للحضيض، وإن كنت في هذه اللحظات صرت أراه عدوّا، لأنه يحملني بين ذراعيه إلى المذبحة ويدعي الشفقة، ولكن لمّا أعود إلى ذاتي أجده رجلا يؤدي واجبا كلّف به، ولا ذنب له في قضيّتي وما في يده شيء قد بخله عني وخاصة لما رأيت في عينيه دموع الحزن، وإن حاول إظهار غير ذلك حتى لا يزيد في حسرتي... ظل يرسم ابتسامات مختزلة تتعرى في حينها لتكشف حقيقة ما يكتنف أعماقه من أسى... دخلنا إلى مكتب مخصص للإيداع ووجدنا فيه ضابطا شابا يحمل رتبة مرشح، يؤدي واجب الخدمة الوطنية، ومعه آخر يحمل رتبة مساعد يبدو في الأربعين من عمره، تسلم الضابط من النقيب ورقة الإيداع وراح يسألني عن اسم والدي ووالدتي وعنواني، وقد احتقرت نفسي أن تسببت في دخول اسميهما الطاهرين إلى مثل هذا المكان... بعدها بصمت بالسبابتين لتؤكد بصماتي بداية الافتتاح الرسمي لعهد جديد لا أعلم نهايته... ودعني النقيب بعدما أوصاني بنفسي خيرا وذكرني بالصبر وأن كل شيء فائت ومر على غيري ما يذكرونه الآن كالمنام... ثم قفل راجعا ولم يستطع أثناءها النظر إلى وجهي، فهو إلى جانب الصداقة التي كانت تربطنا، رقيق المشاعر وطيّب القلب، قيل لي فيما بعد أنه لما عاد إلى الوحدة وبلغ قائدها الرائد بن علال حسين بأمر إيداعي السجن رد عليه منتشيا ومغتبطا ومنتفحا بالكبرياء:
- أحلى خبر سمعته في حياتي!
وقد غضب من قوله ولامه بكل جرأة على ما فعله بي حتى أثار سخط الرائد عليه...!
كانت الساعة في هذه الأثناء تشير إلى منتصف النهار وبضعة دقائق، لذلك بقيت بعض الوقت في انتظار العسكري المكلف بالأمانات والودائع من المطعم حيث كان يتناول وجبة غداءه... خلالها رحت أتبادل مع ذلك المساعد أطراف الحديث، ولقد نسيت اسمه بالرغم من أنه عرفني به وكل ما أذكره عنه أنه رجل هادئ و مثقف، يعرفني من خلال ما كتبته من أشعار وبعض المقالات في مجلّة (الجيش) ومجلة (روضة الجندي) وهما مجلتان تصدران عن مديرية الإعلام والتوجيه للجيش المتواجد مقرها بسطوالي (العاصمة)... استلطف حديثي وبادلني الحوار بصدر رحب ومودة ، عاملني بطريقة متميّزة ومحترمة لا زلت أذكرها، أوعزت ذلك ربما لما يعرفه عني هذا طبعا إلى جانب أنني ضابط...!
حضر بعد مشوار من الحوار العسكري المكلف بالأمانات، فأودعت عنده ما كان معي من أشياء ثمينة وذات قيمة وبعض المال، وكان عقرب الساعة يتكئ على الواحدة ظهرا هذا آخر ما رأيته من ساعتي التي أودعتها أيضا... نادى المساعد الذي آنسني من قبل بحديثه على عسكري يحمل رتبة عريف وكان قويّ البنية يظهر من ملامحه الغلظة وفضاضة القلب... خاطبه آمرا:
- خذه الآن... لا تنسى أن تدخله المطعم!
فكلّمني بلهجة خشنة جدّا وهي عادتهم في معاملة المسجونين وخاصة الوافدين الجدد... قال:
- يلّه...يلّه...!
عندها يتدخل المساعد قائلا:
- ترفق به.... إنه ضابط!
يرمقني بنظرة تتماوج بين الاستهزاء والتردد ثم يأمرني:
- تفضل!
مشينا في رواق طويل تظهر نهايته بعيدة وكنت أمامه وهو يمشي من ورائي يقهقه مع زميل له إلتقاه قبالة المكتب الذي خرجنا منه، وقد تسلل لسمعي بما أخبره عن رتبتي كضابط وتم إيداعي اليوم، ولكن الآخر لم يهتم للأمر، فقد مرّ عليه الكثير من الرتب تبدأ من الجندي وتنتهي باللواء... بعدما تجاوزنا بابا حديديا يتوسط الرواق ويقسمه إلى جزأين، يسهر على غلقه وفتحه عسكري يحمل رتبة جندي ولا يسمح لأي غريب بالمرور إلا بأمر مكتوب من إدارة السجن، باستثناء العسكريين الذين يشتغلون بالسجن... أدخلني إلى قاعة كانت على يساري، وقد خطف بصري كلمة مكتوبة بصباغة بدت قديمة جدا "مطعم" وقد سمعت من قبل أمر المساعد له ووجدت نفسي على موعد أول وجبة غداء في حياتي بالسجن، إن كنت قد فقدت الشهية وسدّ نفسي الاضطراب الذي أتخبط فيه... بدت القاعة واسعة ومخيفة ومرعبة، فيها الطاولات مرصوفة في صفوف تجاوزت الثمانية، أما الكراسي فهي عبارة عن لوحات خشبية تشكل كنبة تمتد على طول الطاولة... أجلسني أحدهم كان بالمطعم في ركن من القاعة، وقد كان المساجين ينظفونه وعيونهم تلسعني، فيهم من طلب منّي لفافة التبغ بإشارة في ظنّه أن الوافد الجديد يحمل معه السيجارة بلا شك... لم أمكث إلا دقيقتين على الأكثر وجاء عسكري يحمل قدرا مصنوعا من الزنك، عليه بقعا سوداء من دخان الموقد، وضعه أمامي بخشونة ورعونة كأنه يطعم كلبه!! كان به معكرونة لم أتحمّل حتى النظر إليها فضلا عن أكلها، فلساني أراه أشرف من تلطيخه بها لأنها تثير التقزز من طعمها الذي لم أتذوّقه ولونها كذلك المزعج ربما لطريقة طبخها... ثم أحضر لي قطعتين من خبز يابس، إقترب مني أحدهم ليعرف تهمتي وما اقترفته من ذنب تسبب في عقابي، وراح يحدثني بلهجة الأمر والاحتقار والاستنطاق وليس بلهجة من يريد معرفة ما يجهله... لما عرف برتبتي العسكرية غيّر من لهجته وطريقة حديثه الفضّة، والذي عرفت فيما بعد أنه مسئول المطعم واسمه قاسي وكان يحمل رتبة عريف أول... تنبّه العسكري الذي جاء بي من الإدارة لامتناعي عن الأكل، فأقترب مني ليخبرني أنني سأتعوّد على هذا الأكل، ويأتي اليوم الذي آكل فيه ما يملأ الشاحنات من العدس واللوبيا... وإن كنت لم أستلطف كلامه المشوب بالاستهزاء والسخرية والفأل السيئ إلا أنني سكتّ على مضض، فطلب أن أحمل معي ذلك الخبز اليابس لعلّني أجوع ولا أجد ما أسد به رمقي... فقلت له:
- وهل هذا وقت الأكل؟!
فزاد في عنجهيته:
- لا شيء يمكنك فعله... الآن النوم والأكل والمرحاض!!
رفضت أن أحمل معي ذلك الخبز اليابس، الذي عمّر على الأقل في سلة المطعم أربعة أيام، حتّى ثلّتي لا تحتمله ولا معدتي لها القدرة على هضمه... عاد وانطلق بي من جديد نحو مكتب آخر غير بعيد من المطعم، لم يكن سوى مخزن للألبسة والأمتعة وفيه تمّ تجريدي من بذلتي الأنيقة وكل لباسي، دككتهم بلا حذر في كيس بلاستيكي من أكياس الدقيق، وممّا حدث أنني كنت أعلّق في سترة البذلة دبوسا يحمل صورة العلم الجزائري، وإن كنت في وضع لا أحسد عليه، فقد فضّلت عدم إهانته في ذلك الكيس الحقير، ونزعته وسلّمته هدية إلى العسكري مسئول المخزن، ولو كان بوسعي لأخذته معي ولكنه لا يسمح بحمل أي شيء حتى اللباس الداخلي فيه غير مسموح به وخاصة الألبسة التي فيها صورا أو لها أذرع طويلة... ربطت عنق الكيس بخيط بعدما علقت به ورقة سجل فيها اسمي ورقمي الخاص... ثم لبست الزي الجنائي والمتمثل في سروال وسترة وقبعة ذات اللون البنّي الغامق ثم حذاء عسكريا من نوع "بالاديوم"، سلّمني فراشا وهو عبارة عن بساط ميدان كانت لنا معه ذكريات في مهماتنا الجبلية المختلفة، أعطاني أيضا حافظة أدوات النظافة (Sace de toilette) بها فرشاة ومعجون أسنان وقطعة صابون لغسل الملابس وكأسا بلاستيكيا... كالعادة حدثني مسئول المخزن كالسابقين ليعرف حكايتي وما اقترفته من جرم، لم أجبه سوى بكلمات مختصرة:
- أنا ضابط وتهمتي هي الفرار!!
دعا لي بالفرج القريب، وأن يفكّ الله غمّتي من محنة لبست كفنها في الحين وتحوّلت إلى صورة من رأيتهم من قبل في حديقة المحكمة وأثاروا شفقتي، لمّا رأيتهم يكنسون وينظفون ويحفرون ويحملون على أكتافهم أكياس المهملات والقاذورات، وإن اختلفت عنهم في بذلتي التي كانت جديدة فقط... للمرة الأخرى ينطلق بي في الرواق نفسه وبعدما تجاوزنا بابا حديديا كالأبواب التي سبقته، أدخلني ساحة تتوسط البنايات المتقابلة، وكان فيها مجموعة من العسكريين الحرّاس، وآخرين مساجين يقومون بالتنظيف والبنايات التي هي أجنحة للمساجين تشكل نجمة خماسية هي في الأصل نجمة العلم الوطني وكنت أعرف ذلك من قبل، حسبما روي لي من طرف العسكريين الزملاء وما أكثرهم الذين ساقتهم أقدارهم إليه... إلا أنني من شدة حنقي على حالي وعلى ما آلت إليه ظروفي صرت أراها سداسية تشكل نجمة داوود، ربما أرى نفسي بناية أخرى ستنهار حتما وفي القريب العاجل...!
استقبلني أحدهم كان يحمل رتبة مساعد أول ويبدو فضا غليظا لا يختلف عمن رأيتهم من قبل، وسألني بغضب شديد، وصوته يلعلع كالبارود كأنه يريد تخويفي:
- من تكون؟!
ثم زاد:
- لماذا دخلت السجن؟!
قبل أن أجيبه قاطعني العسكري الذي رافقني، وأمرني بالاعتدال في وقوفي وتحيته، لأن الذي يتحدث إليّ هو المساعد الأول عطاء الله رئيس فوج الحرّاس... بالرغم من معرفته برتبتي العسكرية إلا أنه تعمد ما قاله، ربما رغبة في رضا المساعد الأول أو إهانتي وخاصة أنهم يترصدون لمثل هذه الفرص للنيل من الضبّاط... اعتدلت كما أمرت فقد بدا من لهجته وطريقة كلامه أنه سيعاملني بوحشية قد تصل إلى الضرب المبرح إن عصيت الأمر، هذا إلى جانب ما كنت أعلمه مسبقا ومن خلال ما رواه لي عسكريون ساقتهم أقدارهم إلى مثل قدري، وهو ما يندى له الجبين من القسوة والرعونة والوحشية... لما أخبرته بحالي ساورني الاحتقار لنفسي، أن آلت بي الأمور إلى أحط الدرجات، فأنا ضابط كانت لي صولات وجولات ويسمع أمري قبل النطق به بالرغم مما كنت أتمتع به من معاملة خاصة لكل الناس أغضبت علي قيادتي كثيرا، أقف الآن ذليلا وأقدم التحية العسكرية إلى من هو دوني رتبة، هذا مساعد أول ربما يصل بي الحال إلى تحية الجنود الذين يعاقبون من لم يناديهم بغير المرخص به في قانون السجن المعمول به داخليا:
- Chef ...!
أحس المساعد الأول بي وشم رائحة ما ساورني حينها فصبّ على النار البنزين... بقوله:
- كنت ضابطا خارج السجن... أما الآن فأنت بلا رتبة!
لم أرد عليه تهكّمه وإن كنت في أمس الحاجة إلى كلام يعيد لي الروح لا يخنقني... فسألني:
- من أي ولاية أنت؟!
أجبته بصوت متحسّر ومنكسر النبرات:
- تبسّة...!
لانت ملامحه حتى خيّل لي أنه من تبسّة أيضا، ثم استدار نحو أحد الحرّاس الذين كانوا يقفون غير بعيدين منّا وأمره أن ينادي على الحلاق... استدار نحوي ضاحكا وقال:
- البذلة زادتك جمالا وما ينقصك إلا الحلاقة والعطور!!
زاد حنقي فقد أحسست أنه يتعمّد السخرية مني، ولكني لم أستطع فعل أي شيء، فأنا كالشاة الذبيحة بين يدي من يتفنن في سلخها... فقلت:
- مظلوم وتآمروا عليّ!
قاطعني:
- كل من يدخل السجن يدعي أنه مظلوم!!
زدت تأكيدا له وتحديت كل الارتياب الذي كان يركض في شراييني:
-... أؤكد لك أنني مظلوم!
شدّه ما غزى ملامحي من تقاسيم الإصرار والصدق... فدعا لي قائلا:
- ربّي يفرج عليك...!
- آمين... آمين!
رق لحالي وذابت تلك القسوة الأولى في لحظة كما يذوب السكر في الشاي الساخن، حينها يحضر الحلاق ولم يكن سوى سجينا مثلي، والصدفة أنه سألني عن مدينتي وأخبرته فكان بدوره من المدينة نفسها، ومن عائلة أعرفها في العاصمة ومدينة الشريعة التي نتحدر منها (ولاية تبسة – الشرق الجزائري)، كان اسمه صدار فيصل دخل السجن بتهمة القتل الخطأ، حيث كان يعمل في الحرس الجمهوري وطاردوا "إرهابيا" تسلل بين الناس فرآه وأطلق النار عليه من سلاحه، أدت طلقة طائشة وعشوائية إلى مقتل مواطن فحكم عليه بسنتين نافذة... حلق شعري على الدرجة صفر وقد عاملني بلطف لما عرف صلتي به، بعدما كان يصول ويجول بآلة الحلاقة (Tendeuse) كأنه يجزّ عنزة متشردة... حتى أنني تحدّثت في قرارة نفسي:
- هذا سجين مثلي ومعاملته هكذا فما بالك بالحراس!
وكأنه كان يشم رائحة ما فارت به أعماقي... فقال مؤكّدا:
- لو لم تكن من الشريعة لما حلقت لك هذه الحلاقة الجميلة!!
ويا لها من حلاقة ما تصوّرتها يوما، قد رأيتها في الآخرين ولم أراها في نفسي، لأنه كان يحلق لي شعــر رأسي- طبعا- في الساحة ولا مرآة عنده حتى أرى فيها حالي الجديدة، ثم أخذني إلى حنفية غير بعيدة منّا، وكانت تضخّ الماء بقوة تقتلع فروة الرأس، غسلته من الشعر المتناثر على كتفي والذي سدّ حتى أنفي وفمي... بعدما أكملت الغسل ومسحت رأسي بمنشفة قذرة أحضرها الحلاق سريعا، أمر المساعد الأول عطاء الله حارسا ناداه برضا، أن يأخذني إلى البناية "C " ويدخلني الزنزانة الرابعة... استدار نحوي ليخبرني بأنها الأفضل ففيها الماء وبعض النزلاء المحترمين...!!
هنا كانت البداية الفعلية للحياة الجديدة، ودخلت الزنزانة الرابعة على الساعة الثانية تقريبا، حسب الحساب الشخصي فنظرتي الأخيرة على ساعتي كانت في الأمانات وقدرت الوقت بناء على ذلك... كان اليوم صيفيا وحارا وقيضه يحرق أديم جسدي، وقد تركت الناس في الخارج مصطافين على الشواطئ... حظيت أن أزلت بعض غمّها بالماء البارد الذي غسلت به رأسي، إلا أن غم عمقي لا يطهّره إلا الخروج من هذا المأزق، الذي تدحرجت في جبّه من حيث لا أحتسب... الله أعلم بالنهاية!!
2) في الزنزانة الرابعة!
كانت أول مرة في حياتي أدخل فيها السجن، وأجد نفسي من وراء القضبان ونزيلا متألما بين أربعة جدران، وفي حصن منيع تجاوزت شهرته حدود الوطن، منذ المحاكمة الشهيرة لقادة الحزب المحل –كما ذكرنا سابقا - وزاده بسطة في الشهرة اللواء المتقاعد مصطفى بلوصيف لما نزله متهما في قضايا سال فيها الحبر الكثير... وإن دأبت قبلها على محلاّت التأديب في المدرسة العليا للدفاع الجوّي للإقليم (ESDAT) بالرغاية، إلا أن الأمر يختلف جملة وتفصيلا... فتح الحارس بابا حديديا، وبمفتاح ضخم كبير يثير الفزع فيمن يراه أول مرّة، وبعدما قرع عدة مرات بلا رأفة ولا رحمة كأنه يريد تنبيه النزلاء بوصوله أو ربما يرعبهم فقط، كنت لا أعلم أسباب ذلك ولما فتحه هرب إلى يمينه من الحمم والبخار التي تنبعث من داخلها، وكأنه فتح قدر مرق محكم الغلق بعد تسخينه لساعات... بالفعل انتابني شعور غريب وقاتل كشعور من أدخل على مقصلة إعدامه، جعلني لا أحتمل نفسي ولا أقدامي قادرة على تحمل تبعات جسد جريح... كانت الزنزانة عبارة عن غرفة لا تتجاوز 6متر مربع، أول ما واجهني نافذة بها قضبان غليظة ومغطاة من الخارج بحديد لا يظهر شيئا، وتظهر خطوط شمسية تتسلل من ثقوب، كأنها تنقل الأمل إلى وجوه يائسة من وضعها ودكناء مما تعيش فيه، في زاويتها اليسرى مرحاضا يحيط به حائط صغير لا يستر من يقضي حاجته، وتنبعث منه رائحة كريهة جدا لا يتحمل البقاء ثانية واحدة فضلا عمن سيعيش أياما بقربه، ووجدت بها ثمانية نزلاء يفترشون أبسطة ممزقة ، يتناثر إسفنجها في كل الجوانب... كانت رائحة العرق تنبعث وكأنني دخلت حماما... حيطانها صفراء اللون زادتها الرطوبة عمقا، وعليها رسومات وكتابات ترغب في الصبر وأخرى تحث على التمرد... آيات قرآنية وأحاديث نبوية ونصوص لعلماء وأخرى لمسجونين، ترغب في الإيمان وتدعو للجهاد، وتتحدث عن فضائل الشهادة وما ينتظر الشهيد من خير عند ربه، وتدفع بقارئها إلى وجوب قتال ما سموه بـ " الطواغيت "و"أعداء الله" أو تحقيق "دولة الإسلام" وإشارات تبدو لأصحابها وهو يعدون الأيام بمرارة ويحسبون ما قضوه بين الجدران الأربعة... أرضية الزنزانة من الإسمنت الخشن الذي يثقب جنوبنا... أما السقف فدهانه أبيضا إلا أنه صار أسودا من الرطوبة، وربما حتى من دخان الأسى المنبعث كالغبار من صدور ملت التنفس في عمق محنة تشبه الموت لحد بعيد...
كان النزلاء يلعبون "الدومينو " المصنوع من ورق البسكويت أو كرتون يجلب من الزبالة وسلات القمامات، لما فتح الباب دسوه تحت الفراش حتى لا يراه الحارس لعلهم يخشون غضبه... استقبلوني وكلهم شغف لمعرفة قصتي، وإن كانت تهمتي واضحة لأن البناية لا يدخلها إلا المتهمون بالفرار، وهذه عادة المسجونين يتلهون ويتسلون بقصص الوافدين الجدد، بل يحاكمونهم كل حسب معرفته بالقانون وشؤون القضاء، أو من خلال القصص المشابهة التي مرت عليهم... راحوا يسألون عن الأحوال في الخارج، وعن النتائج الانتخابية البرلمانية التي جرت في 5جوان 1997م، وشهدت أكبر عملية تزوير في تاريخ الجزائر قادها حينها رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وزادوا شغفا بحكايتي لما عرفوا أنني ضابط، وقد كانت الرتبة الكبيرة بينهم "رقيب أول " وهي لأحدهم يدعى "محمد" من عين تيموشنت، ويشتغل في الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال (ولاية تيبازة)، وكلهم متهمون بالفرار من وحداتهم، تبدأ مدة فرارهم من ثلاثة أشهر وتنتهي بسبع سنوات... كانت حالتي النفسية منهارة جدا... غضبي تجاوز الحنق وبراكيني تنفجر بحمم وشظايا تنذر بالشؤم، وفي داخلي ألعن اليوم الذي إخترت فيه المؤسسة العسكرية مرة، وأخرى ألعن أقداري التي ساقتني على وجهي في هذا النفق المجهول، بل وصل بي القنوط إلى الكفر باليوم الذي ولدت فيه وجئت لهذه الدنيا!!
قام النزلاء وبكل احترام وتودد وفرشوا لي مكانا بينهم، وقد كانوا ينامون على الأرض ولا يوجد نصف سرير بالبناية كلها، عدا الطابق الثاني الذي سيأتي الحديث فيه لاحقا... طلبوا منّي أن آخذ قسطي من الراحة، فلم يبق إلا القليل ونغادر الزنزانة... وأي راحة يمكن أن تزورني أو تقترب من أسواري في هذا المكان الموحش والقذر جدا، وتحت حرارة صفدت جسدي عرقا في الثواني الأولى من دخولي... التفت إليّ أحدهم وقد عرّفني باسمه وهو السعيد، كان رجل في العقد الخامس من عمره، فرّ من ثكنته منذ أكثر من سبع سنوات، ولكن لما وجد نفسه مضايقا ترك فلاحته وماشيته بنواحي ثنيّة الحد بولاية تيسمسيلت وآثر تسوية وضعيته، وهو في الزنزانة منذ سبعة وثلاثين يوما ومن دون محاكمة، ذلك ما زادني خوفا من المجهول والرحلة التي ستطول حتما بي في مكان أفقدني صوابي في اللحظات الأولى، لا أدري كيف سيكون الحال بعد أيام؟ راح يحدثني عن حالته المعنوية وعن أولاده، ويحثّني على الصبر والتناسي فلا شيء بإمكاني فعله سوى التوكل على الله والدعاء إليه... ثم راح يصف لي طبيعة الحياة في السجن وأفواج الحراس، ثم استرسل يحذرني من الأشياء التي تجلب لي السخط والعقوبة... ووصف لي خشونة الحراس وخاصّة أحدهم أطلقوا عليه "عمي صالح" والذي يصفونه بالجلاد والوحش الذي لا يرحم كبيرا ولا صغيرا، ولن ينجو أي سجين من صفعاته مهما احترس وانضبط... عندها تذكرت الملازم الأول صيفي محمد، وهو زميل سابق في المدرسة العليا للدفاع الجوي للإقليم (ESDAT )، أشرف على تدريبنا لما التحقت أول مرة بالمدرسة عام 1991... وعلى ما أعلم أنه مسجون منذ فترة ... قلت له:
- ما دمت هنا منذ مدة فهل تعرف الضابط صيفي محمد؟!
فأشار بسبابته إلى كلمات مكتوبة في زاوية الزنزانة عند رأسه، وهو المكان نفسه الذي كان ينام فيه صيفي... وهي عبارة عن الآية القرآنية: (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين) سورة البقرة(153)
أنا إخترت هنا التي في سورة البقرة وهي موجودة أيضا في سورة الأنفال من الآية 46 وقد كتبها بخط يده... ثم أخبرني أنه مكث ما يقارب الشهرين في تلك الزاوية وتعذّب كثيرا وبكى الأكثر وقد منّ الله عليه وفرّج كربته... لما بلّغني بذلك راودني الإحساس بالفراغ الرهيب، وفقدان من كان سيؤانسني في وحشتي ويبيد الأوجاع المتربصة، وبقدر ما فرحت له بالخروج من المأزق الذي لا يتمناه أحد لعدوّه فضلا عمن كان محل احترام وتقدير، بقدر ما افتقدته وترك ثغرة في وجداني لا يملأها غير الإفراج الذي أراه بعيدا، فالوافد لمثل هذه الأماكن تجد الأمنية الوحيدة التي تراوده وتدغدغ مشاعره أن يجد شخصا على الأقل يعرفه من قبل، حتى يعاونه على تجاوز الموج العاتي خاصة في أول وهلة من دخوله... ارتحت إلى السعيد فقد بدت عليه الطيبة والأخلاق العالية، وآخر اسمه بومازة فريد من منطقة طاورة بنواحي ولاية سوق أهراس شرق البلاد، آخر لا أذكر لقبه العائلي ولكن اسمه محمد من الرويسات بورقلة وهي آخر ما زرته قبل أيام فقط مع أخي أحمد ومكثنا فيها ستة أيام...
كانت أشعة الشمس المتسلّلة داخل الزنزانة فألهبتها وحولتها إلى حمام حرارته عالية جدا، صفدت الأجساد عرقا كالماء، ففاح النزلاء برائحة كريهة من عدم الاغتسال، وإن كانوا محظوظين بحنفية تجلب الماء من حين لآخر... قال السعيد:
- الجو حار ويحرق كما ترى وزنزانتنا، هي الأفضل من الآخرين في الطابق الأول والثاني خاصّة، فهم يحملون الماء في قارورات ويحافظون عليها للشرب فقط... فتجد مراحيضهم تفوح نتنا... يا لطيف!!
اقشعر جلدي... دار رأسي بوجع فجّره... اختنقت من العفن... وكدت أن أتقيّأ مما تخيّلته من حديث السعيد... أما فريد فراح يصف لي طبيعة العيش بأكثر دقة قائلا:
- الصباح نخرج للباحة (la cour ) على الساعة العاشرة فيتم تغيير فوج الحراّس... ثم على الحادية عشرة والنصف نعود مجددا إلى الزنزانة... على الثانية والنصف ظهرا نخرج مرة أخرى ونمكث في الباحة حتى الرابعة لنتناول العشاء، ونعود مرة أخرى للزنزانة على الرابعة والنصف... وكل الأيام عدا الخميس والجمعة فيتغير الوقت بزيادة نصف ساعة على موعد الخروج ويبقى موعد الدخول ثابتا...!
ينبّهه محمد التموشنتي ساخرا:
- ونسيت فطور الصباح!
فيجيبه محمد الورقلي:
- يا له من فطور حقير... قبل أن نخرج من هنا صباحا يحضروا لنا الحليب وهو ماء أبيض لا فيه سكر ولا حتى الملح!
يتكلّم آخر:
- يارب فرج علينا!
فيهتف الجميع بحماس إيماني فياض:
- آمين... آمين!
الرابط:
http://www.watan.com/modules.php?nam...ticle&sid=4215

"شهادة مثيرة لضابط جزائري فار هربها من وراء قضبان سجن البليدة العسكري وخفايا عن حياة وراء الشمس وأسرار العسكري السابق حبيب سوايدية التي لا يعرفها أحد"
 كتبه خصيصا لـ "وطن": الكاتب الصحفي: أنور مالك
كتبه خصيصا لـ "وطن": الكاتب الصحفي: أنور مالكالحلقة الأولى
الفصل الأول
1) الطريق نحو المجهول
صباح يوم الأحد 08 جوان 1997 انطلقنا من الرغاية وبالضبط من مركز القيادة (PC) للمجموعة 14 للوسائل المضادة للطيران (14em GMAA)... وفي سيارة رونو 4 ذات اللون الأزرق الغامق، ترأس المهمة النقيب زرارقي حمود والسائق رقيب لا أذكر اسمه... راودني الخوف من مجهول بات ثمان ليالي قضيتها في محل التأديب بالثكنة يطاردني ويقلّم أظافري، بل يثقب رموشي بأرق متوحّش، فالتفكير حول مستقبل يمر على عتبة محكمة عسكرية أمر مفجع ومخيف، إلا أن الأمل في العودة كان يدغدغ مشاعري ويعزف على أوتاري... النقيب زرارقي حمود بدوره من حين لآخر يزرع الطمأنينة داخلي بكلماته المتشبّعة بالأمل، وببسماته العفراء يجتثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ أشواك الخوف من أعماقي... كنت في الطريق غارقا بأوهامي وشاردا فيما تخبؤه الأيام من مفاجآت... الحقيقة أنني في بعض الأحيان أصل إلى شاطئ اليقين بدخولي السجن وتذوق مرارته، وهذا بسبب ما أعرفه عن طبيعة المؤامرة التي ستحاك في الخفاء والتهديد الذي أطلقه الرائد بن علال حسين قائد الوحدة التي أعمل بها... ولكن لما أعود إلى الحقيقة الساطعة كالشمس في وضح النهار وما تحمله العدالة من معاني أعود وأطمئنّ من جديد، كنت كالزورق تتقاذفه الأمواج والعواصف الهوجاء من كل جانب... الطريق نحو البليدة متعب وشاق، ليس لطول المسافة وبعدها عن الرغاية، وليس للظروف الأمنيّة العصيبة التي تقصف بالوطن وتذبح الفرحة على شفاه صغاره، ولا البليدة التي تحولت من مدينة الورود إلى مدينة البارود، لكن لما أنا عليه من بأس وشقاء وانهيار نفسي لم يصبر عليه سواي... وصلنا المحكمة على العاشرة صباحا تقريبا، وقد شدّ انتباهي هذا البناء السامق المتميز الذي يحكي أساطيرا سجّلها ونقشها التاريخ على صخور صلدة، يصعب الوصول إليها كما يصعب معرفة نوعها... الكل يعرفه مما روّجت له وسائل الإعلام منذ محاكمة شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ، في الحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي أزوره فيها وقد شاهدته وتجولت في أروقة محكمته ذات عام وأنا شاهد في قضية وتمثلت في عملية سطو وقعنا ضحيتها والمتهم فيها جندي يؤدي الخدمة الوطنية، حيث أغتنم فرصة غيابنا ونحن طلبة السنة الأولى بالمدرسة العليا للدفاع الجوي للإقليم(ESDAT ) بالرغاية (ولاية بومرداس)، وكنا حينها في مهمة تدريبية استغرقت أربعة أيام في غابة بمحاذاة منطقة بودواو وقام بسرقة غرفنا... ووقفت في قاعة جلساته متهما بالفرار عام 1994 لمّا كنت طالبا في السنة الثالثة بالمدرسة نفسها، حيث حكم عليّ بثلاثة أشهر حبس مع وقف التنفيذ (توجد صورة من الحكم في ملحق الوثائق)، ولكن الفرق بين هذه الزيارات مختلف إلى حد بعيد وشتّان بين هذا وذاك... دخلت قاعة الانتظار ووجدتها مكتظّة بالناس بينهم العسكري وبينهم المدني، اختلفت الأسباب من واحد لآخر المهم أن كل واحد تراه كالثمل في همومه... تركني النقيب وذهب إلى مكتب النائب العام لدى المحكمة العسكرية يتأبط ملفّ الشؤم تحت إبطه، وبقيت أنا كالطير نتف ريشه وصار يرتمي بين أحجار حادّة لا يقدر على الطيران ولا على المكوث في مكان واحد، هكذا كنت مرة أقف لأمشي وأجيء وأخرى أطل على النافذة كأنني أحمل في ذاكرتي صورا قد تعيش معي أياما طويلة، وعن عالم مآله النسيان من وراء أسوار لا ترحم، نجوت منها بأعجوبة من قبل بفضل العقيد عوار محنّد إيدير قائد المدرسة وبشفاعته لي، لأنني كنت طالبا نشيطا على مستوى العمل الثقافي وشفعت لي ما قدمته من مسرحيات وحفلات خلال المناسبات التاريخية (في ملحق الوثائق صورة من شهادتين شرفيتين الأولى من طرف العقيد عوار محند إيدير والثانية من طرف الرائد لعيمش احسن وهو قائد المدرسة الآن تحت الرقمين المتتاليين 11و12).
... لم يمكث النقيب زرارقي حمود سوى بضعة دقائق وعاد يحمل في يده ورقة عرتها ملامحه المتجهّمة من سطورها... اقشعرّ جلدي وأرتعش من برودة سرت في جسدي كالكهرباء، وقف النقيب قبالتي كالتمثال فاندفعت نحوه كالأسد الجريح يتقي شرّ صياد مترصد... بدت عليه علامات تثير التساؤلات العقيمة... خاطبته ولساني لم يحتمل ثقل الكلمات من الشك الذي عصف بي:
- خيرا إن شاء الله!
حاول أن يلملم شتاته مظهرا القوة وان كانت أعماقه تتمزق حسرة وألما... فرد:
- أمر إيداع...لأنها المرة الثانية لك!
هوى كلامه كالقبضة الثقيلة على رأسي... وأرد الصدى كجدار خرب:
- أمر بالإيداع من دون أن يتحدث معي ويعرف أسبابي... مستحيل!!
أول مرة في حياتي أواجه هذا الموقف ... لم أصدق ما سمعته... جرت في أوردتي دماء باردة وأحسست بقشعريرة تخدّر كياني، ولكن الذي لم أكن أتوقّعه أنني أتمتع بكل ذلك الصبر، فقبلها راودني الظن أنني لو أسجن قد أموت في قاعة الانتظار... من دون تفكير قلت له:
- ألا يوجد حل لورطتي؟!!
في غمرة هذه الحالة البائسة تذكرت أفرادا أعرفهم علهم ينتشلونني من هوة لا قرار لها، فأثناء وجودي طالبا بالمدرسة العليا للدفاع الجوي للإقليم وفي العام الدراسي (1993-1994) أشرفت رفقة زملاء دفعتي أذكر منهم:عسة نورالدين وبن أحمد عبد الحميد وغضاضبة كمال وقوادري رضوان وغيرهم –كلهم الآن برتب رائد - على تدريب كتيبة الطلبة الجدد وهو نظام المدارس العسكرية، حيث يشرف طلبة السنة الثالثة على تكوين وتدريب وجمهرة الطلبة المستجدين - السنة الأولى - وكان من بينهم طلبة التكوين الخاص (FS) وهم تابعون لمديرية القضاء العسكري، ويحملون شهادة الليسانس في الحقوق والعلوم الإدارية، وقد تخرجوا معنا برتبة ملازم أول، ثم توزعوا بين المحاكم العسكرية عبر كامل التراب الوطني... وكنت أعلم من قبل بوجود الملازم الأول بن ضو محمد –رحمه الله- والملازم الأول بوريش خالد في هذه المحكمة كقضاة تحقيق، استأذنت النقيب بالذهاب إلى الغرفة التي يرأسها أحدهما، وكانت القريبة منا غرفة الملازم الأول بن ضو محمد، دخلت عليه وقصصت له مأساتي، ثم طلبت منه النظر فيها ومعاونتي إلا أنه أخبرني بما أوجعني، فهو لا يمكنه فعل أي شيء ولا يستطيع أن يتدخل في صلاحيات الادعاء المباشر ولا عنده علاقة وطيدة تسمح له بذلك، تأسف أنه لو كانت القضية بين يديه لأفرج عليّ فورا، للتذكير أن القاضي بن ضو محمد توفي في ظروف غامضة قيل انه إنتحر بغرفته في المحكمة العسكرية، وإن كانت مصادر أخرى أكدت لنا تصفيته بسبب ملفات فساد وإرهاب كان يحقق فيها... ولكنه لما رآني منهارا لدرجة تثير الشفقة وهو الذي يعرفني جيدا، ويدرك أحلامي يشهد لها حضوري الثقافي والإعلامي بالجيش الوطني الشعبي... قال بلهجة الواثق:
- تجلّد... وأصبر... توكل على الله... أعدك أنني سأسعى بكل ما أملك من جهد لتعجيل محاكمتك...!
كان النقيب في أمانة الغرفة ينتظرني، وإن كنت اقترحت عليه الدخول معي إلا أنه فضّل البقاء حتى نكون على راحتنا في الحديث، ولم أتأخر عليه وخرجت أقتلع أقدامي من البلاط كمن يمشي في الوحل بل أتمايل كالثمل... وإن كنت من قبل أدرك أن الأمر تجاوز الجميع ودخولي السجن صار قاب قوسين أو أدنى، ولما كنت أعرفه عن هذا السجن، والذي كنّا نخوّف به أثناء مرحلة التكوين، فكرت في الهرب وكان بوسعي ذلك ولكنّني عدلت عنه في آخر لحظة، حتّى لا أزيد القضية توريطا وأفتح المجال لمن كان همّه الإساءة لي، ليزيد في غيضه شررا، وشفقة بالصديق الذي كنت أكنّ له كل الاحترام، ولما سوف يلحقه من متابعات وأذى، وهو الذي وثق بي وقبل تسليمي لإدارة السجن فتح لي فرصة حتى يطمئن قلبي ليس إلا، بالرغم من يقينه بعدم الوصول لأي منفذ، ولا أحد بوسعه إلغاء قرار الإيداع سوى من وقّعه ولن يتراجع أبدا... وأنا منكسر الخاطر... سيء الحال... وجهي غزته تجاعيد الألم وأنا أفكر في أهلي عندما يبلغهم خبر ورطة ضابط، كانوا يعوّلون عليه كثيرا، وها قد صار نزيل مؤسسة لإعادة التربية... فبدل أن يعيل أسرته تحوّل لسجين... خاطبني النقيب قائلا:
- أعرف جيدا أنه لا حل الآن ولكنني فعلت ذلك لتطمئن فقط ولا تظن السوء بي...!
بالفعل كان الرجل يدرك ما يقول... فسألته:
- والحل الذي تراه الآن!
يجيب:
- لا تقلق لن تمكث كثيرا سوف تحاكم محاكمة خفيفة فقضيتك بسيطة... لو لم تكن للمرة الثانية تدخلها متهما وبالفرار لما سجنوك اليوم أبدا...!
- في تلك المرة كنت طالبا... اليوم أنا مظلوم!
- هذا هو القضاء... توكل على الله!
تنقلنا بخطوات وئيدة نحو إدارة السجن، الذي يقع على بعد أمتار من المحكمة... خرجنا من باب لم ندخل منه أول مرّة، ومشينا في رصيف معبّد تحفه الأشجار وتتوزع على جوانبه، شاهدت بعض الأشخاص يلبسون زيا بنيّا عرفت من النظرة الأولى أنهم مساجين، يقومون بالتنظيف وتطهير الحديقة من الحشيش المتطفل والأشواك... عندها تخيّلت نفسي وأنا في مثل حالتهم، جاثيا على ركبتي أجمع الزبالة... حينها توقف قلبي عن الوجيب، أحس بي رفيقي وبما كان يراودني من خيال لا يشبهه إلا الكابوس... وعيناه متغضنتان بدموع الحنق المشوب بالشفقة والإستجداء حدثني قائلا:
- أراك خائفا...!
ويشير بسبابته إلى شاب كان يجمع القمامة في أكياس، ويتسول لفافات التبغ ممن يمرون عليه وبطريقة كلها حذر وترقب وخوف ربما كان يخشى أن يتفطّن له الحارس المكلف بمراقبتهم... ويستأنف كلامه:
- إنهم جنود... أما أنتم الضباط فلا يمكن أن تشتغلوا أبدا!
تنفست بعض الصعداء حتى طار الدخان من صدري الملتهب... غير أني أجبته ساخرا على ما وصلت إليه:
- ما دمت أوصلت نفسي لهذه الحال وسألبس لباسهم فأضرب بالهراوة ولا ضير في ذلك!!
ونحن نمشي ونتبادل الحديث لفتت نظري يافطة كبيرة تزيّن مدخلا مصبوغا بالدهن الأصفر وجملة بالبنط العريض:
- "المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية"!!
نزلت على صدري كحديد منصهر، وجف لعابي في حلقي كدت أن أختنق... لقد تخيّلت نفسي مجرما خطيرا تترصد آثاره عيون البحث، وإن كنت لا زلت متهما، وأنا على يقين ببراءتي من تهمة تواطأ في تلفيقها الرائد بن علال حسين الذي كان قائدا للمجموعة 14 للوسائل لمضادة للطيران التي كنت أعمل بها وربما بتحريض من صديقه الدكتور محمد لعقاب، الذي كان صحفيا في أسبوعية "الحرية" وكتب عنّي مقالا وقد سمّاه "بورتريه" وضع له عنوانا مثير:
- "الشاعر ابن قصر العطش:متمرد على شعراء الحانات والقبلات " - صحيفة "الحرية" العدد 73 والصادر في الأسبوع:من27/05 إلى 02/06/1996 ونسخة منه في ملحق الوثائق تحت رقم 7.
وابن قصر العطش هو اسمي الأدبي سيأتي الحديث فيه لاحقا، وقد سبب لي المقال الكثير من المتاعب، سبب لي الإعتقال من طرف مركز التحري والإستنطاق ببن عكون وقضيت يوما كاملا في زنزانة تحت الأرض سيأتي الحديث فيها مستقبلا، وخاصة أن الرجل نشر المقال من دون إذني ومعه صورة ساقتها الأقدار إلى أرشيفه الخاص... كانت جملة "المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية" قاصمة للظهر وتردد صداها في أعماقي كما يسمع صوت حجر وهو يرمى في بئر عميقة... ودفعت أسئلة لتطفو على سطحي وتخامر عقلي، بل تشلّ جسدي، وتدفعني إلى ما لا يحمد عقباه من الأجوبة المتعبة...
- هل أنا عديم التربية؟!
- هل أنا خطير على المجتمع حتى يوقى منّي؟!
- ما الذي يحدث لي؟!
- ما مصيري لمّا أخرج من هنا؟!
كان النقيب يحاول شد أزري ورفع معنوياتي التي نزلت للحضيض، وإن كنت في هذه اللحظات صرت أراه عدوّا، لأنه يحملني بين ذراعيه إلى المذبحة ويدعي الشفقة، ولكن لمّا أعود إلى ذاتي أجده رجلا يؤدي واجبا كلّف به، ولا ذنب له في قضيّتي وما في يده شيء قد بخله عني وخاصة لما رأيت في عينيه دموع الحزن، وإن حاول إظهار غير ذلك حتى لا يزيد في حسرتي... ظل يرسم ابتسامات مختزلة تتعرى في حينها لتكشف حقيقة ما يكتنف أعماقه من أسى... دخلنا إلى مكتب مخصص للإيداع ووجدنا فيه ضابطا شابا يحمل رتبة مرشح، يؤدي واجب الخدمة الوطنية، ومعه آخر يحمل رتبة مساعد يبدو في الأربعين من عمره، تسلم الضابط من النقيب ورقة الإيداع وراح يسألني عن اسم والدي ووالدتي وعنواني، وقد احتقرت نفسي أن تسببت في دخول اسميهما الطاهرين إلى مثل هذا المكان... بعدها بصمت بالسبابتين لتؤكد بصماتي بداية الافتتاح الرسمي لعهد جديد لا أعلم نهايته... ودعني النقيب بعدما أوصاني بنفسي خيرا وذكرني بالصبر وأن كل شيء فائت ومر على غيري ما يذكرونه الآن كالمنام... ثم قفل راجعا ولم يستطع أثناءها النظر إلى وجهي، فهو إلى جانب الصداقة التي كانت تربطنا، رقيق المشاعر وطيّب القلب، قيل لي فيما بعد أنه لما عاد إلى الوحدة وبلغ قائدها الرائد بن علال حسين بأمر إيداعي السجن رد عليه منتشيا ومغتبطا ومنتفحا بالكبرياء:
- أحلى خبر سمعته في حياتي!
وقد غضب من قوله ولامه بكل جرأة على ما فعله بي حتى أثار سخط الرائد عليه...!
كانت الساعة في هذه الأثناء تشير إلى منتصف النهار وبضعة دقائق، لذلك بقيت بعض الوقت في انتظار العسكري المكلف بالأمانات والودائع من المطعم حيث كان يتناول وجبة غداءه... خلالها رحت أتبادل مع ذلك المساعد أطراف الحديث، ولقد نسيت اسمه بالرغم من أنه عرفني به وكل ما أذكره عنه أنه رجل هادئ و مثقف، يعرفني من خلال ما كتبته من أشعار وبعض المقالات في مجلّة (الجيش) ومجلة (روضة الجندي) وهما مجلتان تصدران عن مديرية الإعلام والتوجيه للجيش المتواجد مقرها بسطوالي (العاصمة)... استلطف حديثي وبادلني الحوار بصدر رحب ومودة ، عاملني بطريقة متميّزة ومحترمة لا زلت أذكرها، أوعزت ذلك ربما لما يعرفه عني هذا طبعا إلى جانب أنني ضابط...!
حضر بعد مشوار من الحوار العسكري المكلف بالأمانات، فأودعت عنده ما كان معي من أشياء ثمينة وذات قيمة وبعض المال، وكان عقرب الساعة يتكئ على الواحدة ظهرا هذا آخر ما رأيته من ساعتي التي أودعتها أيضا... نادى المساعد الذي آنسني من قبل بحديثه على عسكري يحمل رتبة عريف وكان قويّ البنية يظهر من ملامحه الغلظة وفضاضة القلب... خاطبه آمرا:
- خذه الآن... لا تنسى أن تدخله المطعم!
فكلّمني بلهجة خشنة جدّا وهي عادتهم في معاملة المسجونين وخاصة الوافدين الجدد... قال:
- يلّه...يلّه...!
عندها يتدخل المساعد قائلا:
- ترفق به.... إنه ضابط!
يرمقني بنظرة تتماوج بين الاستهزاء والتردد ثم يأمرني:
- تفضل!
مشينا في رواق طويل تظهر نهايته بعيدة وكنت أمامه وهو يمشي من ورائي يقهقه مع زميل له إلتقاه قبالة المكتب الذي خرجنا منه، وقد تسلل لسمعي بما أخبره عن رتبتي كضابط وتم إيداعي اليوم، ولكن الآخر لم يهتم للأمر، فقد مرّ عليه الكثير من الرتب تبدأ من الجندي وتنتهي باللواء... بعدما تجاوزنا بابا حديديا يتوسط الرواق ويقسمه إلى جزأين، يسهر على غلقه وفتحه عسكري يحمل رتبة جندي ولا يسمح لأي غريب بالمرور إلا بأمر مكتوب من إدارة السجن، باستثناء العسكريين الذين يشتغلون بالسجن... أدخلني إلى قاعة كانت على يساري، وقد خطف بصري كلمة مكتوبة بصباغة بدت قديمة جدا "مطعم" وقد سمعت من قبل أمر المساعد له ووجدت نفسي على موعد أول وجبة غداء في حياتي بالسجن، إن كنت قد فقدت الشهية وسدّ نفسي الاضطراب الذي أتخبط فيه... بدت القاعة واسعة ومخيفة ومرعبة، فيها الطاولات مرصوفة في صفوف تجاوزت الثمانية، أما الكراسي فهي عبارة عن لوحات خشبية تشكل كنبة تمتد على طول الطاولة... أجلسني أحدهم كان بالمطعم في ركن من القاعة، وقد كان المساجين ينظفونه وعيونهم تلسعني، فيهم من طلب منّي لفافة التبغ بإشارة في ظنّه أن الوافد الجديد يحمل معه السيجارة بلا شك... لم أمكث إلا دقيقتين على الأكثر وجاء عسكري يحمل قدرا مصنوعا من الزنك، عليه بقعا سوداء من دخان الموقد، وضعه أمامي بخشونة ورعونة كأنه يطعم كلبه!! كان به معكرونة لم أتحمّل حتى النظر إليها فضلا عن أكلها، فلساني أراه أشرف من تلطيخه بها لأنها تثير التقزز من طعمها الذي لم أتذوّقه ولونها كذلك المزعج ربما لطريقة طبخها... ثم أحضر لي قطعتين من خبز يابس، إقترب مني أحدهم ليعرف تهمتي وما اقترفته من ذنب تسبب في عقابي، وراح يحدثني بلهجة الأمر والاحتقار والاستنطاق وليس بلهجة من يريد معرفة ما يجهله... لما عرف برتبتي العسكرية غيّر من لهجته وطريقة حديثه الفضّة، والذي عرفت فيما بعد أنه مسئول المطعم واسمه قاسي وكان يحمل رتبة عريف أول... تنبّه العسكري الذي جاء بي من الإدارة لامتناعي عن الأكل، فأقترب مني ليخبرني أنني سأتعوّد على هذا الأكل، ويأتي اليوم الذي آكل فيه ما يملأ الشاحنات من العدس واللوبيا... وإن كنت لم أستلطف كلامه المشوب بالاستهزاء والسخرية والفأل السيئ إلا أنني سكتّ على مضض، فطلب أن أحمل معي ذلك الخبز اليابس لعلّني أجوع ولا أجد ما أسد به رمقي... فقلت له:
- وهل هذا وقت الأكل؟!
فزاد في عنجهيته:
- لا شيء يمكنك فعله... الآن النوم والأكل والمرحاض!!
رفضت أن أحمل معي ذلك الخبز اليابس، الذي عمّر على الأقل في سلة المطعم أربعة أيام، حتّى ثلّتي لا تحتمله ولا معدتي لها القدرة على هضمه... عاد وانطلق بي من جديد نحو مكتب آخر غير بعيد من المطعم، لم يكن سوى مخزن للألبسة والأمتعة وفيه تمّ تجريدي من بذلتي الأنيقة وكل لباسي، دككتهم بلا حذر في كيس بلاستيكي من أكياس الدقيق، وممّا حدث أنني كنت أعلّق في سترة البذلة دبوسا يحمل صورة العلم الجزائري، وإن كنت في وضع لا أحسد عليه، فقد فضّلت عدم إهانته في ذلك الكيس الحقير، ونزعته وسلّمته هدية إلى العسكري مسئول المخزن، ولو كان بوسعي لأخذته معي ولكنه لا يسمح بحمل أي شيء حتى اللباس الداخلي فيه غير مسموح به وخاصة الألبسة التي فيها صورا أو لها أذرع طويلة... ربطت عنق الكيس بخيط بعدما علقت به ورقة سجل فيها اسمي ورقمي الخاص... ثم لبست الزي الجنائي والمتمثل في سروال وسترة وقبعة ذات اللون البنّي الغامق ثم حذاء عسكريا من نوع "بالاديوم"، سلّمني فراشا وهو عبارة عن بساط ميدان كانت لنا معه ذكريات في مهماتنا الجبلية المختلفة، أعطاني أيضا حافظة أدوات النظافة (Sace de toilette) بها فرشاة ومعجون أسنان وقطعة صابون لغسل الملابس وكأسا بلاستيكيا... كالعادة حدثني مسئول المخزن كالسابقين ليعرف حكايتي وما اقترفته من جرم، لم أجبه سوى بكلمات مختصرة:
- أنا ضابط وتهمتي هي الفرار!!
دعا لي بالفرج القريب، وأن يفكّ الله غمّتي من محنة لبست كفنها في الحين وتحوّلت إلى صورة من رأيتهم من قبل في حديقة المحكمة وأثاروا شفقتي، لمّا رأيتهم يكنسون وينظفون ويحفرون ويحملون على أكتافهم أكياس المهملات والقاذورات، وإن اختلفت عنهم في بذلتي التي كانت جديدة فقط... للمرة الأخرى ينطلق بي في الرواق نفسه وبعدما تجاوزنا بابا حديديا كالأبواب التي سبقته، أدخلني ساحة تتوسط البنايات المتقابلة، وكان فيها مجموعة من العسكريين الحرّاس، وآخرين مساجين يقومون بالتنظيف والبنايات التي هي أجنحة للمساجين تشكل نجمة خماسية هي في الأصل نجمة العلم الوطني وكنت أعرف ذلك من قبل، حسبما روي لي من طرف العسكريين الزملاء وما أكثرهم الذين ساقتهم أقدارهم إليه... إلا أنني من شدة حنقي على حالي وعلى ما آلت إليه ظروفي صرت أراها سداسية تشكل نجمة داوود، ربما أرى نفسي بناية أخرى ستنهار حتما وفي القريب العاجل...!
استقبلني أحدهم كان يحمل رتبة مساعد أول ويبدو فضا غليظا لا يختلف عمن رأيتهم من قبل، وسألني بغضب شديد، وصوته يلعلع كالبارود كأنه يريد تخويفي:
- من تكون؟!
ثم زاد:
- لماذا دخلت السجن؟!
قبل أن أجيبه قاطعني العسكري الذي رافقني، وأمرني بالاعتدال في وقوفي وتحيته، لأن الذي يتحدث إليّ هو المساعد الأول عطاء الله رئيس فوج الحرّاس... بالرغم من معرفته برتبتي العسكرية إلا أنه تعمد ما قاله، ربما رغبة في رضا المساعد الأول أو إهانتي وخاصة أنهم يترصدون لمثل هذه الفرص للنيل من الضبّاط... اعتدلت كما أمرت فقد بدا من لهجته وطريقة كلامه أنه سيعاملني بوحشية قد تصل إلى الضرب المبرح إن عصيت الأمر، هذا إلى جانب ما كنت أعلمه مسبقا ومن خلال ما رواه لي عسكريون ساقتهم أقدارهم إلى مثل قدري، وهو ما يندى له الجبين من القسوة والرعونة والوحشية... لما أخبرته بحالي ساورني الاحتقار لنفسي، أن آلت بي الأمور إلى أحط الدرجات، فأنا ضابط كانت لي صولات وجولات ويسمع أمري قبل النطق به بالرغم مما كنت أتمتع به من معاملة خاصة لكل الناس أغضبت علي قيادتي كثيرا، أقف الآن ذليلا وأقدم التحية العسكرية إلى من هو دوني رتبة، هذا مساعد أول ربما يصل بي الحال إلى تحية الجنود الذين يعاقبون من لم يناديهم بغير المرخص به في قانون السجن المعمول به داخليا:
- Chef ...!
أحس المساعد الأول بي وشم رائحة ما ساورني حينها فصبّ على النار البنزين... بقوله:
- كنت ضابطا خارج السجن... أما الآن فأنت بلا رتبة!
لم أرد عليه تهكّمه وإن كنت في أمس الحاجة إلى كلام يعيد لي الروح لا يخنقني... فسألني:
- من أي ولاية أنت؟!
أجبته بصوت متحسّر ومنكسر النبرات:
- تبسّة...!
لانت ملامحه حتى خيّل لي أنه من تبسّة أيضا، ثم استدار نحو أحد الحرّاس الذين كانوا يقفون غير بعيدين منّا وأمره أن ينادي على الحلاق... استدار نحوي ضاحكا وقال:
- البذلة زادتك جمالا وما ينقصك إلا الحلاقة والعطور!!
زاد حنقي فقد أحسست أنه يتعمّد السخرية مني، ولكني لم أستطع فعل أي شيء، فأنا كالشاة الذبيحة بين يدي من يتفنن في سلخها... فقلت:
- مظلوم وتآمروا عليّ!
قاطعني:
- كل من يدخل السجن يدعي أنه مظلوم!!
زدت تأكيدا له وتحديت كل الارتياب الذي كان يركض في شراييني:
-... أؤكد لك أنني مظلوم!
شدّه ما غزى ملامحي من تقاسيم الإصرار والصدق... فدعا لي قائلا:
- ربّي يفرج عليك...!
- آمين... آمين!
رق لحالي وذابت تلك القسوة الأولى في لحظة كما يذوب السكر في الشاي الساخن، حينها يحضر الحلاق ولم يكن سوى سجينا مثلي، والصدفة أنه سألني عن مدينتي وأخبرته فكان بدوره من المدينة نفسها، ومن عائلة أعرفها في العاصمة ومدينة الشريعة التي نتحدر منها (ولاية تبسة – الشرق الجزائري)، كان اسمه صدار فيصل دخل السجن بتهمة القتل الخطأ، حيث كان يعمل في الحرس الجمهوري وطاردوا "إرهابيا" تسلل بين الناس فرآه وأطلق النار عليه من سلاحه، أدت طلقة طائشة وعشوائية إلى مقتل مواطن فحكم عليه بسنتين نافذة... حلق شعري على الدرجة صفر وقد عاملني بلطف لما عرف صلتي به، بعدما كان يصول ويجول بآلة الحلاقة (Tendeuse) كأنه يجزّ عنزة متشردة... حتى أنني تحدّثت في قرارة نفسي:
- هذا سجين مثلي ومعاملته هكذا فما بالك بالحراس!
وكأنه كان يشم رائحة ما فارت به أعماقي... فقال مؤكّدا:
- لو لم تكن من الشريعة لما حلقت لك هذه الحلاقة الجميلة!!
ويا لها من حلاقة ما تصوّرتها يوما، قد رأيتها في الآخرين ولم أراها في نفسي، لأنه كان يحلق لي شعــر رأسي- طبعا- في الساحة ولا مرآة عنده حتى أرى فيها حالي الجديدة، ثم أخذني إلى حنفية غير بعيدة منّا، وكانت تضخّ الماء بقوة تقتلع فروة الرأس، غسلته من الشعر المتناثر على كتفي والذي سدّ حتى أنفي وفمي... بعدما أكملت الغسل ومسحت رأسي بمنشفة قذرة أحضرها الحلاق سريعا، أمر المساعد الأول عطاء الله حارسا ناداه برضا، أن يأخذني إلى البناية "C " ويدخلني الزنزانة الرابعة... استدار نحوي ليخبرني بأنها الأفضل ففيها الماء وبعض النزلاء المحترمين...!!
هنا كانت البداية الفعلية للحياة الجديدة، ودخلت الزنزانة الرابعة على الساعة الثانية تقريبا، حسب الحساب الشخصي فنظرتي الأخيرة على ساعتي كانت في الأمانات وقدرت الوقت بناء على ذلك... كان اليوم صيفيا وحارا وقيضه يحرق أديم جسدي، وقد تركت الناس في الخارج مصطافين على الشواطئ... حظيت أن أزلت بعض غمّها بالماء البارد الذي غسلت به رأسي، إلا أن غم عمقي لا يطهّره إلا الخروج من هذا المأزق، الذي تدحرجت في جبّه من حيث لا أحتسب... الله أعلم بالنهاية!!
2) في الزنزانة الرابعة!
كانت أول مرة في حياتي أدخل فيها السجن، وأجد نفسي من وراء القضبان ونزيلا متألما بين أربعة جدران، وفي حصن منيع تجاوزت شهرته حدود الوطن، منذ المحاكمة الشهيرة لقادة الحزب المحل –كما ذكرنا سابقا - وزاده بسطة في الشهرة اللواء المتقاعد مصطفى بلوصيف لما نزله متهما في قضايا سال فيها الحبر الكثير... وإن دأبت قبلها على محلاّت التأديب في المدرسة العليا للدفاع الجوّي للإقليم (ESDAT) بالرغاية، إلا أن الأمر يختلف جملة وتفصيلا... فتح الحارس بابا حديديا، وبمفتاح ضخم كبير يثير الفزع فيمن يراه أول مرّة، وبعدما قرع عدة مرات بلا رأفة ولا رحمة كأنه يريد تنبيه النزلاء بوصوله أو ربما يرعبهم فقط، كنت لا أعلم أسباب ذلك ولما فتحه هرب إلى يمينه من الحمم والبخار التي تنبعث من داخلها، وكأنه فتح قدر مرق محكم الغلق بعد تسخينه لساعات... بالفعل انتابني شعور غريب وقاتل كشعور من أدخل على مقصلة إعدامه، جعلني لا أحتمل نفسي ولا أقدامي قادرة على تحمل تبعات جسد جريح... كانت الزنزانة عبارة عن غرفة لا تتجاوز 6متر مربع، أول ما واجهني نافذة بها قضبان غليظة ومغطاة من الخارج بحديد لا يظهر شيئا، وتظهر خطوط شمسية تتسلل من ثقوب، كأنها تنقل الأمل إلى وجوه يائسة من وضعها ودكناء مما تعيش فيه، في زاويتها اليسرى مرحاضا يحيط به حائط صغير لا يستر من يقضي حاجته، وتنبعث منه رائحة كريهة جدا لا يتحمل البقاء ثانية واحدة فضلا عمن سيعيش أياما بقربه، ووجدت بها ثمانية نزلاء يفترشون أبسطة ممزقة ، يتناثر إسفنجها في كل الجوانب... كانت رائحة العرق تنبعث وكأنني دخلت حماما... حيطانها صفراء اللون زادتها الرطوبة عمقا، وعليها رسومات وكتابات ترغب في الصبر وأخرى تحث على التمرد... آيات قرآنية وأحاديث نبوية ونصوص لعلماء وأخرى لمسجونين، ترغب في الإيمان وتدعو للجهاد، وتتحدث عن فضائل الشهادة وما ينتظر الشهيد من خير عند ربه، وتدفع بقارئها إلى وجوب قتال ما سموه بـ " الطواغيت "و"أعداء الله" أو تحقيق "دولة الإسلام" وإشارات تبدو لأصحابها وهو يعدون الأيام بمرارة ويحسبون ما قضوه بين الجدران الأربعة... أرضية الزنزانة من الإسمنت الخشن الذي يثقب جنوبنا... أما السقف فدهانه أبيضا إلا أنه صار أسودا من الرطوبة، وربما حتى من دخان الأسى المنبعث كالغبار من صدور ملت التنفس في عمق محنة تشبه الموت لحد بعيد...
كان النزلاء يلعبون "الدومينو " المصنوع من ورق البسكويت أو كرتون يجلب من الزبالة وسلات القمامات، لما فتح الباب دسوه تحت الفراش حتى لا يراه الحارس لعلهم يخشون غضبه... استقبلوني وكلهم شغف لمعرفة قصتي، وإن كانت تهمتي واضحة لأن البناية لا يدخلها إلا المتهمون بالفرار، وهذه عادة المسجونين يتلهون ويتسلون بقصص الوافدين الجدد، بل يحاكمونهم كل حسب معرفته بالقانون وشؤون القضاء، أو من خلال القصص المشابهة التي مرت عليهم... راحوا يسألون عن الأحوال في الخارج، وعن النتائج الانتخابية البرلمانية التي جرت في 5جوان 1997م، وشهدت أكبر عملية تزوير في تاريخ الجزائر قادها حينها رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وزادوا شغفا بحكايتي لما عرفوا أنني ضابط، وقد كانت الرتبة الكبيرة بينهم "رقيب أول " وهي لأحدهم يدعى "محمد" من عين تيموشنت، ويشتغل في الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال (ولاية تيبازة)، وكلهم متهمون بالفرار من وحداتهم، تبدأ مدة فرارهم من ثلاثة أشهر وتنتهي بسبع سنوات... كانت حالتي النفسية منهارة جدا... غضبي تجاوز الحنق وبراكيني تنفجر بحمم وشظايا تنذر بالشؤم، وفي داخلي ألعن اليوم الذي إخترت فيه المؤسسة العسكرية مرة، وأخرى ألعن أقداري التي ساقتني على وجهي في هذا النفق المجهول، بل وصل بي القنوط إلى الكفر باليوم الذي ولدت فيه وجئت لهذه الدنيا!!
قام النزلاء وبكل احترام وتودد وفرشوا لي مكانا بينهم، وقد كانوا ينامون على الأرض ولا يوجد نصف سرير بالبناية كلها، عدا الطابق الثاني الذي سيأتي الحديث فيه لاحقا... طلبوا منّي أن آخذ قسطي من الراحة، فلم يبق إلا القليل ونغادر الزنزانة... وأي راحة يمكن أن تزورني أو تقترب من أسواري في هذا المكان الموحش والقذر جدا، وتحت حرارة صفدت جسدي عرقا في الثواني الأولى من دخولي... التفت إليّ أحدهم وقد عرّفني باسمه وهو السعيد، كان رجل في العقد الخامس من عمره، فرّ من ثكنته منذ أكثر من سبع سنوات، ولكن لما وجد نفسه مضايقا ترك فلاحته وماشيته بنواحي ثنيّة الحد بولاية تيسمسيلت وآثر تسوية وضعيته، وهو في الزنزانة منذ سبعة وثلاثين يوما ومن دون محاكمة، ذلك ما زادني خوفا من المجهول والرحلة التي ستطول حتما بي في مكان أفقدني صوابي في اللحظات الأولى، لا أدري كيف سيكون الحال بعد أيام؟ راح يحدثني عن حالته المعنوية وعن أولاده، ويحثّني على الصبر والتناسي فلا شيء بإمكاني فعله سوى التوكل على الله والدعاء إليه... ثم راح يصف لي طبيعة الحياة في السجن وأفواج الحراس، ثم استرسل يحذرني من الأشياء التي تجلب لي السخط والعقوبة... ووصف لي خشونة الحراس وخاصّة أحدهم أطلقوا عليه "عمي صالح" والذي يصفونه بالجلاد والوحش الذي لا يرحم كبيرا ولا صغيرا، ولن ينجو أي سجين من صفعاته مهما احترس وانضبط... عندها تذكرت الملازم الأول صيفي محمد، وهو زميل سابق في المدرسة العليا للدفاع الجوي للإقليم (ESDAT )، أشرف على تدريبنا لما التحقت أول مرة بالمدرسة عام 1991... وعلى ما أعلم أنه مسجون منذ فترة ... قلت له:
- ما دمت هنا منذ مدة فهل تعرف الضابط صيفي محمد؟!
فأشار بسبابته إلى كلمات مكتوبة في زاوية الزنزانة عند رأسه، وهو المكان نفسه الذي كان ينام فيه صيفي... وهي عبارة عن الآية القرآنية: (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين) سورة البقرة(153)
أنا إخترت هنا التي في سورة البقرة وهي موجودة أيضا في سورة الأنفال من الآية 46 وقد كتبها بخط يده... ثم أخبرني أنه مكث ما يقارب الشهرين في تلك الزاوية وتعذّب كثيرا وبكى الأكثر وقد منّ الله عليه وفرّج كربته... لما بلّغني بذلك راودني الإحساس بالفراغ الرهيب، وفقدان من كان سيؤانسني في وحشتي ويبيد الأوجاع المتربصة، وبقدر ما فرحت له بالخروج من المأزق الذي لا يتمناه أحد لعدوّه فضلا عمن كان محل احترام وتقدير، بقدر ما افتقدته وترك ثغرة في وجداني لا يملأها غير الإفراج الذي أراه بعيدا، فالوافد لمثل هذه الأماكن تجد الأمنية الوحيدة التي تراوده وتدغدغ مشاعره أن يجد شخصا على الأقل يعرفه من قبل، حتى يعاونه على تجاوز الموج العاتي خاصة في أول وهلة من دخوله... ارتحت إلى السعيد فقد بدت عليه الطيبة والأخلاق العالية، وآخر اسمه بومازة فريد من منطقة طاورة بنواحي ولاية سوق أهراس شرق البلاد، آخر لا أذكر لقبه العائلي ولكن اسمه محمد من الرويسات بورقلة وهي آخر ما زرته قبل أيام فقط مع أخي أحمد ومكثنا فيها ستة أيام...
كانت أشعة الشمس المتسلّلة داخل الزنزانة فألهبتها وحولتها إلى حمام حرارته عالية جدا، صفدت الأجساد عرقا كالماء، ففاح النزلاء برائحة كريهة من عدم الاغتسال، وإن كانوا محظوظين بحنفية تجلب الماء من حين لآخر... قال السعيد:
- الجو حار ويحرق كما ترى وزنزانتنا، هي الأفضل من الآخرين في الطابق الأول والثاني خاصّة، فهم يحملون الماء في قارورات ويحافظون عليها للشرب فقط... فتجد مراحيضهم تفوح نتنا... يا لطيف!!
اقشعر جلدي... دار رأسي بوجع فجّره... اختنقت من العفن... وكدت أن أتقيّأ مما تخيّلته من حديث السعيد... أما فريد فراح يصف لي طبيعة العيش بأكثر دقة قائلا:
- الصباح نخرج للباحة (la cour ) على الساعة العاشرة فيتم تغيير فوج الحراّس... ثم على الحادية عشرة والنصف نعود مجددا إلى الزنزانة... على الثانية والنصف ظهرا نخرج مرة أخرى ونمكث في الباحة حتى الرابعة لنتناول العشاء، ونعود مرة أخرى للزنزانة على الرابعة والنصف... وكل الأيام عدا الخميس والجمعة فيتغير الوقت بزيادة نصف ساعة على موعد الخروج ويبقى موعد الدخول ثابتا...!
ينبّهه محمد التموشنتي ساخرا:
- ونسيت فطور الصباح!
فيجيبه محمد الورقلي:
- يا له من فطور حقير... قبل أن نخرج من هنا صباحا يحضروا لنا الحليب وهو ماء أبيض لا فيه سكر ولا حتى الملح!
يتكلّم آخر:
- يارب فرج علينا!
فيهتف الجميع بحماس إيماني فياض:
- آمين... آمين!
الرابط:
http://www.watan.com/modules.php?nam...ticle&sid=4215
من مواضيعي
0 إذهب إلى الغرب و أخسر أولادك وزوجتك و عش شحاذا على أبواب المؤسسات الإجتماعية
0 من هو أفضل صحفي وكاتب جزائري؟
0 نظام يتغذى بالكوارث والأزمات
0 هل نحاسب على الزندقة أدونيس أم خليدة مسعودي؟
0 وكيل حزب الله في كندا يفتح النار على الكاتب الجزائري أنور مالك
0 انور مالك يفتح النار على سمير القنطار
0 من هو أفضل صحفي وكاتب جزائري؟
0 نظام يتغذى بالكوارث والأزمات
0 هل نحاسب على الزندقة أدونيس أم خليدة مسعودي؟
0 وكيل حزب الله في كندا يفتح النار على الكاتب الجزائري أنور مالك
0 انور مالك يفتح النار على سمير القنطار