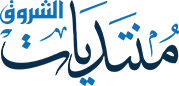حقوق الأخوة ( محاضرة قيمة للشيخ : صالح آل الشيخ ) .
20-01-2009, 04:31 PM
حقـــوق الأُخـــوَّة
بسم الله الرحمن الرحيم
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله، ورسوله، وصفيه، وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد:
فموضوع هذا الدرس حقوق الأخوّة؛ ونعني بحقوق الأخوّة؛ ما يشمل الحق المستحب, والحق الواجب، وليس المراد تفصيل ما هو واجب من تلك الحقوق، وما هو مستحب، وإنما ذِكر الحقوق بعامّة، ومنها ما هو واجب، وما هو مستحب، وهناك حقوق أخرى تُركت أيضا لضيق المقام عنها، وهذا المقام وهو حق الأخوّة؛ حق الصحبة؛ حق الأخ على أخيه، من المقامات العظيمة التي أُكّدت بالنصوص؛ وأُكّدت في الكتاب والسنة، فرعايتها رعاية للعبودية، وإهمالها إهمال لنوع من أنواع العبودية؛ لأن حقيقة العبادة: أنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
ومن الأقوال والأعمال التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها، ما أمر به من أداء حق الأخ على أخيه، وخاصة إذا كان ذلك الأخ قد قامت بينه وبين أخيه مودّة خاصة، ومحبة خاصة، واقتران خاص، فاق أن يكون لمجرد أنه من إخوانه المسلمين، فثَم حق للمسلم على المسلم, للأخ على أخيه من جهة أنه مسلم، ويتأكد ذلك الحق ويزداد إذا كان بين هذا المسلم وبين أخيه المسلم أخوّة خاصة، ومحبة خاصة، ترافقا وتحابا وتشاركا في المحبة في الله وفي طاعة الله، وبعضهم دلّ بعضا إلى الخير، وهداه إلى الهدى وقربه إلى ربه جل وعلا، فثَم حقوق بين هذا وهذا، وهذه الحقوق ينبغي أن يرعاها الأخ المسلم، أن يرعاها المسلم كبيرا كان أو صغيرا، وأن ترعاها أيضا المسلمة، فإذا قلنا حقوق المسلم على المسلم وحقوق الأخوّة فهو شامل للحق، بين الكبار، وبين الصغار، وبين الرجال، وبين النساء أيضا، والله جل جلاله في كتابه العظيم امتن على عباده المؤمنين أن جعلهم بنعمته؛ أن جعلهم بالإسلام إخوانا، قال جل وعلا ﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾[آل عمران:103]، والله جل جلاله لما امتن على عباده المؤمنين بأنه ألّف بين قلوبهم وجعلهم بنعمته إخوانا، دلّنا ذلك، على أن هذه المحبة في الله، وعلى أن هذه الأخوة في الله؛ من النعم العظيمة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب المؤمنين بعضِهم لبعض، ورعاية هذه النعمة والمحافظة عليها، اعتراف بأنها نعمة، وبأنها منَّة من الله جل وعلا، إذ النعم يحافَظ عليها، وإذ النقم يُبتعد عنها ويحذر منها، لهذا قال جل وعلا ﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾[آل عمران:103]، قال بعض أهل العلم في قوله (بِنِعْمَتِهِ) التنبيه على أن حصول الأخوّة، وحصول المحبة بين المؤمنين، إنما هو بفضل الله جل جلاله، وهذا دلّت عليه الآية الأخرى، قال جل وعلا ﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾[الأنفال:63]، فالذي جعل هذا يحب ذاك، جعل هذه القلوب على اختلاف أقطارها، واختلاف جنسياتها، واختلاف قبائلها، واختلاف طبقاتها، جعلهم متحابين في الله، يشتركون في أمر واحد، وهو إقامة العبودية لله جل جلاله، هو أنهم صاروا إخوة في الله جل جلاله بفضل الله سبحانه وبنعمته، وقد قال سبحانه ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾[يونس:58]، وإن أعظم النعمة، وأعظم الرحمة التي يُفرح بها هذا القرآن العظيم، وسنة النبي r، وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾[يونس:58]، روى أن الصّدقة جاءت إلى المدينة فخرج عمر رضي الله عنه وخرج معه مولاه لأرض الصّدقة, أو للمكان الذي تجتمع فيه إبل الصدقة، فلما رأى الغلام هذه الكثرة الكاثرة من إبل الصدقة، ومن الصدقات التي جاءت، وستوزع بين المسلمين، قال له: هذا فضل الله ورحمته يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت ولكن فضل الله ورحمته القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم ما يُفرح به أن يكون المرء ممتثلا لما جاء في هذا القرآن، وما أمرنا الله جل وعلا به، وما نهانا عنه في هذا القرآن؛ لأنه خير لنا في هذه الحياة الدنيا وفي العاقبة.
والأحاديث التي تحث على أن يكون المرء المسلم يألف ويؤلف كثيرة جدا، فقد حثَّ النبي r على ذلك، وبين فضيلة الأخوّة، وفضيلة التحاب في الله، وفضيلة أن يكون المؤمن يألف ويؤلف، وأن يكون قريبا من إخوانه في عدد من الأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام «إن أقربَكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنُكم أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون» وفي حديث آخر رواه أحمد وغيره مروي من طرق، وهو حديث صحيح أن النبي r قال «المؤمن يألف ويؤلف» وفي لفظ «المؤمن مَألفة» يعني يألفه من يراه؛ لأنه لا يرى لإخوانه، لا يرى للناس إلا الخير، وقد أمر الله جل وعلا الناس بذلك بعامة في قوله جل وعلا ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾[البقرة:83]، قال عليه الصلاة والسلام «المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي r قال «إن الله جل جلاله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» أين المتحابون بجلالي يعني الذين تآخوا محبة في الله، ورغبة في الله، لم تُقرب بينهم أموال، لم تقرب بينهم أنساب، وإنما أحب هذا لهذا لا لغرض من الدنيا وإنما لله جل جلاله، وهذا هو الذي دلّ عليه الحديث الآخر المتفق على صحته المشهور؛ «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فهذه النصوص تدل على عظم شأن المحبة في الله، وعلى عظم شأن أن تقام الأخوّة في الله على أساس من المحبة التي جاءت في النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة، وإذا كان كذلك، وإذا كانت المحبة على الفضل العظيم، فهناك حقوق بين المتحابين هناك حقوق للأخوّة، حقوق لهذا الأخ الذي أحب أخاه لهذا المسلم الذي بينه وبين أخيه المسلم عقد أخوّة، عقد أخوّة إيمانية قال الله جل وعلا في شأنها ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ﴾[التوبة:71]، قال العلماء معنى قولِه (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) يعني بعضهم ينصر بعضا، بعضهم يُوادّ بعضا، بعضهم يحب بعضا إلى سائر تلك الحقوق، فالموالاة عقد بين المؤمن والمؤمن، بين المسلم والمسلم، ولها درجات بحسب تلك العلاقة، وتلك المودّة بين الأخ والأخ، هذه الحقوق متنوعة ونذكر بعضا منها:
الحق الأول من تلك الحقوق؛ حقوق الأخوّة، أن يُحبّ أخاه لله لا لغرض من الدنيا؛ وهو الإخلاص في هذه العبودية التي هي أن يعاشر أخاه، وأن يكون بينه وبين أخيه المسلم، بينه وبين هذا الصاحب الخاص، أن يكون بينه وبينه محبة لله لا لغرض من الدنيا، فإذا كانت المحبة لله بقيت، أما إذا كانت لغرض من أغراض الدنيا فإنها تذهب وتضمحل. فالإخلاص في المحبة, الإخلاص في معاملة الأخوّة؛ أن يكون المرء يحب المرء لله جل جلاله، كما ثبت في الصحيح أن النبي r قال «ثلاث من كنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» فبين أن هذه الثلاث من كن فيه، ذاق بهن حلاوة الإيمان, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إذن فليس الشأن أن تكون مُحِبا لأخيك، وإنما الشأن في هذه العبودية التي تمتثل ما أمر الله جل وعلا به، أن تكون محبتُك لهذا الخاص من الناس، أو محبتُك لإخوانك، أن تكون لله لا لغرض من الدنيا، فإذا أحببته فلما في قلبه من محبة الله، لما في قلبه من التوحيد، لما في قلبه من تعظيم الله جل جلاله، لما في قلبه من متابعة النبي r،لما عمل بذلك من إظهار التوحيد على نفسه وجوارحه، وإظهار السنَّة على نفسه وجوارحه، فهذه هي حقيقة المحبة التي هي أول الحقوق، ومعنى كون ذلك حقا أن يخالط المرء إذا خالطه؛ أن يخالطه إذا خالطه وهو يريد من هذه المخالطة أن تكون العلاقة بينهما لله، إذا خالطه على أن المخالطة هذه لله، وهو يُضمر شيئا من أمور الدنيا، فهو في الحقيقة قد غشه, لأن أخاه لا يعلم ما في قلبه، فيظن أن مآخاته لله جل وعلا، ومحبته في الله جل جلاله، وفي الحقيقة إنما آخاه لغرض من أغراض الدنيا يصيبها، محبة المرء لله جل جلاله تثمر ثمرات، تثمر أن يكون العبد في محبته لأخيه قد وفَّى بالحقوق التي ستأتي أنه إذا أحبه لله فإنه في كل معاشرة وكل معاملة يعامل بها أخاه فإنه يخشى الله جل جلاله؛ لأن الذي بعث هذه المحبة في نفسه هو محبة الله جل جلاله فأحب هذا المرء لله، وفي الله، والمحبة الخالصة لله جل جلاله وحده، ولهذا إذا رسخت هذه الحقيقة، وقام المرء بهذا الحق؛ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ظهرت آثار ذلك على قلبه، وعلى تصرفاته، وبقدر إخلاصه، وصدقه في محبته للمرء لا يحبه إلا لله، يظهر أثر ذلك في الحقوق التي ستأتي، ومن آثار ذلك وثمراته أن المحبة إذا كانت لله تدوم، وأما إذا كانت لغير الله فإنها لا تدوم، واستبر ذلك في الناس في علاقاتهم بالناس، في علاقاتهم بإخوانهم، في علاقاتهم بأهل العلم، في علاقاتهم بطلبة العلم، في علاقاتهم مع بعض إخوانهم ممن يملك مالا, أو يملك تجارة، أو له جاه، أو له سمعة، وآخاه وصاحَبَه لا لله وإنما لغرض من أغراض الدنيا، فلما حصل ذلك الغرض انقضت تلك الأخوّة وصار غير شاكر له، أو غير مواصل له فضلا أن يكون أبعد من ذلك -والعياذ بالله- أن يكون ذامّا له مُخْبِرا بسيئاته, مخبرا بأحواله التي رآه منها في سالف زمنه. لا شك أن هذا الحق وهو أول الحقوق؛ أن يوطن المرء نفسه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله يؤتي ثمرات عظيمة في العلاقة، يؤتي ثمرات عظيمة في التعامل، في حفظ الحقوق، وفي العبودية التي هي أعظم تلك الأمور.
الحق الثاني من هذه الحقوق أن يقدّم الأخ لأخيه الإعانة بالمال وبالنفس؛ لا شك أن الناس مختلفون, مختلفون في طبقاتهم، والناس بعضهم لبعض خدم؛ الغني يخدم الفقير والفقير يخدم الغني، من كان ذا جاه فإنه يخدم من كان ليس بِذي جاه، وهكذا فالناس متنوعون، جعلهم الله جل وعلا كذلك، ليتخذ بعضهم لبعض سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، وسنة الله جل وعلا في تصنيف الناس، وهذا إذا كان كذلك فإن من حق الأخوة، من حق الصحبة الخاصة، أن يسعى المرء في بذل نفسه، في بذل ماله لأخيه الخاص؛ لأن حقيقة الأخوّة أن يؤثر المرء غيره على نفسه، كما وصف الله جل وعلا الذين امتثلوا ذلك بقوله ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾[الحشر:9],فالإيثار من حقوق الأخوّة المستحبة، فإذا كان هذا في درجة الإيثار فذاك من الخير؛ لكن نطلب شيئا أقل من الإيثار، من حقوق الأخوّة في الإعانة بالمال والنفس؛ أن يتفقده بشيء فاضل في وقته، أن يتفقده بشيء فاضل في ماله، أن ينظر إلى أخيه، ينظر إلى حاجاته، وقد قال بعض العلماء إن من آداب أداء هذا الحق أن لا ينتظر أن يسأله أخوه ذلك الشيء، بل يبتدأ هو ويبحث عن حاجة أخيه الذي صافاه ووادَّه في الله جل جلاله، وقد كان أمر النبي r كما روى مسلم في الصحيح أمر بعض الصحابة أن يلقوا ما معهم الآخرين من الصحابة في بعض الغزوات حتى قال الراوي: حتى لم يكن أحدنا يرى أن له فضلا على أخيه. وهذا لاشك من المراتب العظيمة، لكن هذه المسألة -وهي بذل المال وبذل النفس- هذه مسألة عظيمة، ولها مراتب، فمن حقوق الأخوة أن تبذل مالك لأخيك؛ نطلب بذل المال الفاضل، إذا كان عندك شيء زائد تقرضه، وقرض المسلم مرة خير وإحسان، وإذا أقرضه مرتين فهو صدقة، كأنه تصدّق على أخيه بتلك الصدقة، كما روى ابن ماجة في سننه: «من أقرض أخاه مرتين فهو كالصدقة عليه» وهذا أمر عظيم، بذل المال من غير سؤال، تتفقد حاجته، رأيته بحاجة إلى مال، رأيت حالته رثّة، رأيته بحال ليست بمحمودة، وأنت قد وسَّع الله جل وعلا عليك، فتبذل الفاضل من ذلك، تواسيه بذلك، والأحسن تواسيه بذلك، لأن في هذا بذل الفضل، ولأن في هذا إقامة عقد الأخوة، والذي يبذل مبتدءا ليس كمن يبذل مسؤولا، وقد قال الله جل وعلا في صفة المؤمنين ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾[الفتح:29]، وكونهم رحماء بينهم يقتضي أن بعضهم يرحم بعضا، وبعضهم يرحم بعضا فيما يحتاجه؛ يحتاج إلى بذل الجاه، يحتاج إلى بذل المساعدة، يحتاج أن تساعده في نفسه، في بيته، يحتاج أن تساعده في جهده في إصلاح شيء، ضاق وقته عن بعض الأشياء عنده مهمات وعنده سفرات، فحق الأخ على أخيه -حقوق الأخوة الخاصة- أن تسعى في ذلك، لأن عقد الأخوة الخاصة يقتضي البذل، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي r قال: «مَثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» وفي الحديث الآخر حديث صحيح معروف «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا».
إذن فهذا الحق وهو بذل النفس؛ أن يُعَوِّدَ الأخ أن يبذل نفسه لأخيه، أن يبذل بعض وقته لأخيه، أن يبذل بعض ماله لأخيه، وأن يسعى في ذلك، يُقيم في القلب حقيقةً التخلص من الشح، والمؤمن مأمور بأن يتخلص من الشح أمر استحباب، وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك بقوله﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾([1]) شُحّ النفس يكون بأنواع، يمكنه أن يذهب مع أخيه إلى مكان ليُعَرِّفه عليه، أو ليبذل جاه، أو ليذكره عند أحد، فيبخل بهذا الجهد، ويشح بالنفس، ويشح ببعض الوقت على أخيه. ما حقيقة الأخوّة إذا لم يكن ثم بذل، وثم عطاء في هذه المسائل وفي غيرها؟ وقد جاء في الحديث أيضا «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» فإذا كنت موطنا نفسك في هذه المسائل أن تبذل لصفيِّك، أن تبذل لخليلك، أن تبذل لصاحبك، فإن ذلك من حقوق الأخوة التي من بذلها قبل السؤال فإنه قد أدى شيئا عظيما، ومن بذلها بعد السؤال فإنما أدى ما وجب عليه أو ما استحب له، لكن مكارم الأخلاق والإقبال على الخير أن تبتدأ بالشيء قبل أن تُسأل عنه، لهذا كان بعض السلف يتفقد حاجة إخوانه من دون أن يُعرف، كم روي لنا من أحوال السلف أنهم دسّوا أموالا؛ دسّوا بعض المال في بيت إخوانهم من دون أن يُعلم من هذا الذي أرسل، ومن هذا الذي أعطى، وقد قال الربيع بن خثيم مرة لأهله: اصنعوا لي طعاما -وكان يحب ذلك النوع من الطعام- فصنعه له أهله كأحسن ما يكون، فأخذه وذهب به إلى أخ له مسلم ابتلاه الله جل وعلا بأنه ليس بذي لسان وليس بذي سمع وليس بذي بصر، يعني أصيب بمصيبة فقد معها البصر وفقد معها اللسان وفقد معها السمع، فإذا أتاه هذا وأطعمه أو أهدى إليه، فمن الذي يعلم بحاجته؟ من الذي يعلم بما أعطى؟ هذا الرجل لن يعلم ما فعله به الربيع بن خثيم مثلا، فأتى الربيع بن خثيم وأخذ هذه الحاجة؛ هذا الطعام الخاص الذي يحبه هو، وذهب به إلى ذلك الرجل الذي هو من إخوانه المؤمنين في بلده، فأخذه وأخذ يطعمه شيئا فشيئا حتى غذَّاه وأشبعه، فلما انصرف، فقيل له: يا ربيع فعلت فعلا لا ندري وجهه؟ قال: ما فعلت؟ قالوا: فعلت إذ أطعمت هذا، وهو لا يعرفك، ألم تكتفِ أن أعطيته أهله فأطعموه؟ قال: لكن الله جل جلاله يعلمه. وكم من آثار للسلف في هذا الباب فقد رعى بعض السلف حال أولاد أخ له يعني صاحب له رعى أحوال أهله وأحوال ولده أربعين سنة حتى توفي، قالوا فكأننا لم نفقد أبانا كأنهم ما فقدوا أباهم لشدة ما حصل لهم من البذل في ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذُكر عنه أنه لما مات بعض المشايخ الذين كانوا يعادونه، كان يسعى في حاجة أهله، في حاجة صغاره، ذلك أنه وإن عاداه فثَم حق للأخوة خاص؛ حق لعقد الإسلام، وهؤلاء المساكين من لهم؟ لهم الذي تخلص من شهوة نفسه, وتخلص من الانتصار لنفسه فبذل لهم, وكان يتعاهد أبناء وأهل أعدائه الذين عادَوه وسعوا به، إلى آخر ذلك، وهذا لاشك من امتثال الشرع، وجعل الشرع فوق هوى النفس، وفوق مُرادات النفس، هذا كله يحصل وربما وُفّق إليه الكثير، وهناك مرتبة من المراتب يُحث عليها وهي أن كثيرين قد يبذلون، وقد يكون له مع إخوانه مواقف حسنة ومواقف طيبة، لكنه يرى أن له فضلا بعد الإعانة، يرى أن له فضلا أن قَدَّم له، يرى أن له فضلا أن أعانه بمال، أن أعانه بجاه، أن أعانه ببذل، وحقيقة العبودية التامة، أن يكون المؤمن الذي بذل وأعطى شاكرا لله جل جلاله، أن جعله سببا من أسباب الخير، التي ساق الخير على يديها، فإن الله جل جلاله يستعمل بعض عباده في الخيرات، ومن الناس من عباد الله من هو مفتاح للخير مِغلاق للشر، فالعبد إذا أعان أخاه وإذا أعطاه وإذا بذل نفسه, إذا بذل جاهه له فإنه لا يستحب له، بل إنه ليس بمحمود في حقه، ولا هو من مكارم الأخلاق، أن ينتظر الثناء، وأن يُصبح يذل ويمنُّ بهذا الذي عمله، فإن حقيقة الإخلاص والمحبة وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يعامله لأجل أمر الله جل وعلا بذلك، فينتظر الأجر والثواب من الله جل جلاله.
الحق الثالث من حقوق الأخوّة حفظ العِرض، وهو حق عظيم من الحقوق، بل لا يكاد تُفهم الأخوة الخاصة إلا أن يحفظ الأخ على أخيه عرضه، والأخوّة العامة؛ أخوّة المسلم للمسلم قد أمر النبي r فيها بحفظ الأعراض، فقد ثبت في الحديث الصحيح، حديث أبي بكرة في البخاري ومسلم وفي غيرهما، أن النبي r قال في خطبته يوم عرفة في خطبته في حجة الوداع يوم عرفة «إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» إلى آخر الحديث، فعِرض المسلم على المسلم حرام بعامة، فكيف إذا كان بين المسلم والمسلم أخوّة خاصة وعقد خاص من الأخوة, كيف لا يحفظ عرضه، وقد قام بينهم من الأخوة والمحبة الخاصة ما ليس بينه وبين غيره، إذا كان المسلم مأمورا أن يحفظ عرض أخيه الذي هو بعيد عنه، الذي ليس بينه وبينه صلة ولا محبة خاصة، فكيف بالذي بينه وبينه موادّة، وتعاون على البر والتقوى، وسعي في طاعة الله، وفي العبودية لله جل جلاله، واكتساب الخيرات، والبعد عن المآثم.
لحفظ العرض مظاهر؛ لأداء هذا الحق مظاهر, هذا الحق أن تحفظ عرض أخيك الذي بينك وبينه أخوّة خاصة، وكذلك أخوك الذي بينك وبينه أخوّة عامّة لذلك مظاهر؛ من مظاهره:
أولا أن تسكت عن ذكر العيوب؛ لأن المصادقة أو الأخوة الخاصة تقتضي أن تطّلع منه على أشياء، يقول كلمة، يتصرف تصرفا، فعل فعلا, ما معنى الأخوة الخاصة إلا أن تكون مؤتمنا على ما رأيت، أن تكون مؤتمنا على ما سمعت، وإلا فيكون كل واحد يتحرز ممن يخالطه، فليس ثَم إذن إخوان صدق، ولا إخوان يحفظون المرء في حضوره، وفي غيبته، مما حَدَا ببعض الناس لما رأى الزمن -زمنه- لما رأى زمنه خلا من هذا الصديق، وهذا المحب الذي يحفظ عِرضه، ويكون وفيًّا معه، هداه أن ألف كتابا وسماه (تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب) لأنه وجد الكلب إذا أحسن إليه من ربَّاه، فإنه يكون وفيا له، حتى يبذل دمه لأجل من أحسن إليه، فقال تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، لأن كثيرين يخونون؛ يخالط مخالطة خاصة، ويطّلع على أشياء خاصة، ثم ما يلبث أن يبُثَّها، وأن يذكر العيوب التي رأى، وأن يفضحه بأشياء، لو كان ذاك يعلم أنه سيخبر عنه لعدّه عدوا، ولم يعدّه حبيبا موافيا، لهذا من حق أخيك عليك أن تحفظ عرضه بالسكوت عن ذكر عيوبه، سواء بمحضر الناس في حضرته، أو في غيبته من باب أولى، فإن حق المسلم على المسلم أن يحفظ العرض فكيف إذا كان ذلك خاصا.
‚من مظاهر حفظ هذا الحق أن لا تدقق معه السؤال، وأن لا تبحث معه في مسائل لم يبدها لك، مثلا تراه في مكان، فتقول ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ما الذي حضر بك؟ لماذا ذهبت إلى فلان؟ (وُوشْ عندك وفلان؟) إلى آخره من التدخل فيما لا يعني, إذا أحب أخبرك، وإذا لم يحب فإن الكتمان له فيه مصلحة، والمرء من حُسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه، ما ثبت ذلك على النبي r بقوله «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فإذا رأيته في حال، إذا رأيته متوجها لشيء، فلا تسأله عن حاله، لا تسأله عن الوُجهة التي هو ذاهب إليها؛ لأن عقد الأخوة لا يقتضي أن يخبرك بكل شيء، فإن للناس أسرارا وإن لهم أحوالا.
ƒالمظهر الثالث من مظاهر حفظ العرض أن تحفظ أسراره, وأسراره هي التي بثها إليك، بثّ إليك نظرا له، بثّ إليك رأيا رآه في مسألة, تكلمتم في فلان، فقال لك رأيا له في فلان، تكلمتم في مسألة فله رأي فيها بثَّه إليك؛ لأنك من خاصته، ولأنك من أصحابه، ربما يخطئ وربما يصيب، فإذا كنت أخا صادقا له فإنما بث إليك ذلك لتحفظه لا لأن تشيعه، لأن مقتضى الأخوة الخاصة أن يكون ما بين الأحباب سر، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داوود في سننه «الرجل إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت عنه فهي أمانة» هي أمانة، والله جل وعلا أمرنا بحفظ الأمانات، وحفظ الأعراض، لأنّك إذا ذكرت هذا الرأي منه، فإن الناس سيقعون فيه، ترى منه رأيا عجيبا، تقول فلان يرى هذا الرأي، فلان يقول في فلان كذا، ما معنى الأخوَّة؟ هل تُشيع عنه ما يرغب أن يُشاعَ عنه؟ بل أعظم من ذلك أن يأتي أخ بينه وبين أخيه عقد أخوّة خاصة فيستكتمه على حديث فيقول: هذا الحديث خاص بك لا تخبر به أحدا. فيأتي هذا الثاني ويخبر ثالثا ويقول: هذا خاص بيني وبينك ولا تخبر أحدا. ثم ينتشر في المجتمع والأول غافل عنه، كما قال الشاعر:
فهذا واقع، فإن المرء إذا اصطفى آخر؛ إذا اصطفى صاحبا له، أخا له فأخبره بسر، فلا بد من الكتمان، خاصة إذا استأمنه عليه، فإذا لم يستأمنه عليه فكما قال النبي r «إذا حدَّث الرجلُ الرجلَ بحديث ثم التفت عنه فهي أمانة» فكيف إذا استكتمه إياه، ولم يأذن له بذكره، من مظاهر حفظ العرض أن يُحجم المرء عن ذكر المساوئ التي رآها في أخيه، أو في أهله أو في قرابته، أو في ما سمع منه، مثلا واحد يتّصل بأخيه، فيسمع -وهذا ساكن مثلا مع أهله أو منفرد- فيسمع في بيته ما لا يُرضي، فيذهب ويخبر؛ يقول: سمعت في بيت فلان كذا وكذا، وكذا. أو يراه على حال ليست بمحمودة، فيذهب يخبر بمساوئه، ليس هذا من حفظ العرض، بل هذا من انتهاك العرض، والواجب عليك أن تحفظ عرض أخيك، وإذا سمعت شيئا عنه، أو رأيته هو على حال، أو تكلم بمقال، أو رأيته على شيء لن يحمد، أو نحو ذلك فحفظ عرضه هو الواجب، لا أن تبذل عرضه، وأن تتكلم فيه؛ لأن العرض مأمور أنت بحفظه، والمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. مسألة النصيحة تأتي إن شاء الله بحق خاص فيما يكون بين الإخوان من التناصح.
قد قال عليه الصلاة والسلام «لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا» لقد اشتمل على كلمتين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المتفق على صحته «لا تحسسوا ولا تجسسوا» الفرق بين التحسس والتجسس كما قال طائفة من أهل العلم -وثَم خلاف في ذلك- قالوا: التجسس يكون بالعين، والتحسس يكون بالأخبار، دليل ذلك قوله جل وعلا ﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾[يوسف:87]، (تَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ) من التحسس، وهو طلب الخبر، أما التجسس فنهى الله جل وعلا عنه في قوله ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾[يوسف:12]، التجسس بالعين، تبدأ تنظر تتبعه، رأيته يسير في مسير، فتنظر إليه وتتبعه حتى تعرف خبره, لا اِحْمَدِ الله جل وعلا أن لم ترَ من أخيك إلا خيرا، كذلك التحسس ما أخبار فلان؟ إيش قال فلان؟ وهو من إخوانك وأصحابك الصادقين الذين بينك وبينهم خُلّة، وبينك وبينهم، وفاء وصحبة، فلا تحسس في أخباره، ولا تجسس عليه، فإن ذلك منهي عنه المسلم مع إخوانه المسلمين بعامة، فكيف بمن له معهم عقد أخوّة خاصة، لا تحسسوا يعني لا تتبع أخبار إخوانك، ولا تتجسسوا يعني لا تذهب بعينك, تنظر ما ذا فعل، وما ذا فعل، فإن هذا من المنهي عنه وهو من المحرمات.
الحق الرابع من الحقوق أن تُجنِّب أخاك سوء الظن به, لأن سوء الظن به مخالف لما تقتضيه الأخوة، مقتضى الأخوة أن يكون الأخ لأخيه فيه الصدق والصلاح والطاعة، هذا الأصل في المسلم، الأصل في المسلم أنه مطيع لله جل وعلا، فإذا كان من إخوانك الخاصة، فإنه يكون ثم حقان؛ حق عام له، وحق خاص بأن تجنبه سوء الظن، وأن تحترس أنت من سوء الظن، والله جل وعلا نهى عن الظن، فقال سبحانه ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾[الحجرات:12]قال العلماء على قوله جل وعلا (اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) أن الظن منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، فما كان من الظن محمودا، هو ما كان من قبيل الأمارات والقرائن التي هي عند القضاة، وعند أهل الإصلاح، وأهل الخير، الذي يريد النصيحة أو يريد إقامة القرائن والدلائل عند القاضي، فالقاضي يقيم الحجة ويطلب البيّنة، وكثير منها قائم في مقام الظنون، لكن هنا يجب أن يأخذ بها، فالاجتناب لكثير من الظن؛ وهذا الظن هو أن تظن بأخيك سوءا، أن تظن بأخيك شرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام «إياكم والظن» فهذا عام، ظنٌّ من جهة الأقوال، ونهي عن الظن من جهة الأفعال، «فإن الظن أكذب الحديث» هذا نصه عليه الصلاة والسلام, الظن هو أكذب ما يكون في قلبك، فإن الظن أكذب الحديث إذا حدثتك نفسك من داخلك بظنون، فاعلم أن هذا هو أكذب الحديث، إذن حق أخيك عليك ألا تظن به إلا خيرا، وأن تجتنب معه الظن السيئ كما أمرك الله جل وعلا بذلك بقوله ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾[الحجرات:12]فالظن السيئ إثم على صاحبه، يأثم به لأنه خالف الأصل، وقد روى الإمام أحمد في الزهد ورواه غيره أن عمر رضي الله عنه قال ناصحا: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. لاحظ أنه نهى عن الظن السيئ في الأقوال، ما دام أن الكلام يحتمل الصواب، يحتمل الخير فلا تظنن السوء بأخيك، لأن الأصل أنه إنما يقول الصواب، لا يقول الباطل، فإذا كان الكلام يحتمل الصواب فوجِّه إلى الصواب، فيسلم أخوك من النقد ويسلم من الظن السيئ، وتسلم أنت من الإثم، وأيضا يسلم من التأثر؛ تسلم ويسلم هو من أن يتأثر به ويقتدى به، لهذا قال عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد المعروف قال: المؤمن يطلب المعاذير. يلتمس المعذرة؛ لأن الأحوال كثيرة، والشيطان يأتي للمسلم فيحدّد الحالة، يُحدِّد معنى الكلمة بشيء واحد حتى يوقع العداوة والبغضاء ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ﴾[المائدة:91]؛ الشيطان يحدد لك أن تفسير هذه الحالة هو كذا فقط، أن تفسير هذه المقالة هو كذا فقط، حتى تكون ظانّا ظنا سيئا فتأثم، وحتى يكون بينك وبين أخيك النفرة وعدم الائتلاف، وهناك أصل من الأصول في فهم الكلام وهو أن لكل كلام دِلالة؛ ودلالة الكلام عند الأصوليين متنوعة، ومن دلالاته ما يسمى بالدِّلالة الحملية، يعني دلالة السياق على الكلام، هناك كلام إذا أُخذ بمفرده دل على شيء، ولكن إذا أخذ بسياقه؛ يعني سباقه ولحاقه بما قبله وبما بعده أوضح المراد، فإذا الكلام صادر من مؤمن، صادر ممن بينك وبينه أخوة، سمعت منه كلمة فلا يأتي الشيطان وينفخ فيك أن تحمل هذه الكلمة على المحمل السوء، بل احملها على المحمل الخير يكن في قلبك إقامة المودة مع إخوانك، وأيضا لا يدخل الشيطان بينك وبين إخوانك، فرعاية الدلالة الحملية؛ دلالة الكلام هذه مهمة، وهي التي يعتمدها أهل العلم في فهم الكلام، وكذلك يعتمدها الصالحون في فهم كلام الناس، لأن الناس إنما يُفهم كلامهم على ما يدل عليه الكلام بكله لا بلفظة منه فقط، فإن الألفاظ قد تخون المتكلم، لكن إذا عُلم مقصده في كل الكلام فإنه يُعذر، وقد بينا أن من كلام الناس -يعني في الدرس الماضي- وهو من باب أولى، من كلام الناس ما هو متشابه يشتبه على الناظر فيه، يشتبه على السامع له، فإذا نظر إلى هذا الكلام نظر طالب للمعذرة, طالب لحمل الكلام على أحسن محامله، فإنه يستريح ويُريح، ويبقى هذا الحق ويكون قد أدّى هذا الحق لأخيه, إذن من فسر كلام أخيه تفسيرا مغالطا؛ زاد فيه، حمله على أسوأ المحامل, فإنه لم يؤدِّ حقه، كذلك في باب الأفعال, تصرّف أمامه بتصرف معين، تكلم هذا بكلمة، فإذا الآخر التفت إلى من بجنبه ونظر إليه نظرة، فأتاه الشيطان فقال: هذا ما نظر إلى ذاك، إلا منتقدا لكلامك، أو إلا عائبا لكلامك ونحو ذلك، لا يدخل الشيطان أيضا في تفسير الأفعال، لأن الأفعال لها احتمالات كثيرة، وقليل من الناس من يسأل أخاه لما تصرفت هذا التصرف، فقد جاء في نفسي منه؟ قليل من يفعل ذلك، ولهذا يأتي الشيطان ويقول: هذا التصرف هو لكذا، وتصرف لأجل هذا المعنى، هو يقصد كذا، هذه التصرفات منه لأجل أن يصل إلى كذا، هو يريد بتصرفه كذا وكذا. التصرفات لها محامل كثيرة، فإذا حملت تلك التصرفات على أمر واحد، وشخَّصت ذلك التصرف فيه، فإنك في الواقع جنيت على نفسك، ولم تحترم عقلك وفكرك، لأنك جعلت احتمالات التصرف احتمالا واحدا, هذا واحد، والثاني أنك جنيت على أخيك، لأنك جعلت تصرفه محمولا على أسوء التصرفات، أسوء المحامل لا على أحسنها، وقد قال النبي r «إياكم والظنّ, فإنّ الظنّ أكذبُ الحديث».
الحق الخامس من حقوق الأخوّة أن تتجنّب مع إخوانك المراء والممارات, فإن المراء مُذْهِبٌ للمحبة، ومُذْهِبٌ للصداقة، مُفسد للصداقة القديمة، ومُحلّ للبغضاء والتشاحن والقطيعة بين الناس. ما معنى المراء؟ يعني أن يكون ثَم مناقشة، ثَم بحث؛ يبحث رجل مع رجل، تبحث امرأة مع امرأة إلى آخره, كبير مع صغير, صغير مع كبير، فإذا أتى البحث، هذا يتعصب لرأيه، وهذا يتعصب لرأيه، فيماريه فهذا يشتدّ وذاك يشتدّ، هذه حقيقة الممارات؛ أن ينتصر كل منهما لرأي رآه، فيأتي بالأدلة فيرفع صوته، ثُم بعد ذلك يحصل في النفوس ما يحصل، وقد كان بعض ذلك بين الصحابة، فقد قال أبو بكر مرة لعمر: ما أردتَّ إلا مخالفتي. وهم الصحابة رضوان الله عليهم، فيجب أن يكون المسلم مع أخيه، ومع صحبته، ومع خاصته مُتنزهًا عن الممارات، لأن وجهات النظر في المسائل تختلف، كلما توسع نظر المرء، وتوسع عقله وإدراكه، علم أن النظر في بعض المسائل متسع، لا يكون على جهة واحدة, تناقش مسألة من المسائل فتنظر إليها من جهة, وينظر إليها الآخر من جهة أخرى، فتختلف أنت وهو، فإذا اختلفتما فكل منكما له وجهة نظره، فإذا ماريت واستدللت لقولك وتعصبت ثم رفعت صوتك والآخر كذلك حتى حصلت الشحناء؛ حصلت مفسدة ولم تحصل مصلحة، والعاقل ينظر إلى أن الأمور التي يتناقش فيها الناس عادة في أمورهم تختلف وُجهاتها، لها وجهات كثيرة، ولها أسباب كثيرة، قد يأتي ثالث ورابع فيخرج كل واحد برأي جديد, يُخرج كل واحد ممن أتى رأيا جديدا, وجهة نظر جديدة في المسألة المطروحة، فإذن النقاش لا يعني المراء، إذا بدأت المسألة تدخل في المِراء فانسحب سواء كنت محقا أو ترى من نفسك أن الصواب مع أخيك وليس معك، وقد قال عليه الصلاة والسلام «من ترك المِراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة, ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة» فترك المراء محمود، وهو من حق الأخ على أخيه ألا يستدرجه في أن يماريه، لا يستدرجه في أن يجادله, أن لا يستدرجه في أن يكون هذا يرفع الصوت على هذا، حتى تنقطع الأخوّة وحتى يعدو هذا على هذا بالكلام، وإن لم يعدُ بالكلام، فقد يعدو بقلبه، ويظن أن هذا قصد كذا، وخالفه، ويرى كذا، وهذا لا يقدر هذا إلى آخر ذلك من مساوئ الشيطان.
المراء له أسباب؛ أسباب نفسية لابد أن يعالجها المرء في نفسه:
من أسبابه أن يُظهر أنه لم يستسلم لوجهة النظر، يقول رأيا خطئا، فيأتي الثاني فيقول أنت أخطأت ليست كذا هي كذا، فيستعظم أن يخطأ, وإذا أخطأ فالحمد لله، العلماء أخطأوا في مسائل في الدماء ورجعوا عنها، أخطأ بعضهم في مسائل في الفروج ورجعوا عنها؛ في مسائل اجتهادية، الرجوع عن الخطأ مَحْمَدَة وليس بعيب، فكل من رجع عن خطأ أخطأ فهو تاج على رأسه، فهو يدل على أنه روّض نفسه في طاعة الله، وجعل العبودية فوق الهوى، من أسباب المراء هذا الذي ذكرت.
‚ ومن أسبابه الرغبة في الانتصار، هذا يرغب في أن يكون أحسن عقلا، في أن يكون أحسن إدراكا من الآخر، فيبدي وجهات نظر متنوعة، والآخر يبدي وجهات نظر من جهة أخرى، يريد أن يكون فائقا عليه، فيماريه بأن يقول هذا الذي ذكرت، هذه النقطة خطأ بل الأصح أنها كذا، فيدخل في مراء بأسلوب يوقع الشحناء ويوقع البغضاء في القلوب.
ƒمن أسباب المراء أيضا عدم رعاية آفات اللسان، واللسان فيما ينطق، وفيما يتحرك به محاسب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقد قال جل وعلا ﴿خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾[النساء:114], «كُفّ عَلَيْكَ هَذَا» -وأشار إلى لسانه- فقال معاذ: يا رسول الله أو إنا محاسبون على ما نقول, قال «ثَكِلَتْكَ أمّك يَا مُعَاذُ, وَهَلْ يَكُبّ النّاسَ في النّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ, أَوْ قال عَلَى مَنَاخِرِهِمْ, إِلاَ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ» فمن أسباب الممارات عدم رعاية إصلاح اللسان، الاستخفاف باللسان، واللسان كما قيل صغير الجِرم لكنه كبير الجُرم؛ يعني أن ما يحصل من الآفات عن طريق اللسان هذه عظيمة، فبها يتفرق الأحباب، بها تحصل الشحناء، بها تحصل العداوة، بها يدخل العدو، بها يدخل من يريد أن يوقع بينك وبين أحبابك، يدخل الكثير من جراء اللسان, فمن لم يحفظ لسانه من جرّاء الممارات في المسائل المختلف فيها التي تكون في المجالس عادة، فإنه يقع ولا بد ويكون بينه وبين إخوانه ما لا يحمد.
أخيرا في الممارات وفي المراء, المراء مضاد لحسن الخُلق، فإن الناظر إذا تأمل ما يجب عليه من حسن الخُلق، فإنه لا يماري، لأن الممارات فيها انتصار، وفيها استعلاء على الآخر، وهذا مضاد لحسن الخلق، بل تُبدي ما عندك بهدوء ولين، فإن قُبل منك فالحمد لله، وإلا تكون ذكرت وجهة نظرك, بعض الناس في المجالس يؤدي به المراء أن يكرر نفس الفكرة عشر مرات, عشرين مرة وهي، هي، يعيدها بصيغة أخرى، هذا ما يحمله على ذلك؟ يحمله الانتصار للنفس، أو أسباب أخرى الله أعلم بها، أو غفلة عما يجب عليه، إذا أوردتها مرة فُهمت عنك فلا تماري في ذلك؛ لأن حقيقة المراء أنه مضاد لحسن الخلق، والمسلم مأمور بأن يحسّن خلقه، والنبي r أمرنا بذلك في أحاديث كثيرة.
الحق السادس من حقوق الأخوة بذل اللسان لأخيك؛ اللسان كما أنه في حفظ العرض كففت اللسان عن أخيك، فهنا من الحقوق أن تبذل اللسان له؛ لأن المصاحبة والأخوّة قامت على رؤية الصور فقط، أم على الحديث؟ إنما قامت على الحديث، وحركة اللسان هذا مع حركة لسان الآخر تُقيم بين القلوب تآلفا، فلذلك لابد أن تبذل اللسان لأخيك.
لهذا مظاهر:
تبذل اللسان في التودُّد له، يعني لا تكن شحيحا بلسانك عن أن تتودد لأخيك، والنبي r قال «إذا أحب أحدكم أخاه فليُعلمه فإذا أعلمه فليقل الآخر أحبك الله الذي أحببتني فيه»، هذا من أنواع بذل اللسان، وهذا يورث المودة، يورث المحبة، ومن الناس من يقول هذه الكلمة وهو غير صادق فيها، أو غير عالم بحقيقة معناها، يقول أحبّك في الله، إذا قلت لآخر أحبك في الله، فمعنى ذلك أن في قلبك محبة لهذا؛ محبة خاصة في الله ولله، فيقتضي أن تحفظ حقه، أما أن تقول له أحبك في الله وأنت في الحقيقة لا تحفظ له حقا، فما حقيقة المحبة إذن، الأول أن تتودد له باللسان؛ بمثل أن تقول له هذه الكلمة، بأن تتكلم معه بأحسن الكلام، وقد قال جل وعلا ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ﴾[الإسراء:53]، قال ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[الإسراء:53]، فهذا بذل اللسان لأخيه أن تنتقي في معاملتك مع إخوانك ومع خاصتك بل ومع المسلمين بعامة أن تنتقي اللفظ الحسن فقط؟ لا , ولكن أحسن الألفاظ لأن الله جل وعلا أمر بذلك فقال﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ﴾[الإسراء:53]فإذا توددت له باللسان وذكرت له أحسن ما تجد فإن هذا فيه إقامة علاقة القلب ومحبة القلب وفي هذا من المصالح التي تكون في المجتمع المسلم وفي قلوب المؤمنين بعضهم مع بعض ما يضيق المقام عن ذكره وعن تَعداده.
‚ من مظاهر التودد باللسان أو بذل اللسان له؛ من مظاهر بذل اللسان للأخ أن تثني عليه في غير حضوره إذا خالطتَ أحدا وتعلم من أخيك هذا صفات محمودة، تثني عليه في غير حضوره؛ لأنك إذا أثنيت عليه في حضوره صار مدحا، والمدح ممنوع لأنه يورث عجباً، لكن تثني عليه في غير حضوره، هل الثناء عليه لابد أن يبلغه، فتقوم المحبة صادقة، فتقوم المحبة قياما صحيحا, الثاني أن ذكر محاسن أخيك عند غيرك تجعل أولئك يجتهدون في الإقتداء، ويعلمون أن الخير فيه أناس كثيرون يعملون به، فالمرء إذا ذُكر عنده الخير تشجع له، وإذا ذكرت عنده الشرور تشجع لها، فذكر الخيرات في المجالس هو الذي ينبغي، أما ذكر الشرور وذكر الآفات وذكر المعايب فإنه هو الذي يجب الالتفات عنه، لأن في ذكر المعايب ما ييسر سبيل الإقتداء بأهلها فيها، وفي ذكر المحاسن والثناء على أصحابها فيه ما يشجع على الإقتداء بهم فيها، فإذن من حق أخيك عليك أنك إذا نظرت له من حسنة فلا تخفها، وإذا نظرت منه إلى سيئة فأخفها، وفي ذلك من المصالح ما هو معلوم، أيضا يتبع هذا المظهر أنه إذا أثني عليه فتدخل السرور على قلبه بإبلاغه بالثناء عليه, أثنى عليك بعض الأخوة في مجلس, أثنى عليك فلان لأنه هو لا يعلم, فإذا علم أن فلانا أثنى عليه صار قلبه محبا له، والناس محبون لمن أحسن إليهم:
والإحسان يكون بالكلمة كما يكون بالفعل، فإذا سمعت أن هناك من يثني عليه فتبلغه؛ الحمد لله والله أثنى عليك فلان وقال عليك خيرا نسأل لك الثبات ونحو ذلك، وهذا يشجعه، الآخر ينبغي له في حقه أن ينتبه لنفسه، وإذا اُثني عليه يعلم أن المنة من الله جل وعلا عليه عظمت، وأن شكر الله بملازمة ما أثني عليه به من الحق، وألا يغتر بنفسه.
ƒ من مظاهر بذل اللسان للأخ شكرُه على بذله وعلى حسن المعاملة، لأن النبي r قال «لا يشكر الله من لا يشكر الناس», «من صنع إليكم معروفا فكافئوه» إذا لم تجد ما تكافؤه تجازيه خيرا؛ تدعو له, تشكره، هذا من حق الأخ لأخيه, من الناس من يأخذ ويأخذ ويأخذ ولا يعوض ولا يثني ولا يذكر، إذا لما استطعت أن تبذل بكلمة، أبذل برسالة، أبذل بورقة، بنصف ورقة، فإن هذا فيه أثر، وفيه تشجيع لأبواب الخير، وقد قال علي فيما روي عنه (من لم يحمد أخاه على حسن النية، لم يحمده على حسن الصنيعة), هذه مرتبة عُليا؛ من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنيعة؛ لأن أخاك إذا بذل لك فإنه في أول الأمر حَسَّن نيته معك، وعاملك معاملة من يريد الخير، قد يكون بذل لك فعلا، أو يكون أراد أن يبذل، ولم يحصل له، يشكره حتى على حسن النية على ما قام في قلبه، لأن في هذا عقد للأخوة، وفيه تشجيع على بذل الخير، وأن يبذل كل أخ لأخيه, من لم يحمد أخاه على حسن النية،لم يحمده على حسن الصنيعة، يعني لو فعل معه صنيعة فإنه ربما لم يحمده عليها.
الحق السابع من حقوق الأخوة العفو عن الزَّلات، وهذا باب واسع، باب عظيم؛ لأن ما من متعاشرَين، ما من متصاحبين، ما من متآخيين، أو ما من متآخيين، إلا ولابد أن يكون بينهم زلات، لابد أن يطلع هذا من هذا على زلة، على هفوة، لابد أن يكون منه كلمة، لأن الناس بشر، والبشر خطّاء، «كُلّكم خَطّاءٌ. وَخَيْرُ الْخَطّائِينَ التّوّابُونَ»فمن حق الأخوة أن تعفو عن الزلات.
الزلاّت قسمان: زلات في الدين وزلات في حقك, يعني زلات في حق الله وزلات في حقك أنت:
· أما ما كان في الدين؛ إذا زلّ في الدين بمعنى فرّط في واجب؛ عمل معصية، فإن العفو عن هذه الزلة أن لا تشهرها عنه، وأن تسعى في إصلاحه، لأن محبتك له إنما كانت لله، وإذا كانت لله فأن تقيمه على الشريعة، وأن تقيمه على العبودية، هذا مقتضى المحبة, فإذا كانت في الدين تسعى فيها بما يجب؛ بما يصلحها، إذا كانت تصلحها النصيحة فانصح، إذا كان يُصلحها الهجر فتهجر، والهجر كما ذكرنا لكم في درس سالف الهجر نوعان: هناك هجر تأديب, وهناك هجر عقوبة, هناك هجر لحضك، وهناك هجر لحض المهجور، إذا كان هو عمل زلة، فما كان لحضه هو إذا كان ينفع فيه الهجر فتهجره, إذا كان بين اثنين من الأخوة والصحبة والصداقة ما لا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر فرأى أحدهما من أخيه زلة عظيمة، رأى منه هفوة بحق الله جل وعلا، فيعلم أنه إذا تركه ولم يجبه، إذا لقيه بوجه ليس كالمعتاد، فإنه يقع في نفسه أنه عصى، ويستعظم تلك المعصية، لأن هذا لا يستغني عن ذاك، فهذا يُبذل في حقه الهجر، لأن الهجر في هذه الحال مصلح، أما من لا ينفع فيه الهجر، فالهجر نوع تأديب وهو للإصلاح، ولهذا اختلف حال النبي r مع المخالفين؛ مع من عصى، فهجر بعضا، ولم يهجر بعضا، قال العلماء: مقام الهجر فيمن ينفعه الهجر فيمن يصلحه الهجر ومقام ترك الهجر فيمن لا يصلحه ذلك.
· أمّا ما كان من الزلات في حقك، فحق الأخوّة أولا أن لا تعظِّم تلك الزلة, يأتي الشيطان فينفخ في القلب، ويبدأ يكرر عليه هذه الكلمة، يكرر عليه هذا الفعل حتى يعظمها، يعظمها وتنقطع أواصل المحبة والأخوة، ويكون الأمر بعد المحبة وبعد التواصل، يكون هجرانا وقطيعة للدنيا، وليس لله جل جلاله, سبيل ذلك أن تنظر إلى حسناته؛ تقول أصابني منه هذه الزلة، غلط علي هذه المرة، تناولني بكلام، في حضرتك أو في غيبتك، لكن تنظر إلى حسناته، تنظر إلى معاشرته، تنظر إلى صدقه معك في سنين مضت، أو في أحوال مضت، فتعظم الحسنات، وتصغر السيئات، حتى يقوم عقد الأخوة بينك وبينه، حتى لا تنفصل تلك المحبة.
الحق الثامن من حقوق الأخوة الفرح بما آتاه الله جل وعلا, فرح الأخ لأخيه بما آتاه الله جل وعلا، الله سبحانه قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم، فضَّل بعضهم على بعض، فحق الأخ لأخيه، وحق الأخ على أخيه أنه إذا آتى اللهُ جل وعلا واحدا من إخوانك فضلا ونعمة فتفرح بذلك، وكأن الله جل وعلا خصك بذلك، وهذا من مقتضيات عقد الأخوّة، وهذا طارد للحسد، ومن لم يكن فرحا بما آتى اللهُ جل وعلا إخوانه فإنه قد يكون غير فرح مجردًا، وقد يكون غير فرح وحاسد أيضا، وهذا من آفات الأخوة فإنك تنظر أحيانا فترى أن هذا إذا رأى على أخيه نعمة، أو رأى أن أخاه قد جاءه خير وفضل من الله جل وعلا، وأسدى الله جل وعلا عليه نعم خاصة، بها تميز عمن حوله، أو تميز عن أصحابه، فإنه يأتي ويعترف بنفسه لهذا، لما أوتي هذا الشيء؟ أو ينظر في نفسه أن هذا لا يستحق هذا الشيء، أو نحو ذلك، وهذا من مفسدات عقد الأخوة، بل الواجب أن تتخلص من الحسد، وينبغي لك أن تفرح لأخيك، وأن تحب له كما تحب لنفسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام «لا يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ حتى يُحِبّ لأِخِيه ما يُحِبّ لِنَفْسِهِ» قال أهل العلم (لا يُؤْمِنُ) يعني الإيمان الكامل، (لا يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ) الإيمان الكامل، (حتى يُحِبّ لأِخِيه ما يُحِبّ لِنَفْسِهِ)؛ تحب لنفسك أن تكون ذا مال، فكذلك أحب لأخيك أن يكون ذا مال, تحب لنفسك أن تكون ذا علم، أحب لأخيك أن يكون ذا علم, تحب لنفسك أن يُثنى عليك، كذلك أحب لأخيك أن يثنى عليه, وهكذا في أمور شتى وكثيرة, فطارد الحسد أن تفرح بما من الله جل وعلا به على إخوانك، وكأن الله جل جلاله حباك بهذا، فإن المؤمن ينبغي له، ويُستحب، بل ويتأكد بحقه أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام «لا يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ حتى يُحِبّ لأِخِيه ما يُحِبّ لِنَفْسِهِ»يغني من الخير كما جاء ذلك مقيدا في رواية أخرى، فأمور الخير بعامّة، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، ولا تحسد أحدا على شيء من فضل الله ساقه إليه.
في المال: إذا أنعم الله جل وعلا على أخيك بمال، وصرت أنت معدما مثلا، أو قليل المال، وذاك في عزٍّ، وفي مال وفير، تستغرب من تصرفاته، تستغرب من مشترياته، تستغرب من أحواله، تستغرب من كرمه إلى آخر ذلك، فاحمد الله جل وعلا أن جعل أخاك بهذه المثابة، وكأنك أنت بهذه المثابة، ووطِّن نفسك على أن يكون ما أنعم الله جل وعلا به على أخيك كأنه أنعم عليك.
كذلك في العلم: من الناس من لا يفرح بما آتى الله جل وعلا أخاه من العلم، يسمع أخاه مثلا حقّق مسألة تحقيقا جيدا، أو تكلم في مكان بكلام جيد، أو ألقى خطبة جيدة، أو أثر في الناس بتأثير بالعلم، ساق العلم مساقا حسنا ونحو ذلك، فيظل يعتلج في نفسه ذلك، ولا يفرح أن كان أخوه بهذه المثابة، وعلى هذه الحال، هذا لا يسوغ، بل من حقوق الأخوة أن تفرح لأخيك بالعلم، إذا كنت مثلا لست مثله في العلم، أو كنت متخلّفا عنه في العلم، وكان هو أحدّ فهما، أو كان أحدُّ حفظا، أو نحو ذلك، سبقك في ذلك، فاحمد الله جل جلاله أن سخر من هذه الأمة، وأن جعل من هذه الأمة من يبذل هذا الواجب ويكون متقدما فيه، لا تكن حاسدا لإخوانك على هذا.
والحسد داء قاتل، ومُذهب للحسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام «إياكم والتحاسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» وهذا يكون تارة في العلم، وتارة في المال، وتارة في الجاه، وفي أمور كثيرة, كذلك هذا وهذا متآخين ومتصاحبين يرى أنى أخاه يقدم عليه، أن أخاه له في المجالس كلمة، أن أخاه له جاه، أنه مقدّر، وهو ليس كذلك، فيحمله هذا على أ ن يكون في قلبه شيء على أخيه، وهذا لا ينبغي، بل هذا يدخل في الحسد، والواجب عليه أن يتخلص من الحسد؛ لأن الحسد محرم، والذي ينبغي في حقه أن يحب لأخيه كما يحب لنفسه، وكأنه هو الذي منَّ الله جل وعلا عليه بذلك.
كذلك في الدين والصلاح: من الناس من يُنعم الله عليه، يعني يفتح له باب من أبواب الخير في العبادة، فيكون كثير الصيام، أو كثير الصلاة، وقد سُئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقيل له أنت الإمام، أنت مالك، وشأنك في الناس بهذه المثابة، ولا نراك كثير التعبد، لا نراك كثير الصلاة، لا نراك كثير الصيام، لا نراك مجاهدا في سبيل الله، فقال الإمام مالك لهذا الذي أورد عليه هذا الإيراد: إن من الناس من يفتح الله عليه باب الصلاة، ومنهم من يفتح الله عليه باب الصيام، ومنهم من يفتح الله عليه باب الصدقة، ومنهم من يفتح الله عليه باب الجهاد في سبيل الله، ومنهم من يفتح الله عليهم باب العلم، وقد فُتح لي باب العلم، ورضيت بما فتح الله لي من ذلك. الناس يختلفون، فإذا رأى أخا يتعبد والناس يثنون عليه بتعبداته، قد يحمله عدم الفرح بهذا الثناء على أخيه، أن يذكر عيبا من عيوبه، أن يذكر مقالة أخطأ فيها، أن يذكر شيئا من الأشياء التي ينقص بها من قدره، وهذا مخالف لما ينبغي في حقه، وأن يكون مع أخيه محبا له، كما يحب لنفسه، وأن يسعى في أن يكون أخوه مثنى عليه، ولو كان هو لا يعرف، ليست المسألة بالمقام بين يدي الناس، بل المسألة بالمقام بين يدي الله جل وعلا، بل المسألة في تخليص القلب، وتخليص النفس من أن يكون فيها غير الله جل جلاله، وقد ثبت في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي r قال «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» ينظر إلى القلوب، وينظر إلى الأعمال، قد يكون المرء غير معروف خفي، لا أحد يعرفه، لكن هو عند الله جل وعلا بالمقام العظيم، كما جاء في الحديث «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه».
هناك حقوق أُخر أذكر منها اثنين الحق التاسع والعاشر، وتنظرون فيهما، وتُفرّعون كما ذكرنا:
الحق التاسع أن يكون بينك وبين إخوانك تعاون في الخير والصلاح وقد أمر الله جل وعلا بذلك في قوله ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِوَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة:2].
والحق العاشر والأخير أن يكون بين أصحاب الأخوة الخاصة تشاور وتآلف فيما بينهم وأن لا يكون عند الواحد منهم إنفراد بالأمر بل يكون التشاور والله جل وعلا مدح المؤمنين بذلك في قوله ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾[الشورى:38].
وهذان الحقّان؛ التاسع والعاشر يحتاجان إلى تفصيل، وإلى بيان لكن ضاق الوقت عنه.
أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، المتآخين فيه، الذين قال فيهم «أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي».
وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، المتناصحين في ذلك، الباذلين الخير، المفتِّحين أبواب الخيرات، المغلِّقين أبواب الشرور، وأن يجعلنا ممن يقصدون بأعمالهم وجه الله جل وعلا، وأن يمن علينا بذلك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه، نسأل أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا المسلمين بعامة، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قام بتفرغها الأخ السلفي : سالم الجزائري - جزاه الله خيرا عما فعل وجعله في ميزان حسناته .
[شريط مفرّغ]
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله، ورسوله، وصفيه، وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد:
فموضوع هذا الدرس حقوق الأخوّة؛ ونعني بحقوق الأخوّة؛ ما يشمل الحق المستحب, والحق الواجب، وليس المراد تفصيل ما هو واجب من تلك الحقوق، وما هو مستحب، وإنما ذِكر الحقوق بعامّة، ومنها ما هو واجب، وما هو مستحب، وهناك حقوق أخرى تُركت أيضا لضيق المقام عنها، وهذا المقام وهو حق الأخوّة؛ حق الصحبة؛ حق الأخ على أخيه، من المقامات العظيمة التي أُكّدت بالنصوص؛ وأُكّدت في الكتاب والسنة، فرعايتها رعاية للعبودية، وإهمالها إهمال لنوع من أنواع العبودية؛ لأن حقيقة العبادة: أنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
ومن الأقوال والأعمال التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها، ما أمر به من أداء حق الأخ على أخيه، وخاصة إذا كان ذلك الأخ قد قامت بينه وبين أخيه مودّة خاصة، ومحبة خاصة، واقتران خاص، فاق أن يكون لمجرد أنه من إخوانه المسلمين، فثَم حق للمسلم على المسلم, للأخ على أخيه من جهة أنه مسلم، ويتأكد ذلك الحق ويزداد إذا كان بين هذا المسلم وبين أخيه المسلم أخوّة خاصة، ومحبة خاصة، ترافقا وتحابا وتشاركا في المحبة في الله وفي طاعة الله، وبعضهم دلّ بعضا إلى الخير، وهداه إلى الهدى وقربه إلى ربه جل وعلا، فثَم حقوق بين هذا وهذا، وهذه الحقوق ينبغي أن يرعاها الأخ المسلم، أن يرعاها المسلم كبيرا كان أو صغيرا، وأن ترعاها أيضا المسلمة، فإذا قلنا حقوق المسلم على المسلم وحقوق الأخوّة فهو شامل للحق، بين الكبار، وبين الصغار، وبين الرجال، وبين النساء أيضا، والله جل جلاله في كتابه العظيم امتن على عباده المؤمنين أن جعلهم بنعمته؛ أن جعلهم بالإسلام إخوانا، قال جل وعلا ﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾[آل عمران:103]، والله جل جلاله لما امتن على عباده المؤمنين بأنه ألّف بين قلوبهم وجعلهم بنعمته إخوانا، دلّنا ذلك، على أن هذه المحبة في الله، وعلى أن هذه الأخوة في الله؛ من النعم العظيمة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب المؤمنين بعضِهم لبعض، ورعاية هذه النعمة والمحافظة عليها، اعتراف بأنها نعمة، وبأنها منَّة من الله جل وعلا، إذ النعم يحافَظ عليها، وإذ النقم يُبتعد عنها ويحذر منها، لهذا قال جل وعلا ﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾[آل عمران:103]، قال بعض أهل العلم في قوله (بِنِعْمَتِهِ) التنبيه على أن حصول الأخوّة، وحصول المحبة بين المؤمنين، إنما هو بفضل الله جل جلاله، وهذا دلّت عليه الآية الأخرى، قال جل وعلا ﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾[الأنفال:63]، فالذي جعل هذا يحب ذاك، جعل هذه القلوب على اختلاف أقطارها، واختلاف جنسياتها، واختلاف قبائلها، واختلاف طبقاتها، جعلهم متحابين في الله، يشتركون في أمر واحد، وهو إقامة العبودية لله جل جلاله، هو أنهم صاروا إخوة في الله جل جلاله بفضل الله سبحانه وبنعمته، وقد قال سبحانه ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾[يونس:58]، وإن أعظم النعمة، وأعظم الرحمة التي يُفرح بها هذا القرآن العظيم، وسنة النبي r، وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾[يونس:58]، روى أن الصّدقة جاءت إلى المدينة فخرج عمر رضي الله عنه وخرج معه مولاه لأرض الصّدقة, أو للمكان الذي تجتمع فيه إبل الصدقة، فلما رأى الغلام هذه الكثرة الكاثرة من إبل الصدقة، ومن الصدقات التي جاءت، وستوزع بين المسلمين، قال له: هذا فضل الله ورحمته يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت ولكن فضل الله ورحمته القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم ما يُفرح به أن يكون المرء ممتثلا لما جاء في هذا القرآن، وما أمرنا الله جل وعلا به، وما نهانا عنه في هذا القرآن؛ لأنه خير لنا في هذه الحياة الدنيا وفي العاقبة.
والأحاديث التي تحث على أن يكون المرء المسلم يألف ويؤلف كثيرة جدا، فقد حثَّ النبي r على ذلك، وبين فضيلة الأخوّة، وفضيلة التحاب في الله، وفضيلة أن يكون المؤمن يألف ويؤلف، وأن يكون قريبا من إخوانه في عدد من الأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام «إن أقربَكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنُكم أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون» وفي حديث آخر رواه أحمد وغيره مروي من طرق، وهو حديث صحيح أن النبي r قال «المؤمن يألف ويؤلف» وفي لفظ «المؤمن مَألفة» يعني يألفه من يراه؛ لأنه لا يرى لإخوانه، لا يرى للناس إلا الخير، وقد أمر الله جل وعلا الناس بذلك بعامة في قوله جل وعلا ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾[البقرة:83]، قال عليه الصلاة والسلام «المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي r قال «إن الله جل جلاله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» أين المتحابون بجلالي يعني الذين تآخوا محبة في الله، ورغبة في الله، لم تُقرب بينهم أموال، لم تقرب بينهم أنساب، وإنما أحب هذا لهذا لا لغرض من الدنيا وإنما لله جل جلاله، وهذا هو الذي دلّ عليه الحديث الآخر المتفق على صحته المشهور؛ «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فهذه النصوص تدل على عظم شأن المحبة في الله، وعلى عظم شأن أن تقام الأخوّة في الله على أساس من المحبة التي جاءت في النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة، وإذا كان كذلك، وإذا كانت المحبة على الفضل العظيم، فهناك حقوق بين المتحابين هناك حقوق للأخوّة، حقوق لهذا الأخ الذي أحب أخاه لهذا المسلم الذي بينه وبين أخيه المسلم عقد أخوّة، عقد أخوّة إيمانية قال الله جل وعلا في شأنها ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ﴾[التوبة:71]، قال العلماء معنى قولِه (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) يعني بعضهم ينصر بعضا، بعضهم يُوادّ بعضا، بعضهم يحب بعضا إلى سائر تلك الحقوق، فالموالاة عقد بين المؤمن والمؤمن، بين المسلم والمسلم، ولها درجات بحسب تلك العلاقة، وتلك المودّة بين الأخ والأخ، هذه الحقوق متنوعة ونذكر بعضا منها:
الحق الأول من تلك الحقوق؛ حقوق الأخوّة، أن يُحبّ أخاه لله لا لغرض من الدنيا؛ وهو الإخلاص في هذه العبودية التي هي أن يعاشر أخاه، وأن يكون بينه وبين أخيه المسلم، بينه وبين هذا الصاحب الخاص، أن يكون بينه وبينه محبة لله لا لغرض من الدنيا، فإذا كانت المحبة لله بقيت، أما إذا كانت لغرض من أغراض الدنيا فإنها تذهب وتضمحل. فالإخلاص في المحبة, الإخلاص في معاملة الأخوّة؛ أن يكون المرء يحب المرء لله جل جلاله، كما ثبت في الصحيح أن النبي r قال «ثلاث من كنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» فبين أن هذه الثلاث من كن فيه، ذاق بهن حلاوة الإيمان, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إذن فليس الشأن أن تكون مُحِبا لأخيك، وإنما الشأن في هذه العبودية التي تمتثل ما أمر الله جل وعلا به، أن تكون محبتُك لهذا الخاص من الناس، أو محبتُك لإخوانك، أن تكون لله لا لغرض من الدنيا، فإذا أحببته فلما في قلبه من محبة الله، لما في قلبه من التوحيد، لما في قلبه من تعظيم الله جل جلاله، لما في قلبه من متابعة النبي r،لما عمل بذلك من إظهار التوحيد على نفسه وجوارحه، وإظهار السنَّة على نفسه وجوارحه، فهذه هي حقيقة المحبة التي هي أول الحقوق، ومعنى كون ذلك حقا أن يخالط المرء إذا خالطه؛ أن يخالطه إذا خالطه وهو يريد من هذه المخالطة أن تكون العلاقة بينهما لله، إذا خالطه على أن المخالطة هذه لله، وهو يُضمر شيئا من أمور الدنيا، فهو في الحقيقة قد غشه, لأن أخاه لا يعلم ما في قلبه، فيظن أن مآخاته لله جل وعلا، ومحبته في الله جل جلاله، وفي الحقيقة إنما آخاه لغرض من أغراض الدنيا يصيبها، محبة المرء لله جل جلاله تثمر ثمرات، تثمر أن يكون العبد في محبته لأخيه قد وفَّى بالحقوق التي ستأتي أنه إذا أحبه لله فإنه في كل معاشرة وكل معاملة يعامل بها أخاه فإنه يخشى الله جل جلاله؛ لأن الذي بعث هذه المحبة في نفسه هو محبة الله جل جلاله فأحب هذا المرء لله، وفي الله، والمحبة الخالصة لله جل جلاله وحده، ولهذا إذا رسخت هذه الحقيقة، وقام المرء بهذا الحق؛ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ظهرت آثار ذلك على قلبه، وعلى تصرفاته، وبقدر إخلاصه، وصدقه في محبته للمرء لا يحبه إلا لله، يظهر أثر ذلك في الحقوق التي ستأتي، ومن آثار ذلك وثمراته أن المحبة إذا كانت لله تدوم، وأما إذا كانت لغير الله فإنها لا تدوم، واستبر ذلك في الناس في علاقاتهم بالناس، في علاقاتهم بإخوانهم، في علاقاتهم بأهل العلم، في علاقاتهم بطلبة العلم، في علاقاتهم مع بعض إخوانهم ممن يملك مالا, أو يملك تجارة، أو له جاه، أو له سمعة، وآخاه وصاحَبَه لا لله وإنما لغرض من أغراض الدنيا، فلما حصل ذلك الغرض انقضت تلك الأخوّة وصار غير شاكر له، أو غير مواصل له فضلا أن يكون أبعد من ذلك -والعياذ بالله- أن يكون ذامّا له مُخْبِرا بسيئاته, مخبرا بأحواله التي رآه منها في سالف زمنه. لا شك أن هذا الحق وهو أول الحقوق؛ أن يوطن المرء نفسه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله يؤتي ثمرات عظيمة في العلاقة، يؤتي ثمرات عظيمة في التعامل، في حفظ الحقوق، وفي العبودية التي هي أعظم تلك الأمور.
الحق الثاني من هذه الحقوق أن يقدّم الأخ لأخيه الإعانة بالمال وبالنفس؛ لا شك أن الناس مختلفون, مختلفون في طبقاتهم، والناس بعضهم لبعض خدم؛ الغني يخدم الفقير والفقير يخدم الغني، من كان ذا جاه فإنه يخدم من كان ليس بِذي جاه، وهكذا فالناس متنوعون، جعلهم الله جل وعلا كذلك، ليتخذ بعضهم لبعض سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، وسنة الله جل وعلا في تصنيف الناس، وهذا إذا كان كذلك فإن من حق الأخوة، من حق الصحبة الخاصة، أن يسعى المرء في بذل نفسه، في بذل ماله لأخيه الخاص؛ لأن حقيقة الأخوّة أن يؤثر المرء غيره على نفسه، كما وصف الله جل وعلا الذين امتثلوا ذلك بقوله ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾[الحشر:9],فالإيثار من حقوق الأخوّة المستحبة، فإذا كان هذا في درجة الإيثار فذاك من الخير؛ لكن نطلب شيئا أقل من الإيثار، من حقوق الأخوّة في الإعانة بالمال والنفس؛ أن يتفقده بشيء فاضل في وقته، أن يتفقده بشيء فاضل في ماله، أن ينظر إلى أخيه، ينظر إلى حاجاته، وقد قال بعض العلماء إن من آداب أداء هذا الحق أن لا ينتظر أن يسأله أخوه ذلك الشيء، بل يبتدأ هو ويبحث عن حاجة أخيه الذي صافاه ووادَّه في الله جل جلاله، وقد كان أمر النبي r كما روى مسلم في الصحيح أمر بعض الصحابة أن يلقوا ما معهم الآخرين من الصحابة في بعض الغزوات حتى قال الراوي: حتى لم يكن أحدنا يرى أن له فضلا على أخيه. وهذا لاشك من المراتب العظيمة، لكن هذه المسألة -وهي بذل المال وبذل النفس- هذه مسألة عظيمة، ولها مراتب، فمن حقوق الأخوة أن تبذل مالك لأخيك؛ نطلب بذل المال الفاضل، إذا كان عندك شيء زائد تقرضه، وقرض المسلم مرة خير وإحسان، وإذا أقرضه مرتين فهو صدقة، كأنه تصدّق على أخيه بتلك الصدقة، كما روى ابن ماجة في سننه: «من أقرض أخاه مرتين فهو كالصدقة عليه» وهذا أمر عظيم، بذل المال من غير سؤال، تتفقد حاجته، رأيته بحاجة إلى مال، رأيت حالته رثّة، رأيته بحال ليست بمحمودة، وأنت قد وسَّع الله جل وعلا عليك، فتبذل الفاضل من ذلك، تواسيه بذلك، والأحسن تواسيه بذلك، لأن في هذا بذل الفضل، ولأن في هذا إقامة عقد الأخوة، والذي يبذل مبتدءا ليس كمن يبذل مسؤولا، وقد قال الله جل وعلا في صفة المؤمنين ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾[الفتح:29]، وكونهم رحماء بينهم يقتضي أن بعضهم يرحم بعضا، وبعضهم يرحم بعضا فيما يحتاجه؛ يحتاج إلى بذل الجاه، يحتاج إلى بذل المساعدة، يحتاج أن تساعده في نفسه، في بيته، يحتاج أن تساعده في جهده في إصلاح شيء، ضاق وقته عن بعض الأشياء عنده مهمات وعنده سفرات، فحق الأخ على أخيه -حقوق الأخوة الخاصة- أن تسعى في ذلك، لأن عقد الأخوة الخاصة يقتضي البذل، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي r قال: «مَثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» وفي الحديث الآخر حديث صحيح معروف «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا».
إذن فهذا الحق وهو بذل النفس؛ أن يُعَوِّدَ الأخ أن يبذل نفسه لأخيه، أن يبذل بعض وقته لأخيه، أن يبذل بعض ماله لأخيه، وأن يسعى في ذلك، يُقيم في القلب حقيقةً التخلص من الشح، والمؤمن مأمور بأن يتخلص من الشح أمر استحباب، وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك بقوله﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾([1]) شُحّ النفس يكون بأنواع، يمكنه أن يذهب مع أخيه إلى مكان ليُعَرِّفه عليه، أو ليبذل جاه، أو ليذكره عند أحد، فيبخل بهذا الجهد، ويشح بالنفس، ويشح ببعض الوقت على أخيه. ما حقيقة الأخوّة إذا لم يكن ثم بذل، وثم عطاء في هذه المسائل وفي غيرها؟ وقد جاء في الحديث أيضا «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» فإذا كنت موطنا نفسك في هذه المسائل أن تبذل لصفيِّك، أن تبذل لخليلك، أن تبذل لصاحبك، فإن ذلك من حقوق الأخوة التي من بذلها قبل السؤال فإنه قد أدى شيئا عظيما، ومن بذلها بعد السؤال فإنما أدى ما وجب عليه أو ما استحب له، لكن مكارم الأخلاق والإقبال على الخير أن تبتدأ بالشيء قبل أن تُسأل عنه، لهذا كان بعض السلف يتفقد حاجة إخوانه من دون أن يُعرف، كم روي لنا من أحوال السلف أنهم دسّوا أموالا؛ دسّوا بعض المال في بيت إخوانهم من دون أن يُعلم من هذا الذي أرسل، ومن هذا الذي أعطى، وقد قال الربيع بن خثيم مرة لأهله: اصنعوا لي طعاما -وكان يحب ذلك النوع من الطعام- فصنعه له أهله كأحسن ما يكون، فأخذه وذهب به إلى أخ له مسلم ابتلاه الله جل وعلا بأنه ليس بذي لسان وليس بذي سمع وليس بذي بصر، يعني أصيب بمصيبة فقد معها البصر وفقد معها اللسان وفقد معها السمع، فإذا أتاه هذا وأطعمه أو أهدى إليه، فمن الذي يعلم بحاجته؟ من الذي يعلم بما أعطى؟ هذا الرجل لن يعلم ما فعله به الربيع بن خثيم مثلا، فأتى الربيع بن خثيم وأخذ هذه الحاجة؛ هذا الطعام الخاص الذي يحبه هو، وذهب به إلى ذلك الرجل الذي هو من إخوانه المؤمنين في بلده، فأخذه وأخذ يطعمه شيئا فشيئا حتى غذَّاه وأشبعه، فلما انصرف، فقيل له: يا ربيع فعلت فعلا لا ندري وجهه؟ قال: ما فعلت؟ قالوا: فعلت إذ أطعمت هذا، وهو لا يعرفك، ألم تكتفِ أن أعطيته أهله فأطعموه؟ قال: لكن الله جل جلاله يعلمه. وكم من آثار للسلف في هذا الباب فقد رعى بعض السلف حال أولاد أخ له يعني صاحب له رعى أحوال أهله وأحوال ولده أربعين سنة حتى توفي، قالوا فكأننا لم نفقد أبانا كأنهم ما فقدوا أباهم لشدة ما حصل لهم من البذل في ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذُكر عنه أنه لما مات بعض المشايخ الذين كانوا يعادونه، كان يسعى في حاجة أهله، في حاجة صغاره، ذلك أنه وإن عاداه فثَم حق للأخوة خاص؛ حق لعقد الإسلام، وهؤلاء المساكين من لهم؟ لهم الذي تخلص من شهوة نفسه, وتخلص من الانتصار لنفسه فبذل لهم, وكان يتعاهد أبناء وأهل أعدائه الذين عادَوه وسعوا به، إلى آخر ذلك، وهذا لاشك من امتثال الشرع، وجعل الشرع فوق هوى النفس، وفوق مُرادات النفس، هذا كله يحصل وربما وُفّق إليه الكثير، وهناك مرتبة من المراتب يُحث عليها وهي أن كثيرين قد يبذلون، وقد يكون له مع إخوانه مواقف حسنة ومواقف طيبة، لكنه يرى أن له فضلا بعد الإعانة، يرى أن له فضلا أن قَدَّم له، يرى أن له فضلا أن أعانه بمال، أن أعانه بجاه، أن أعانه ببذل، وحقيقة العبودية التامة، أن يكون المؤمن الذي بذل وأعطى شاكرا لله جل جلاله، أن جعله سببا من أسباب الخير، التي ساق الخير على يديها، فإن الله جل جلاله يستعمل بعض عباده في الخيرات، ومن الناس من عباد الله من هو مفتاح للخير مِغلاق للشر، فالعبد إذا أعان أخاه وإذا أعطاه وإذا بذل نفسه, إذا بذل جاهه له فإنه لا يستحب له، بل إنه ليس بمحمود في حقه، ولا هو من مكارم الأخلاق، أن ينتظر الثناء، وأن يُصبح يذل ويمنُّ بهذا الذي عمله، فإن حقيقة الإخلاص والمحبة وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يعامله لأجل أمر الله جل وعلا بذلك، فينتظر الأجر والثواب من الله جل جلاله.
الحق الثالث من حقوق الأخوّة حفظ العِرض، وهو حق عظيم من الحقوق، بل لا يكاد تُفهم الأخوة الخاصة إلا أن يحفظ الأخ على أخيه عرضه، والأخوّة العامة؛ أخوّة المسلم للمسلم قد أمر النبي r فيها بحفظ الأعراض، فقد ثبت في الحديث الصحيح، حديث أبي بكرة في البخاري ومسلم وفي غيرهما، أن النبي r قال في خطبته يوم عرفة في خطبته في حجة الوداع يوم عرفة «إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» إلى آخر الحديث، فعِرض المسلم على المسلم حرام بعامة، فكيف إذا كان بين المسلم والمسلم أخوّة خاصة وعقد خاص من الأخوة, كيف لا يحفظ عرضه، وقد قام بينهم من الأخوة والمحبة الخاصة ما ليس بينه وبين غيره، إذا كان المسلم مأمورا أن يحفظ عرض أخيه الذي هو بعيد عنه، الذي ليس بينه وبينه صلة ولا محبة خاصة، فكيف بالذي بينه وبينه موادّة، وتعاون على البر والتقوى، وسعي في طاعة الله، وفي العبودية لله جل جلاله، واكتساب الخيرات، والبعد عن المآثم.
لحفظ العرض مظاهر؛ لأداء هذا الحق مظاهر, هذا الحق أن تحفظ عرض أخيك الذي بينك وبينه أخوّة خاصة، وكذلك أخوك الذي بينك وبينه أخوّة عامّة لذلك مظاهر؛ من مظاهره:
أولا أن تسكت عن ذكر العيوب؛ لأن المصادقة أو الأخوة الخاصة تقتضي أن تطّلع منه على أشياء، يقول كلمة، يتصرف تصرفا، فعل فعلا, ما معنى الأخوة الخاصة إلا أن تكون مؤتمنا على ما رأيت، أن تكون مؤتمنا على ما سمعت، وإلا فيكون كل واحد يتحرز ممن يخالطه، فليس ثَم إذن إخوان صدق، ولا إخوان يحفظون المرء في حضوره، وفي غيبته، مما حَدَا ببعض الناس لما رأى الزمن -زمنه- لما رأى زمنه خلا من هذا الصديق، وهذا المحب الذي يحفظ عِرضه، ويكون وفيًّا معه، هداه أن ألف كتابا وسماه (تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب) لأنه وجد الكلب إذا أحسن إليه من ربَّاه، فإنه يكون وفيا له، حتى يبذل دمه لأجل من أحسن إليه، فقال تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، لأن كثيرين يخونون؛ يخالط مخالطة خاصة، ويطّلع على أشياء خاصة، ثم ما يلبث أن يبُثَّها، وأن يذكر العيوب التي رأى، وأن يفضحه بأشياء، لو كان ذاك يعلم أنه سيخبر عنه لعدّه عدوا، ولم يعدّه حبيبا موافيا، لهذا من حق أخيك عليك أن تحفظ عرضه بالسكوت عن ذكر عيوبه، سواء بمحضر الناس في حضرته، أو في غيبته من باب أولى، فإن حق المسلم على المسلم أن يحفظ العرض فكيف إذا كان ذلك خاصا.
‚من مظاهر حفظ هذا الحق أن لا تدقق معه السؤال، وأن لا تبحث معه في مسائل لم يبدها لك، مثلا تراه في مكان، فتقول ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ما الذي حضر بك؟ لماذا ذهبت إلى فلان؟ (وُوشْ عندك وفلان؟) إلى آخره من التدخل فيما لا يعني, إذا أحب أخبرك، وإذا لم يحب فإن الكتمان له فيه مصلحة، والمرء من حُسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه، ما ثبت ذلك على النبي r بقوله «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فإذا رأيته في حال، إذا رأيته متوجها لشيء، فلا تسأله عن حاله، لا تسأله عن الوُجهة التي هو ذاهب إليها؛ لأن عقد الأخوة لا يقتضي أن يخبرك بكل شيء، فإن للناس أسرارا وإن لهم أحوالا.
ƒالمظهر الثالث من مظاهر حفظ العرض أن تحفظ أسراره, وأسراره هي التي بثها إليك، بثّ إليك نظرا له، بثّ إليك رأيا رآه في مسألة, تكلمتم في فلان، فقال لك رأيا له في فلان، تكلمتم في مسألة فله رأي فيها بثَّه إليك؛ لأنك من خاصته، ولأنك من أصحابه، ربما يخطئ وربما يصيب، فإذا كنت أخا صادقا له فإنما بث إليك ذلك لتحفظه لا لأن تشيعه، لأن مقتضى الأخوة الخاصة أن يكون ما بين الأحباب سر، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داوود في سننه «الرجل إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت عنه فهي أمانة» هي أمانة، والله جل وعلا أمرنا بحفظ الأمانات، وحفظ الأعراض، لأنّك إذا ذكرت هذا الرأي منه، فإن الناس سيقعون فيه، ترى منه رأيا عجيبا، تقول فلان يرى هذا الرأي، فلان يقول في فلان كذا، ما معنى الأخوَّة؟ هل تُشيع عنه ما يرغب أن يُشاعَ عنه؟ بل أعظم من ذلك أن يأتي أخ بينه وبين أخيه عقد أخوّة خاصة فيستكتمه على حديث فيقول: هذا الحديث خاص بك لا تخبر به أحدا. فيأتي هذا الثاني ويخبر ثالثا ويقول: هذا خاص بيني وبينك ولا تخبر أحدا. ثم ينتشر في المجتمع والأول غافل عنه، كما قال الشاعر:
وكل سرٍّ جاوز الاثنين فإنه
بنفس وتكسيرِ الحديثِ قمين
قد قال عليه الصلاة والسلام «لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا» لقد اشتمل على كلمتين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المتفق على صحته «لا تحسسوا ولا تجسسوا» الفرق بين التحسس والتجسس كما قال طائفة من أهل العلم -وثَم خلاف في ذلك- قالوا: التجسس يكون بالعين، والتحسس يكون بالأخبار، دليل ذلك قوله جل وعلا ﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾[يوسف:87]، (تَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ) من التحسس، وهو طلب الخبر، أما التجسس فنهى الله جل وعلا عنه في قوله ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾[يوسف:12]، التجسس بالعين، تبدأ تنظر تتبعه، رأيته يسير في مسير، فتنظر إليه وتتبعه حتى تعرف خبره, لا اِحْمَدِ الله جل وعلا أن لم ترَ من أخيك إلا خيرا، كذلك التحسس ما أخبار فلان؟ إيش قال فلان؟ وهو من إخوانك وأصحابك الصادقين الذين بينك وبينهم خُلّة، وبينك وبينهم، وفاء وصحبة، فلا تحسس في أخباره، ولا تجسس عليه، فإن ذلك منهي عنه المسلم مع إخوانه المسلمين بعامة، فكيف بمن له معهم عقد أخوّة خاصة، لا تحسسوا يعني لا تتبع أخبار إخوانك، ولا تتجسسوا يعني لا تذهب بعينك, تنظر ما ذا فعل، وما ذا فعل، فإن هذا من المنهي عنه وهو من المحرمات.
الحق الرابع من الحقوق أن تُجنِّب أخاك سوء الظن به, لأن سوء الظن به مخالف لما تقتضيه الأخوة، مقتضى الأخوة أن يكون الأخ لأخيه فيه الصدق والصلاح والطاعة، هذا الأصل في المسلم، الأصل في المسلم أنه مطيع لله جل وعلا، فإذا كان من إخوانك الخاصة، فإنه يكون ثم حقان؛ حق عام له، وحق خاص بأن تجنبه سوء الظن، وأن تحترس أنت من سوء الظن، والله جل وعلا نهى عن الظن، فقال سبحانه ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾[الحجرات:12]قال العلماء على قوله جل وعلا (اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) أن الظن منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، فما كان من الظن محمودا، هو ما كان من قبيل الأمارات والقرائن التي هي عند القضاة، وعند أهل الإصلاح، وأهل الخير، الذي يريد النصيحة أو يريد إقامة القرائن والدلائل عند القاضي، فالقاضي يقيم الحجة ويطلب البيّنة، وكثير منها قائم في مقام الظنون، لكن هنا يجب أن يأخذ بها، فالاجتناب لكثير من الظن؛ وهذا الظن هو أن تظن بأخيك سوءا، أن تظن بأخيك شرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام «إياكم والظن» فهذا عام، ظنٌّ من جهة الأقوال، ونهي عن الظن من جهة الأفعال، «فإن الظن أكذب الحديث» هذا نصه عليه الصلاة والسلام, الظن هو أكذب ما يكون في قلبك، فإن الظن أكذب الحديث إذا حدثتك نفسك من داخلك بظنون، فاعلم أن هذا هو أكذب الحديث، إذن حق أخيك عليك ألا تظن به إلا خيرا، وأن تجتنب معه الظن السيئ كما أمرك الله جل وعلا بذلك بقوله ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾[الحجرات:12]فالظن السيئ إثم على صاحبه، يأثم به لأنه خالف الأصل، وقد روى الإمام أحمد في الزهد ورواه غيره أن عمر رضي الله عنه قال ناصحا: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. لاحظ أنه نهى عن الظن السيئ في الأقوال، ما دام أن الكلام يحتمل الصواب، يحتمل الخير فلا تظنن السوء بأخيك، لأن الأصل أنه إنما يقول الصواب، لا يقول الباطل، فإذا كان الكلام يحتمل الصواب فوجِّه إلى الصواب، فيسلم أخوك من النقد ويسلم من الظن السيئ، وتسلم أنت من الإثم، وأيضا يسلم من التأثر؛ تسلم ويسلم هو من أن يتأثر به ويقتدى به، لهذا قال عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد المعروف قال: المؤمن يطلب المعاذير. يلتمس المعذرة؛ لأن الأحوال كثيرة، والشيطان يأتي للمسلم فيحدّد الحالة، يُحدِّد معنى الكلمة بشيء واحد حتى يوقع العداوة والبغضاء ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ﴾[المائدة:91]؛ الشيطان يحدد لك أن تفسير هذه الحالة هو كذا فقط، أن تفسير هذه المقالة هو كذا فقط، حتى تكون ظانّا ظنا سيئا فتأثم، وحتى يكون بينك وبين أخيك النفرة وعدم الائتلاف، وهناك أصل من الأصول في فهم الكلام وهو أن لكل كلام دِلالة؛ ودلالة الكلام عند الأصوليين متنوعة، ومن دلالاته ما يسمى بالدِّلالة الحملية، يعني دلالة السياق على الكلام، هناك كلام إذا أُخذ بمفرده دل على شيء، ولكن إذا أخذ بسياقه؛ يعني سباقه ولحاقه بما قبله وبما بعده أوضح المراد، فإذا الكلام صادر من مؤمن، صادر ممن بينك وبينه أخوة، سمعت منه كلمة فلا يأتي الشيطان وينفخ فيك أن تحمل هذه الكلمة على المحمل السوء، بل احملها على المحمل الخير يكن في قلبك إقامة المودة مع إخوانك، وأيضا لا يدخل الشيطان بينك وبين إخوانك، فرعاية الدلالة الحملية؛ دلالة الكلام هذه مهمة، وهي التي يعتمدها أهل العلم في فهم الكلام، وكذلك يعتمدها الصالحون في فهم كلام الناس، لأن الناس إنما يُفهم كلامهم على ما يدل عليه الكلام بكله لا بلفظة منه فقط، فإن الألفاظ قد تخون المتكلم، لكن إذا عُلم مقصده في كل الكلام فإنه يُعذر، وقد بينا أن من كلام الناس -يعني في الدرس الماضي- وهو من باب أولى، من كلام الناس ما هو متشابه يشتبه على الناظر فيه، يشتبه على السامع له، فإذا نظر إلى هذا الكلام نظر طالب للمعذرة, طالب لحمل الكلام على أحسن محامله، فإنه يستريح ويُريح، ويبقى هذا الحق ويكون قد أدّى هذا الحق لأخيه, إذن من فسر كلام أخيه تفسيرا مغالطا؛ زاد فيه، حمله على أسوأ المحامل, فإنه لم يؤدِّ حقه، كذلك في باب الأفعال, تصرّف أمامه بتصرف معين، تكلم هذا بكلمة، فإذا الآخر التفت إلى من بجنبه ونظر إليه نظرة، فأتاه الشيطان فقال: هذا ما نظر إلى ذاك، إلا منتقدا لكلامك، أو إلا عائبا لكلامك ونحو ذلك، لا يدخل الشيطان أيضا في تفسير الأفعال، لأن الأفعال لها احتمالات كثيرة، وقليل من الناس من يسأل أخاه لما تصرفت هذا التصرف، فقد جاء في نفسي منه؟ قليل من يفعل ذلك، ولهذا يأتي الشيطان ويقول: هذا التصرف هو لكذا، وتصرف لأجل هذا المعنى، هو يقصد كذا، هذه التصرفات منه لأجل أن يصل إلى كذا، هو يريد بتصرفه كذا وكذا. التصرفات لها محامل كثيرة، فإذا حملت تلك التصرفات على أمر واحد، وشخَّصت ذلك التصرف فيه، فإنك في الواقع جنيت على نفسك، ولم تحترم عقلك وفكرك، لأنك جعلت احتمالات التصرف احتمالا واحدا, هذا واحد، والثاني أنك جنيت على أخيك، لأنك جعلت تصرفه محمولا على أسوء التصرفات، أسوء المحامل لا على أحسنها، وقد قال النبي r «إياكم والظنّ, فإنّ الظنّ أكذبُ الحديث».
الحق الخامس من حقوق الأخوّة أن تتجنّب مع إخوانك المراء والممارات, فإن المراء مُذْهِبٌ للمحبة، ومُذْهِبٌ للصداقة، مُفسد للصداقة القديمة، ومُحلّ للبغضاء والتشاحن والقطيعة بين الناس. ما معنى المراء؟ يعني أن يكون ثَم مناقشة، ثَم بحث؛ يبحث رجل مع رجل، تبحث امرأة مع امرأة إلى آخره, كبير مع صغير, صغير مع كبير، فإذا أتى البحث، هذا يتعصب لرأيه، وهذا يتعصب لرأيه، فيماريه فهذا يشتدّ وذاك يشتدّ، هذه حقيقة الممارات؛ أن ينتصر كل منهما لرأي رآه، فيأتي بالأدلة فيرفع صوته، ثُم بعد ذلك يحصل في النفوس ما يحصل، وقد كان بعض ذلك بين الصحابة، فقد قال أبو بكر مرة لعمر: ما أردتَّ إلا مخالفتي. وهم الصحابة رضوان الله عليهم، فيجب أن يكون المسلم مع أخيه، ومع صحبته، ومع خاصته مُتنزهًا عن الممارات، لأن وجهات النظر في المسائل تختلف، كلما توسع نظر المرء، وتوسع عقله وإدراكه، علم أن النظر في بعض المسائل متسع، لا يكون على جهة واحدة, تناقش مسألة من المسائل فتنظر إليها من جهة, وينظر إليها الآخر من جهة أخرى، فتختلف أنت وهو، فإذا اختلفتما فكل منكما له وجهة نظره، فإذا ماريت واستدللت لقولك وتعصبت ثم رفعت صوتك والآخر كذلك حتى حصلت الشحناء؛ حصلت مفسدة ولم تحصل مصلحة، والعاقل ينظر إلى أن الأمور التي يتناقش فيها الناس عادة في أمورهم تختلف وُجهاتها، لها وجهات كثيرة، ولها أسباب كثيرة، قد يأتي ثالث ورابع فيخرج كل واحد برأي جديد, يُخرج كل واحد ممن أتى رأيا جديدا, وجهة نظر جديدة في المسألة المطروحة، فإذن النقاش لا يعني المراء، إذا بدأت المسألة تدخل في المِراء فانسحب سواء كنت محقا أو ترى من نفسك أن الصواب مع أخيك وليس معك، وقد قال عليه الصلاة والسلام «من ترك المِراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة, ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة» فترك المراء محمود، وهو من حق الأخ على أخيه ألا يستدرجه في أن يماريه، لا يستدرجه في أن يجادله, أن لا يستدرجه في أن يكون هذا يرفع الصوت على هذا، حتى تنقطع الأخوّة وحتى يعدو هذا على هذا بالكلام، وإن لم يعدُ بالكلام، فقد يعدو بقلبه، ويظن أن هذا قصد كذا، وخالفه، ويرى كذا، وهذا لا يقدر هذا إلى آخر ذلك من مساوئ الشيطان.
المراء له أسباب؛ أسباب نفسية لابد أن يعالجها المرء في نفسه:
من أسبابه أن يُظهر أنه لم يستسلم لوجهة النظر، يقول رأيا خطئا، فيأتي الثاني فيقول أنت أخطأت ليست كذا هي كذا، فيستعظم أن يخطأ, وإذا أخطأ فالحمد لله، العلماء أخطأوا في مسائل في الدماء ورجعوا عنها، أخطأ بعضهم في مسائل في الفروج ورجعوا عنها؛ في مسائل اجتهادية، الرجوع عن الخطأ مَحْمَدَة وليس بعيب، فكل من رجع عن خطأ أخطأ فهو تاج على رأسه، فهو يدل على أنه روّض نفسه في طاعة الله، وجعل العبودية فوق الهوى، من أسباب المراء هذا الذي ذكرت.
‚ ومن أسبابه الرغبة في الانتصار، هذا يرغب في أن يكون أحسن عقلا، في أن يكون أحسن إدراكا من الآخر، فيبدي وجهات نظر متنوعة، والآخر يبدي وجهات نظر من جهة أخرى، يريد أن يكون فائقا عليه، فيماريه بأن يقول هذا الذي ذكرت، هذه النقطة خطأ بل الأصح أنها كذا، فيدخل في مراء بأسلوب يوقع الشحناء ويوقع البغضاء في القلوب.
ƒمن أسباب المراء أيضا عدم رعاية آفات اللسان، واللسان فيما ينطق، وفيما يتحرك به محاسب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقد قال جل وعلا ﴿خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾[النساء:114], «كُفّ عَلَيْكَ هَذَا» -وأشار إلى لسانه- فقال معاذ: يا رسول الله أو إنا محاسبون على ما نقول, قال «ثَكِلَتْكَ أمّك يَا مُعَاذُ, وَهَلْ يَكُبّ النّاسَ في النّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ, أَوْ قال عَلَى مَنَاخِرِهِمْ, إِلاَ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ» فمن أسباب الممارات عدم رعاية إصلاح اللسان، الاستخفاف باللسان، واللسان كما قيل صغير الجِرم لكنه كبير الجُرم؛ يعني أن ما يحصل من الآفات عن طريق اللسان هذه عظيمة، فبها يتفرق الأحباب، بها تحصل الشحناء، بها تحصل العداوة، بها يدخل العدو، بها يدخل من يريد أن يوقع بينك وبين أحبابك، يدخل الكثير من جراء اللسان, فمن لم يحفظ لسانه من جرّاء الممارات في المسائل المختلف فيها التي تكون في المجالس عادة، فإنه يقع ولا بد ويكون بينه وبين إخوانه ما لا يحمد.
أخيرا في الممارات وفي المراء, المراء مضاد لحسن الخُلق، فإن الناظر إذا تأمل ما يجب عليه من حسن الخُلق، فإنه لا يماري، لأن الممارات فيها انتصار، وفيها استعلاء على الآخر، وهذا مضاد لحسن الخلق، بل تُبدي ما عندك بهدوء ولين، فإن قُبل منك فالحمد لله، وإلا تكون ذكرت وجهة نظرك, بعض الناس في المجالس يؤدي به المراء أن يكرر نفس الفكرة عشر مرات, عشرين مرة وهي، هي، يعيدها بصيغة أخرى، هذا ما يحمله على ذلك؟ يحمله الانتصار للنفس، أو أسباب أخرى الله أعلم بها، أو غفلة عما يجب عليه، إذا أوردتها مرة فُهمت عنك فلا تماري في ذلك؛ لأن حقيقة المراء أنه مضاد لحسن الخلق، والمسلم مأمور بأن يحسّن خلقه، والنبي r أمرنا بذلك في أحاديث كثيرة.
الحق السادس من حقوق الأخوة بذل اللسان لأخيك؛ اللسان كما أنه في حفظ العرض كففت اللسان عن أخيك، فهنا من الحقوق أن تبذل اللسان له؛ لأن المصاحبة والأخوّة قامت على رؤية الصور فقط، أم على الحديث؟ إنما قامت على الحديث، وحركة اللسان هذا مع حركة لسان الآخر تُقيم بين القلوب تآلفا، فلذلك لابد أن تبذل اللسان لأخيك.
لهذا مظاهر:
تبذل اللسان في التودُّد له، يعني لا تكن شحيحا بلسانك عن أن تتودد لأخيك، والنبي r قال «إذا أحب أحدكم أخاه فليُعلمه فإذا أعلمه فليقل الآخر أحبك الله الذي أحببتني فيه»، هذا من أنواع بذل اللسان، وهذا يورث المودة، يورث المحبة، ومن الناس من يقول هذه الكلمة وهو غير صادق فيها، أو غير عالم بحقيقة معناها، يقول أحبّك في الله، إذا قلت لآخر أحبك في الله، فمعنى ذلك أن في قلبك محبة لهذا؛ محبة خاصة في الله ولله، فيقتضي أن تحفظ حقه، أما أن تقول له أحبك في الله وأنت في الحقيقة لا تحفظ له حقا، فما حقيقة المحبة إذن، الأول أن تتودد له باللسان؛ بمثل أن تقول له هذه الكلمة، بأن تتكلم معه بأحسن الكلام، وقد قال جل وعلا ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ﴾[الإسراء:53]، قال ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[الإسراء:53]، فهذا بذل اللسان لأخيه أن تنتقي في معاملتك مع إخوانك ومع خاصتك بل ومع المسلمين بعامة أن تنتقي اللفظ الحسن فقط؟ لا , ولكن أحسن الألفاظ لأن الله جل وعلا أمر بذلك فقال﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ﴾[الإسراء:53]فإذا توددت له باللسان وذكرت له أحسن ما تجد فإن هذا فيه إقامة علاقة القلب ومحبة القلب وفي هذا من المصالح التي تكون في المجتمع المسلم وفي قلوب المؤمنين بعضهم مع بعض ما يضيق المقام عن ذكره وعن تَعداده.
‚ من مظاهر التودد باللسان أو بذل اللسان له؛ من مظاهر بذل اللسان للأخ أن تثني عليه في غير حضوره إذا خالطتَ أحدا وتعلم من أخيك هذا صفات محمودة، تثني عليه في غير حضوره؛ لأنك إذا أثنيت عليه في حضوره صار مدحا، والمدح ممنوع لأنه يورث عجباً، لكن تثني عليه في غير حضوره، هل الثناء عليه لابد أن يبلغه، فتقوم المحبة صادقة، فتقوم المحبة قياما صحيحا, الثاني أن ذكر محاسن أخيك عند غيرك تجعل أولئك يجتهدون في الإقتداء، ويعلمون أن الخير فيه أناس كثيرون يعملون به، فالمرء إذا ذُكر عنده الخير تشجع له، وإذا ذكرت عنده الشرور تشجع لها، فذكر الخيرات في المجالس هو الذي ينبغي، أما ذكر الشرور وذكر الآفات وذكر المعايب فإنه هو الذي يجب الالتفات عنه، لأن في ذكر المعايب ما ييسر سبيل الإقتداء بأهلها فيها، وفي ذكر المحاسن والثناء على أصحابها فيه ما يشجع على الإقتداء بهم فيها، فإذن من حق أخيك عليك أنك إذا نظرت له من حسنة فلا تخفها، وإذا نظرت منه إلى سيئة فأخفها، وفي ذلك من المصالح ما هو معلوم، أيضا يتبع هذا المظهر أنه إذا أثني عليه فتدخل السرور على قلبه بإبلاغه بالثناء عليه, أثنى عليك بعض الأخوة في مجلس, أثنى عليك فلان لأنه هو لا يعلم, فإذا علم أن فلانا أثنى عليه صار قلبه محبا له، والناس محبون لمن أحسن إليهم:
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمُ
فطالما استعبدَ الإنسانَ إحسانُ
ƒ من مظاهر بذل اللسان للأخ شكرُه على بذله وعلى حسن المعاملة، لأن النبي r قال «لا يشكر الله من لا يشكر الناس», «من صنع إليكم معروفا فكافئوه» إذا لم تجد ما تكافؤه تجازيه خيرا؛ تدعو له, تشكره، هذا من حق الأخ لأخيه, من الناس من يأخذ ويأخذ ويأخذ ولا يعوض ولا يثني ولا يذكر، إذا لما استطعت أن تبذل بكلمة، أبذل برسالة، أبذل بورقة، بنصف ورقة، فإن هذا فيه أثر، وفيه تشجيع لأبواب الخير، وقد قال علي فيما روي عنه (من لم يحمد أخاه على حسن النية، لم يحمده على حسن الصنيعة), هذه مرتبة عُليا؛ من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنيعة؛ لأن أخاك إذا بذل لك فإنه في أول الأمر حَسَّن نيته معك، وعاملك معاملة من يريد الخير، قد يكون بذل لك فعلا، أو يكون أراد أن يبذل، ولم يحصل له، يشكره حتى على حسن النية على ما قام في قلبه، لأن في هذا عقد للأخوة، وفيه تشجيع على بذل الخير، وأن يبذل كل أخ لأخيه, من لم يحمد أخاه على حسن النية،لم يحمده على حسن الصنيعة، يعني لو فعل معه صنيعة فإنه ربما لم يحمده عليها.
الحق السابع من حقوق الأخوة العفو عن الزَّلات، وهذا باب واسع، باب عظيم؛ لأن ما من متعاشرَين، ما من متصاحبين، ما من متآخيين، أو ما من متآخيين، إلا ولابد أن يكون بينهم زلات، لابد أن يطلع هذا من هذا على زلة، على هفوة، لابد أن يكون منه كلمة، لأن الناس بشر، والبشر خطّاء، «كُلّكم خَطّاءٌ. وَخَيْرُ الْخَطّائِينَ التّوّابُونَ»فمن حق الأخوة أن تعفو عن الزلات.
الزلاّت قسمان: زلات في الدين وزلات في حقك, يعني زلات في حق الله وزلات في حقك أنت:
· أما ما كان في الدين؛ إذا زلّ في الدين بمعنى فرّط في واجب؛ عمل معصية، فإن العفو عن هذه الزلة أن لا تشهرها عنه، وأن تسعى في إصلاحه، لأن محبتك له إنما كانت لله، وإذا كانت لله فأن تقيمه على الشريعة، وأن تقيمه على العبودية، هذا مقتضى المحبة, فإذا كانت في الدين تسعى فيها بما يجب؛ بما يصلحها، إذا كانت تصلحها النصيحة فانصح، إذا كان يُصلحها الهجر فتهجر، والهجر كما ذكرنا لكم في درس سالف الهجر نوعان: هناك هجر تأديب, وهناك هجر عقوبة, هناك هجر لحضك، وهناك هجر لحض المهجور، إذا كان هو عمل زلة، فما كان لحضه هو إذا كان ينفع فيه الهجر فتهجره, إذا كان بين اثنين من الأخوة والصحبة والصداقة ما لا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر فرأى أحدهما من أخيه زلة عظيمة، رأى منه هفوة بحق الله جل وعلا، فيعلم أنه إذا تركه ولم يجبه، إذا لقيه بوجه ليس كالمعتاد، فإنه يقع في نفسه أنه عصى، ويستعظم تلك المعصية، لأن هذا لا يستغني عن ذاك، فهذا يُبذل في حقه الهجر، لأن الهجر في هذه الحال مصلح، أما من لا ينفع فيه الهجر، فالهجر نوع تأديب وهو للإصلاح، ولهذا اختلف حال النبي r مع المخالفين؛ مع من عصى، فهجر بعضا، ولم يهجر بعضا، قال العلماء: مقام الهجر فيمن ينفعه الهجر فيمن يصلحه الهجر ومقام ترك الهجر فيمن لا يصلحه ذلك.
· أمّا ما كان من الزلات في حقك، فحق الأخوّة أولا أن لا تعظِّم تلك الزلة, يأتي الشيطان فينفخ في القلب، ويبدأ يكرر عليه هذه الكلمة، يكرر عليه هذا الفعل حتى يعظمها، يعظمها وتنقطع أواصل المحبة والأخوة، ويكون الأمر بعد المحبة وبعد التواصل، يكون هجرانا وقطيعة للدنيا، وليس لله جل جلاله, سبيل ذلك أن تنظر إلى حسناته؛ تقول أصابني منه هذه الزلة، غلط علي هذه المرة، تناولني بكلام، في حضرتك أو في غيبتك، لكن تنظر إلى حسناته، تنظر إلى معاشرته، تنظر إلى صدقه معك في سنين مضت، أو في أحوال مضت، فتعظم الحسنات، وتصغر السيئات، حتى يقوم عقد الأخوة بينك وبينه، حتى لا تنفصل تلك المحبة.
الحق الثامن من حقوق الأخوة الفرح بما آتاه الله جل وعلا, فرح الأخ لأخيه بما آتاه الله جل وعلا، الله سبحانه قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم، فضَّل بعضهم على بعض، فحق الأخ لأخيه، وحق الأخ على أخيه أنه إذا آتى اللهُ جل وعلا واحدا من إخوانك فضلا ونعمة فتفرح بذلك، وكأن الله جل وعلا خصك بذلك، وهذا من مقتضيات عقد الأخوّة، وهذا طارد للحسد، ومن لم يكن فرحا بما آتى اللهُ جل وعلا إخوانه فإنه قد يكون غير فرح مجردًا، وقد يكون غير فرح وحاسد أيضا، وهذا من آفات الأخوة فإنك تنظر أحيانا فترى أن هذا إذا رأى على أخيه نعمة، أو رأى أن أخاه قد جاءه خير وفضل من الله جل وعلا، وأسدى الله جل وعلا عليه نعم خاصة، بها تميز عمن حوله، أو تميز عن أصحابه، فإنه يأتي ويعترف بنفسه لهذا، لما أوتي هذا الشيء؟ أو ينظر في نفسه أن هذا لا يستحق هذا الشيء، أو نحو ذلك، وهذا من مفسدات عقد الأخوة، بل الواجب أن تتخلص من الحسد، وينبغي لك أن تفرح لأخيك، وأن تحب له كما تحب لنفسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام «لا يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ حتى يُحِبّ لأِخِيه ما يُحِبّ لِنَفْسِهِ» قال أهل العلم (لا يُؤْمِنُ) يعني الإيمان الكامل، (لا يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ) الإيمان الكامل، (حتى يُحِبّ لأِخِيه ما يُحِبّ لِنَفْسِهِ)؛ تحب لنفسك أن تكون ذا مال، فكذلك أحب لأخيك أن يكون ذا مال, تحب لنفسك أن تكون ذا علم، أحب لأخيك أن يكون ذا علم, تحب لنفسك أن يُثنى عليك، كذلك أحب لأخيك أن يثنى عليه, وهكذا في أمور شتى وكثيرة, فطارد الحسد أن تفرح بما من الله جل وعلا به على إخوانك، وكأن الله جل جلاله حباك بهذا، فإن المؤمن ينبغي له، ويُستحب، بل ويتأكد بحقه أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام «لا يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ حتى يُحِبّ لأِخِيه ما يُحِبّ لِنَفْسِهِ»يغني من الخير كما جاء ذلك مقيدا في رواية أخرى، فأمور الخير بعامّة، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، ولا تحسد أحدا على شيء من فضل الله ساقه إليه.
في المال: إذا أنعم الله جل وعلا على أخيك بمال، وصرت أنت معدما مثلا، أو قليل المال، وذاك في عزٍّ، وفي مال وفير، تستغرب من تصرفاته، تستغرب من مشترياته، تستغرب من أحواله، تستغرب من كرمه إلى آخر ذلك، فاحمد الله جل وعلا أن جعل أخاك بهذه المثابة، وكأنك أنت بهذه المثابة، ووطِّن نفسك على أن يكون ما أنعم الله جل وعلا به على أخيك كأنه أنعم عليك.
كذلك في العلم: من الناس من لا يفرح بما آتى الله جل وعلا أخاه من العلم، يسمع أخاه مثلا حقّق مسألة تحقيقا جيدا، أو تكلم في مكان بكلام جيد، أو ألقى خطبة جيدة، أو أثر في الناس بتأثير بالعلم، ساق العلم مساقا حسنا ونحو ذلك، فيظل يعتلج في نفسه ذلك، ولا يفرح أن كان أخوه بهذه المثابة، وعلى هذه الحال، هذا لا يسوغ، بل من حقوق الأخوة أن تفرح لأخيك بالعلم، إذا كنت مثلا لست مثله في العلم، أو كنت متخلّفا عنه في العلم، وكان هو أحدّ فهما، أو كان أحدُّ حفظا، أو نحو ذلك، سبقك في ذلك، فاحمد الله جل جلاله أن سخر من هذه الأمة، وأن جعل من هذه الأمة من يبذل هذا الواجب ويكون متقدما فيه، لا تكن حاسدا لإخوانك على هذا.
والحسد داء قاتل، ومُذهب للحسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام «إياكم والتحاسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» وهذا يكون تارة في العلم، وتارة في المال، وتارة في الجاه، وفي أمور كثيرة, كذلك هذا وهذا متآخين ومتصاحبين يرى أنى أخاه يقدم عليه، أن أخاه له في المجالس كلمة، أن أخاه له جاه، أنه مقدّر، وهو ليس كذلك، فيحمله هذا على أ ن يكون في قلبه شيء على أخيه، وهذا لا ينبغي، بل هذا يدخل في الحسد، والواجب عليه أن يتخلص من الحسد؛ لأن الحسد محرم، والذي ينبغي في حقه أن يحب لأخيه كما يحب لنفسه، وكأنه هو الذي منَّ الله جل وعلا عليه بذلك.
كذلك في الدين والصلاح: من الناس من يُنعم الله عليه، يعني يفتح له باب من أبواب الخير في العبادة، فيكون كثير الصيام، أو كثير الصلاة، وقد سُئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقيل له أنت الإمام، أنت مالك، وشأنك في الناس بهذه المثابة، ولا نراك كثير التعبد، لا نراك كثير الصلاة، لا نراك كثير الصيام، لا نراك مجاهدا في سبيل الله، فقال الإمام مالك لهذا الذي أورد عليه هذا الإيراد: إن من الناس من يفتح الله عليه باب الصلاة، ومنهم من يفتح الله عليه باب الصيام، ومنهم من يفتح الله عليه باب الصدقة، ومنهم من يفتح الله عليه باب الجهاد في سبيل الله، ومنهم من يفتح الله عليهم باب العلم، وقد فُتح لي باب العلم، ورضيت بما فتح الله لي من ذلك. الناس يختلفون، فإذا رأى أخا يتعبد والناس يثنون عليه بتعبداته، قد يحمله عدم الفرح بهذا الثناء على أخيه، أن يذكر عيبا من عيوبه، أن يذكر مقالة أخطأ فيها، أن يذكر شيئا من الأشياء التي ينقص بها من قدره، وهذا مخالف لما ينبغي في حقه، وأن يكون مع أخيه محبا له، كما يحب لنفسه، وأن يسعى في أن يكون أخوه مثنى عليه، ولو كان هو لا يعرف، ليست المسألة بالمقام بين يدي الناس، بل المسألة بالمقام بين يدي الله جل وعلا، بل المسألة في تخليص القلب، وتخليص النفس من أن يكون فيها غير الله جل جلاله، وقد ثبت في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي r قال «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» ينظر إلى القلوب، وينظر إلى الأعمال، قد يكون المرء غير معروف خفي، لا أحد يعرفه، لكن هو عند الله جل وعلا بالمقام العظيم، كما جاء في الحديث «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه».
هناك حقوق أُخر أذكر منها اثنين الحق التاسع والعاشر، وتنظرون فيهما، وتُفرّعون كما ذكرنا:
الحق التاسع أن يكون بينك وبين إخوانك تعاون في الخير والصلاح وقد أمر الله جل وعلا بذلك في قوله ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِوَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة:2].
والحق العاشر والأخير أن يكون بين أصحاب الأخوة الخاصة تشاور وتآلف فيما بينهم وأن لا يكون عند الواحد منهم إنفراد بالأمر بل يكون التشاور والله جل وعلا مدح المؤمنين بذلك في قوله ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾[الشورى:38].
وهذان الحقّان؛ التاسع والعاشر يحتاجان إلى تفصيل، وإلى بيان لكن ضاق الوقت عنه.
أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، المتآخين فيه، الذين قال فيهم «أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي».
وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، المتناصحين في ذلك، الباذلين الخير، المفتِّحين أبواب الخيرات، المغلِّقين أبواب الشرور، وأن يجعلنا ممن يقصدون بأعمالهم وجه الله جل وعلا، وأن يمن علينا بذلك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه، نسأل أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا المسلمين بعامة، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قام بتفرغها الأخ السلفي : سالم الجزائري - جزاه الله خيرا عما فعل وجعله في ميزان حسناته .
من مواضيعي
0 وقفة مع بعض مظاهر الخلل في منهج التلقي
0 الاختلاف والافتراق .. أخطاء يجب تصحيحها
0 الحركات الإسلامية .. تجاوزات وأخطاء
0 عقيدة التوحيد ... من الرسل إلى محمد - صلى الله عليه وسلم -
0 السلفيون هم العقلانيون
0 أركان العبادة ( المحبة - الخوف - الرجاء )
0 الاختلاف والافتراق .. أخطاء يجب تصحيحها
0 الحركات الإسلامية .. تجاوزات وأخطاء
0 عقيدة التوحيد ... من الرسل إلى محمد - صلى الله عليه وسلم -
0 السلفيون هم العقلانيون
0 أركان العبادة ( المحبة - الخوف - الرجاء )