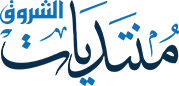دعاوى الجهاد بين الخنادق... والفنادق
24-05-2007, 10:45 PM
دعاوى الجهاد بين الخنادق... والفنادق
محمد بن موسى آل نصر
يقول الحق -جل جلاله-: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً}.
ويقول -سبحانه-: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.
ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم".
وقال في أعظم مجمع من مجامع الإسلام والمسلمين -في يوم عرفة-: "إن أموالكم وأعراضكم ودماءَكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
وقال: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".
ولهذا؛ جاء الإسلام العظيم بحفظ الحقوق والنهي عن سلبها، وانتقاصها، ومصادرتها، جاء بحفظ الأرواح، والأنفس، والأموال، والأعراض، جاء بحفظ العقل والدين، وهذه هي الضرورات الخمس، التي أنزل الله -عزَّ وجل- من أجلها كتبه، وأرسل لها رسله.
وأمر الله بالعدل، ونهى عن الظلم وحرّمه الله على نفسه، وعلى عباده؛ فقال -جلّ من قائل-: "يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم بينكم محرّماً فلا تظالموا"...
فالمسلم معصوم الدم، معصوم العرض، معصوم المال "كل المسلم على المسلم حرام"؛ ولهذا لا يجوز تحقير المسلم، ولا الاستهانة به...
فكيف يجوز قتله وبخاصّةٍ إذا كان بغير حق، وإذا كان بريئاً لم يقترف ذنباً ولا جرماً، فكيف إذا كان طفلاً رضيعاً، فكيف إذا كانت امرأة لا تحمل سلاحاً، فكيف إذا كان شيخاً كبيراً فانياً، وكيف إذا كان في ذلك التقتيل ترويع للآمنين، وزعزعة لأمن البلاد، ونشر للفوضى والفساد بين العباد، وتطميع للطامعين من الأعداء في بلاد الإسلام؛ فإذا كانت الوحوش الكاسرة تخشاها مثيلاتها وهي في قوّتها وفي صحتها، بينما تطمع فيها الحشرات إذا جرحت أو وقعت، بل يطمع فيها الذَّرُّ والنمل، فيقتلها ويأكلها، وهي تنظر إليه! فكيف في بلدان آمنة إذا ما زعزع أمنها؟ فإنّه يتطلّع إليها أولئك الطغاة، وأولئك الجبابرة، وأولئك المستعمرون الجدد، الذين يسيل لعابهم على أرض العرب والمسلمين، يسيل لعابهم لسلخهم من دينهم، ولنهب خيرات بلادهم، فيتَّخذونها فرصة، ويبتهلونها مناسبة ليتدخَّلوا في شؤون هذه البلدان.
نعم يا عباد الله! إنّ الغلو والتطرف والإرهاب بمعناه المعاصر: لا المعنى الشرعي، وهو ترويع الآمنين؛ إنّ هذا الإرهاب المعاصر لا دين له، ولا هوية، ولا حدود، ولا زمان، ولا مكان، فهو قد بدأ من زمن الصحابة -رضي الله عنهم-، حينما قتل هؤلاء الغلاة التكفيريون الذين -كانوا يُسَمّون في ذلك العصر بالخوارج-؛ لخروجهم على الخليفة الراشد علي -رضي الله عنه-، ولخروجهم على أئمة المسلمين وعامتهم بالسيف، واليوم: يُسَمّون بالتكفيريين؛ لأنهم يكفرون بالجملة، يكفرون الأنظمة والشعوب، يكفرون كلّ موظف في الدولة، ولهذا يستبيحون دماء الجميع، أمّا هؤلاء الضحايا من المساكين من نساء وأطفال فعندهم -يبعثون على نيّاتهم، فالتكفيريون يفهمون النصوص فهماً منعكساً، فهماً غالياً، فهماً لا يمت إلى كتاب الله ولا إلى سنّة رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-، ولا إلى نهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين بِصِلَةٍ، لا يفهمون الشرع فهماً صحيحاً، ولذلك أُتوا من جهلهم، ومن قلّة علمهم، ومن ضعف بصيرتهم، ومن حداثة أسنانهم، ولهذا قال فيهم النبي -صلى الله عليه وسلّم-: "حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البريّة"، ولكن بينهم وبينه بُعْدَ المشرق والمغرب، قال فيهم النبي -صلى الله عليه وسلّم-: "الخوارج كلاب أهل النار، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تمشوا في جنائزهم، لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد وثمود، لمن قتلهم أجر كذا وكذا عند الله"، ولهذا يجب محاربة هذا الفكر الفاسد، العاطل، الباطل، الكاسد، هذا الفكر القديم الجديد المتجدّد، والذي يُنسب -أحياناً- ظلماً وزوراً إلى السلفيّة، والسلفيّة منه براء؛ فَالسلفيّة: علم، السلفيّة: إخلاص، السلفيّة: صدق، السلفيّة: اتّباع، السلفيّة: رحمة وليست لعنة!! حاشا لله أن ينتمي هؤلاء إلى السلف الصالح، حاشا لله أن ينتمي هؤلاء إلى الصحابة الكرام، الذي تنتمي إليهم المدرسة السلفيّة المباركة -التي على رأسها أئمتها الثلاثة: ابن باز، والألباني، وابن العثيمين، وفتاواهم محفوظة، ومسطورة في التحذير من هذا الفكر، والبراءة من هذه الأفعال الشنيعة-قبل أن تظهر هذه التفجيرات هنا وهناك-؛ لأنهم ينطلقون من عقيدة سلفيّةٍ، وأصولٍ صحيحة، ولولا الإطالة لأتينا بكلامهم الذهبي الذي يكتب بماء العيون وقرأناه عليكم، إنهم كانوا سبباً في نزول الآلاف من الجبال في الجزائر، من الذين كانوا يقتلون، ويشردون، ويسلبون، وينهبون، ويغتصبون العواتق والأبكار، ويقتلون الأطفال، حينما وصلت رسالتهم إليهم؛ نزل الآلاف منهم من الجبال، وألقوا السلاح، وفِعْلُ مشايخنا هذا كان أسوة بفعل ابن عباس العالم الرباني، الحبر ترجمان القرآن، الذي ذهب إلى الخوارج وناظرهم، وأقام عليهم الحجة، وقال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-، وليس فيكم واحد منهم؛ -لأنه حاشا لله أن يخرج الصحابة، وأن يَسْفَهُوا سَفَهَ هؤلاء-، فناظرهم، فعرضوا عليه الشبه ورد عليها وأفحمهم، فرجع منهم ألفان، والأكثر ظلوا على عُتُوِّهم وعنادهم، فقاتلهم علي واستأصلهم، وهم -أي الخوارج- الذين قتلوا عثمان، وقتلوا علياً، وحاولوا قتل معاوية فلم يفلحوا، وهم الذين لم يعرف عنهم في تاريخ الإسلام إلا أنهم كما قال -عليه الصلاة والسلام-: "يقتلون أهل الإسلام، ويَدَعون أهل الأوثان" هذا دَيدنُهم، وكما قال أحد العلماء: "لا للباطل كسروا، ولا للحقّ نصروا".
هذا هو حالهم على مرّ التاريخ، والآن ها هم ينقلون المعركة مِن الأراضي المحتلة في مقابلة الأعداء -كما ينبغي أن تكون-؛ فينقلونها إلى أرض المسلمين، وإلى مجتمعاتهم، بل ينقلونها إلى الأعراس، وهي لمسلمين يظهرون الفرحة -حتى لو وقعوا في شيء من المعاصي أو المخالفات- فلستَ مسؤولاً عن قتلهم، فلا يجوز قتلهم بحال، بل عليك أن تَعِظَهم، وأن تذكرهم، ولكن ليس هذا هو السبب في جريمتهم، إنّ السبب الرئيسَ في حمل هؤلاء المجرمين القتلة على سفك الدماء البريئة، وترويع الآمنين في هذا البلد الآمن -الذي يضرب به المثل في أمنه- بل يغبطه الصديق، ويحسده العدو على أمنه واستقراره، هذا البلد الذي أصبح ملاذاً للخائفين، فكل خائف يجد ملاذاً له في هذا البلد، يجد كَرَمَ الضيافة، يجد المحبة، يجد النصرة وسعة الصدر، ولكنه -بعد- يجازى جزاء سنمّار، ذلك المهندس العظيم الذي بنى قصراً عظيماً، ثمّ دعى الملك صاحب القصر، وأصعده فوق القصر وقال له -بعد أن أعجبه القصر-: إنّ في هذا القصر لبنة لو نزعت من مكانها انهار القصر كله، فقال له الملك: هل يعرفها غيرك؟ فقال: لا، فأهوى به من سطح القصر إلى الأرض فقتله!
فلهذا -أيها الإخوة-: إنّ هذه الجرائم، وهذا التفجيرات، وهذا التدمير إنما يُراد به زعزعة أمن هذا البلد، الذي يغبط على أمنه، ويضرب به المثل في أمنه، الناس يتخطّفون من حولنا، ويفزعون إلينا، فيجدون الأمن والأمان، فأراد هؤلاء القتلة المجرمون -باسم الإسلام- والإسلام منهم براء، والدين عنهم في معزل، أرادوا أن يزعزعوا أمن هذا البلد، ولكن هيهات! هيهات؛ لأنّ الله تكفّل بحفظ بلاد الشام، قال -صلى الله عليه وسلّم-: "إنّ الله تكفّل لي بالشام وأهله"، قال: "إنّ الملائكة باسطة أجنحتها فوق الشام"...
وإنّ السبب الرئيسَ في ذلك الإجرام، والدافعَ له: هو تكفير أولئك الضُلاّل للمجتمعات الإسلاميّة، والحكم على أهلها بأنهم خرجوا من الملّة، وعليه؛ فإنّهم يستحلُّون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ويفعلون بهم هذه الأفاعيل.
ولكنّ الله -تعالى- حفظ بلاد الشام، وتكفّل بها، ولذلك ما من معتد غاشم أراد أرض الشام بسوء إلا أخذه الله وجعله نكال الآخرة والأولى.
ماذا فعل الله بالصليبيين؟ وماذا فعل بالمغول؟ وأين كانت هزائمهم؟ تلك بقاياهم وآثارهم، فاصبروا وصابروا.
عباد الله! اتقوا الله، واعلموا أنّ الإيمان والأمن صنوان لا يفترقان، فإذا ضاع الإيمان ضاع الأمن كما قال الحقّ -جلّ جلاله-: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} [أي: المعاصي والذنوب، وأعظمها الشرك].
فتكفّل الله لمن آمن بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ -صلى الله عليه وسلّم- نبيّاً ورسولاً، بالأمن والهداية، وهما من أعظم النعم التي ينعم الله بها على بني الإنسان، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
اعلموا عباد الله أن الأمن نعمة عظيمة تُطلب من اللهِ واهبِها للخلق، ولله سنن في خلقه، فالمعاصي والذنوب سبب لكل فساد {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}.
ومع ذلك فمهما بلغت معاصي الأمة فليس هناك مسوغ للفتك بها، ولا حق لكبير ولا صغير، ولا قريب ولا بعيد أن يبطش بها، وأن يسفك دمها، وأن يشيع بينها الرعب والخوف، وما شرع الله -عز وجل- الحدود والقصاص إلا لأجل ردع الجناة العابثين بأمن الأمة المفرقين لجمعها، المشتتين لشملها، الذين يخدمون أعداءها بقصد أو بغير قصد، فالعبرة بالنتائج -يا عباد الله-، ومن ثمارهم تعرفونهم، ولهذا خسر هؤلاء قضيتهم إن كانوا يظنون إنهم بذلك يجاهدون، فبئس الجهاد جهادهم، وبئس الفعل فعلهم، وبئست الأغراض والمقاصد مقاصدهم!
أي جهاد هذا الذي يكون في الفنادق؟!!
الجهاد في الخنادق وليس في الفنادق!
الجهاد في ميادين القتال في مواجهة الأعداء المحتلين المغتصبين بطرق شريفة لا بأساليب خسيسة وحشية.
فالبشاعة في القتل يأباها الإسلام، ولذا نهى النبي -صلى الله عليه وسلّم- عن المثلة، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلّم- عن الغدر، وهذا من صور الغدر، يأتي الواحد من هؤلاء الأبطال المزعومين! يلبس حزاماً ناسفاً، وينخرط في جموع الأعراس كأنه واحد منهم، جاءهم يقاسمهم جمعهم، ويشاركهم فرحتهم، وإذا هو عدو لدود قاتل، ووحش كاسر، لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة في مسلم ولا ذمي، ولا صغير ولا كبير، ويبدأ بقتل نفسه وهو عين الانتحار، يظن أنه شهيد! وما هو والله بشهيد، بل هو حطب جهنّم؛ لأن الله يقول: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}.
فكيف إذا قتل طفلاً رضيعاً؟!
كيف إذا روّع الآمنين؟!
كيف إذا زعزع بلداً آمنا؟!!
فليست هذه الأفعال الإجرامية من الجهاد في شيء!
وليست من الشهادة في شيء!
إن هذا الفكر -التكفيري- الخطير ينبغي أن نحذره، وأن نحذِّر منه، وإذا ابتليتَ بواحد من هؤلاء فينبغي أن ترجع إلى العلماء، ليجلسوا معه ويناظروه، ويقيموا الحجة عليه، وعليك أن تتقي الله يا مسلم يا عبد الله فيمن يدخل بيتك، ومن تؤجره؛ فإن هؤلاء القتلة ما عاشوا في عراء ولا سكنوا الخلاء، إنهم سكنوا بيوتاً واستأجروها، ولهذا ينبغي أن تكون يا صاحب البيت أيها المؤجر يقظاً حذراً، فتراقب -وهذا واجب عليك-، لا أقول: لك أن تتجسس، وإنما تكون ذكياً فطناً، فتعرف من يدخل ويخرج، وماذا يحمل، وما هي مقاصده، وأن تسأله عن اسمه، هل تعرف هويته وانتماءه؛ لتعينَه إن كان خيّراً طيِّباً، صالحاً، فأمّا إن كان غادراً، أو خبيثاً، أو عدوّاً مندساً، فالواجب أن تحذره، وتحذِّر منه، لِتكون سبباً في إطفاء فتنة قد تقع، ومنع كارثة قد تحدث، فلهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: "لعن الله من آوى محدثاً" [رواه مسلم].
والتستر على المجرم جريمة يعاقب عليها الشرع، وكذا القوانين.
وقال -صلى الله عليه وسلّم-: "المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
تصور أيها الأخ المسلم وتفكر لو رأيت ناراً شبت في دارك كيف يكون حالك، ألا تخرج فزعاً صارخاً تطلب النجدة؟!
فإن كان هذا وقع في دار جارك ما الذي يجب عليك شرعاً؟
أليس أقل الأحوال أن تتصل بالإطفائية؟!
أليس أقل الأحوال أن تأخذ دلواً من ماء فتهريقه على هذه النار؟!
عباد الله: حينما ألقي إبراهيم -عليه السلام- في النار فزعت كل الحيوانات وهي غير مكلفة فملأت أفواهها بالماء وأخذت تتفل هذا الماء على النار لتطفئها، وأنّى لهذه النار أن تنطفئ، ببصقة ثعلب أو ذئب أو قطة أو دجاجة إلا حشرة الوزغة [السام الأبرص](*) تلك الحشرة الخبيثة، هذه الحشرة كان موقفها عدائياً سلبياً من خليل الله إبراهيم، جاءت لتنفخ على النار لتزداد اشتعالا، علم الله قصدها الخبيث فسجل الله عليها هذا الموقف العدائي لوليه وخليله إبراهيم فجعل لمن قتلها من الضربة الأولى مائة حسنة، ولذلك يتسابق الصالحون والمؤمنون على ضربها وقتلها بالنعال.
ماذا تصنع هذه الحشرة بنار متأججة إشعالاً أو إطفاءً! ولكنه القصد الخبيث!
ولهذا يجب الحذر من هذه الجماعات التكفيرية والتحذير منها، ولستَ آثماً إذا علمت أحداً يخطط للتقتيل والإفساد والترويع فبلغت الأمن عنه، بل تكون مجرماً آثماً مشاركاً في جريمته إن سكتَّ عنه!!
أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجنب بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين القتل والتقتيل والشر والتدمير والكفر والتكفير.
وأن يجنبه سائر الفتن والمحن والبلاء والوباء، وسائر النقم.
وأن يتم عليه أمنه وإيمانه، وأن يرد أهله إلى دينهم الحق رداً جميلاً، وأن يوفقهم جميعاً للاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله وأن يجتمعوا على كلمة التوحيد التي هي أساس الوحدة.
ونسأل الله تعالى أن يجنب المسلمين شر كل ذي شر، وأن يحفظ قيادتنا، وأن يوفقها للخير، وأن يعينها على طاعته، اللهم وفق ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم وفقه لقمع الفتنة والفساد، اللهم أعنه على طاعتك، وقيض له أعواناً وأنصاراً على الحق يا رب العالمين.
واهد يا رب سائر حكام المسلمين، ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رحمن يا رحيم.
9/شوال/1426هـ - الموافق 11/11/2005م
هامـــش:
(*) سميت ساماً أبرصاً لأنها إذا وقعت في الطعام وتفسخت فيه كان سماً زعافاً قاتلاً لمن أكله.
المصدر: شبكة الدعوة السلفية من المسجد الأقصى المبارك
محمد بن موسى آل نصر
يقول الحق -جل جلاله-: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً}.
ويقول -سبحانه-: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.
ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم".
وقال في أعظم مجمع من مجامع الإسلام والمسلمين -في يوم عرفة-: "إن أموالكم وأعراضكم ودماءَكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
وقال: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".
ولهذا؛ جاء الإسلام العظيم بحفظ الحقوق والنهي عن سلبها، وانتقاصها، ومصادرتها، جاء بحفظ الأرواح، والأنفس، والأموال، والأعراض، جاء بحفظ العقل والدين، وهذه هي الضرورات الخمس، التي أنزل الله -عزَّ وجل- من أجلها كتبه، وأرسل لها رسله.
وأمر الله بالعدل، ونهى عن الظلم وحرّمه الله على نفسه، وعلى عباده؛ فقال -جلّ من قائل-: "يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم بينكم محرّماً فلا تظالموا"...
فالمسلم معصوم الدم، معصوم العرض، معصوم المال "كل المسلم على المسلم حرام"؛ ولهذا لا يجوز تحقير المسلم، ولا الاستهانة به...
فكيف يجوز قتله وبخاصّةٍ إذا كان بغير حق، وإذا كان بريئاً لم يقترف ذنباً ولا جرماً، فكيف إذا كان طفلاً رضيعاً، فكيف إذا كانت امرأة لا تحمل سلاحاً، فكيف إذا كان شيخاً كبيراً فانياً، وكيف إذا كان في ذلك التقتيل ترويع للآمنين، وزعزعة لأمن البلاد، ونشر للفوضى والفساد بين العباد، وتطميع للطامعين من الأعداء في بلاد الإسلام؛ فإذا كانت الوحوش الكاسرة تخشاها مثيلاتها وهي في قوّتها وفي صحتها، بينما تطمع فيها الحشرات إذا جرحت أو وقعت، بل يطمع فيها الذَّرُّ والنمل، فيقتلها ويأكلها، وهي تنظر إليه! فكيف في بلدان آمنة إذا ما زعزع أمنها؟ فإنّه يتطلّع إليها أولئك الطغاة، وأولئك الجبابرة، وأولئك المستعمرون الجدد، الذين يسيل لعابهم على أرض العرب والمسلمين، يسيل لعابهم لسلخهم من دينهم، ولنهب خيرات بلادهم، فيتَّخذونها فرصة، ويبتهلونها مناسبة ليتدخَّلوا في شؤون هذه البلدان.
نعم يا عباد الله! إنّ الغلو والتطرف والإرهاب بمعناه المعاصر: لا المعنى الشرعي، وهو ترويع الآمنين؛ إنّ هذا الإرهاب المعاصر لا دين له، ولا هوية، ولا حدود، ولا زمان، ولا مكان، فهو قد بدأ من زمن الصحابة -رضي الله عنهم-، حينما قتل هؤلاء الغلاة التكفيريون الذين -كانوا يُسَمّون في ذلك العصر بالخوارج-؛ لخروجهم على الخليفة الراشد علي -رضي الله عنه-، ولخروجهم على أئمة المسلمين وعامتهم بالسيف، واليوم: يُسَمّون بالتكفيريين؛ لأنهم يكفرون بالجملة، يكفرون الأنظمة والشعوب، يكفرون كلّ موظف في الدولة، ولهذا يستبيحون دماء الجميع، أمّا هؤلاء الضحايا من المساكين من نساء وأطفال فعندهم -يبعثون على نيّاتهم، فالتكفيريون يفهمون النصوص فهماً منعكساً، فهماً غالياً، فهماً لا يمت إلى كتاب الله ولا إلى سنّة رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-، ولا إلى نهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين بِصِلَةٍ، لا يفهمون الشرع فهماً صحيحاً، ولذلك أُتوا من جهلهم، ومن قلّة علمهم، ومن ضعف بصيرتهم، ومن حداثة أسنانهم، ولهذا قال فيهم النبي -صلى الله عليه وسلّم-: "حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البريّة"، ولكن بينهم وبينه بُعْدَ المشرق والمغرب، قال فيهم النبي -صلى الله عليه وسلّم-: "الخوارج كلاب أهل النار، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تمشوا في جنائزهم، لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد وثمود، لمن قتلهم أجر كذا وكذا عند الله"، ولهذا يجب محاربة هذا الفكر الفاسد، العاطل، الباطل، الكاسد، هذا الفكر القديم الجديد المتجدّد، والذي يُنسب -أحياناً- ظلماً وزوراً إلى السلفيّة، والسلفيّة منه براء؛ فَالسلفيّة: علم، السلفيّة: إخلاص، السلفيّة: صدق، السلفيّة: اتّباع، السلفيّة: رحمة وليست لعنة!! حاشا لله أن ينتمي هؤلاء إلى السلف الصالح، حاشا لله أن ينتمي هؤلاء إلى الصحابة الكرام، الذي تنتمي إليهم المدرسة السلفيّة المباركة -التي على رأسها أئمتها الثلاثة: ابن باز، والألباني، وابن العثيمين، وفتاواهم محفوظة، ومسطورة في التحذير من هذا الفكر، والبراءة من هذه الأفعال الشنيعة-قبل أن تظهر هذه التفجيرات هنا وهناك-؛ لأنهم ينطلقون من عقيدة سلفيّةٍ، وأصولٍ صحيحة، ولولا الإطالة لأتينا بكلامهم الذهبي الذي يكتب بماء العيون وقرأناه عليكم، إنهم كانوا سبباً في نزول الآلاف من الجبال في الجزائر، من الذين كانوا يقتلون، ويشردون، ويسلبون، وينهبون، ويغتصبون العواتق والأبكار، ويقتلون الأطفال، حينما وصلت رسالتهم إليهم؛ نزل الآلاف منهم من الجبال، وألقوا السلاح، وفِعْلُ مشايخنا هذا كان أسوة بفعل ابن عباس العالم الرباني، الحبر ترجمان القرآن، الذي ذهب إلى الخوارج وناظرهم، وأقام عليهم الحجة، وقال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-، وليس فيكم واحد منهم؛ -لأنه حاشا لله أن يخرج الصحابة، وأن يَسْفَهُوا سَفَهَ هؤلاء-، فناظرهم، فعرضوا عليه الشبه ورد عليها وأفحمهم، فرجع منهم ألفان، والأكثر ظلوا على عُتُوِّهم وعنادهم، فقاتلهم علي واستأصلهم، وهم -أي الخوارج- الذين قتلوا عثمان، وقتلوا علياً، وحاولوا قتل معاوية فلم يفلحوا، وهم الذين لم يعرف عنهم في تاريخ الإسلام إلا أنهم كما قال -عليه الصلاة والسلام-: "يقتلون أهل الإسلام، ويَدَعون أهل الأوثان" هذا دَيدنُهم، وكما قال أحد العلماء: "لا للباطل كسروا، ولا للحقّ نصروا".
هذا هو حالهم على مرّ التاريخ، والآن ها هم ينقلون المعركة مِن الأراضي المحتلة في مقابلة الأعداء -كما ينبغي أن تكون-؛ فينقلونها إلى أرض المسلمين، وإلى مجتمعاتهم، بل ينقلونها إلى الأعراس، وهي لمسلمين يظهرون الفرحة -حتى لو وقعوا في شيء من المعاصي أو المخالفات- فلستَ مسؤولاً عن قتلهم، فلا يجوز قتلهم بحال، بل عليك أن تَعِظَهم، وأن تذكرهم، ولكن ليس هذا هو السبب في جريمتهم، إنّ السبب الرئيسَ في حمل هؤلاء المجرمين القتلة على سفك الدماء البريئة، وترويع الآمنين في هذا البلد الآمن -الذي يضرب به المثل في أمنه- بل يغبطه الصديق، ويحسده العدو على أمنه واستقراره، هذا البلد الذي أصبح ملاذاً للخائفين، فكل خائف يجد ملاذاً له في هذا البلد، يجد كَرَمَ الضيافة، يجد المحبة، يجد النصرة وسعة الصدر، ولكنه -بعد- يجازى جزاء سنمّار، ذلك المهندس العظيم الذي بنى قصراً عظيماً، ثمّ دعى الملك صاحب القصر، وأصعده فوق القصر وقال له -بعد أن أعجبه القصر-: إنّ في هذا القصر لبنة لو نزعت من مكانها انهار القصر كله، فقال له الملك: هل يعرفها غيرك؟ فقال: لا، فأهوى به من سطح القصر إلى الأرض فقتله!
فلهذا -أيها الإخوة-: إنّ هذه الجرائم، وهذا التفجيرات، وهذا التدمير إنما يُراد به زعزعة أمن هذا البلد، الذي يغبط على أمنه، ويضرب به المثل في أمنه، الناس يتخطّفون من حولنا، ويفزعون إلينا، فيجدون الأمن والأمان، فأراد هؤلاء القتلة المجرمون -باسم الإسلام- والإسلام منهم براء، والدين عنهم في معزل، أرادوا أن يزعزعوا أمن هذا البلد، ولكن هيهات! هيهات؛ لأنّ الله تكفّل بحفظ بلاد الشام، قال -صلى الله عليه وسلّم-: "إنّ الله تكفّل لي بالشام وأهله"، قال: "إنّ الملائكة باسطة أجنحتها فوق الشام"...
وإنّ السبب الرئيسَ في ذلك الإجرام، والدافعَ له: هو تكفير أولئك الضُلاّل للمجتمعات الإسلاميّة، والحكم على أهلها بأنهم خرجوا من الملّة، وعليه؛ فإنّهم يستحلُّون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ويفعلون بهم هذه الأفاعيل.
ولكنّ الله -تعالى- حفظ بلاد الشام، وتكفّل بها، ولذلك ما من معتد غاشم أراد أرض الشام بسوء إلا أخذه الله وجعله نكال الآخرة والأولى.
ماذا فعل الله بالصليبيين؟ وماذا فعل بالمغول؟ وأين كانت هزائمهم؟ تلك بقاياهم وآثارهم، فاصبروا وصابروا.
عباد الله! اتقوا الله، واعلموا أنّ الإيمان والأمن صنوان لا يفترقان، فإذا ضاع الإيمان ضاع الأمن كما قال الحقّ -جلّ جلاله-: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} [أي: المعاصي والذنوب، وأعظمها الشرك].
فتكفّل الله لمن آمن بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ -صلى الله عليه وسلّم- نبيّاً ورسولاً، بالأمن والهداية، وهما من أعظم النعم التي ينعم الله بها على بني الإنسان، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
اعلموا عباد الله أن الأمن نعمة عظيمة تُطلب من اللهِ واهبِها للخلق، ولله سنن في خلقه، فالمعاصي والذنوب سبب لكل فساد {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}.
ومع ذلك فمهما بلغت معاصي الأمة فليس هناك مسوغ للفتك بها، ولا حق لكبير ولا صغير، ولا قريب ولا بعيد أن يبطش بها، وأن يسفك دمها، وأن يشيع بينها الرعب والخوف، وما شرع الله -عز وجل- الحدود والقصاص إلا لأجل ردع الجناة العابثين بأمن الأمة المفرقين لجمعها، المشتتين لشملها، الذين يخدمون أعداءها بقصد أو بغير قصد، فالعبرة بالنتائج -يا عباد الله-، ومن ثمارهم تعرفونهم، ولهذا خسر هؤلاء قضيتهم إن كانوا يظنون إنهم بذلك يجاهدون، فبئس الجهاد جهادهم، وبئس الفعل فعلهم، وبئست الأغراض والمقاصد مقاصدهم!
أي جهاد هذا الذي يكون في الفنادق؟!!
الجهاد في الخنادق وليس في الفنادق!
الجهاد في ميادين القتال في مواجهة الأعداء المحتلين المغتصبين بطرق شريفة لا بأساليب خسيسة وحشية.
فالبشاعة في القتل يأباها الإسلام، ولذا نهى النبي -صلى الله عليه وسلّم- عن المثلة، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلّم- عن الغدر، وهذا من صور الغدر، يأتي الواحد من هؤلاء الأبطال المزعومين! يلبس حزاماً ناسفاً، وينخرط في جموع الأعراس كأنه واحد منهم، جاءهم يقاسمهم جمعهم، ويشاركهم فرحتهم، وإذا هو عدو لدود قاتل، ووحش كاسر، لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة في مسلم ولا ذمي، ولا صغير ولا كبير، ويبدأ بقتل نفسه وهو عين الانتحار، يظن أنه شهيد! وما هو والله بشهيد، بل هو حطب جهنّم؛ لأن الله يقول: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}.
فكيف إذا قتل طفلاً رضيعاً؟!
كيف إذا روّع الآمنين؟!
كيف إذا زعزع بلداً آمنا؟!!
فليست هذه الأفعال الإجرامية من الجهاد في شيء!
وليست من الشهادة في شيء!
إن هذا الفكر -التكفيري- الخطير ينبغي أن نحذره، وأن نحذِّر منه، وإذا ابتليتَ بواحد من هؤلاء فينبغي أن ترجع إلى العلماء، ليجلسوا معه ويناظروه، ويقيموا الحجة عليه، وعليك أن تتقي الله يا مسلم يا عبد الله فيمن يدخل بيتك، ومن تؤجره؛ فإن هؤلاء القتلة ما عاشوا في عراء ولا سكنوا الخلاء، إنهم سكنوا بيوتاً واستأجروها، ولهذا ينبغي أن تكون يا صاحب البيت أيها المؤجر يقظاً حذراً، فتراقب -وهذا واجب عليك-، لا أقول: لك أن تتجسس، وإنما تكون ذكياً فطناً، فتعرف من يدخل ويخرج، وماذا يحمل، وما هي مقاصده، وأن تسأله عن اسمه، هل تعرف هويته وانتماءه؛ لتعينَه إن كان خيّراً طيِّباً، صالحاً، فأمّا إن كان غادراً، أو خبيثاً، أو عدوّاً مندساً، فالواجب أن تحذره، وتحذِّر منه، لِتكون سبباً في إطفاء فتنة قد تقع، ومنع كارثة قد تحدث، فلهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: "لعن الله من آوى محدثاً" [رواه مسلم].
والتستر على المجرم جريمة يعاقب عليها الشرع، وكذا القوانين.
وقال -صلى الله عليه وسلّم-: "المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
تصور أيها الأخ المسلم وتفكر لو رأيت ناراً شبت في دارك كيف يكون حالك، ألا تخرج فزعاً صارخاً تطلب النجدة؟!
فإن كان هذا وقع في دار جارك ما الذي يجب عليك شرعاً؟
أليس أقل الأحوال أن تتصل بالإطفائية؟!
أليس أقل الأحوال أن تأخذ دلواً من ماء فتهريقه على هذه النار؟!
عباد الله: حينما ألقي إبراهيم -عليه السلام- في النار فزعت كل الحيوانات وهي غير مكلفة فملأت أفواهها بالماء وأخذت تتفل هذا الماء على النار لتطفئها، وأنّى لهذه النار أن تنطفئ، ببصقة ثعلب أو ذئب أو قطة أو دجاجة إلا حشرة الوزغة [السام الأبرص](*) تلك الحشرة الخبيثة، هذه الحشرة كان موقفها عدائياً سلبياً من خليل الله إبراهيم، جاءت لتنفخ على النار لتزداد اشتعالا، علم الله قصدها الخبيث فسجل الله عليها هذا الموقف العدائي لوليه وخليله إبراهيم فجعل لمن قتلها من الضربة الأولى مائة حسنة، ولذلك يتسابق الصالحون والمؤمنون على ضربها وقتلها بالنعال.
ماذا تصنع هذه الحشرة بنار متأججة إشعالاً أو إطفاءً! ولكنه القصد الخبيث!
ولهذا يجب الحذر من هذه الجماعات التكفيرية والتحذير منها، ولستَ آثماً إذا علمت أحداً يخطط للتقتيل والإفساد والترويع فبلغت الأمن عنه، بل تكون مجرماً آثماً مشاركاً في جريمته إن سكتَّ عنه!!
أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجنب بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين القتل والتقتيل والشر والتدمير والكفر والتكفير.
وأن يجنبه سائر الفتن والمحن والبلاء والوباء، وسائر النقم.
وأن يتم عليه أمنه وإيمانه، وأن يرد أهله إلى دينهم الحق رداً جميلاً، وأن يوفقهم جميعاً للاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله وأن يجتمعوا على كلمة التوحيد التي هي أساس الوحدة.
ونسأل الله تعالى أن يجنب المسلمين شر كل ذي شر، وأن يحفظ قيادتنا، وأن يوفقها للخير، وأن يعينها على طاعته، اللهم وفق ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم وفقه لقمع الفتنة والفساد، اللهم أعنه على طاعتك، وقيض له أعواناً وأنصاراً على الحق يا رب العالمين.
واهد يا رب سائر حكام المسلمين، ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رحمن يا رحيم.
9/شوال/1426هـ - الموافق 11/11/2005م
هامـــش:
(*) سميت ساماً أبرصاً لأنها إذا وقعت في الطعام وتفسخت فيه كان سماً زعافاً قاتلاً لمن أكله.
المصدر: شبكة الدعوة السلفية من المسجد الأقصى المبارك
من مواضيعي
0 الفرق بين نظام Fat و Ntfs
0 معلومات عن الكراك للفائدة
0 هل تعانون من الناموس أمام شاشة الكمبيوتر؟ الحل هنا مجرب 100%
0 باربعة كلمات تنظف جهازك من الملفات الي تبطئ الجهاز
0 تعال تعلم معنا الفوتوشوب خطوه خطوه للمبتدئين ( متجدد ) روابط جديده
0 برنامج مفيد جدا لمن يهمهم معرفة المده التى استغرقها منذ تشغيل الويندوز
0 معلومات عن الكراك للفائدة
0 هل تعانون من الناموس أمام شاشة الكمبيوتر؟ الحل هنا مجرب 100%
0 باربعة كلمات تنظف جهازك من الملفات الي تبطئ الجهاز
0 تعال تعلم معنا الفوتوشوب خطوه خطوه للمبتدئين ( متجدد ) روابط جديده
0 برنامج مفيد جدا لمن يهمهم معرفة المده التى استغرقها منذ تشغيل الويندوز