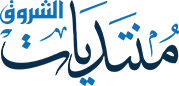الإيـمـان كـمـال الإنسانيـة (منقول)
05-07-2017, 09:38 PM
الإيـمـان كـمـال الإنسانيـة
لا شك ولا ريب أنَّ الإنسان أوَّل ما يخرج إلى هذا الكون من بطن أمه لا يعلم شيئاً، وقد جعل له تعالى السمع والبصر والفؤاد، فإذا ما كبر وبدأ يُدرك ما حوله وأخذ يتعرَّف إلى الأشياء فيتفحصها ويقلِّبها ويسبر مدى مقاومتها ومدى قوته في التغلُّب عليها وجعل يصدمها بعضها ببعض ليتعرَّف إلى أصواتها وتأثيراتها ببعضها بعضاً، ثم ينمو إدراكه ويبدأ يميِّز فيتطلَّع إلى السماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم متلألئة، وينظر إلى الأرض وما عليها من بحار وأنهار وجبال وإنسان وحيوان فيتساءل لماذا تلمع النجوم؟. ومن أين تأتي الغيوم؟. وأين تذهب الشمس في المساء؟. وقد يصل به الأمر فيسأل عن الله تعالى فيقول أين الله؟. حقّاً أين الله!. وقد يذهب بالبعض الحال لأن يسأل هل له عينان فيرى، وهل له آذان فيسمع، أم هل له يد فيبطش، أم هل له رِجلان فيمشي عليهما!. هل له جسم، أم لا؛ فهل يأكل أو يشرب، هل يُرى.. أين هو؟. ما هو الله، ما ماهيته، فهل شاهده أحد؟. حقّاً هل يُشهد ويُرى.. من رآه؟.
ليس السؤال عن الآثار، بل عن ذات الله، ما الذات الإلهية، وأين هو حقّاً موجود؟!.
أجيبونا بعلم أيها المؤمنون!.
هكذا قال الشاعر الإنكليزي الكبير "ويليام شكسبير"..
كانت تساؤلاته تدور حول ماهية الإله قوله: إذا لم تكن له عينان ويدان ورِجلان ولا يسمع صوته أحد ولا يُرى، فهل هو وهمٌ. نحن نريد أن نعيش بالمحسوس الملموس لا بالأوهام، هل ننكر المحسوس الملموس والواقع لنعيش بتصورات وتخيُّلات.. عندها هَجَرَ الدين. هل نعبد ما لا نرى ولا نسمع.
الإيمان: الإيمان شهود وحقيقة، ودين الإسلام دين حقائق.. الإيمان الحق الشهودي علم نفسي وشهود يقيني تشهده النفس في ذاتها وتعقل الوجود الإلهي في سرِّها فإذا هو حقيقة يقينية مستقرَّة فيها تخالطها وتمازجها ولا تنفكُّ أبداً عنها.
الإيمان حقيقة نفسية معنوية تبدأ شهوداً بالعين لآيات صنع وعظمة منشيء الأكوان ومحيي الكائنات الحية ومميتها، تصل بعدها نفس طالب الإله لأنوار الإله العظيم وتشاهد جماله الساري على الوجود والورود والأزهار والكائنات الفاتنات والتي هي أثر بسيط من جلال جماله تعالى.. فكلُّ روعةٍ وفتنة انعكاس من إمدادات جماله الصاعق. وتشاهد عظمته ووسعته تعالى من خلال عظمة الجبال الشاهقات المستعليات الراسخات ووسعة صنعه بالبحار والسموات.
الإيمان الصحيح لا يأتينا من غيرنا، بل إنما ينبعث في قرارة نفوسنا ويتولَّد في قلوبنا. الإيمان حقيقة معنوية تسري في نفوس طالبي الحق تعالى والحقيقة المجرَّدة والدين الحق.. تسري سريان الكهرباء في الأسلاك والماء في الأغصان والحياة في الأجساد، يُشرق في النفوس فتشعُّ فيها نور المعرفة وعلم اليقين والحياة العلوية السامية المنعكسة على الأجساد فلا شقاء بعدها ولا نكد، لا خوف ولا جبن.. لا ذلة ولا مسكنة، لا خشية في الحق للومة لائم، فكلُّ ما على التراب تراب، لا شهوةً منحطة لها أدنى تأثير على قلبٍ مؤمن إيماناً ذاتياً، بل سموٌّ وعلو، تدلُّ على هذا الإيمان الحق الصفات الحسنة والمعاملات الطيبة الممزوجة بالإنسانية الحقيقية النزيهة المجرَّدة عن الغايات المنحطة وعن المصالح الذاتية والمنافع الدنيوية، كما تدلُّ عليه الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة التي ترفع شأن المؤمن عند ربِّه وعند الناس، ويشعر به المؤمن في صميمه فيطمئن به قلبه وترتاح به نفسه وتنقشع أمامه الشكوك والشُبَهْ وتنمحي به الظلمات عن القلب فيرى.
العين ترى والقلب يرى.. "العين ترى جمال الدنيا وجمال المراه"، والقلب الخاشع من ذكرى الموت المشاهد لربِّه من آيات صنعه الكونية يرى جلال الله.. عظمة الله.. جمال الله ويستقي بقلبه جمالاً وجلالاً من حضرة الله تتضاءل تجاهه عظمة وجمال وجلال الكائنات المادية بأسرها، فمن شَهِدَ الخالق صَغُرَ المخلوق في عينه؛ فارجع البصر بالآيات كرَّتين يا موقن بلقاء ربِّك ينقلبْ إليك البصر ومشاهداته وهي خاسئة والبصر حسير.
المشاهدة الحقيقية بعين البصيرة لا بعين البصر، والإيمان شهود: أشهد أن لا إله إلاَّ الله، فمن خافت نفسه على مستقبله وحسب حساب الانتقال ومواراة جسده بالقبر ليسأل نفسه: هل توصَّلَتْ إلى هذا الإيمان الصحيح، وهل هي سلكت وتابعت خطواتهِ ومراحلَه واحدة إثر أخرى من النظر الجدِّي بالموت وما بعده، وبالسماء وآياتها، ثم بالغيوم والرياح والأنهار والجبال... فإن فعلت وصلت وإلاَّ فاستمع لإرشاد أهل الاتصال والوصول بالأصول يُرشدوك.
الإيمان ليس مجرَّد كلام نقله المرء عن الآباء والمعلِّمين والمجتمع نقلاً، بل هو شهود ذاتي وعقل، وما نقله المرء نقلاً ولم يُشاهده فيعقله عقلاً، أي: يشاهده بقلبه، {قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمَانُ في قُلُوبِكُم..}(1): وسيدخل بإذن الله.
فالنقل والإقرار إسلام والشهود بلا إله إلا الله إيمان.. والفرق شاسع والبون عظيم. والله تعالى يُدافع عن الذين آمنوا {..وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنينَ}(2).. فإن رمت السمو الإنساني والعلو الأبدي فعليك بسلوك طريق الإيمان الذاتي تربَتْ يداك، إذ الإيمان أساس كلّ خير ولا عمل عالٍ وصالحٍ إلاَّ بالإيمان.
فحذار أن تضيِّع عمرك بدون الإيمان سدى فتخسر بالشيخوخة وبعد الانتقال لعوالم الحقائق غداً. وكفى بالإنسان سموّاً أن يؤمن، إذ الإيمان كمال الإنسانية.
تقديم المربي الأستاذ
الإيـمـــــــــــــــان
( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله )
أوَّل المدارس العليا للتقوى
يخرج الإنسان أوَّل ما يخرج إلى هذا الكون من بطن أمِّه لا يعلم شيئاً، وقد جعل له الله تعالى السمع والبصر والفؤاد، فإذا ما كبر وبدأ يدرك ما حوله جعل يتعرف إلى الأشياء فيتفحَّصها ويُقلِّبها ويسبر مدى مقاومتها ومدى قوته في التغلُّب عليها وجعل يصدمها بعضها ببعض ليتعرَّف إلى أصواتها وتأثيراتها ببعضها بعضاً، ثم ينمو إدراكه ويبدأ يميِّز فيتطلع إلى السماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم متلألئة وينظر إلى الأرض وما عليها من بحار وأنهار وجبال وإنسان وحيوان فيتساءل لماذا تلمع النجوم؟. ومن أين تجيء الغيوم؟. وأين تذهب الشمس في المساء؟. وقد يصل به الأمر فيسأل عن الله تعالى فيقول: أين الله… إلى غير ذلك من الأسئلة التي يريد أن يتعرف منها إلى هذا الكون، لا بل إلى موجد هذا الكون ومبدع ما فيه. تُرى من الذي يلقِّن هذه الأسئلة للطفل، أم من الذي يوجهها إليه؟. لا ريب أن هناك صوتاً خفياً ينبض في قرارة نفسه بين الحين والحين، إنه صوت الملَكْ، يرسله الله تعالى إلى هذا الصغير يناديه في سرِّه لتحيل النفس هذه المشاكل الجديدة، وتطرح هذه الأسئلة على الفكر، ذلك الجهاز الذي أودعه الله تعالى في الإنسان، لتصل النفس بواسطته إلى معرفة الحقائق، وتتعرَّف إلى كل ما يحيط بها فتدركه وتعقله وهنالك تطمئن بما وصلت إليه عن طريقه من علم وترتاح إليه. وبمثل هذه الأسئلة التي يلقيها الملك في نفس ذلك الطفل تبدأ دواليب هذا الجهاز بالعمل وتأخذ خلاياه بالنمو وأجزاؤه بالتكامل يوماً إثر يوم وعاماً بعد عام، وما يزال كذلك آخذاً بالنمو حتى يصل هذا الطفل إلى سن الرشد حيث النضج وحيث القدرة التامة على الوصول إلى الحقيقة ومعرفة الخالق المبدع والرب الممد.
فإذا نظر الإنسان وقد بلغ هذه السن إلى تركيب جسمه البديع، وصورته البالغة في الكمال أعظم حدّ من الدقة والتنظيم، ودقَّق في كل عضو من أعضائه وما قامت عليه أجهزة جسمه من نظام، وفكَّر فيما بينها من ترابط، وما هي فيه من حركة دائمة وعمل وظيفي وأنها تعمل كلها متضافرة متعاونة بنظام متَّسق لتوفر لهذا الجسم البقاء ودوام الوجود والنماء، وإن شئت فقل لهذا العالم الذي هو وحدة في ذاته. أقول: إذا نظر هذا الإنسان إلى جسمه هذه النظرات، وفكَّر هذا التفكير، ثم رجع إلى أصله يوم كان نطفة من مني يُمنى يوم أودع في رحم أمِّه فما كان شيئاً مذكوراً، ما كانت له هذه الشخصية ولا هذه المكانة والمرتبة، ولا هذا الجسم المنظَّم، ولا ذلك الترتيب. إذا نظر الإنسان هاتين النظرتين: نظرة إلى الحاضر العتيد، ونظرة إلى الماضي، وجمع بين هذين الحالين بالمقارنة والتساؤل والمحاكمة فلا ريب أنَّ تفكيره يهديه وسرعان ما يهديه إلى أن هنالك يداً قديرة كوَّنته إنساناً سوياً، وخلقته هذا الخلق البديع وأشرفت وما تزال مشرفة عليه. وما تزال هذه النفس تمعن في التفكير بهذه النقطة وتجول في هذا المجال شوطاً بعد شوط حتى تتحقق بهذه الحقيقة ويغدو ذلك لديها أمراً بديهياً لا يحتاج إلى مناقشة أو برهان أو دليل. وهكذا فأصل الإنسان وخروجه إلى الدنيا قضية ذات شأن تستدعي التأمل وتستثير التفكير.
وكذلك وكما الخروج إلى الدنيا قضية ذات شأن، فالخروج منها قضية أبلغ شأناً وأعمق في النفس أثراً.. فبينما نحن مع من نحب وبينما هو يعمل ويكد وفيما نحن نأمل في حياتنا معه آمالاً جساماً ونعدُّ لمستقبلنا عدة ونحلم أحلاماً ذهبية إذ به كالمصباح تهب عليه عاصفة من ريح فتطفئ شعلته وتخمد حركته وتدعه جثة هامدة وجسداً خامداً.. فأين المصباح وأين الضياء.. وأين الحركة.. والحديث والآمال وأين البنات والبنين والأطفال. لقد انطفأت الشعلة وخمدت الحركة وهدأت العاصفة ومات هذا الإنسان. وهنا وبمشاهدة النفس هذا المشهد من غيرها تدور دواليب هذا الفكر دوراناً من نوع آخر وهو وإن كان يغاير دورانها الأول ويختلف عنه من حيث المجال والكيفية غير أنه يتفق معه في النتيجة والغاية كل الاتفاق فتعلم هذه النفس أن تلك اليد التي أنشأتها وأبدعتها وأخرجتها إلى هذا الوجود ووهبتها الحياة لا بد لها في يوم من الأيام مهما طال بها الأمد وامتد الزمان من أن تسترد وديعتها وتأخذ أمانتها ومهما طمعت بالبقاء وحاولت البقاء فلا بقاء فالمدة مؤقتة والعارية مستردَّة وأن مع القوة ضعفاً ومع الفرح حزناً ومع الحياة موتاً محتماً وإذا حلَّ الموت وأحاط فلا فوت ولا مناص. قال تعالى: {وَلَو تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَريبٍ} 1
{فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، وأَنْتُمْ حِينَئذٍ تَنْظُرُونَ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُون}1
وبمثل هذا الحال تخاف النفس وترهب وتلتجئ إلى الفكر تطلب إليه التعرُّف على تلك اليد التي أنشأتها وبرأتها، والتي ألقتها في هذا الوجود وأخرجتها، والتي إذا هي شاءت استردَّت وديعتها وتوفَّتها. وهنا يتَّسع مجال التفكير ويتجاوز الإنسان حدود ذاته ويبدأ يفكِّر فيما حوله من آيات هذا الكون من شمس وقمر ونجوم وجبال وأنهار وبحار وحيوان ونبات وليل ونهار وفصول أربعة ورياح وسحب ورعود وبروق وأمطار.
ينظر الإنسان في هذا الكون العظيم نظرات عميقات فيرى أن كل ما في الكون يعمل ويسير لكنه إنما يعمل وفق نظام وقانون. وفق قانون شامل ونظام عام والكون كله إنما هو وحدة تسيطر عليه وتسيِّره قوة وإرادة واحدة ضمن علم وحكمة وقدرة ورحمة. ينظر الإنسان في هذا الكون هذه النظرة ويرجع إلى نفسه فيجد أنه جزء صغير في هذا الكون وأنه مشمول أيضاً بهذا النظام، فهذه الأرض العظيمة السابحة في هذا الخضم الواسع اللامتناهي مرتبطة بالشمس والقمر والنجوم، وما هذه الأجرام كلها وما هذه الموجودات جميعها إلا خاضعات لتلك الإرادة العليا والقوة اللامتناهية التي تشرف عليها جميعها وتسيِّرها كلها.
وبالوصول إلى هذه النقطة وبلوغ هذه المشاهدة وإن شئت فقل: بمشاهدة أن لا إله إلا الله والإيمان بالله يتولَّد في النفس شعور بالعظمة، وتحصل لها الخشية من تلك الإرادة العليا المهيمنة على هذا الكون، والمسيِّرة له ضمن العلم والحكمة والقدرة والرحمة فلا يستطيع هذا الإنسان من بعدُ أن يتعرّض بالسوء لأحد من بني الإنسان مهما تكن صفته ومهما تكن درجة قرابته، ولا يجرؤ على إيذاء مخلوق من المخلوقات لأن كل ما في الكون من مخلوقات إنما هو نسيج هذه الذات العلية.
فتجد هذا الإنسان أضحى مستقيماً بالمعاملة مع جميع الخلق، وتجرّه الاستقامة هذه إلى الثقة بأن الله راضٍ عنه فيقبل عليه، فبهذا الإقبال والوجهة تشتق النفس من الله تعالى كمالاً، تلك هي الصلاة في حقيقتها، وتلك هي الصلاة التي يجب أن تقيمها وتسعى إليها، وإنك لتجد النفس إذا وصلت إلى هذه الصلاة وبلغت هذا الحال لا تعود تميل إلى الدنيا وما فيها من الشهوات الدنيئة وتعاف ما في الدنيا مما سوى فعل المعروف والإحسان. لقد اصطبغت بصبغة من الله ومن أحسن من الله صبغة.
على أنك قد تعجب من نفسك أيها القارئ وتقول: مالي أصلِّي ولا أجد طعماً للصلاة، وأصوم ولا أصلُ لما يهدف إليه الصيام من غايات، وكم مرة حججت فما عرفت من الحج إلا جملة أدعية وأذكار ومراسم وأشكال وزيارات وركوب مشقَّات، وتصدَّقت بما تصدقت وأنا لا أتصدَّق عن طيب نفس ولا أنفق إلا كارهاً خائفاً الفقر!!.
وأسمع بالمؤذن يؤذِّن فلا أجد للأذان حلاوة!!. ولا في سماع القرآن طلاوة!. ولست أدرك منه ما فيه من معانٍ عالية كما تقولون. ولا أجد فيه ترابطاً بين الآيات، ولست أدري من أحاديثه عن الأمم السابقة إلاَّ أنها مجرد قصص وحكايات، وأنا لا أفهمه بذاتي بل لابد لي من تفسير ألجأ إليه يترجم لي عن معانيه ومع ذلك كله فكثيراً ما أنسى هذه الترجمة، وكثيراً ما لا أدرك معنى التفسير ذاته، ولا أفقه شيئاً من ذلك الترجمان؟؟.
فأجيبك على قولك هذا وأقول: لا تعجب يا أخي من قولك هذا ولا تستغربن ما أنت فيه فأكثر الناس يصلُّون ولا يدركون من الصلاة إلا أنها مجرد أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير منتهية بالتسليم، وأنها من أحسن الرياضات الجسمية وأنها أمر تعبدي أمر به الله تعالى الإنسان ليقدّم واجب الخضوع لخالقه في اليوم والليلة خمس مرات. ويعرّفون الصوم بأنه ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات بنيّة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وأنه يشعر الغني بألم الجوع الذي يكابده الفقير، وأنه يُذهب بالأمراض ويفيد الصحة إلى حد كبير.
وأن الحج زيارة أمكنة مخصوصة في أشهر مخصوصة، وأنه مؤتمر عام يجمع المسلمين يتدارسون الأوضاع ويتعارفون ويرسمون الخطط السياسية التي تجعلهم يهنؤون في العيش ويردُّون عدوان المعتدين، ويحسبون الزكاة بأنها تأدية مالية بنسبة معينة يقدّمها الغني للفقير، وهكذا تراهم يضعون حدوداً وأشكالاً من التعاريف، وتجد الكثيرين يقومون مثلك بهذه العبادات والأشكال والمراسيم، ويكرِّرون ويعيدون ما يسمعونه يحسبونه الإسلام وما هو من الإسلام في شيء، فما أمرك خالقك بالصلاة لِتُقدِّم واجب الخضوع.. فهو سبحانه غني عن العالمين، وهو أعزُّ وأكبر من أن يتطلَّب من هذا الإنسان أن يعترف بوحدانيته وأن يقدِّم الخضوع إليه، وهو أرحم بالإنسان من أن يأمره بالصوم شهراً كاملاً وأن يفصله عن أهله يركب المشقات والأخطار، ويطوف حول الكعبة وينادي بأعلى صوته مبتهلاً بالدعاء ليحصل على الغفران. ولو يشاء لأغنى الفقير ولمَا طلب من الغني زكاة ولا صدقة وما هو بحاجة لك لتطعم من لو يشاء الله أطعمه وما هذه الأوامر كلها إلا أوامر من مستوى عالٍ وضعت لإنسان وصل لمستوى عالٍ ذاك هو يعقلها ويدرك أسرارها، ويقدِّر فضل خالقه الذي أمره بها، فتراه يصلي ساجداً وهو يتمنى أن يظل العمر ساجداً وهو في حقيقته ساجدٌ دوماً لله لا يرفع رأسه ولا ينقطع عن السجود. ويصوم وينقضي رمضان فتراه يبكي متطلباً من الله تعالى أن يهبه عمراً يصوم به رمضان ثانيةً لما وَجَدتْه نفسه في الصيام من سموٍ وما وصلت إليه في منازل العلم والمعرفة وهي حقيقة التقوى من مراتب ودرجات.
ويحج ويعود من الحج إنساناً قد أرخت إليه المعرفة زمامها فأضحى بصيراً مشاهداً عارفاً بماهية الحياة وأسرارها.. فلم الحياة؟. وكيف الحياة؟. ومتى تدوم؟. وما الشرائع؟. وما الكون؟. وأين هي سعادة المخلوق؟. كيف ينالها؟. وكيف تكون؟.
ويزكِّي فيجد في الزكاة مغنماً، وفضلاً كبيراً فيشكر المعطي الأول ويستغرق في حمده سابحاً في فضله، فهو وحده المعطي وهو المتفضل وكل الفضل منه وإليه يعود.
ويقول لا إله إلا الله فيشهد معناها شهوداً نفسياً. فإذا قال بلسانه أشهد: فما اللسان إلاَّ ترجمان ما شَهدتْهُ نفسه وعاينته من الحنان وعطف تلك اليد التي تسيِّر الكون كله غامرةً إياه بفيض من التلطف والرأفة والرحمة والحنان والفضل والإحسان. وكلما كررها اللسان مرة أذكى القول الشعلة في النفس فأضاءت واتَّقدت، وأضافت النفس إلى شهودها شهوداً والله أكبر ولا نهاية ولا حدَّ لذلك الشهود والعلم به ولا انتهاء.
أمَّا رسول الله e فما أعظم رسول الله في الحقيقة وأجلَّ مقامه عند هذا الإنسان، إنه السيد الأعظم الذي فاز بالقرب من الله بأعلى منزلةٍ وأسمى مقام.. المؤمنون جميعاً مؤتمّون به وتحت لوائه، وهم أبداً في صلة دائمية معه وهو الداخل بهم على الله، وهو الأول في هذا المجال وهو الإمام. فيا سعادة النفس إذا هي صلَّت به، واتَّصلت بهذه النفس الطاهرة، فكانت بمعية الحضرة الإلهية والإقبال على الله.
تلك معانٍ يشعر بها هذا الإنسان حال إقباله على الله، من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وصومٍ، وصلاةٍ، وحجٍّ، وزكاةٍ، يشعر بها هذا الإنسان فتطير نفسه شعاعاً وكثيراً ما تفنى عن ذاتها مستغرقة بهذا الشعور ثم تعود وهي أسمى ما تكون علماً وأكثر مما كانت عليه معرفة وأعظم لله تعالى حمداً وشكراً. وهي أبداً في سعادة وهي أبداً في ارتقاء وهي أبداً في حياة طيبة غفل عنها كثير من الناس فظنوا الأوامر الإلهية أموراً تعبدية وحسبوها تقديماً لواجب الخضوع، ونسوا حظاً مما ذكِّروا به فضلّوا عن السعادة، وأضلوا كثيراً.
والسبب في ذلك كله أن هذه الأوامر التي جاء بها سيد الخلق والمرسلين مُبلِّغاً إياها عن رب العالمين، إنما هي مدرسة عليا خاصة بالمؤمنين وليس يفقه دروسها إلا من سمت به همَّته فتدرَّج فيما سبقها من الدراسة في مدرستين اثنتين تحضيريتين.
وإذا نحن أردنا أن نسمي هذه المدرسة العليا بالجامعة، فما المدرستان السابقتان سوى الابتدائية والثانوية وهل يمكن لمن لم ينتسب للثانوية والابتدائية أن ينتسب رأساً للجامعة!. أم ماذا يكون حاله إذا دخل صفاً من صفوفها وانخرط بين طلابها، فهل تجد له وعياً وهل تجده يفقه من ذلك المعلم العظيم قولاً، وهل يستطيع أن يجد بين أقواله انسجاماً أو يفقه لأقواله تفسيراً أو تأويلاً، وهل هو بمقدِّر لهذا المعلم العظيم وعارف فضل أولئك الطلاب في ذلك المعهد العالي الرفيع!!.
إن كلَّ ما يقوم به هؤلاء من أعمال ومهمات إن هو في نظره إلا مجرّد أقوال وأفعال، فالصلة والالتفات إلى ذلك المعلم العظيم أسر وبدعة وقيود وهو لا يحب الأسرَ ولا البدعة ولا القيود. والصوم جوعٌ وعطش وخمول والمجيء إلى هذا المعهد أهوال ومغامرات وركوب مشقات. قال تعالى: {وَمَثَلُ الَّذينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ}(1).
نعم وما ذلك كله إلا لأن هذا الطالب طَفَر طَفْرَةً واحدةً فدخل الجامعة ولمَّا يستعدّ لها. وكذلك المدرسة التي جاء يدعو لها رسول الله e إنها معهد من سوية عالية وهي في الحقيقة جامعة. لكنها تختلف عما سواها من الجامعات إذ لها بداية وليس لصفوفها حدٌّ ولا انتهاء. ولا بدَّ لك حتى تعرف عظمتها وتدرك قدر رئيسها الأول وتفهم كلامه e وتفقه بيانه من أن تعدَّ نفسك إعداداً صحيحاً بالانتساب إلى المدرستين السابقتين اللتين أشرنا إليهما من قبل وسنكرر لك القول ونعيده فنذكِّرك والذكرى تنفع المؤمنين فنقول: إن هذا الصوم الذي جاء به رسول الله e لابدَّ له من صومٍ يسبقه ولابدَّ لتلك الصلاة التي أمرنا بها عن لسان الله تعالى من صلاة قبلها تتقدمها وتمهد لها.
وكذلك الحج والزكاة، وأقول لك وحقاً ما أقول إن حديث «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجُّ البيت من استطاع إليه سبيلاً»1.. إنما هو حديث شريف يعرِّفك بصفوف الدراسة في الجامعة العليا ومراحلها. ولست بمستطيع أن تدرك ممَّا جاء بها شيئاً، ولا أن تفقه سرَّ ما ورد فيه ولا أن تتذوق طعم ما أشار إليه، إلاَّ إذا أعددت نفسك إعداداً تاماً، ووصلت بها إلى سوية رفيعة.. فإذا شهدت أن لا إله إلا الله وأتْبعت ذلك بصوم وصلاة وزكاة وحج فعندئذٍ تكون أهلاً لأن تشهد أنَّ محمداً رسول الله وتستطيع أن تدخل تلك الجامعة وتتَّصل بذلك المعلم العظيم الذي يعلِّمك الصلاة والصيام والزكاة والحج. وتتابع الدراسة متعرفاً إلى حديث بُني الإسلام على خمس فتكون من أهل التقوى وأهل المعرفة بالله. قال تعالى: {وَالَّذينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ}2.
وقد تعجب من ترتيبـي الذي عرضته لك. إذ بدأت بشهادة أن لا إله إلا الله وأتبعتها بصوم وصلاة وزكاة وحج ثم ختمت ذلك بشهادة أن محمداً رسول الله، ثم قلت إن السير على هذا يصل بالإنسان إلى الدخول في تلك الجامعة العليا ومتابعة الدراسة فيها. والحقيقة أني ما أردت بترتيب الصوم والصلاة والزكاة والحج ما ورد في الحديث الشريف، إنما مبادئ ودروس ترتكز عليها تلك الصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال التي جاء بها السيد الأعظم e.
فإذا بلغ الإنسان من الطفولة مرحلة التمييز ودارت دواليب الفكر لديه فتعرَّف على الخالق الذي خلقه وجعله على هذا التركيب وأنهى الدراسة الأولى في التعرّف إلى الخالق، والإدراك عن طريق الفكر أن هذا الجسم المنظَّم لا بدَّ له من منظِّم ووصل إلى سن البلوغ وقد عرف هذه الحقيقة وثبتت لديه، فهنالك وبتفكيره بالموت وشهوده وقائع عديدة منه ترهب نفسه خائفة وتلتجئ إلى الفكر تطلب منه أن يجدَّ في البحث عن المربي إذ يرى نفسه مخلوقاً ضعيفاً، وأنه بحاجة إلى من يربّيه ويديم إمداده له ويشرف عليه. إنه بحاجة إلى الطعام والشراب، بحاجة إلى الشمس والهواء، بحاجة إلى الثلوج والأمطار، بحاجة إلى الليل والنهار. مفتقرٌ إلى ذلك كله، إذ بدون هذا لا يمكن بقاؤه ولا تدوم حياته، فمن الذي يعنى به هذه العناية ويقدِّم له صنوف هذه الأشياء التي يتوقف عليها بقاؤه في الحياة؟.
إنه لابدَّ له من ربٍ ممدٍ يمدّه بهذه الخيرات. وهنا ينتقل إلى صف أعلى فيعرف أن له ربّاً قديراً يمدُّه بما يمدُّهُ به ويحفظ عليه الحياة، ويوسِّع الإيمان بالمربي آفاق الفكر لديه فيقول: إذا كان هذا المربي هو الذي ينزل الأمطار ويسوق الرياح والسحاب ويحرك الكرة في الفضاء فيتولد الليل والنهار وينبت الزرع والنبات ويدير الكون كله ليتأمن لي ما أحتاج فهو لاشك المسيِّر للكون فالكون كله في جميع ما فيه خاضعٌ له تعالى ومفتقر إليه، وهنا وبالوصول إلى هذه النقطة ينال هذا الإنسان شهادة ثانية وهي شهادة أن لا إله إلا الله شهدها قلبه من بعد أن حاكم وناقش فكره وعقلت ذلك نفسه فإذا شهد هذه الشهادة وإن شئت فقل: إذا رأت نفس الإنسان عظمة هذا الكون وشاهدت جلال اليد التي تديره كله في لحظة واحدة دون انقطاع فلا يَعْزُبُ عنها شيء في الأرض ولا في السماء، أقول : إذا شاهدت النفس هذه المشاهدة وإن شئت فقل إذا شهدت النفس أن لا إله إلا الله شهوداً معنوياً، وشعرت في أعماقها ذلك الجلال الإلهي والعظمة فهنالك تحصل لها الخشية من الله، وتحمل هذه الخشية الإنسان على الاستقامة وتحول بينه وبين كل معصية فلا يعود هذا الإنسان يجرؤ على اقتراف إثمٍ أو الوقوع في خطيئة، إذ كيف اتَّجه وحيثما سار وأينما كان يرى الله تعالى معه مشرفاً عليه وناظراً إليه، ولذلك تراه يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به فلا يستطيع أن يؤذي إنساناً ولا أن يمدَّ يده بالسوء إلى أحد من المخلوقات، وذلك ما عنيناه نحن من الصيام فهو في الحقيقة صوم عن الأذى صوم عن المعصية والفسق والعدوان. وبما أن القوانين الثابتة للنفس البشرية بفطرتها الأزلية عدم الاستقرار والهدوء بل لابدَّ لها من أن تعمل خيراً أم شراً، فهي مفطورةٌ دائماً وأبداً بجبلتها على العمل ولا تستطيع أن تبقى هادئةً لذا فإذا بلغت في عروجها مرحلة الصيام الحقيقي فهي تعمل وكل عمل يصدر عنها وهي في حصن الصوم هو عمل خيِّر ينبع منه الإحسان. فهذا العمل العالي يورث في النفس الثقة بإحسانها والثقة برضاء بارئها بارئ السموات العلى عنها. ويولِّد هذا الصوم عن المحرمات ثقة في النفس برضاء الله عنها فتقبل عليه بكلِّيتها مطمئنة بإحسانها راضية بعملها.
وهنالك تشعر باطنياً بشعور جميل إنه شعورٌ بالقرب من تلك الذات العلية إنه شعورٌ فريدٌ في نوعه شعورٌ ما عهدته النفس من قبل. فما الأغنياء بذهبهم وفضَّتهم وأموالهم، ولا المزارعون في بساتينهم ومزارعهم، ولا المترفون في قصورهم وحدائقهم، ولا الحكام في صولتهم ودولتهم ولا الملوك والأمراء في صولجان ملكهم وإمارتهم أقول ليس هؤلاء جميعاً بأسعد حظّاً من النفس القريبة من ربها، ولو علم هؤلاء بما في هذه النفس من الشعور السامي الجميل لقاتلوا عليه ولتنازلوا عن ملكهم وعما بين أيديهم رغبةً فيه.
فسبحانك ربي ما أجمل القرب منك وما أحلاه وما أجمل الحياة لدى النفس في ساعات قربها من الله. إنه النعيم، إنها السعادة، إنها الحياة الطيبة التي لا يمازجها نغص، إنها الجنة، ولعمري تلك هي الصلاة. وذلك ما عنيناه بكلمة (الصلاة) التي يولّدها الصوم عن المحرمات. وأعتقد الآن أنك أدركت سرَّ ترتيبنا في بدئنا بشهادة أن لا إله إلا الله ثم اتباعها بالصيام والصلاة وعرفت ما نعنيه من شهادة أن لا إله إلا الله وما نعنيه من الصيام والصلاة.
وبذلك نستطيع أن نتابع ترتيبنا وننتقل بك إلى الزكاة فنقول:
إن هذه الصلة الجميلة، وهذا الشعور السامي الذي نشعره في حال قربنا من الله يجعلنا في الوقت ذاته نكتسب من الله تعالى كمالاً ونصطبغ منه تعالى بصبغة الكمال لأن النفس خلال قربها وحال وجهتها إلى خالقها يسري النور إليها فيطهرها مما بها من جرثوم، ويقضي على ما فيها من انحرافات ويزكّيها ممَّا علق بها من قبل من الميول المنحطة، والدنيء من الشهوات فينقلب هذا الإنسان وهو أصفى ما يكون حالاً، وأطهر قلباً، وأزكى وأنقى نفساً، وذلك ما نعنيه بكلمة (الزكاة).
فإذا ما زكت نفس الإنسان هذه الزكاة بالله وطهرت هذه الطهارة فهنالك لا تعود تحب أن تفعل منكراً، ولا أن تقع في معصية أو خطيئة.
وإذا ما أراد الشيطان أن يغريها بشيء أو يغريها بما في الشهوات الدنيا من جمال وزينة فإنها لا تلتفت إليه ولا تميل بل إنما تردّه خائباً، وتقيم عليه الحجة فلها من كمالها وطهارتها، ولها من زكاتها التي ولدتها صلتها بخالقها ما يجعلها تأنف من كل خطيئة وتعاف كل دنيَّة، وذلك هو الحج الذي نوَّهنا عنه من قبل، وذلك سبب إيرادنا إيَّاه بعد الزكاة، ولعلَّك عرفت سرَّ كلامنا عنه في آخر هذا المجال الذي سننتقل منه إلى شهادة أن محمداً رسول الله حيث الصلة بسيد الخلق والعالمين، وحيث الانتساب إلى معهده العالي الرفيع فنقول: إذا شهد الإنسان أن لا إله إلا الله حسبما بيَّناه من قبل، وأدَّت به شهادة أن لا إله إلا الله إلى صوم وصلاة وزكاة وحج وأصبحت نفس هذا الإنسان من سوية عالية تختلف عمَّا سواها من الأنفس البشرية من حيث تذوّقها معاني الفضيلة، وأنفتها من الرذيلة، وأنس بالله وسعادة بالإقبال عليه، واصطباغ منه تعالى بصبغة الكمال، فهنالك تراه يدأب باحثاً ويجدُّ في طلب الاجتماع بذلك الرجل وإن شئت فقل بذلك المعلم العظيم الذي فاقه في هذه الآفاق العالية فكان المرشد وكان السابق وكان الأول في هذا المضمار. فلعلك تقول إذا كان هذا الإنسان قد نشأ في بلاد بعيدة ومناطق نائية عن العمران وكان ممن لم يسمع قط بأن هناك إنساناً فاق العالمين في تلك النواحي فكيف يجدّ في طلبه أم كيف يبحث عنه ولا عهد له به، ولا قرأ ولا سمع عنه من أي شخص كان!. فأقول وعلى وجه المثال أوضّح ما أقول: هب أن امرءاً أصابه مرض أمضَّه وألزمه الفراش أياماً، ثم اجتمع إلى طبيب فجعل يصف له من العلاجات ما أزال عنه بعض ما به، وانتهت به معالجات هذا الطبيب إلى حدّ لم يستطع معه أن يستأصل العلّة كل الاستئصال وإن كان أصاب بواسطته تقدماً ظاهراً، أفلا تجد هذا الشخص المريض يبحث دوماً ويتطلع إلى أخبار العالم كله ويسأل ويجدُّ في الطلب عن طبيب نطاسي ينال على يديه شفاءً تاماً وبرءاً كليّاً؟؟.
لاشك أنه ما يزال يبحث ويفتش حتى يجتمع بذلك الطبيب وهو لابدّ واصل إلى بغيته وأنك لتراه ينفق ما ينفق في سبيل الوصول إليه راضية بذلك نفسه غير مكترث بما يصيبه في هذا السبيل من أتعاب، وما يكابده من مشقَّات. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المتعلمين في عصرنا الحاضر فإنك تجد الواحد منهم إذا نال الشهادة الثانوية تتفتَّح لديه آفاق جديدة من المعرفة فتراه يبحث عن الجامعات التي تصل به إلى معرفة وعلم، بل إلى مستوى ثقافي واجتماعي أعلى وأرفع ممّا نال. وما يزال يسأل هذا وذاك حتى يهتدي ويقع على الخبر الصحيح، ثم تراه بعد ذلك يفارق الأهل ويغادر الأوطان، ويركب البحار، ويكابد الأهوال. وكم مرةٍ يتعرض للموت وتحيط به المخاطر في طريقه إلى تلك الجامعة، وتراه مع ذلك كله طيِّبةً بذلك نفسه، إذ سيصل إلى ذلك المعهد العالي وسيجتمع بذلك المعلم العظيم الذي ينهض به ويؤمِّن له اجتماعه إليه سوية أرفع ومكانة أسمى وأشرف ممَّا هو عليه الآن. تُرى: هل كان ذلك الإنسان المريض الذي ضربناه لك مثلاً يتساءل ويبحث عن أمهر الأطباء، وما يزال يجدّ حتى يتعرف إليه لو لم تكن به علَّة، ولو لم تكن لديه تلك الحاجة الماسة، والضرورة المُلحَّة وهل كان ذلك الإنسان الثاني الذي ذهب يطلب العلم من تلك الجامعات العالية يهتم في البحث عن تلك الجامعات ويسأل القريب والبعيد عن ذلك المعلم الذي سينهض به؟.
وهل تظن أنه كان سيهتدي إليه لو لم يصل إلى تلك السويّة العلمية التي جعلته أهلاً لأن يبحث ويجدّ في طلبه والاجتماع به!. وكذلك الإنسان الطالب الوصول إلى التقوى ومعالي منازل الإيمان، كمالُه وصفاؤُه النفسي. وأُنسُهُ بالله، وحُبُّه للفضيلة، يجعله يبحثُ ويجدُّ في الطلب، ومن وراء ذلك كله صوت الملك يناديه دوماً في صميمه يا عبد الله لابدَّ من وجود رجل يفوقك فيما أنت فيه، فابحث عنه وجدَّ في طلبه، وإنه والحالة هذه ليصدق وما يزال يصدق ويتحرَّى الطلب حتى يهديه الله، والله يهدي من يشاء الهداية. قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنينَ}1
ومما يؤيد لك ما قلناه ما رواه الرواة عن إسلام سيِّدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وإنه ليأخذك العجب العجاب حين تسمع بقصة إسلامه المذكورة مفصَّلةً في كتب السيرة فنقول: كيف تسنَّى لرجل من فارس أن يجتمع برسول الله فيؤمن به وينصره ويصبح من أقرب المقرَّبين إليه وما بين بلد هذا الرجل وما بين يثرب حيث الرسول الكريم شاسع المسافات ونائي الديار؟؟. لكنَّك إذا دقَّقت فيما قدَّمناه من قبل وأمعنت النظر فيه وجدت أنَّ الأمر لا يتوقف على قرب الديار وبعدها ولا علاقة له بالقرابة والنسب إنما الأمر كله موقوف على أهليّة النفس واستعدادها، فإذا ما أعدَّ الإنسان نفسه الإعداد اللازم وبلغ بها تلك السوية العالية التي تجعله أهلاً للاجتماع بذلك الرسول الكريم، أو المرشد الذي ينوب عنه e في البلوغ بالأنفس الصادقة إلى ذلك المقام العالي الرفيع، فهنالك تجدُّ هذه النفس وتندفع في طريقها باحثة منقبة، وما تزال تبحث حتى يهديها الله وتقع على الحقيقة. فسيدنا سلمان رضي الله عنه، لو لم يكن به ذلك الدافع إلى معرفة الحق لما وصلت به قدماه إلى أرض الحجاز، ولما أخذ قلبه يرجف فرحاً لما سمع بمقدمه e إلى المدينة المنورة، بل لما كاد أن يسقط من أعلى النخلة وهو يجني ثمارها شوقاً إلى هذا الرسول الكريم والسيد العظيم، لكنها إرادة الحكيم ومشيئة هذا الرب الرحيم تسوق كل امرئ إلى ما تطلبه نفسه، وتجمعه بمن صدق في طلبه وابتغاه.
أنت والمشيئة مشيئتك فإذا ما أعددت نفسك الإعداد الكافي وأهَّلتها الأهلية التامة، فلا ريب أن الله تعالى يتفضل بما تشاء وتريد قال تعالى: {مَنْ كَانَ يُريدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً، كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً، انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وللآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضيلاً)1
قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، تُؤْتي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربِّهَا.) 2
وكذلك الأمر بالنسبة لي ولك ولكل إنسان مهما امتد وطال به الزمان إذا هو تحقَّق بمعرفة خالقه ومربيه، وانتهت به معرفته هذه إلى الإيمان بكلمة (لا إله إلا الله)، لابدَّ له من أن يجتمع حقاً بذلك المرشد الذي يدله على الله ويصل به إلى حضرة الله، فتكون له برفقته ودخوله بمعيّته على الله أذواق وأحوال ومشاهدات ثم إنه لابدَّ له في يوم من الأيام ما دام وقد ارتبطت نفسه به وثيق الارتباط من أن يكون وسيطاً بينه وبين رسول الله e، ينعكس في قلب هذا المريد الصادق ما انعكس في قلب مرشده من حب الرسول والارتباط به e وما يزال به حتى يتم ارتباطه بذلك الرسول الكريم حيث الشهود بذلك السراج المنير لكمال الله وحيث الاستنارة بنور الله، يشاهد به الخير خيراً والشر شراً، ويصل إلى السعادة الحقَّة والحياة، وأنت ترى مما أسلفناه أن الإيمان بالمرشد الصادق وكذلك الإيمان برسول الله e ليس بالأمر الهيّن إذ لابدّ لهذا الإيمان بالرسول من إيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، نعم إنه ليس بالأمر الهيّن لكنه يسير كل اليسر على الصادق.
إذا شهد الإنسان هذه الشهادة الأولى وعقل كلمة (لا إله إلا الله) عقلاً نفسيّاً ولَّد في نفسه استقامة وأدَّت به هذه الاستقامة إلى الصلة بالله والإقبال النفسي عليه فعندئذٍ وبما اكتسبت نفسه من الله تعالى من الكمال، وبما انطبع فيها من الحق تراه إذا سمع بكلمة عن رسول الله صدَّقها كل التصديق إذ يجدها مطابقة لما في نفسه، فبكماله يشهد طرفاً من كمال رسول الله، وبما اصطبغ به قلبه من الحق يرى الحق الذي جاء به رسول الله فيصدِّق بكلمات الله ورسوله ويصدِّق بالحق وأهله. قال تعالى: {الَّذينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، وَإذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمينَ}1
{وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدينَ، وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ باللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالحينَ}2
وهكذا فإيمانك، وشهودك وتحقُّقك بكلمة (لا إله إلا الله) هو الدعامة الأولى وهو الركيزة التي يبنى عليها إيمانك برسول الله e. وإن شئت فقل: شهادة أن لا إله إلاَّ الله هي التي توصلك إلى شهادة أن محمداً رسول الله، إذ بكمالك ترى طرفاً من كماله فتؤمن له وتشهد، وبما انطبع في نفسك من الحق تشاهد الحق الذي جاء به فتذعن له وتخضع وعندئذٍ تدخل ذلك المعهد العالي وتنتسب إلى تلك الجامعة التي نوَّهنا عنها من قبل فتتَّخذ رسول اللهe لك هادياً ومرشداً، وتجعله في دخولك على الله إماماً وتطيعه كل الطاعة وتستسلم له كل الاستسلام. قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليماً}1
وإن نفسك لترتبط بنفس رسول الله الكريم وهي في مثل هذه الحال وثيق الارتباط وتحصل لها صلة معنوية حقيقية به ما مثلها من صلة، إنَّها صلة حبّ وتعظيم وذوق رفيع لا يعرفه إلاَّ المؤمنون بالله الذين شارفت نفوسهم منازل الكمال فسمعوا النداء الإلهي يناديهم في سرِّهم قال تعالى: {إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليماً}2
نعم إن نفسك لتتصل معنوياً بنفس رسول الله الطاهرة السامية وإن أذنك وقلبك ليتفتح لما يمليه عليك من الدلالات والأوامر الإلهية فتصغي إليه، ويحق لك وقد وصلت إلى ما وصلت إليه من كمال أن تكون طالباً لهذا المعلم العظيم يعلمك الأوامر التي جاء بها عن الله. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً، وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنيراً، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ الله فَضْلاً كَبيراً3
ليس المقصود بالإيمان بالله تعالى الاعتراف بوجود الخالق، ذلك الاعتراف القولي الذي يدور على ألسنة العامّة من الناس. لأنَّ مجرَّد الاعتراف بوجود الخالق لا يسمى إيماناً وهو لا يغرس في قلب صاحبه مكرمةً أو يكسبه فضيلة أو ينتزع من نفسه خبثاً، كما لا يدخله في الآخرة جنَّةً أو يقيه ناراً.
وقد ضرب لنا تعالى على ذلك إبليس مثلاً، فذكر لنا في القرآن الكريم اعترافات إبليس بوجود خالقه وإقراره له بالربوبية والعزة فقال تعالى: {قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ، قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّك رَجيمٌ، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتي إِلى يَوْمِ الدّينِ، قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْني إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ، إِلى يَوْمِ الْوَقتِ الْمَعْلُومِ، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ}1
ففي الآية الأولى اعتراف منه لخالقه وفيما يليها إقرار بربوبيته ثم أقسم بعزة الله ومع ذلك كله وصف تعالى إبليس بأنه من الكافرين وأن عليه اللعنة إلى يوم الدين. وكذلك اليهود ما كان اعترافهم بخالقهم ليردّهم عن طغيانهم قال تعالى: {وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ}2
وإذاً فليس الإيمان بالخالق اعترافاً قولياً إنما هو شعور داخلي ولَّده في النفس بحث ذاتي وتفكير متواصل فجعل صاحبه يسبح في جلال الله تعالى ويخرُّ ساجداً لعظمته. وهكذا فالإقرار النفسي المقرون بذلك الشعور والتذوُّق المنبعث من قرارة النفس، هو الإيمان الصحيح وما سواه مما يتلقَّنه الإنسان من أبيه وأمه أو البيئة التي ينشأ فيها تلقناً ولا ينبعث في النفس متولِّداً عن نظر وتفكير ما هو بالإيمان المطلوب.
ولكن كيف يتولَّد هذا الإيمان الذي هو أساس طهارة النفس وتحليتها بالكمالات الإنسانية في نفس الإنسان!. وكيف يشع في قلبه؟.
أقول: لقد خلق الله الإنسان وميَّزه كما ذكرنا من قبل على سائر المخلوقات بتلك الجوهرة التي يستطيع بها أن يتوصل للكشف عن الحقيقة وأعني بهذه الجوهرة التفكير.. ثم إنَّ الله تعالى جعل هذا الكون وما فيه من آيات بيِّنات ونظام بديع وحكمة بالغة بين يدي الإنسان كتاباً مفتوحاً يستطيع أي إنسان كان إذا نظر فيه مدقّقاً وتفكر متأملاً أن يعظِّم هذا الكون تعظيماً يهتدي من ورائه إذا كان صادقاً في طلب الحقيقة إلى معرفة خالقه والإيمان به والخشوع له. وهكذا فمعرفة المربي هي النبراس الذي يصل بالإنسان إلى مشاهدة الحقيقة وهي السبب الوحيد في الوصول إلى الخير والسعادة، وقد وهب الله الناس جميعاً الفكر تلك الأداة التي يستطيعون بواسطتها أن يصلوا إلى معرفة خالقهم ومربِّيهم، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وبثَّ في هذا الكون ما لا يحصى من الآيات التي تساعد الفكر على البحث والاستدلال. فمن استفاد من هذه الجوهرة الثمينة، وأشغل فكره وأعمله في معرفة خالقه ومربيه فقد ظفر بالسعادة، وفاز، ومن أشغل هذا الفكر وأعمله في السعي وراء المكاسب الدنيوية وتأمين الشهوات الدنيّة فقد خاب وخسر هذه الحياة قال تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئكُمْ بِالأَخْسَرينَ أَعْمَالاً، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحيَاة الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً، أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَزْناً، ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آياتي وَرُسُلي هُزُواً، إِنَّ الَّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً، خَالِدينَ فيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً}1
ليس المراد بالإيمان ذلك الإيمان الذي يتناقله السامع عن محدثه، أو يتلقَّاه الطالب عن كتابه ومعلمه ويتوارثه الولد عن أمه وأبيه. فهذا النوع من الإيمان لا نستطيع أن نسمِّيه إيماناً بل هو مجرد اعتقاد وتصديق.
الإيمان الصحيح لا يأتينا من غيرنا بل إنما ينبعث في قرارة نفوسنا ويتولّد في قلوبنا. الإيمان الصحيح علم نفسي وشهود يقيني تشهده النفس في ذاتها وتعقله في سرِّها فإذا هو حقيقة مستقرة فيها تخالطها وتمازجها ولا تنفك عنها. الإيمان شيء معنوي حقيقي يسري في النفس سريان الكهرباء في الأسلاك والماء في الأغصان والحياة في الأجساد، يشرق في النفس فيشعُّ فيها النور والعلم والحياة، تدلُّ عليه الصفات الحسنة والمعاملات الطيّبة والأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة ويشعر به المرء في صميمه فيطمئن به قلبه وترتاح به نفسه وتنقشع أمامه الشكوك والشُبَهْ وتنمحي به الظلمات. أما الذين في قلوبهم ريْب وفي أعمالهم إساءات وفي نواياهم سوء وخبث وفي أعمالهم أيضاً تلاعب وانحراف، فما هم من الإيمان في شيء ولو زعموا أنهم مؤمنون قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا باللهِ وَبِاليَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنينَ، يُخَادِعُونَ الله وَالَّذينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يشْعُرُونَ، في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}1
فاسأل أيها الإنسان نفسك هل توصلت إلى هذا الإيمان الصحيح الذي نتكلم عنه، وهل هي تابعَتْ خطواته ومراحله واحدة إثر أخرى، فإن فَعَلَتْ فاطلب منها أن تذكر لك هذه المراحل وتعددها وتبيّن لك الطريق التي سَلَكَتْها. وإن لم تفعل فاستمع إلي أرشدك وما عليك إلا أن تسلك الطريق بذاتك وتتعرَّف إلى مراحله واحدة بعد واحدة فأقول:
أول ما يجب أن يبدأ به الإنسان أن ينظر في نفسه ويتفكَّر في ذاته ممَّ خُلق.. وكيف تكوَّن في بطن أمه حتى صار إنساناً سوياً.. وعليه أن يتابع بفكره الأطوار التي تنقَّل فيها والمراحل التي مرَّ عليها فمن نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مضغة، ومن مضغة إلى إنسان سويٍّ كامل الهيئة تام التركيب يحار الفكر في كمال صنعه ويقف حائراً أمام عظمة كل جهاز من أجهزته وحاسة من حواسِّه ولا يسعه إلا أن يخرَّ ساجداً لعظمة تلك اليد التي عملت على تكوينه وإحكام صنعه.
فإذا ما نظر في نفسه هذه النظرات جنيناً وأتبعها بنظرات أخرى تدور حول أيام طفولته الأولى مولوداً صغيراً يوم كان يأتيه الغذاء من ثدي أمه لبناً سائغاً كامل التركيب كافي المقدار منظم المعايير متوافقاً في نسبته الغذائية مع تدرجه في النمو يوماً بعد يوم بحسب ما يتطلبه جسمه ويحتاج إليه. أقول: إذا نظر الإنسان في نفسه هذه النظرات، وفكَّر هذا التفكير وتابع ذلك وتوسَّع فيه لا شك أن تفكيره هذا يرشده ويهديه إلى أن هناك يداً عظيمة صنعته وخلقته وعنيت بتربيته منذ أن تشكل وخرج إلى هذا الوجود وهي ما تزال مستمرة العناية به قائمة بالتربية عليه. إن هذه النظرات في البداية وفي أصل التكوين لها أثرها لا بل عليها يتوقف الإيمان بالمربي. ومن لم ينظر هذه النظرات في أصله، ومن لم يتعرَّف إلى بدايته فما هو من الإيمان الصحيح اليقيني بربه في شيء.
قال تعالى معرِّفاً إيانا بطريق الاستدلال على معرفة المربي بما أشارت إليه الآيات الكريمة في قوله سبحانه: {قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ، ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ}1
{فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ والتَّرَائِبِ}1
{وَلَقَد خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قَرَارٍ مَكينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقينَ}2
أما وقد عرف الإنسان خالقه ومربيه وتبدَّت له عظمة ربّه فلا شكَّ أن ذلك يقوده إلى التوسُّع في التفكير وينتقل به إلى النظر في نهايته كما نظر في بدايته فيتساءل في نفسه؛ ما بال فلان قد قضى نحبه؟. وما بال فلان لم يطل به أمد الحياة؟. وأين فلان وفلان وما بقي لهؤلاء الذين فارقوا هذه الحياة من العزّ والسلطان؟. وأين هم من متع الحياة وشهواتها وجميع ما فيها من ملذَّات؟. وإذا كان الموت نهاية كل إنسان ومصيره المحتوم وإذا كانت مساعي الإنسان جميعها تصل به إلى هذه النهاية مهما امتد العمر وطال، فما في الحياة من أمل، والخاسر الذي يسترسل فيها دون أن يتعرَّف فيها إلى ما ورائها.
وهنا وبمثل هذا التفكير في النهاية، والمصير إلى القبر وما فيه من رهبة ووحشة تخاف النفس وتلتجئ إلى الفكر وتصدق في طلب معرفة الحقيقة. فلم جاء الإنسان إلى هذا الوجود وما هذه اليد التي خلقته وأرسلته إلى هذه الدنيا ثم كتبت عليه الموت ومفارقة الحياة؟!. وينشد الإنسان هذا النوع الجديد من المعرفة ناظراً في أصله لما كان نطفة فيقول: هذه النطفة التي منها أنا، منها خلقت وتكونت، إن هي إلا خلاصة ألوان شتى من أطعمة وفواكه وأثمار تجمّعت هذه الخلاصات ومنها خُلقت، فمن أين جاءت هذه الأطعمة؟. ومن الذي خلق هذه الفواكه والخضر والألوان؟. وما هذه البذور المختلفة؟. ومن أين جاءت؟. ومن الذي ألقى بها على سطح الأرض؟. ما هذه التربة التي اشتملت عليها؟. وكيف تكوَّنت؟. ما هذه الأنهار؟. ما هذه الأمطار؟. ما هذه الشمس؟. ما هذا الليل والنهار؟. ما هذا السير الدائم؟. ما هذه الحركة المستمرة المنتظمة في هذا الكون؟. ما هذه الدورات المنظمات؟. بل ما هذه اليد التي تدير هذا كله لتتأمن حياتي ولتتوفر أقواتي ويستمر وجودي؟. أليس هذا الكون كله وحدة مترابطة الأجزاء متماسكة الأجرام؟. أليس ذلك كله يعمل ضمن قانون ونظام؟. أما لهذا الكون من يديره!. وقدرة عليا مهيمنة تشرف على ملكوت السموات والأرض ولا يعزب عنها من مثقال ذرة!. وهنا ينتقل هذا الإنسان إلى هذه النقطة الجديدة فتعقل النفس عظمة هذه الإرادة العليا، والقدرة التي لا حدَّ لها والتي نظَّمت الكون بما فيه عُلْويّهُ وسفليّه، جليله وحقيره، صغيره وكبيره تدرك النفس طرفاً من عظمة الله تعالى وتعرف أنه لا مسيّر غيره ولا متصرف في هذا الكون إلا الله إنها تدرك حقيقة كلمة (لا إله إلا الله) فتعلم أن التصرُّف بيده وحده وليس لأحد من حول ولا قوة إلا به وليس من حركة إلا بإمداده ومن بعد إذنه.. فلا تهب رياح ولا تتراكم غيوم ولا تهطل أمطار، ولا تشرق شمس ولا تدور أرض ولا يتعاقب ليل ونهار، ولا تدب دابّة، ولا تنبت نبتة، ولا تنعقد ثمرة، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه تعالى ومن بعد إذنه. ويتسع أفق التفكير لدى هذا الإنسان فيرى أن اليد لا تتحرك حركة وأن الرجل لا تنطلق خطوة، والعين لا تطرف طرفة، والأذن لا تسمع همسة، واللسان لا ينطق ويلفظ كلمة إلاَّ بإذن الله وبحول وقوة منه. يدرك هذا الإنسان ذلك كله عندها تدخل النفس في حصن الاستقامة فتجد أن الله تعالى معها ومشرف عليها بل هو الممدُّ لها في كل لحظة وحين لا يحول ولا يزول فحيثما حلَّ هذا الإنسان وارتحل وأينما سار وانتقل. وكيفما نظر وأنَّى اتَّجه يرى الله تعالى معه، وأنه شاهد عليه فهو سبحانه ناظر رقيب، وسامع قريب، وبه قيام وجود الكون بجميع ما فيه وهو أقرب إلى الإنسان من نفسه التي بين جنبيه.
قال تعالى:{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ}(1).
هذه هي المرحلة التي يفضي إليها الإنسان، وهذه هي الحقيقة التي يعثر عليها من بعد تفكيره المتواصل يعقلها عقلاً، ويصبح إيمانه بكلمة (لا إله إلا الله) مبنياً على علم كما أمر سبحانه وتعالى بذلك، إذ قال: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَه إلاَّ اللهُ..}2 وهذا النوع من الإيمان هو المطلوب من كل إنسان وذلك هو الإيمان الحق الذي يحجز الإنسان عن المعاصي والموبقات.
وفي الحديث الشريف: «كفى بالمرء علماً أن يخشى الله1
وقال تعالى: {..إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ..}2
وإلى ذلك أشار e بقوله الشريف: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة، قيل: وما إخلاصها؟. قال أن تحجُزَهُ عن محارم الله»3
أما وقد أصبح هذا الإنسان في حال يشهد معه أن الله تعالى ناظر رقيب ومشرف قريب لذلك تراه يستقيم على أمر الله فلا يخالف أوامر ربه في شيء. فالعين لا تنطلق واللسان لا ينطق واليد لا تتحرك والرجل لا تخطو إلا ضمن ما أمر به الله ووفق ما بينه رسول الله e. وإلى ذلك أشار e بقوله الشريف: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به»4
وهنا وبمثل هذا السير الطيب والعمل الصالح تتولَّد في تلك النفس المؤمنة الثقة برضاء الله عنها، وتطمئن أنها ذات حظوة لديه تعالى ولذا تجدها تقبل على الله وتتجه إليه وتحصل لها وبحسب حالها الصلة النفسية بخالقها، وبهذه الصلة تنمحي من النفس شوائبها وكدوراتها وتطهر من أدرانها. وبهذه الصلة أيضاً تشتق النفس منه تعالى كمالاً وخلقاً سامياً وصفة عالية، وبهذا تدخل في عداد من تحلَّت نفوسهم بالكمال، وتغدو ذات قابلية وأهلية لتقدير رسول الله e سيِّد أهل الكمال، وبذلك تُضحي من صحابته e وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. عندها تستطيع أن تصلي الصلوات الخمس كما أمر الله بها وتحصل على الفائدة المرجوَّة منها والتي شرعت من أجلها وإلى ذلك أشار e حيث يقول: «أرأيتم لو أنَّ نهراً بباب أحدكم يغتسل في كل يوم خمس مرات، ما تقولون؟. ذلك يبقي من درنه؟. قالوا لا يبقي من درنه شيئاً قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا»1
وتتقدَّم النفس بصلاتها يوماً إثر يوم وترقى حيناً بعد حين في منازل الكمال حتى تصبح أهلاً لأن تشتبك بنفس رسول الله e فتعشقه، وهنالك وبمثل هذه الحال تدخل بمعيّته e على الله فتشهد من الكمال الإلهي وترى من الأسماء الحسنى ما يجعلها تهيم بالله حبّاً بنسبة ما شهدت ورأت.
بقي علينا أن نبيِّن في هذا القدر كيفية تولد الغل والحسد وسائر العلل المعنوية في النفس، كما أنه من الواجب علينا أن نبيّن كيفية التخلُّص من هذه العلل. والوصول إلى تطهير النفس منها وتحليتها بالفضائل والكمالات الإنسانية فنقول: خلق الله تعالى الإنسان وأخرجه إلى هذه الدنيا نقيّاً طاهر القلب، نفسه كالمرآة الصافية أو الصفحة البيضاء التي لم ينقش عليها شيء وإلى ذلك يشير الحديث في قوله e : «كل مولود يولد على الفطرة»1
كما تشير الآية الكريمة في قوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا..}2
وما يزال الإنسان نقي النفس حتى يبلغ الحلم ويصل إلى سن الرشد وفي هذه المرحلة يصبح أمام طريقين اثنين: فإما أن ينهج طريق الإيمان، وإما أن ينهج طريق الكفر والإعراض. فإن هو آمن بالله حق الإيمان وأقبل بالصلاة بكل قلبه عليه فهنالك تشتق نفسه من الله تعالى منبع الكمال وموئل الفضائل كلها وينتقش فيها الكمال، فيغدو هذا الإنسان إنساناً كاملاً فاضلاً متحلِّياً بالكمالات الإنسانية، مشحون القلب بالرحمة والرأفة والرضاء، عفيفاً طاهراً صادقاً أميناً سخياً كريماً شجاعاً جريئاً عادلاً محسناً مشغوفاً بعمل الخير عطوفاً على الخلق يتمنى الخير لكلِّ إنسان.
كل هذه الكمالات وسائر الكمالات الإنسانية تنقش في نفس هذا المؤمن بالصلاة بصورة لاشعورية وتصطبغ بها بصبغة من الله، قال تعالى: {صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً..}3
وهكذا وبنسبة هذا الإقبال تزداد هذه الانطباعات بالفضائل والكمال ولذا كان رسول الله e أعظم الناس رحمةً وأشدهم على الخلق إشفاقاً ورحمة وعطفاً وأكبرهم من الفضائل حظاً قال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ..}1، {وَاصْبِر وَمَا صَبْرُكَ إلاَّ بِاللهِ..}2
لهذا نال رسول الله الرحمة وسائر الكمالات.. وتلك هي الطريق الوحيدة إلى نيل الكمال التي سلكها الصحابة الكرام، وكان حظّهم من هذا الكمال مُتناسباً مع إقبالهم فكان منهم السابق والأسبق والمجلّي في هذا الميدان. وكذلك كل مؤمن بحسب إقباله بصلاته يتبع ذلك الركب الأول الأمثل فالأمثل. أما الذي يصل إلى سن الرشد والتمييز ولا يستعمل تلك الجوهرة الثمينة التي زيّنه الله بها ورفع شأنه على الحيوان لا بل على سائر ما خلق، هذا الإنسان الذي لم يُعمل تفكيره في الوصول إلى الإيمان بالله فلا شك أنه يظلُ محروماً من الإقبال على الله، وينشأ عن الإعراض وعدم الإقبال عدم التقدير لفضل الله وإحسانه ذلك المعبَّر عنه بكلمة (الكفر).
وبسبب الكفر والإعراض عن الله تتولَّد في النفس العلل المعنوية من غلّ وحقد وحسد وقسوة قلب وحرمان من الرحمة وحب للتعدّي والظلم إلى غير ذلك من العلل والرذائل والصفات المنحطة الذميمة، وهنالك يدْلُك الشيطان إلى النفس التي امتلأت بهذه العلل وأضحت مشحونة بالخبث يزيِّن لها سوء أعمالها فتظنُّها حسنة. وتلك العلل المتولِّدة في هذه النفس المعرضة هي حظ الشيطان من الإنسان.
ومن أحسن الأمثلة في هذا الموضوع مثل: غرفتين إحداهما معرَّضة لنور الشمس والأخرى مظلمة محرومة منها. فلا شك أن الأولى التي تتعرَّض لنور الشمس تصبح طاهرة نقية، ولا شك أن الثانية بحرمانها من النور تنبت فيها الجراثيم والعُفونات وتغدو خبيثة الرائحة ملوثة الهواء.
ذلك هو مثل الأنفس في إقبالها على الله وبُعدها وإعراضها عنه فالمقبلة عليه تعالى تصبح طاهرة نقية تتولَّد فيها الفضائل وتنطبع فيها الكمالات. والمعرضة عنه تعالى يتولد فيها الخبث وتنشأ فيها العلل المعنوية المنحطة، غير أن هذه النفس المعرضة التي وهبها الله تعالى من الاستعداد ما تستطيع به أن تتراجع عن غيِّها لا يأساً من شفائها مما هي مصابة به فالأمر موكول إلى هذا الإنسان وحده. قال تعالى: {..إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ..}1
فإن رجع الإنسان إلى نفسه بالتفكير واهتدى من وراء تفكيره إلى خالقه فأناب إليه وأقبل عليه تعالى بكلِّيته، فهنالك يمسح النور الإلهي صفحات النفس فيعيد إليها طهارتها ونقاءها ويرجع بها إلى فطرتها قال تعالى: {فأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلقِ اللهِ ذلِكَ الدّينُ القَيِّمُ وَلكِنَّ أكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ، مُنيبينَ إليْهِ وَاتَّقُوهُ وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}2
وهكذا فالمسألة مسألة إقبال وإدبار. فمن فكَّر وأناب وأقبل على الله تعالى تحلَّت نفسه بالفضائل وطهرت من العلل وامتلأت بالكمال، ومن استكبر وأعرض انحطَّت نفسه وتدنَّت وتلوثت بالعلل المعنوية والأدران.
ليس بوسع الإنسان، أي إنسان أن يؤوّل القرآن مهما بلغ من الثقافة ومهما حصل من العلوم حتى ولو حفظ القرآن، وروى الأحاديث بأسانيدها واطلع على جميع المذاهب وعرف اللغة ومصطلحاتها من نحو وصرف وغيرها، كل هذا ما كان ليكفيه إلا بشرط واحد وأساسي، به يرى القرآن وقد توضحت له معانيه ووجده مترابطاً متناسقاً يدور حول نقطة أساسية وهذا الشرط هو الإيمان بلا إله إلا الله. قال تعالى: {..قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ والَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً..}1
من هذا المنطلق يؤمن باليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله عندها يرى كل ما في القرآن من أوامر ونواه وكل ما فيه من عبر وحكم وأمثال، وكل ما يأمر به تعالى من صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إن هي إلا أوامر خيِّرة ليقرِّبه بها إليه وليعلم بأنه لا إله إلا هو، فلا يعتمد ولا يتَّكل، ولا يطلب، ولا يستعين إلا به وبدونه لا تحصل له زكاة وطهارة، ولن يكون عنصراً صالحاً للمجتمع مهما كانت التربية ومهما كانت الثقافة التي تلقَّاها من دونه تعالى. فإن لم تكن معايناً وممارساً ومشاهداً التسيير الإلهي، وإذا لم تحصل لك حلاوة الإيمان، ولم تتذوق الرحمة، والعدل والكرم، وإن لم تعلم علماً يقينيّاً بأنه لا فاعل إلاَّ الله، وأنه لا يتحرَّك متحرِّك ولا يسكن ساكن إلا من بعد إذنه، فكيف تستطيع أن تؤوِّل القرآن وتفقه مراميه؟. فالقائد إذا لم يدرس القتال عملياً، لا بد أن يخطئ مهما درس وتعلم، والميكانيكي إذا لم يرَ الآلة وحركتها ولم يختبرها بنفسه فإن علمه عنها يبقى في الحدود النظرية، وكذلك الإنسان قد يسمع وقد يقنع ويصدِّق بفكره فيعرف أن الرزَّاق هو الله، ولكن لا يتَّكل عليه كليّاً، ويعلم أن النصر من الله ولكنه يتهيب غيره، وقد تصيبه مصيبة فتثور ثائرته، وينسى بأن ما أصابه إنما جاء نتيجة ما قدَّمت يداه، فأوْلى له أن يرجع إلى نفسه، لا أن يتَّهم غيره، وبمعنى أشمل إن العلوم النظرية عامة وعلوم الدين خاصة لا تساوي شيئاً دون المحك العملي، فإذا لم يتبع النظر العمل فإن علمه يظل سطحياً.
إن البعيد عن الله لا يعرف مراده تعالى، وهل باستطاعة إنسان أن يعرف مراد ومغزى من لا يعرفه؟. إلاَّ من قبيل الظن والتخمين؟. وإن الظن لا يغني عن الحق شيئاً. إن القرآن حق، والبعيد عن الله لا يعرف إلاَّ الباطل، فكيف يستطيع المعرض أن يعرّف الحق ويبيِّنه. فالإنسان لا يفهم مراد ربِّ العالمين "أي لا يفهم القرآن إلا إذا كان قريباً من الذي نزَّل القرآن".. ولا يستطيع أن يتقرَّب منه إلا إذا سلك طريق الإيمان به، وبهذا التقرُّب ينطبع في نفسه الحق من صاحب الحق، وتغدو نفسه مملوءة من الكمال الإلهي، بعدها إذا نظر إلى القرآن وتدبر آياته يجده الحقّ من ربه فلا يؤوِّله إلا بما يتوافق والكمال الإلهي. فكلَّما علا الإيمان سما التأويل، وكلَّما سما التأويل فإن تنزيه الحضرة الإلهية يكون أكمل.
الإيمان: هو الأساس في تأويل القرآن، أما اللغة وما فيها من نحو وصرف والأدب وما فيه من بلاغة وبيان، والتاريخ وما يحويه من العلوم القرآنية وأسباب نزول الآيات، والسير والعبر والحوادث، إن هي إلا علوم مساعدة وثانوية بالنسبة للإيمان.
إن الرسول e ما نزل القرآن على قلبه الطاهر ولا استطاع أن يفهم مراد رب العالمين إلا بإيمانه الرفيع، فهو الذي فاق الخلق جميعاً بالقرب منه تعالى وهو الذي أصبح بالأفق الأعلى من بين الرسل الكرام، فشاهد من آيات ربه الكبرى وما كذب فؤاده ما رأى بل هي أشد وضوحاً من رؤيته البصرية. كل ذلك ما كان إلاَّ عندما أضحى قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله في قلبه ما أوحى. فهو e أول الخلق في الغاية التي من أجلها خُلقوا. قال تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ}1
ولهذا ما نزل القرآن العظيم على قلبه إلا بالحق وبجدارة. قال تعالى: {وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ..}2
فقد تعلَّم منه علماً وفهم من القرآن فهماً لم ولن يبلغه أحد من العالمين قال تعالى في سورة الرعد (43): {ويَقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرسَلاً قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْني وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}: مثلي؟. أي ومن عنده علم الكتاب مثلي؟. كل ما جاء به من سنن وكل ما رويَ عنه من أحاديث إنما جاء بها القرآن الكريم ومن علمه العالي به.
إن القرآن بحر ما فرَّط الله فيه من شيء، وهو تبيان لكل شيء من أمور العبادة، والسنن، والشرائع المنظمة للفرد والجماعة والدولة والدول. ولن يقدِّر علم الرسول ولن يقدِّر فضله إلا من سلك مسلكه وأحبَّت نفسُه نفسَه حبّاً تضاءل أمامه حب ابنه وزوجته وأمه وأبيه وعشيرته التي تؤويه. وكل من في الأرض جميعاً حتى نفسه التي بين جنبيه، فعندئذٍ يعلم طرفاً من علم الرسول لهذا الكتاب الكريم. ومن الخطأ أن يُعتبر الحديث والسنَّة والإجماع متمِّمة للقرآن، بل هي قواعد عملية ونظرية استنبطها الرسول e من هذا الكتاب، فالنبي محمد e لم يأت من عنده بشيء وليس هو بحاجة إلى شيء، ففي القرآن تفصيلٌ لكل شيء.
إن القرآن نزل على قلبه في ليلة قدَّر الله فيها حق قدره، قدَّر رحمته وعطفه، وحنانه وعدله، وعظمته، ثم رتَّله عليه آية إثر آية وسورة بعد سورة بحسب الظروف والمناسبات، قال تعالى: {.. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}1. إنه شاهد الحق وعاينه فجاء القرآن تثبيتاً وتصديقاً لما شاهده من قبل لقد نزل القرآن على قلبه الطاهر في ليلة مباركة من شهر مبارك في ليلة القدر التي هي خير من عبادة إنسان قضى في عبادته ثلاثة وثمانين عاماً ونيف.
هذا الشهر هو شهر التقوى، فيه تصفو النفس يوماً بعد يوم وتزكو بإقبالها على الله بالثقة التي اكتسبها المرء من صيامه وقيامه، وصدقه، حتى إذا ما بلغت النفس العشر الأواخر تكون قد استوت وزكت، فيكشف الله لها ما يكشف في صلاة التراويح، فتصبح وقد غدت عالمة بقدرته وعظمته، مستسلمة للحق، لا تلتفت إلى سواه، محفوظة بسلام حتى مطلع فجر الآخرة. قال تعالى: {سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}1
{وَقَالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَولاَ نُزِّلَ عَلَيهِ القُرآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلنَاهُ تَرْتِيلاً}2
أي كذلك نحن نزلناه جملة واحدة ثم رتلناه عليك ببيان، وبلاغة عالية حسب المناسبات، ولنثبت به فؤادك، وليكون تأكيداً وشاهداً لك على ما شاهدته من الحق قبل أن ينزل عليك ثانية وتضعه في مصاحف وأي إنسان يسلك مسلك رسول الله e فإنه يرى في القرآن انطباعاته النفسية، أي أن القرآن يعكس مشاهداته العملية، ويرى تطابقاً بين ما شاهده بنفسه وبين ما شاهده في القرآن فيزداد ثقة ويزداد إيماناً وابتهاجاً.
قال تعالى: {وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكْتُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}3
{إِنَّا أنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرينَ}4
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالفُرقَانِ..}5
مقدمة.................................................. ................. 5
الإيمان (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) أول المدارس العليا للتقوى. 9
كيفية الوصول إلى الإيمان.............................................. 29
ثمرة الإيمان اليقيني وطريقها........................................... .. 31
الطريق الوحيد لتطهير النفس وتحليتها بالفضائل......................... 38
بالإيمان يتم تأويل القرآن............................................ ... 42
لا شك ولا ريب أنَّ الإنسان أوَّل ما يخرج إلى هذا الكون من بطن أمه لا يعلم شيئاً، وقد جعل له تعالى السمع والبصر والفؤاد، فإذا ما كبر وبدأ يُدرك ما حوله وأخذ يتعرَّف إلى الأشياء فيتفحصها ويقلِّبها ويسبر مدى مقاومتها ومدى قوته في التغلُّب عليها وجعل يصدمها بعضها ببعض ليتعرَّف إلى أصواتها وتأثيراتها ببعضها بعضاً، ثم ينمو إدراكه ويبدأ يميِّز فيتطلَّع إلى السماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم متلألئة، وينظر إلى الأرض وما عليها من بحار وأنهار وجبال وإنسان وحيوان فيتساءل لماذا تلمع النجوم؟. ومن أين تأتي الغيوم؟. وأين تذهب الشمس في المساء؟. وقد يصل به الأمر فيسأل عن الله تعالى فيقول أين الله؟. حقّاً أين الله!. وقد يذهب بالبعض الحال لأن يسأل هل له عينان فيرى، وهل له آذان فيسمع، أم هل له يد فيبطش، أم هل له رِجلان فيمشي عليهما!. هل له جسم، أم لا؛ فهل يأكل أو يشرب، هل يُرى.. أين هو؟. ما هو الله، ما ماهيته، فهل شاهده أحد؟. حقّاً هل يُشهد ويُرى.. من رآه؟.
ليس السؤال عن الآثار، بل عن ذات الله، ما الذات الإلهية، وأين هو حقّاً موجود؟!.
أجيبونا بعلم أيها المؤمنون!.
هكذا قال الشاعر الإنكليزي الكبير "ويليام شكسبير"..
كانت تساؤلاته تدور حول ماهية الإله قوله: إذا لم تكن له عينان ويدان ورِجلان ولا يسمع صوته أحد ولا يُرى، فهل هو وهمٌ. نحن نريد أن نعيش بالمحسوس الملموس لا بالأوهام، هل ننكر المحسوس الملموس والواقع لنعيش بتصورات وتخيُّلات.. عندها هَجَرَ الدين. هل نعبد ما لا نرى ولا نسمع.
الإيمان: الإيمان شهود وحقيقة، ودين الإسلام دين حقائق.. الإيمان الحق الشهودي علم نفسي وشهود يقيني تشهده النفس في ذاتها وتعقل الوجود الإلهي في سرِّها فإذا هو حقيقة يقينية مستقرَّة فيها تخالطها وتمازجها ولا تنفكُّ أبداً عنها.
الإيمان حقيقة نفسية معنوية تبدأ شهوداً بالعين لآيات صنع وعظمة منشيء الأكوان ومحيي الكائنات الحية ومميتها، تصل بعدها نفس طالب الإله لأنوار الإله العظيم وتشاهد جماله الساري على الوجود والورود والأزهار والكائنات الفاتنات والتي هي أثر بسيط من جلال جماله تعالى.. فكلُّ روعةٍ وفتنة انعكاس من إمدادات جماله الصاعق. وتشاهد عظمته ووسعته تعالى من خلال عظمة الجبال الشاهقات المستعليات الراسخات ووسعة صنعه بالبحار والسموات.
الإيمان الصحيح لا يأتينا من غيرنا، بل إنما ينبعث في قرارة نفوسنا ويتولَّد في قلوبنا. الإيمان حقيقة معنوية تسري في نفوس طالبي الحق تعالى والحقيقة المجرَّدة والدين الحق.. تسري سريان الكهرباء في الأسلاك والماء في الأغصان والحياة في الأجساد، يُشرق في النفوس فتشعُّ فيها نور المعرفة وعلم اليقين والحياة العلوية السامية المنعكسة على الأجساد فلا شقاء بعدها ولا نكد، لا خوف ولا جبن.. لا ذلة ولا مسكنة، لا خشية في الحق للومة لائم، فكلُّ ما على التراب تراب، لا شهوةً منحطة لها أدنى تأثير على قلبٍ مؤمن إيماناً ذاتياً، بل سموٌّ وعلو، تدلُّ على هذا الإيمان الحق الصفات الحسنة والمعاملات الطيبة الممزوجة بالإنسانية الحقيقية النزيهة المجرَّدة عن الغايات المنحطة وعن المصالح الذاتية والمنافع الدنيوية، كما تدلُّ عليه الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة التي ترفع شأن المؤمن عند ربِّه وعند الناس، ويشعر به المؤمن في صميمه فيطمئن به قلبه وترتاح به نفسه وتنقشع أمامه الشكوك والشُبَهْ وتنمحي به الظلمات عن القلب فيرى.
العين ترى والقلب يرى.. "العين ترى جمال الدنيا وجمال المراه"، والقلب الخاشع من ذكرى الموت المشاهد لربِّه من آيات صنعه الكونية يرى جلال الله.. عظمة الله.. جمال الله ويستقي بقلبه جمالاً وجلالاً من حضرة الله تتضاءل تجاهه عظمة وجمال وجلال الكائنات المادية بأسرها، فمن شَهِدَ الخالق صَغُرَ المخلوق في عينه؛ فارجع البصر بالآيات كرَّتين يا موقن بلقاء ربِّك ينقلبْ إليك البصر ومشاهداته وهي خاسئة والبصر حسير.
المشاهدة الحقيقية بعين البصيرة لا بعين البصر، والإيمان شهود: أشهد أن لا إله إلاَّ الله، فمن خافت نفسه على مستقبله وحسب حساب الانتقال ومواراة جسده بالقبر ليسأل نفسه: هل توصَّلَتْ إلى هذا الإيمان الصحيح، وهل هي سلكت وتابعت خطواتهِ ومراحلَه واحدة إثر أخرى من النظر الجدِّي بالموت وما بعده، وبالسماء وآياتها، ثم بالغيوم والرياح والأنهار والجبال... فإن فعلت وصلت وإلاَّ فاستمع لإرشاد أهل الاتصال والوصول بالأصول يُرشدوك.
الإيمان ليس مجرَّد كلام نقله المرء عن الآباء والمعلِّمين والمجتمع نقلاً، بل هو شهود ذاتي وعقل، وما نقله المرء نقلاً ولم يُشاهده فيعقله عقلاً، أي: يشاهده بقلبه، {قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمَانُ في قُلُوبِكُم..}(1): وسيدخل بإذن الله.
فالنقل والإقرار إسلام والشهود بلا إله إلا الله إيمان.. والفرق شاسع والبون عظيم. والله تعالى يُدافع عن الذين آمنوا {..وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنينَ}(2).. فإن رمت السمو الإنساني والعلو الأبدي فعليك بسلوك طريق الإيمان الذاتي تربَتْ يداك، إذ الإيمان أساس كلّ خير ولا عمل عالٍ وصالحٍ إلاَّ بالإيمان.
فحذار أن تضيِّع عمرك بدون الإيمان سدى فتخسر بالشيخوخة وبعد الانتقال لعوالم الحقائق غداً. وكفى بالإنسان سموّاً أن يؤمن، إذ الإيمان كمال الإنسانية.
تقديم المربي الأستاذ
عبد القادر يحيى الشهير بالديراني
الإيـمـــــــــــــــان
( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله )
أوَّل المدارس العليا للتقوى
يخرج الإنسان أوَّل ما يخرج إلى هذا الكون من بطن أمِّه لا يعلم شيئاً، وقد جعل له الله تعالى السمع والبصر والفؤاد، فإذا ما كبر وبدأ يدرك ما حوله جعل يتعرف إلى الأشياء فيتفحَّصها ويُقلِّبها ويسبر مدى مقاومتها ومدى قوته في التغلُّب عليها وجعل يصدمها بعضها ببعض ليتعرَّف إلى أصواتها وتأثيراتها ببعضها بعضاً، ثم ينمو إدراكه ويبدأ يميِّز فيتطلع إلى السماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم متلألئة وينظر إلى الأرض وما عليها من بحار وأنهار وجبال وإنسان وحيوان فيتساءل لماذا تلمع النجوم؟. ومن أين تجيء الغيوم؟. وأين تذهب الشمس في المساء؟. وقد يصل به الأمر فيسأل عن الله تعالى فيقول: أين الله… إلى غير ذلك من الأسئلة التي يريد أن يتعرف منها إلى هذا الكون، لا بل إلى موجد هذا الكون ومبدع ما فيه. تُرى من الذي يلقِّن هذه الأسئلة للطفل، أم من الذي يوجهها إليه؟. لا ريب أن هناك صوتاً خفياً ينبض في قرارة نفسه بين الحين والحين، إنه صوت الملَكْ، يرسله الله تعالى إلى هذا الصغير يناديه في سرِّه لتحيل النفس هذه المشاكل الجديدة، وتطرح هذه الأسئلة على الفكر، ذلك الجهاز الذي أودعه الله تعالى في الإنسان، لتصل النفس بواسطته إلى معرفة الحقائق، وتتعرَّف إلى كل ما يحيط بها فتدركه وتعقله وهنالك تطمئن بما وصلت إليه عن طريقه من علم وترتاح إليه. وبمثل هذه الأسئلة التي يلقيها الملك في نفس ذلك الطفل تبدأ دواليب هذا الجهاز بالعمل وتأخذ خلاياه بالنمو وأجزاؤه بالتكامل يوماً إثر يوم وعاماً بعد عام، وما يزال كذلك آخذاً بالنمو حتى يصل هذا الطفل إلى سن الرشد حيث النضج وحيث القدرة التامة على الوصول إلى الحقيقة ومعرفة الخالق المبدع والرب الممد.
فإذا نظر الإنسان وقد بلغ هذه السن إلى تركيب جسمه البديع، وصورته البالغة في الكمال أعظم حدّ من الدقة والتنظيم، ودقَّق في كل عضو من أعضائه وما قامت عليه أجهزة جسمه من نظام، وفكَّر فيما بينها من ترابط، وما هي فيه من حركة دائمة وعمل وظيفي وأنها تعمل كلها متضافرة متعاونة بنظام متَّسق لتوفر لهذا الجسم البقاء ودوام الوجود والنماء، وإن شئت فقل لهذا العالم الذي هو وحدة في ذاته. أقول: إذا نظر هذا الإنسان إلى جسمه هذه النظرات، وفكَّر هذا التفكير، ثم رجع إلى أصله يوم كان نطفة من مني يُمنى يوم أودع في رحم أمِّه فما كان شيئاً مذكوراً، ما كانت له هذه الشخصية ولا هذه المكانة والمرتبة، ولا هذا الجسم المنظَّم، ولا ذلك الترتيب. إذا نظر الإنسان هاتين النظرتين: نظرة إلى الحاضر العتيد، ونظرة إلى الماضي، وجمع بين هذين الحالين بالمقارنة والتساؤل والمحاكمة فلا ريب أنَّ تفكيره يهديه وسرعان ما يهديه إلى أن هنالك يداً قديرة كوَّنته إنساناً سوياً، وخلقته هذا الخلق البديع وأشرفت وما تزال مشرفة عليه. وما تزال هذه النفس تمعن في التفكير بهذه النقطة وتجول في هذا المجال شوطاً بعد شوط حتى تتحقق بهذه الحقيقة ويغدو ذلك لديها أمراً بديهياً لا يحتاج إلى مناقشة أو برهان أو دليل. وهكذا فأصل الإنسان وخروجه إلى الدنيا قضية ذات شأن تستدعي التأمل وتستثير التفكير.
وكذلك وكما الخروج إلى الدنيا قضية ذات شأن، فالخروج منها قضية أبلغ شأناً وأعمق في النفس أثراً.. فبينما نحن مع من نحب وبينما هو يعمل ويكد وفيما نحن نأمل في حياتنا معه آمالاً جساماً ونعدُّ لمستقبلنا عدة ونحلم أحلاماً ذهبية إذ به كالمصباح تهب عليه عاصفة من ريح فتطفئ شعلته وتخمد حركته وتدعه جثة هامدة وجسداً خامداً.. فأين المصباح وأين الضياء.. وأين الحركة.. والحديث والآمال وأين البنات والبنين والأطفال. لقد انطفأت الشعلة وخمدت الحركة وهدأت العاصفة ومات هذا الإنسان. وهنا وبمشاهدة النفس هذا المشهد من غيرها تدور دواليب هذا الفكر دوراناً من نوع آخر وهو وإن كان يغاير دورانها الأول ويختلف عنه من حيث المجال والكيفية غير أنه يتفق معه في النتيجة والغاية كل الاتفاق فتعلم هذه النفس أن تلك اليد التي أنشأتها وأبدعتها وأخرجتها إلى هذا الوجود ووهبتها الحياة لا بد لها في يوم من الأيام مهما طال بها الأمد وامتد الزمان من أن تسترد وديعتها وتأخذ أمانتها ومهما طمعت بالبقاء وحاولت البقاء فلا بقاء فالمدة مؤقتة والعارية مستردَّة وأن مع القوة ضعفاً ومع الفرح حزناً ومع الحياة موتاً محتماً وإذا حلَّ الموت وأحاط فلا فوت ولا مناص. قال تعالى: {وَلَو تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَريبٍ} 1
{فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، وأَنْتُمْ حِينَئذٍ تَنْظُرُونَ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُون}1
وبمثل هذا الحال تخاف النفس وترهب وتلتجئ إلى الفكر تطلب إليه التعرُّف على تلك اليد التي أنشأتها وبرأتها، والتي ألقتها في هذا الوجود وأخرجتها، والتي إذا هي شاءت استردَّت وديعتها وتوفَّتها. وهنا يتَّسع مجال التفكير ويتجاوز الإنسان حدود ذاته ويبدأ يفكِّر فيما حوله من آيات هذا الكون من شمس وقمر ونجوم وجبال وأنهار وبحار وحيوان ونبات وليل ونهار وفصول أربعة ورياح وسحب ورعود وبروق وأمطار.
ينظر الإنسان في هذا الكون العظيم نظرات عميقات فيرى أن كل ما في الكون يعمل ويسير لكنه إنما يعمل وفق نظام وقانون. وفق قانون شامل ونظام عام والكون كله إنما هو وحدة تسيطر عليه وتسيِّره قوة وإرادة واحدة ضمن علم وحكمة وقدرة ورحمة. ينظر الإنسان في هذا الكون هذه النظرة ويرجع إلى نفسه فيجد أنه جزء صغير في هذا الكون وأنه مشمول أيضاً بهذا النظام، فهذه الأرض العظيمة السابحة في هذا الخضم الواسع اللامتناهي مرتبطة بالشمس والقمر والنجوم، وما هذه الأجرام كلها وما هذه الموجودات جميعها إلا خاضعات لتلك الإرادة العليا والقوة اللامتناهية التي تشرف عليها جميعها وتسيِّرها كلها.
وبالوصول إلى هذه النقطة وبلوغ هذه المشاهدة وإن شئت فقل: بمشاهدة أن لا إله إلا الله والإيمان بالله يتولَّد في النفس شعور بالعظمة، وتحصل لها الخشية من تلك الإرادة العليا المهيمنة على هذا الكون، والمسيِّرة له ضمن العلم والحكمة والقدرة والرحمة فلا يستطيع هذا الإنسان من بعدُ أن يتعرّض بالسوء لأحد من بني الإنسان مهما تكن صفته ومهما تكن درجة قرابته، ولا يجرؤ على إيذاء مخلوق من المخلوقات لأن كل ما في الكون من مخلوقات إنما هو نسيج هذه الذات العلية.
فتجد هذا الإنسان أضحى مستقيماً بالمعاملة مع جميع الخلق، وتجرّه الاستقامة هذه إلى الثقة بأن الله راضٍ عنه فيقبل عليه، فبهذا الإقبال والوجهة تشتق النفس من الله تعالى كمالاً، تلك هي الصلاة في حقيقتها، وتلك هي الصلاة التي يجب أن تقيمها وتسعى إليها، وإنك لتجد النفس إذا وصلت إلى هذه الصلاة وبلغت هذا الحال لا تعود تميل إلى الدنيا وما فيها من الشهوات الدنيئة وتعاف ما في الدنيا مما سوى فعل المعروف والإحسان. لقد اصطبغت بصبغة من الله ومن أحسن من الله صبغة.
على أنك قد تعجب من نفسك أيها القارئ وتقول: مالي أصلِّي ولا أجد طعماً للصلاة، وأصوم ولا أصلُ لما يهدف إليه الصيام من غايات، وكم مرة حججت فما عرفت من الحج إلا جملة أدعية وأذكار ومراسم وأشكال وزيارات وركوب مشقَّات، وتصدَّقت بما تصدقت وأنا لا أتصدَّق عن طيب نفس ولا أنفق إلا كارهاً خائفاً الفقر!!.
وأسمع بالمؤذن يؤذِّن فلا أجد للأذان حلاوة!!. ولا في سماع القرآن طلاوة!. ولست أدرك منه ما فيه من معانٍ عالية كما تقولون. ولا أجد فيه ترابطاً بين الآيات، ولست أدري من أحاديثه عن الأمم السابقة إلاَّ أنها مجرد قصص وحكايات، وأنا لا أفهمه بذاتي بل لابد لي من تفسير ألجأ إليه يترجم لي عن معانيه ومع ذلك كله فكثيراً ما أنسى هذه الترجمة، وكثيراً ما لا أدرك معنى التفسير ذاته، ولا أفقه شيئاً من ذلك الترجمان؟؟.
فأجيبك على قولك هذا وأقول: لا تعجب يا أخي من قولك هذا ولا تستغربن ما أنت فيه فأكثر الناس يصلُّون ولا يدركون من الصلاة إلا أنها مجرد أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير منتهية بالتسليم، وأنها من أحسن الرياضات الجسمية وأنها أمر تعبدي أمر به الله تعالى الإنسان ليقدّم واجب الخضوع لخالقه في اليوم والليلة خمس مرات. ويعرّفون الصوم بأنه ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات بنيّة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وأنه يشعر الغني بألم الجوع الذي يكابده الفقير، وأنه يُذهب بالأمراض ويفيد الصحة إلى حد كبير.
وأن الحج زيارة أمكنة مخصوصة في أشهر مخصوصة، وأنه مؤتمر عام يجمع المسلمين يتدارسون الأوضاع ويتعارفون ويرسمون الخطط السياسية التي تجعلهم يهنؤون في العيش ويردُّون عدوان المعتدين، ويحسبون الزكاة بأنها تأدية مالية بنسبة معينة يقدّمها الغني للفقير، وهكذا تراهم يضعون حدوداً وأشكالاً من التعاريف، وتجد الكثيرين يقومون مثلك بهذه العبادات والأشكال والمراسيم، ويكرِّرون ويعيدون ما يسمعونه يحسبونه الإسلام وما هو من الإسلام في شيء، فما أمرك خالقك بالصلاة لِتُقدِّم واجب الخضوع.. فهو سبحانه غني عن العالمين، وهو أعزُّ وأكبر من أن يتطلَّب من هذا الإنسان أن يعترف بوحدانيته وأن يقدِّم الخضوع إليه، وهو أرحم بالإنسان من أن يأمره بالصوم شهراً كاملاً وأن يفصله عن أهله يركب المشقات والأخطار، ويطوف حول الكعبة وينادي بأعلى صوته مبتهلاً بالدعاء ليحصل على الغفران. ولو يشاء لأغنى الفقير ولمَا طلب من الغني زكاة ولا صدقة وما هو بحاجة لك لتطعم من لو يشاء الله أطعمه وما هذه الأوامر كلها إلا أوامر من مستوى عالٍ وضعت لإنسان وصل لمستوى عالٍ ذاك هو يعقلها ويدرك أسرارها، ويقدِّر فضل خالقه الذي أمره بها، فتراه يصلي ساجداً وهو يتمنى أن يظل العمر ساجداً وهو في حقيقته ساجدٌ دوماً لله لا يرفع رأسه ولا ينقطع عن السجود. ويصوم وينقضي رمضان فتراه يبكي متطلباً من الله تعالى أن يهبه عمراً يصوم به رمضان ثانيةً لما وَجَدتْه نفسه في الصيام من سموٍ وما وصلت إليه في منازل العلم والمعرفة وهي حقيقة التقوى من مراتب ودرجات.
ويحج ويعود من الحج إنساناً قد أرخت إليه المعرفة زمامها فأضحى بصيراً مشاهداً عارفاً بماهية الحياة وأسرارها.. فلم الحياة؟. وكيف الحياة؟. ومتى تدوم؟. وما الشرائع؟. وما الكون؟. وأين هي سعادة المخلوق؟. كيف ينالها؟. وكيف تكون؟.
ويزكِّي فيجد في الزكاة مغنماً، وفضلاً كبيراً فيشكر المعطي الأول ويستغرق في حمده سابحاً في فضله، فهو وحده المعطي وهو المتفضل وكل الفضل منه وإليه يعود.
ويقول لا إله إلا الله فيشهد معناها شهوداً نفسياً. فإذا قال بلسانه أشهد: فما اللسان إلاَّ ترجمان ما شَهدتْهُ نفسه وعاينته من الحنان وعطف تلك اليد التي تسيِّر الكون كله غامرةً إياه بفيض من التلطف والرأفة والرحمة والحنان والفضل والإحسان. وكلما كررها اللسان مرة أذكى القول الشعلة في النفس فأضاءت واتَّقدت، وأضافت النفس إلى شهودها شهوداً والله أكبر ولا نهاية ولا حدَّ لذلك الشهود والعلم به ولا انتهاء.
أمَّا رسول الله e فما أعظم رسول الله في الحقيقة وأجلَّ مقامه عند هذا الإنسان، إنه السيد الأعظم الذي فاز بالقرب من الله بأعلى منزلةٍ وأسمى مقام.. المؤمنون جميعاً مؤتمّون به وتحت لوائه، وهم أبداً في صلة دائمية معه وهو الداخل بهم على الله، وهو الأول في هذا المجال وهو الإمام. فيا سعادة النفس إذا هي صلَّت به، واتَّصلت بهذه النفس الطاهرة، فكانت بمعية الحضرة الإلهية والإقبال على الله.
تلك معانٍ يشعر بها هذا الإنسان حال إقباله على الله، من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وصومٍ، وصلاةٍ، وحجٍّ، وزكاةٍ، يشعر بها هذا الإنسان فتطير نفسه شعاعاً وكثيراً ما تفنى عن ذاتها مستغرقة بهذا الشعور ثم تعود وهي أسمى ما تكون علماً وأكثر مما كانت عليه معرفة وأعظم لله تعالى حمداً وشكراً. وهي أبداً في سعادة وهي أبداً في ارتقاء وهي أبداً في حياة طيبة غفل عنها كثير من الناس فظنوا الأوامر الإلهية أموراً تعبدية وحسبوها تقديماً لواجب الخضوع، ونسوا حظاً مما ذكِّروا به فضلّوا عن السعادة، وأضلوا كثيراً.
والسبب في ذلك كله أن هذه الأوامر التي جاء بها سيد الخلق والمرسلين مُبلِّغاً إياها عن رب العالمين، إنما هي مدرسة عليا خاصة بالمؤمنين وليس يفقه دروسها إلا من سمت به همَّته فتدرَّج فيما سبقها من الدراسة في مدرستين اثنتين تحضيريتين.
وإذا نحن أردنا أن نسمي هذه المدرسة العليا بالجامعة، فما المدرستان السابقتان سوى الابتدائية والثانوية وهل يمكن لمن لم ينتسب للثانوية والابتدائية أن ينتسب رأساً للجامعة!. أم ماذا يكون حاله إذا دخل صفاً من صفوفها وانخرط بين طلابها، فهل تجد له وعياً وهل تجده يفقه من ذلك المعلم العظيم قولاً، وهل يستطيع أن يجد بين أقواله انسجاماً أو يفقه لأقواله تفسيراً أو تأويلاً، وهل هو بمقدِّر لهذا المعلم العظيم وعارف فضل أولئك الطلاب في ذلك المعهد العالي الرفيع!!.
إن كلَّ ما يقوم به هؤلاء من أعمال ومهمات إن هو في نظره إلا مجرّد أقوال وأفعال، فالصلة والالتفات إلى ذلك المعلم العظيم أسر وبدعة وقيود وهو لا يحب الأسرَ ولا البدعة ولا القيود. والصوم جوعٌ وعطش وخمول والمجيء إلى هذا المعهد أهوال ومغامرات وركوب مشقات. قال تعالى: {وَمَثَلُ الَّذينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ}(1).
نعم وما ذلك كله إلا لأن هذا الطالب طَفَر طَفْرَةً واحدةً فدخل الجامعة ولمَّا يستعدّ لها. وكذلك المدرسة التي جاء يدعو لها رسول الله e إنها معهد من سوية عالية وهي في الحقيقة جامعة. لكنها تختلف عما سواها من الجامعات إذ لها بداية وليس لصفوفها حدٌّ ولا انتهاء. ولا بدَّ لك حتى تعرف عظمتها وتدرك قدر رئيسها الأول وتفهم كلامه e وتفقه بيانه من أن تعدَّ نفسك إعداداً صحيحاً بالانتساب إلى المدرستين السابقتين اللتين أشرنا إليهما من قبل وسنكرر لك القول ونعيده فنذكِّرك والذكرى تنفع المؤمنين فنقول: إن هذا الصوم الذي جاء به رسول الله e لابدَّ له من صومٍ يسبقه ولابدَّ لتلك الصلاة التي أمرنا بها عن لسان الله تعالى من صلاة قبلها تتقدمها وتمهد لها.
وكذلك الحج والزكاة، وأقول لك وحقاً ما أقول إن حديث «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجُّ البيت من استطاع إليه سبيلاً»1.. إنما هو حديث شريف يعرِّفك بصفوف الدراسة في الجامعة العليا ومراحلها. ولست بمستطيع أن تدرك ممَّا جاء بها شيئاً، ولا أن تفقه سرَّ ما ورد فيه ولا أن تتذوق طعم ما أشار إليه، إلاَّ إذا أعددت نفسك إعداداً تاماً، ووصلت بها إلى سوية رفيعة.. فإذا شهدت أن لا إله إلا الله وأتْبعت ذلك بصوم وصلاة وزكاة وحج فعندئذٍ تكون أهلاً لأن تشهد أنَّ محمداً رسول الله وتستطيع أن تدخل تلك الجامعة وتتَّصل بذلك المعلم العظيم الذي يعلِّمك الصلاة والصيام والزكاة والحج. وتتابع الدراسة متعرفاً إلى حديث بُني الإسلام على خمس فتكون من أهل التقوى وأهل المعرفة بالله. قال تعالى: {وَالَّذينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ}2.
وقد تعجب من ترتيبـي الذي عرضته لك. إذ بدأت بشهادة أن لا إله إلا الله وأتبعتها بصوم وصلاة وزكاة وحج ثم ختمت ذلك بشهادة أن محمداً رسول الله، ثم قلت إن السير على هذا يصل بالإنسان إلى الدخول في تلك الجامعة العليا ومتابعة الدراسة فيها. والحقيقة أني ما أردت بترتيب الصوم والصلاة والزكاة والحج ما ورد في الحديث الشريف، إنما مبادئ ودروس ترتكز عليها تلك الصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال التي جاء بها السيد الأعظم e.
فإذا بلغ الإنسان من الطفولة مرحلة التمييز ودارت دواليب الفكر لديه فتعرَّف على الخالق الذي خلقه وجعله على هذا التركيب وأنهى الدراسة الأولى في التعرّف إلى الخالق، والإدراك عن طريق الفكر أن هذا الجسم المنظَّم لا بدَّ له من منظِّم ووصل إلى سن البلوغ وقد عرف هذه الحقيقة وثبتت لديه، فهنالك وبتفكيره بالموت وشهوده وقائع عديدة منه ترهب نفسه خائفة وتلتجئ إلى الفكر تطلب منه أن يجدَّ في البحث عن المربي إذ يرى نفسه مخلوقاً ضعيفاً، وأنه بحاجة إلى من يربّيه ويديم إمداده له ويشرف عليه. إنه بحاجة إلى الطعام والشراب، بحاجة إلى الشمس والهواء، بحاجة إلى الثلوج والأمطار، بحاجة إلى الليل والنهار. مفتقرٌ إلى ذلك كله، إذ بدون هذا لا يمكن بقاؤه ولا تدوم حياته، فمن الذي يعنى به هذه العناية ويقدِّم له صنوف هذه الأشياء التي يتوقف عليها بقاؤه في الحياة؟.
إنه لابدَّ له من ربٍ ممدٍ يمدّه بهذه الخيرات. وهنا ينتقل إلى صف أعلى فيعرف أن له ربّاً قديراً يمدُّه بما يمدُّهُ به ويحفظ عليه الحياة، ويوسِّع الإيمان بالمربي آفاق الفكر لديه فيقول: إذا كان هذا المربي هو الذي ينزل الأمطار ويسوق الرياح والسحاب ويحرك الكرة في الفضاء فيتولد الليل والنهار وينبت الزرع والنبات ويدير الكون كله ليتأمن لي ما أحتاج فهو لاشك المسيِّر للكون فالكون كله في جميع ما فيه خاضعٌ له تعالى ومفتقر إليه، وهنا وبالوصول إلى هذه النقطة ينال هذا الإنسان شهادة ثانية وهي شهادة أن لا إله إلا الله شهدها قلبه من بعد أن حاكم وناقش فكره وعقلت ذلك نفسه فإذا شهد هذه الشهادة وإن شئت فقل: إذا رأت نفس الإنسان عظمة هذا الكون وشاهدت جلال اليد التي تديره كله في لحظة واحدة دون انقطاع فلا يَعْزُبُ عنها شيء في الأرض ولا في السماء، أقول : إذا شاهدت النفس هذه المشاهدة وإن شئت فقل إذا شهدت النفس أن لا إله إلا الله شهوداً معنوياً، وشعرت في أعماقها ذلك الجلال الإلهي والعظمة فهنالك تحصل لها الخشية من الله، وتحمل هذه الخشية الإنسان على الاستقامة وتحول بينه وبين كل معصية فلا يعود هذا الإنسان يجرؤ على اقتراف إثمٍ أو الوقوع في خطيئة، إذ كيف اتَّجه وحيثما سار وأينما كان يرى الله تعالى معه مشرفاً عليه وناظراً إليه، ولذلك تراه يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به فلا يستطيع أن يؤذي إنساناً ولا أن يمدَّ يده بالسوء إلى أحد من المخلوقات، وذلك ما عنيناه نحن من الصيام فهو في الحقيقة صوم عن الأذى صوم عن المعصية والفسق والعدوان. وبما أن القوانين الثابتة للنفس البشرية بفطرتها الأزلية عدم الاستقرار والهدوء بل لابدَّ لها من أن تعمل خيراً أم شراً، فهي مفطورةٌ دائماً وأبداً بجبلتها على العمل ولا تستطيع أن تبقى هادئةً لذا فإذا بلغت في عروجها مرحلة الصيام الحقيقي فهي تعمل وكل عمل يصدر عنها وهي في حصن الصوم هو عمل خيِّر ينبع منه الإحسان. فهذا العمل العالي يورث في النفس الثقة بإحسانها والثقة برضاء بارئها بارئ السموات العلى عنها. ويولِّد هذا الصوم عن المحرمات ثقة في النفس برضاء الله عنها فتقبل عليه بكلِّيتها مطمئنة بإحسانها راضية بعملها.
وهنالك تشعر باطنياً بشعور جميل إنه شعورٌ بالقرب من تلك الذات العلية إنه شعورٌ فريدٌ في نوعه شعورٌ ما عهدته النفس من قبل. فما الأغنياء بذهبهم وفضَّتهم وأموالهم، ولا المزارعون في بساتينهم ومزارعهم، ولا المترفون في قصورهم وحدائقهم، ولا الحكام في صولتهم ودولتهم ولا الملوك والأمراء في صولجان ملكهم وإمارتهم أقول ليس هؤلاء جميعاً بأسعد حظّاً من النفس القريبة من ربها، ولو علم هؤلاء بما في هذه النفس من الشعور السامي الجميل لقاتلوا عليه ولتنازلوا عن ملكهم وعما بين أيديهم رغبةً فيه.
فسبحانك ربي ما أجمل القرب منك وما أحلاه وما أجمل الحياة لدى النفس في ساعات قربها من الله. إنه النعيم، إنها السعادة، إنها الحياة الطيبة التي لا يمازجها نغص، إنها الجنة، ولعمري تلك هي الصلاة. وذلك ما عنيناه بكلمة (الصلاة) التي يولّدها الصوم عن المحرمات. وأعتقد الآن أنك أدركت سرَّ ترتيبنا في بدئنا بشهادة أن لا إله إلا الله ثم اتباعها بالصيام والصلاة وعرفت ما نعنيه من شهادة أن لا إله إلا الله وما نعنيه من الصيام والصلاة.
وبذلك نستطيع أن نتابع ترتيبنا وننتقل بك إلى الزكاة فنقول:
إن هذه الصلة الجميلة، وهذا الشعور السامي الذي نشعره في حال قربنا من الله يجعلنا في الوقت ذاته نكتسب من الله تعالى كمالاً ونصطبغ منه تعالى بصبغة الكمال لأن النفس خلال قربها وحال وجهتها إلى خالقها يسري النور إليها فيطهرها مما بها من جرثوم، ويقضي على ما فيها من انحرافات ويزكّيها ممَّا علق بها من قبل من الميول المنحطة، والدنيء من الشهوات فينقلب هذا الإنسان وهو أصفى ما يكون حالاً، وأطهر قلباً، وأزكى وأنقى نفساً، وذلك ما نعنيه بكلمة (الزكاة).
فإذا ما زكت نفس الإنسان هذه الزكاة بالله وطهرت هذه الطهارة فهنالك لا تعود تحب أن تفعل منكراً، ولا أن تقع في معصية أو خطيئة.
وإذا ما أراد الشيطان أن يغريها بشيء أو يغريها بما في الشهوات الدنيا من جمال وزينة فإنها لا تلتفت إليه ولا تميل بل إنما تردّه خائباً، وتقيم عليه الحجة فلها من كمالها وطهارتها، ولها من زكاتها التي ولدتها صلتها بخالقها ما يجعلها تأنف من كل خطيئة وتعاف كل دنيَّة، وذلك هو الحج الذي نوَّهنا عنه من قبل، وذلك سبب إيرادنا إيَّاه بعد الزكاة، ولعلَّك عرفت سرَّ كلامنا عنه في آخر هذا المجال الذي سننتقل منه إلى شهادة أن محمداً رسول الله حيث الصلة بسيد الخلق والعالمين، وحيث الانتساب إلى معهده العالي الرفيع فنقول: إذا شهد الإنسان أن لا إله إلا الله حسبما بيَّناه من قبل، وأدَّت به شهادة أن لا إله إلا الله إلى صوم وصلاة وزكاة وحج وأصبحت نفس هذا الإنسان من سوية عالية تختلف عمَّا سواها من الأنفس البشرية من حيث تذوّقها معاني الفضيلة، وأنفتها من الرذيلة، وأنس بالله وسعادة بالإقبال عليه، واصطباغ منه تعالى بصبغة الكمال، فهنالك تراه يدأب باحثاً ويجدُّ في طلب الاجتماع بذلك الرجل وإن شئت فقل بذلك المعلم العظيم الذي فاقه في هذه الآفاق العالية فكان المرشد وكان السابق وكان الأول في هذا المضمار. فلعلك تقول إذا كان هذا الإنسان قد نشأ في بلاد بعيدة ومناطق نائية عن العمران وكان ممن لم يسمع قط بأن هناك إنساناً فاق العالمين في تلك النواحي فكيف يجدّ في طلبه أم كيف يبحث عنه ولا عهد له به، ولا قرأ ولا سمع عنه من أي شخص كان!. فأقول وعلى وجه المثال أوضّح ما أقول: هب أن امرءاً أصابه مرض أمضَّه وألزمه الفراش أياماً، ثم اجتمع إلى طبيب فجعل يصف له من العلاجات ما أزال عنه بعض ما به، وانتهت به معالجات هذا الطبيب إلى حدّ لم يستطع معه أن يستأصل العلّة كل الاستئصال وإن كان أصاب بواسطته تقدماً ظاهراً، أفلا تجد هذا الشخص المريض يبحث دوماً ويتطلع إلى أخبار العالم كله ويسأل ويجدُّ في الطلب عن طبيب نطاسي ينال على يديه شفاءً تاماً وبرءاً كليّاً؟؟.
لاشك أنه ما يزال يبحث ويفتش حتى يجتمع بذلك الطبيب وهو لابدّ واصل إلى بغيته وأنك لتراه ينفق ما ينفق في سبيل الوصول إليه راضية بذلك نفسه غير مكترث بما يصيبه في هذا السبيل من أتعاب، وما يكابده من مشقَّات. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المتعلمين في عصرنا الحاضر فإنك تجد الواحد منهم إذا نال الشهادة الثانوية تتفتَّح لديه آفاق جديدة من المعرفة فتراه يبحث عن الجامعات التي تصل به إلى معرفة وعلم، بل إلى مستوى ثقافي واجتماعي أعلى وأرفع ممّا نال. وما يزال يسأل هذا وذاك حتى يهتدي ويقع على الخبر الصحيح، ثم تراه بعد ذلك يفارق الأهل ويغادر الأوطان، ويركب البحار، ويكابد الأهوال. وكم مرةٍ يتعرض للموت وتحيط به المخاطر في طريقه إلى تلك الجامعة، وتراه مع ذلك كله طيِّبةً بذلك نفسه، إذ سيصل إلى ذلك المعهد العالي وسيجتمع بذلك المعلم العظيم الذي ينهض به ويؤمِّن له اجتماعه إليه سوية أرفع ومكانة أسمى وأشرف ممَّا هو عليه الآن. تُرى: هل كان ذلك الإنسان المريض الذي ضربناه لك مثلاً يتساءل ويبحث عن أمهر الأطباء، وما يزال يجدّ حتى يتعرف إليه لو لم تكن به علَّة، ولو لم تكن لديه تلك الحاجة الماسة، والضرورة المُلحَّة وهل كان ذلك الإنسان الثاني الذي ذهب يطلب العلم من تلك الجامعات العالية يهتم في البحث عن تلك الجامعات ويسأل القريب والبعيد عن ذلك المعلم الذي سينهض به؟.
وهل تظن أنه كان سيهتدي إليه لو لم يصل إلى تلك السويّة العلمية التي جعلته أهلاً لأن يبحث ويجدّ في طلبه والاجتماع به!. وكذلك الإنسان الطالب الوصول إلى التقوى ومعالي منازل الإيمان، كمالُه وصفاؤُه النفسي. وأُنسُهُ بالله، وحُبُّه للفضيلة، يجعله يبحثُ ويجدُّ في الطلب، ومن وراء ذلك كله صوت الملك يناديه دوماً في صميمه يا عبد الله لابدَّ من وجود رجل يفوقك فيما أنت فيه، فابحث عنه وجدَّ في طلبه، وإنه والحالة هذه ليصدق وما يزال يصدق ويتحرَّى الطلب حتى يهديه الله، والله يهدي من يشاء الهداية. قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنينَ}1
ومما يؤيد لك ما قلناه ما رواه الرواة عن إسلام سيِّدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وإنه ليأخذك العجب العجاب حين تسمع بقصة إسلامه المذكورة مفصَّلةً في كتب السيرة فنقول: كيف تسنَّى لرجل من فارس أن يجتمع برسول الله فيؤمن به وينصره ويصبح من أقرب المقرَّبين إليه وما بين بلد هذا الرجل وما بين يثرب حيث الرسول الكريم شاسع المسافات ونائي الديار؟؟. لكنَّك إذا دقَّقت فيما قدَّمناه من قبل وأمعنت النظر فيه وجدت أنَّ الأمر لا يتوقف على قرب الديار وبعدها ولا علاقة له بالقرابة والنسب إنما الأمر كله موقوف على أهليّة النفس واستعدادها، فإذا ما أعدَّ الإنسان نفسه الإعداد اللازم وبلغ بها تلك السوية العالية التي تجعله أهلاً للاجتماع بذلك الرسول الكريم، أو المرشد الذي ينوب عنه e في البلوغ بالأنفس الصادقة إلى ذلك المقام العالي الرفيع، فهنالك تجدُّ هذه النفس وتندفع في طريقها باحثة منقبة، وما تزال تبحث حتى يهديها الله وتقع على الحقيقة. فسيدنا سلمان رضي الله عنه، لو لم يكن به ذلك الدافع إلى معرفة الحق لما وصلت به قدماه إلى أرض الحجاز، ولما أخذ قلبه يرجف فرحاً لما سمع بمقدمه e إلى المدينة المنورة، بل لما كاد أن يسقط من أعلى النخلة وهو يجني ثمارها شوقاً إلى هذا الرسول الكريم والسيد العظيم، لكنها إرادة الحكيم ومشيئة هذا الرب الرحيم تسوق كل امرئ إلى ما تطلبه نفسه، وتجمعه بمن صدق في طلبه وابتغاه.
أنت والمشيئة مشيئتك فإذا ما أعددت نفسك الإعداد الكافي وأهَّلتها الأهلية التامة، فلا ريب أن الله تعالى يتفضل بما تشاء وتريد قال تعالى: {مَنْ كَانَ يُريدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً، كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً، انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وللآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضيلاً)1
قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، تُؤْتي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربِّهَا.) 2
وكذلك الأمر بالنسبة لي ولك ولكل إنسان مهما امتد وطال به الزمان إذا هو تحقَّق بمعرفة خالقه ومربيه، وانتهت به معرفته هذه إلى الإيمان بكلمة (لا إله إلا الله)، لابدَّ له من أن يجتمع حقاً بذلك المرشد الذي يدله على الله ويصل به إلى حضرة الله، فتكون له برفقته ودخوله بمعيّته على الله أذواق وأحوال ومشاهدات ثم إنه لابدَّ له في يوم من الأيام ما دام وقد ارتبطت نفسه به وثيق الارتباط من أن يكون وسيطاً بينه وبين رسول الله e، ينعكس في قلب هذا المريد الصادق ما انعكس في قلب مرشده من حب الرسول والارتباط به e وما يزال به حتى يتم ارتباطه بذلك الرسول الكريم حيث الشهود بذلك السراج المنير لكمال الله وحيث الاستنارة بنور الله، يشاهد به الخير خيراً والشر شراً، ويصل إلى السعادة الحقَّة والحياة، وأنت ترى مما أسلفناه أن الإيمان بالمرشد الصادق وكذلك الإيمان برسول الله e ليس بالأمر الهيّن إذ لابدّ لهذا الإيمان بالرسول من إيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، نعم إنه ليس بالأمر الهيّن لكنه يسير كل اليسر على الصادق.
إذا شهد الإنسان هذه الشهادة الأولى وعقل كلمة (لا إله إلا الله) عقلاً نفسيّاً ولَّد في نفسه استقامة وأدَّت به هذه الاستقامة إلى الصلة بالله والإقبال النفسي عليه فعندئذٍ وبما اكتسبت نفسه من الله تعالى من الكمال، وبما انطبع فيها من الحق تراه إذا سمع بكلمة عن رسول الله صدَّقها كل التصديق إذ يجدها مطابقة لما في نفسه، فبكماله يشهد طرفاً من كمال رسول الله، وبما اصطبغ به قلبه من الحق يرى الحق الذي جاء به رسول الله فيصدِّق بكلمات الله ورسوله ويصدِّق بالحق وأهله. قال تعالى: {الَّذينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، وَإذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمينَ}1
{وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدينَ، وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ باللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالحينَ}2
وهكذا فإيمانك، وشهودك وتحقُّقك بكلمة (لا إله إلا الله) هو الدعامة الأولى وهو الركيزة التي يبنى عليها إيمانك برسول الله e. وإن شئت فقل: شهادة أن لا إله إلاَّ الله هي التي توصلك إلى شهادة أن محمداً رسول الله، إذ بكمالك ترى طرفاً من كماله فتؤمن له وتشهد، وبما انطبع في نفسك من الحق تشاهد الحق الذي جاء به فتذعن له وتخضع وعندئذٍ تدخل ذلك المعهد العالي وتنتسب إلى تلك الجامعة التي نوَّهنا عنها من قبل فتتَّخذ رسول اللهe لك هادياً ومرشداً، وتجعله في دخولك على الله إماماً وتطيعه كل الطاعة وتستسلم له كل الاستسلام. قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليماً}1
وإن نفسك لترتبط بنفس رسول الله الكريم وهي في مثل هذه الحال وثيق الارتباط وتحصل لها صلة معنوية حقيقية به ما مثلها من صلة، إنَّها صلة حبّ وتعظيم وذوق رفيع لا يعرفه إلاَّ المؤمنون بالله الذين شارفت نفوسهم منازل الكمال فسمعوا النداء الإلهي يناديهم في سرِّهم قال تعالى: {إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليماً}2
نعم إن نفسك لتتصل معنوياً بنفس رسول الله الطاهرة السامية وإن أذنك وقلبك ليتفتح لما يمليه عليك من الدلالات والأوامر الإلهية فتصغي إليه، ويحق لك وقد وصلت إلى ما وصلت إليه من كمال أن تكون طالباً لهذا المعلم العظيم يعلمك الأوامر التي جاء بها عن الله. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً، وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنيراً، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ الله فَضْلاً كَبيراً3
كيفيــة الوصــول إلـى الإيمــان
وقد ضرب لنا تعالى على ذلك إبليس مثلاً، فذكر لنا في القرآن الكريم اعترافات إبليس بوجود خالقه وإقراره له بالربوبية والعزة فقال تعالى: {قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ، قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّك رَجيمٌ، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتي إِلى يَوْمِ الدّينِ، قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْني إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ، إِلى يَوْمِ الْوَقتِ الْمَعْلُومِ، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ}1
ففي الآية الأولى اعتراف منه لخالقه وفيما يليها إقرار بربوبيته ثم أقسم بعزة الله ومع ذلك كله وصف تعالى إبليس بأنه من الكافرين وأن عليه اللعنة إلى يوم الدين. وكذلك اليهود ما كان اعترافهم بخالقهم ليردّهم عن طغيانهم قال تعالى: {وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ}2
وإذاً فليس الإيمان بالخالق اعترافاً قولياً إنما هو شعور داخلي ولَّده في النفس بحث ذاتي وتفكير متواصل فجعل صاحبه يسبح في جلال الله تعالى ويخرُّ ساجداً لعظمته. وهكذا فالإقرار النفسي المقرون بذلك الشعور والتذوُّق المنبعث من قرارة النفس، هو الإيمان الصحيح وما سواه مما يتلقَّنه الإنسان من أبيه وأمه أو البيئة التي ينشأ فيها تلقناً ولا ينبعث في النفس متولِّداً عن نظر وتفكير ما هو بالإيمان المطلوب.
ولكن كيف يتولَّد هذا الإيمان الذي هو أساس طهارة النفس وتحليتها بالكمالات الإنسانية في نفس الإنسان!. وكيف يشع في قلبه؟.
أقول: لقد خلق الله الإنسان وميَّزه كما ذكرنا من قبل على سائر المخلوقات بتلك الجوهرة التي يستطيع بها أن يتوصل للكشف عن الحقيقة وأعني بهذه الجوهرة التفكير.. ثم إنَّ الله تعالى جعل هذا الكون وما فيه من آيات بيِّنات ونظام بديع وحكمة بالغة بين يدي الإنسان كتاباً مفتوحاً يستطيع أي إنسان كان إذا نظر فيه مدقّقاً وتفكر متأملاً أن يعظِّم هذا الكون تعظيماً يهتدي من ورائه إذا كان صادقاً في طلب الحقيقة إلى معرفة خالقه والإيمان به والخشوع له. وهكذا فمعرفة المربي هي النبراس الذي يصل بالإنسان إلى مشاهدة الحقيقة وهي السبب الوحيد في الوصول إلى الخير والسعادة، وقد وهب الله الناس جميعاً الفكر تلك الأداة التي يستطيعون بواسطتها أن يصلوا إلى معرفة خالقهم ومربِّيهم، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وبثَّ في هذا الكون ما لا يحصى من الآيات التي تساعد الفكر على البحث والاستدلال. فمن استفاد من هذه الجوهرة الثمينة، وأشغل فكره وأعمله في معرفة خالقه ومربيه فقد ظفر بالسعادة، وفاز، ومن أشغل هذا الفكر وأعمله في السعي وراء المكاسب الدنيوية وتأمين الشهوات الدنيّة فقد خاب وخسر هذه الحياة قال تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئكُمْ بِالأَخْسَرينَ أَعْمَالاً، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحيَاة الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً، أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَزْناً، ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آياتي وَرُسُلي هُزُواً، إِنَّ الَّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً، خَالِدينَ فيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً}1
ثمـرة الإيمـان اليقيني وطريقهـا
الإيمان الصحيح لا يأتينا من غيرنا بل إنما ينبعث في قرارة نفوسنا ويتولّد في قلوبنا. الإيمان الصحيح علم نفسي وشهود يقيني تشهده النفس في ذاتها وتعقله في سرِّها فإذا هو حقيقة مستقرة فيها تخالطها وتمازجها ولا تنفك عنها. الإيمان شيء معنوي حقيقي يسري في النفس سريان الكهرباء في الأسلاك والماء في الأغصان والحياة في الأجساد، يشرق في النفس فيشعُّ فيها النور والعلم والحياة، تدلُّ عليه الصفات الحسنة والمعاملات الطيّبة والأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة ويشعر به المرء في صميمه فيطمئن به قلبه وترتاح به نفسه وتنقشع أمامه الشكوك والشُبَهْ وتنمحي به الظلمات. أما الذين في قلوبهم ريْب وفي أعمالهم إساءات وفي نواياهم سوء وخبث وفي أعمالهم أيضاً تلاعب وانحراف، فما هم من الإيمان في شيء ولو زعموا أنهم مؤمنون قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا باللهِ وَبِاليَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنينَ، يُخَادِعُونَ الله وَالَّذينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يشْعُرُونَ، في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}1
فاسأل أيها الإنسان نفسك هل توصلت إلى هذا الإيمان الصحيح الذي نتكلم عنه، وهل هي تابعَتْ خطواته ومراحله واحدة إثر أخرى، فإن فَعَلَتْ فاطلب منها أن تذكر لك هذه المراحل وتعددها وتبيّن لك الطريق التي سَلَكَتْها. وإن لم تفعل فاستمع إلي أرشدك وما عليك إلا أن تسلك الطريق بذاتك وتتعرَّف إلى مراحله واحدة بعد واحدة فأقول:
أول ما يجب أن يبدأ به الإنسان أن ينظر في نفسه ويتفكَّر في ذاته ممَّ خُلق.. وكيف تكوَّن في بطن أمه حتى صار إنساناً سوياً.. وعليه أن يتابع بفكره الأطوار التي تنقَّل فيها والمراحل التي مرَّ عليها فمن نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مضغة، ومن مضغة إلى إنسان سويٍّ كامل الهيئة تام التركيب يحار الفكر في كمال صنعه ويقف حائراً أمام عظمة كل جهاز من أجهزته وحاسة من حواسِّه ولا يسعه إلا أن يخرَّ ساجداً لعظمة تلك اليد التي عملت على تكوينه وإحكام صنعه.
فإذا ما نظر في نفسه هذه النظرات جنيناً وأتبعها بنظرات أخرى تدور حول أيام طفولته الأولى مولوداً صغيراً يوم كان يأتيه الغذاء من ثدي أمه لبناً سائغاً كامل التركيب كافي المقدار منظم المعايير متوافقاً في نسبته الغذائية مع تدرجه في النمو يوماً بعد يوم بحسب ما يتطلبه جسمه ويحتاج إليه. أقول: إذا نظر الإنسان في نفسه هذه النظرات، وفكَّر هذا التفكير وتابع ذلك وتوسَّع فيه لا شك أن تفكيره هذا يرشده ويهديه إلى أن هناك يداً عظيمة صنعته وخلقته وعنيت بتربيته منذ أن تشكل وخرج إلى هذا الوجود وهي ما تزال مستمرة العناية به قائمة بالتربية عليه. إن هذه النظرات في البداية وفي أصل التكوين لها أثرها لا بل عليها يتوقف الإيمان بالمربي. ومن لم ينظر هذه النظرات في أصله، ومن لم يتعرَّف إلى بدايته فما هو من الإيمان الصحيح اليقيني بربه في شيء.
قال تعالى معرِّفاً إيانا بطريق الاستدلال على معرفة المربي بما أشارت إليه الآيات الكريمة في قوله سبحانه: {قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ، ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ}1
{فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ والتَّرَائِبِ}1
{وَلَقَد خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قَرَارٍ مَكينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقينَ}2
أما وقد عرف الإنسان خالقه ومربيه وتبدَّت له عظمة ربّه فلا شكَّ أن ذلك يقوده إلى التوسُّع في التفكير وينتقل به إلى النظر في نهايته كما نظر في بدايته فيتساءل في نفسه؛ ما بال فلان قد قضى نحبه؟. وما بال فلان لم يطل به أمد الحياة؟. وأين فلان وفلان وما بقي لهؤلاء الذين فارقوا هذه الحياة من العزّ والسلطان؟. وأين هم من متع الحياة وشهواتها وجميع ما فيها من ملذَّات؟. وإذا كان الموت نهاية كل إنسان ومصيره المحتوم وإذا كانت مساعي الإنسان جميعها تصل به إلى هذه النهاية مهما امتد العمر وطال، فما في الحياة من أمل، والخاسر الذي يسترسل فيها دون أن يتعرَّف فيها إلى ما ورائها.
وهنا وبمثل هذا التفكير في النهاية، والمصير إلى القبر وما فيه من رهبة ووحشة تخاف النفس وتلتجئ إلى الفكر وتصدق في طلب معرفة الحقيقة. فلم جاء الإنسان إلى هذا الوجود وما هذه اليد التي خلقته وأرسلته إلى هذه الدنيا ثم كتبت عليه الموت ومفارقة الحياة؟!. وينشد الإنسان هذا النوع الجديد من المعرفة ناظراً في أصله لما كان نطفة فيقول: هذه النطفة التي منها أنا، منها خلقت وتكونت، إن هي إلا خلاصة ألوان شتى من أطعمة وفواكه وأثمار تجمّعت هذه الخلاصات ومنها خُلقت، فمن أين جاءت هذه الأطعمة؟. ومن الذي خلق هذه الفواكه والخضر والألوان؟. وما هذه البذور المختلفة؟. ومن أين جاءت؟. ومن الذي ألقى بها على سطح الأرض؟. ما هذه التربة التي اشتملت عليها؟. وكيف تكوَّنت؟. ما هذه الأنهار؟. ما هذه الأمطار؟. ما هذه الشمس؟. ما هذا الليل والنهار؟. ما هذا السير الدائم؟. ما هذه الحركة المستمرة المنتظمة في هذا الكون؟. ما هذه الدورات المنظمات؟. بل ما هذه اليد التي تدير هذا كله لتتأمن حياتي ولتتوفر أقواتي ويستمر وجودي؟. أليس هذا الكون كله وحدة مترابطة الأجزاء متماسكة الأجرام؟. أليس ذلك كله يعمل ضمن قانون ونظام؟. أما لهذا الكون من يديره!. وقدرة عليا مهيمنة تشرف على ملكوت السموات والأرض ولا يعزب عنها من مثقال ذرة!. وهنا ينتقل هذا الإنسان إلى هذه النقطة الجديدة فتعقل النفس عظمة هذه الإرادة العليا، والقدرة التي لا حدَّ لها والتي نظَّمت الكون بما فيه عُلْويّهُ وسفليّه، جليله وحقيره، صغيره وكبيره تدرك النفس طرفاً من عظمة الله تعالى وتعرف أنه لا مسيّر غيره ولا متصرف في هذا الكون إلا الله إنها تدرك حقيقة كلمة (لا إله إلا الله) فتعلم أن التصرُّف بيده وحده وليس لأحد من حول ولا قوة إلا به وليس من حركة إلا بإمداده ومن بعد إذنه.. فلا تهب رياح ولا تتراكم غيوم ولا تهطل أمطار، ولا تشرق شمس ولا تدور أرض ولا يتعاقب ليل ونهار، ولا تدب دابّة، ولا تنبت نبتة، ولا تنعقد ثمرة، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه تعالى ومن بعد إذنه. ويتسع أفق التفكير لدى هذا الإنسان فيرى أن اليد لا تتحرك حركة وأن الرجل لا تنطلق خطوة، والعين لا تطرف طرفة، والأذن لا تسمع همسة، واللسان لا ينطق ويلفظ كلمة إلاَّ بإذن الله وبحول وقوة منه. يدرك هذا الإنسان ذلك كله عندها تدخل النفس في حصن الاستقامة فتجد أن الله تعالى معها ومشرف عليها بل هو الممدُّ لها في كل لحظة وحين لا يحول ولا يزول فحيثما حلَّ هذا الإنسان وارتحل وأينما سار وانتقل. وكيفما نظر وأنَّى اتَّجه يرى الله تعالى معه، وأنه شاهد عليه فهو سبحانه ناظر رقيب، وسامع قريب، وبه قيام وجود الكون بجميع ما فيه وهو أقرب إلى الإنسان من نفسه التي بين جنبيه.
قال تعالى:{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ}(1).
هذه هي المرحلة التي يفضي إليها الإنسان، وهذه هي الحقيقة التي يعثر عليها من بعد تفكيره المتواصل يعقلها عقلاً، ويصبح إيمانه بكلمة (لا إله إلا الله) مبنياً على علم كما أمر سبحانه وتعالى بذلك، إذ قال: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَه إلاَّ اللهُ..}2 وهذا النوع من الإيمان هو المطلوب من كل إنسان وذلك هو الإيمان الحق الذي يحجز الإنسان عن المعاصي والموبقات.
وفي الحديث الشريف: «كفى بالمرء علماً أن يخشى الله1
وقال تعالى: {..إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ..}2
وإلى ذلك أشار e بقوله الشريف: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة، قيل: وما إخلاصها؟. قال أن تحجُزَهُ عن محارم الله»3
أما وقد أصبح هذا الإنسان في حال يشهد معه أن الله تعالى ناظر رقيب ومشرف قريب لذلك تراه يستقيم على أمر الله فلا يخالف أوامر ربه في شيء. فالعين لا تنطلق واللسان لا ينطق واليد لا تتحرك والرجل لا تخطو إلا ضمن ما أمر به الله ووفق ما بينه رسول الله e. وإلى ذلك أشار e بقوله الشريف: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به»4
وهنا وبمثل هذا السير الطيب والعمل الصالح تتولَّد في تلك النفس المؤمنة الثقة برضاء الله عنها، وتطمئن أنها ذات حظوة لديه تعالى ولذا تجدها تقبل على الله وتتجه إليه وتحصل لها وبحسب حالها الصلة النفسية بخالقها، وبهذه الصلة تنمحي من النفس شوائبها وكدوراتها وتطهر من أدرانها. وبهذه الصلة أيضاً تشتق النفس منه تعالى كمالاً وخلقاً سامياً وصفة عالية، وبهذا تدخل في عداد من تحلَّت نفوسهم بالكمال، وتغدو ذات قابلية وأهلية لتقدير رسول الله e سيِّد أهل الكمال، وبذلك تُضحي من صحابته e وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. عندها تستطيع أن تصلي الصلوات الخمس كما أمر الله بها وتحصل على الفائدة المرجوَّة منها والتي شرعت من أجلها وإلى ذلك أشار e حيث يقول: «أرأيتم لو أنَّ نهراً بباب أحدكم يغتسل في كل يوم خمس مرات، ما تقولون؟. ذلك يبقي من درنه؟. قالوا لا يبقي من درنه شيئاً قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا»1
وتتقدَّم النفس بصلاتها يوماً إثر يوم وترقى حيناً بعد حين في منازل الكمال حتى تصبح أهلاً لأن تشتبك بنفس رسول الله e فتعشقه، وهنالك وبمثل هذه الحال تدخل بمعيّته e على الله فتشهد من الكمال الإلهي وترى من الأسماء الحسنى ما يجعلها تهيم بالله حبّاً بنسبة ما شهدت ورأت.
الطريق الوحيد لتطهير النفس وتحليتها بالفضائل
كما تشير الآية الكريمة في قوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا..}2
وما يزال الإنسان نقي النفس حتى يبلغ الحلم ويصل إلى سن الرشد وفي هذه المرحلة يصبح أمام طريقين اثنين: فإما أن ينهج طريق الإيمان، وإما أن ينهج طريق الكفر والإعراض. فإن هو آمن بالله حق الإيمان وأقبل بالصلاة بكل قلبه عليه فهنالك تشتق نفسه من الله تعالى منبع الكمال وموئل الفضائل كلها وينتقش فيها الكمال، فيغدو هذا الإنسان إنساناً كاملاً فاضلاً متحلِّياً بالكمالات الإنسانية، مشحون القلب بالرحمة والرأفة والرضاء، عفيفاً طاهراً صادقاً أميناً سخياً كريماً شجاعاً جريئاً عادلاً محسناً مشغوفاً بعمل الخير عطوفاً على الخلق يتمنى الخير لكلِّ إنسان.
كل هذه الكمالات وسائر الكمالات الإنسانية تنقش في نفس هذا المؤمن بالصلاة بصورة لاشعورية وتصطبغ بها بصبغة من الله، قال تعالى: {صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً..}3
وهكذا وبنسبة هذا الإقبال تزداد هذه الانطباعات بالفضائل والكمال ولذا كان رسول الله e أعظم الناس رحمةً وأشدهم على الخلق إشفاقاً ورحمة وعطفاً وأكبرهم من الفضائل حظاً قال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ..}1، {وَاصْبِر وَمَا صَبْرُكَ إلاَّ بِاللهِ..}2
لهذا نال رسول الله الرحمة وسائر الكمالات.. وتلك هي الطريق الوحيدة إلى نيل الكمال التي سلكها الصحابة الكرام، وكان حظّهم من هذا الكمال مُتناسباً مع إقبالهم فكان منهم السابق والأسبق والمجلّي في هذا الميدان. وكذلك كل مؤمن بحسب إقباله بصلاته يتبع ذلك الركب الأول الأمثل فالأمثل. أما الذي يصل إلى سن الرشد والتمييز ولا يستعمل تلك الجوهرة الثمينة التي زيّنه الله بها ورفع شأنه على الحيوان لا بل على سائر ما خلق، هذا الإنسان الذي لم يُعمل تفكيره في الوصول إلى الإيمان بالله فلا شك أنه يظلُ محروماً من الإقبال على الله، وينشأ عن الإعراض وعدم الإقبال عدم التقدير لفضل الله وإحسانه ذلك المعبَّر عنه بكلمة (الكفر).
وبسبب الكفر والإعراض عن الله تتولَّد في النفس العلل المعنوية من غلّ وحقد وحسد وقسوة قلب وحرمان من الرحمة وحب للتعدّي والظلم إلى غير ذلك من العلل والرذائل والصفات المنحطة الذميمة، وهنالك يدْلُك الشيطان إلى النفس التي امتلأت بهذه العلل وأضحت مشحونة بالخبث يزيِّن لها سوء أعمالها فتظنُّها حسنة. وتلك العلل المتولِّدة في هذه النفس المعرضة هي حظ الشيطان من الإنسان.
ومن أحسن الأمثلة في هذا الموضوع مثل: غرفتين إحداهما معرَّضة لنور الشمس والأخرى مظلمة محرومة منها. فلا شك أن الأولى التي تتعرَّض لنور الشمس تصبح طاهرة نقية، ولا شك أن الثانية بحرمانها من النور تنبت فيها الجراثيم والعُفونات وتغدو خبيثة الرائحة ملوثة الهواء.
ذلك هو مثل الأنفس في إقبالها على الله وبُعدها وإعراضها عنه فالمقبلة عليه تعالى تصبح طاهرة نقية تتولَّد فيها الفضائل وتنطبع فيها الكمالات. والمعرضة عنه تعالى يتولد فيها الخبث وتنشأ فيها العلل المعنوية المنحطة، غير أن هذه النفس المعرضة التي وهبها الله تعالى من الاستعداد ما تستطيع به أن تتراجع عن غيِّها لا يأساً من شفائها مما هي مصابة به فالأمر موكول إلى هذا الإنسان وحده. قال تعالى: {..إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ..}1
فإن رجع الإنسان إلى نفسه بالتفكير واهتدى من وراء تفكيره إلى خالقه فأناب إليه وأقبل عليه تعالى بكلِّيته، فهنالك يمسح النور الإلهي صفحات النفس فيعيد إليها طهارتها ونقاءها ويرجع بها إلى فطرتها قال تعالى: {فأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلقِ اللهِ ذلِكَ الدّينُ القَيِّمُ وَلكِنَّ أكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ، مُنيبينَ إليْهِ وَاتَّقُوهُ وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}2
وهكذا فالمسألة مسألة إقبال وإدبار. فمن فكَّر وأناب وأقبل على الله تعالى تحلَّت نفسه بالفضائل وطهرت من العلل وامتلأت بالكمال، ومن استكبر وأعرض انحطَّت نفسه وتدنَّت وتلوثت بالعلل المعنوية والأدران.
بالإيمـان يتـم تأويـل القـرآن
من هذا المنطلق يؤمن باليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله عندها يرى كل ما في القرآن من أوامر ونواه وكل ما فيه من عبر وحكم وأمثال، وكل ما يأمر به تعالى من صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إن هي إلا أوامر خيِّرة ليقرِّبه بها إليه وليعلم بأنه لا إله إلا هو، فلا يعتمد ولا يتَّكل، ولا يطلب، ولا يستعين إلا به وبدونه لا تحصل له زكاة وطهارة، ولن يكون عنصراً صالحاً للمجتمع مهما كانت التربية ومهما كانت الثقافة التي تلقَّاها من دونه تعالى. فإن لم تكن معايناً وممارساً ومشاهداً التسيير الإلهي، وإذا لم تحصل لك حلاوة الإيمان، ولم تتذوق الرحمة، والعدل والكرم، وإن لم تعلم علماً يقينيّاً بأنه لا فاعل إلاَّ الله، وأنه لا يتحرَّك متحرِّك ولا يسكن ساكن إلا من بعد إذنه، فكيف تستطيع أن تؤوِّل القرآن وتفقه مراميه؟. فالقائد إذا لم يدرس القتال عملياً، لا بد أن يخطئ مهما درس وتعلم، والميكانيكي إذا لم يرَ الآلة وحركتها ولم يختبرها بنفسه فإن علمه عنها يبقى في الحدود النظرية، وكذلك الإنسان قد يسمع وقد يقنع ويصدِّق بفكره فيعرف أن الرزَّاق هو الله، ولكن لا يتَّكل عليه كليّاً، ويعلم أن النصر من الله ولكنه يتهيب غيره، وقد تصيبه مصيبة فتثور ثائرته، وينسى بأن ما أصابه إنما جاء نتيجة ما قدَّمت يداه، فأوْلى له أن يرجع إلى نفسه، لا أن يتَّهم غيره، وبمعنى أشمل إن العلوم النظرية عامة وعلوم الدين خاصة لا تساوي شيئاً دون المحك العملي، فإذا لم يتبع النظر العمل فإن علمه يظل سطحياً.
إن البعيد عن الله لا يعرف مراده تعالى، وهل باستطاعة إنسان أن يعرف مراد ومغزى من لا يعرفه؟. إلاَّ من قبيل الظن والتخمين؟. وإن الظن لا يغني عن الحق شيئاً. إن القرآن حق، والبعيد عن الله لا يعرف إلاَّ الباطل، فكيف يستطيع المعرض أن يعرّف الحق ويبيِّنه. فالإنسان لا يفهم مراد ربِّ العالمين "أي لا يفهم القرآن إلا إذا كان قريباً من الذي نزَّل القرآن".. ولا يستطيع أن يتقرَّب منه إلا إذا سلك طريق الإيمان به، وبهذا التقرُّب ينطبع في نفسه الحق من صاحب الحق، وتغدو نفسه مملوءة من الكمال الإلهي، بعدها إذا نظر إلى القرآن وتدبر آياته يجده الحقّ من ربه فلا يؤوِّله إلا بما يتوافق والكمال الإلهي. فكلَّما علا الإيمان سما التأويل، وكلَّما سما التأويل فإن تنزيه الحضرة الإلهية يكون أكمل.
الإيمان: هو الأساس في تأويل القرآن، أما اللغة وما فيها من نحو وصرف والأدب وما فيه من بلاغة وبيان، والتاريخ وما يحويه من العلوم القرآنية وأسباب نزول الآيات، والسير والعبر والحوادث، إن هي إلا علوم مساعدة وثانوية بالنسبة للإيمان.
إن الرسول e ما نزل القرآن على قلبه الطاهر ولا استطاع أن يفهم مراد رب العالمين إلا بإيمانه الرفيع، فهو الذي فاق الخلق جميعاً بالقرب منه تعالى وهو الذي أصبح بالأفق الأعلى من بين الرسل الكرام، فشاهد من آيات ربه الكبرى وما كذب فؤاده ما رأى بل هي أشد وضوحاً من رؤيته البصرية. كل ذلك ما كان إلاَّ عندما أضحى قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله في قلبه ما أوحى. فهو e أول الخلق في الغاية التي من أجلها خُلقوا. قال تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ}1
ولهذا ما نزل القرآن العظيم على قلبه إلا بالحق وبجدارة. قال تعالى: {وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ..}2
فقد تعلَّم منه علماً وفهم من القرآن فهماً لم ولن يبلغه أحد من العالمين قال تعالى في سورة الرعد (43): {ويَقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرسَلاً قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْني وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}: مثلي؟. أي ومن عنده علم الكتاب مثلي؟. كل ما جاء به من سنن وكل ما رويَ عنه من أحاديث إنما جاء بها القرآن الكريم ومن علمه العالي به.
إن القرآن بحر ما فرَّط الله فيه من شيء، وهو تبيان لكل شيء من أمور العبادة، والسنن، والشرائع المنظمة للفرد والجماعة والدولة والدول. ولن يقدِّر علم الرسول ولن يقدِّر فضله إلا من سلك مسلكه وأحبَّت نفسُه نفسَه حبّاً تضاءل أمامه حب ابنه وزوجته وأمه وأبيه وعشيرته التي تؤويه. وكل من في الأرض جميعاً حتى نفسه التي بين جنبيه، فعندئذٍ يعلم طرفاً من علم الرسول لهذا الكتاب الكريم. ومن الخطأ أن يُعتبر الحديث والسنَّة والإجماع متمِّمة للقرآن، بل هي قواعد عملية ونظرية استنبطها الرسول e من هذا الكتاب، فالنبي محمد e لم يأت من عنده بشيء وليس هو بحاجة إلى شيء، ففي القرآن تفصيلٌ لكل شيء.
إن القرآن نزل على قلبه في ليلة قدَّر الله فيها حق قدره، قدَّر رحمته وعطفه، وحنانه وعدله، وعظمته، ثم رتَّله عليه آية إثر آية وسورة بعد سورة بحسب الظروف والمناسبات، قال تعالى: {.. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}1. إنه شاهد الحق وعاينه فجاء القرآن تثبيتاً وتصديقاً لما شاهده من قبل لقد نزل القرآن على قلبه الطاهر في ليلة مباركة من شهر مبارك في ليلة القدر التي هي خير من عبادة إنسان قضى في عبادته ثلاثة وثمانين عاماً ونيف.
هذا الشهر هو شهر التقوى، فيه تصفو النفس يوماً بعد يوم وتزكو بإقبالها على الله بالثقة التي اكتسبها المرء من صيامه وقيامه، وصدقه، حتى إذا ما بلغت النفس العشر الأواخر تكون قد استوت وزكت، فيكشف الله لها ما يكشف في صلاة التراويح، فتصبح وقد غدت عالمة بقدرته وعظمته، مستسلمة للحق، لا تلتفت إلى سواه، محفوظة بسلام حتى مطلع فجر الآخرة. قال تعالى: {سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}1
{وَقَالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَولاَ نُزِّلَ عَلَيهِ القُرآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلنَاهُ تَرْتِيلاً}2
أي كذلك نحن نزلناه جملة واحدة ثم رتلناه عليك ببيان، وبلاغة عالية حسب المناسبات، ولنثبت به فؤادك، وليكون تأكيداً وشاهداً لك على ما شاهدته من الحق قبل أن ينزل عليك ثانية وتضعه في مصاحف وأي إنسان يسلك مسلك رسول الله e فإنه يرى في القرآن انطباعاته النفسية، أي أن القرآن يعكس مشاهداته العملية، ويرى تطابقاً بين ما شاهده بنفسه وبين ما شاهده في القرآن فيزداد ثقة ويزداد إيماناً وابتهاجاً.
قال تعالى: {وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكْتُبنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ}3
{إِنَّا أنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرينَ}4
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالفُرقَانِ..}5
الإيـــمـــــــــــــان
أوَّل المدارس العليا للتقوى
كيفية الوصول إلى الإيمان.............................................. 29
ثمرة الإيمان اليقيني وطريقها........................................... .. 31
الطريق الوحيد لتطهير النفس وتحليتها بالفضائل......................... 38
بالإيمان يتم تأويل القرآن............................................ ... 42