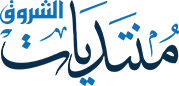الحضارة الإنسانية، بين الذاكرة و الحلم
30-01-2018, 02:44 PM
يقول عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته (مقدمة ابن خلدون)، معرفاً المدنية بما يلي: " هي أحوال زائدة عن الضروري من أحوال العمران، أو بمعنى آخر رفاهية العيش، لذلك فهي تظهر في المدن والأمصار والبلدان والقرى، أي في الحضر، ولا تظهر في البادية".
لقد عمرت الأرض مدنيات كثيرة، تركت لنا آثاراً تشهد بمبلغ التطور والرقي الذي وصلته، لكن لم يسبق لأي من هذه المدنيات بلوغ ذرى التقدم العلمي الذي تشهده المدنية المعاصرة، والتي تدين بكثير من الفضل لمنهج البحث الذي اتبعته، فحملها خلال بضع من السنين إلى الكواكب البعيدة، لقد شهدنا دهورا هيمنت فيها الفلسفة الإغريقية على الغرب في العصور الوسطى، و كان خطأ فلاسفة الإغريق الكبير أنهم صرفوا وقتا كبيرا في المناحي النظرية، والقليل من الجهد في الملاحظة والبحث العلمي، فكان على الغرب كي ينهض، أن يضرب عرض الحائط بالجدل والحوار العقيم الذي لا فائدة للناس فيه و بجميع نظريات هذه العصور.
نهج الفلاسفة الإغريق على اعتبار (العلم) نوعاً من الترف العقلي، فذهب (أفلاطون) إلى أن ممارسة الأعمال اليدوية هو من الأعمال الدنيئة التي لا تليق بالأشراف، صحيح أن الفيلسوف وعالم الطبيعة الشهير(أرخميدس) استطاع صنع عدسات ضوئية، سلط بواسطتها أشعة الشمس على الأسطول الروماني الذي هاجم أثينا، فأوقفه عن التقدم في خلجانها ثلاث سنوات، إلا أن هذا المهندس البارع شعر بالذنب لهذه الأعمال اليدوية، واعتبرها نوعاً من الترفيه عن عقله المجهد بالفلسفة والمثل.
إذا توغلنا عمقاً في التاريخ نجد أن الفلسفة الإغريقية لم تقم منعزلة عن العالم، بل تسربت إليها الفلسفات الشرقية القديمة بشكل واسع، ولم يكن استقدام الفلسفة الرواقية، أوالزينونية التي جاء بها التاجر الفينيقي (زينون) إلى أثينا حوالي عام (310 ق،م) سوى وجه واحد للتسرب الشرقي الواسع للفلسفة الذي دخل إلى الإغريق، كذلك فقد ساعدت فتوحات(الإسكندر المقدوني) على تدفق سيل الفلسفات الشرقية على الأراضي الأوروبية، خاصة وأنّ هذه الفلسفات أكثر اتساعاً وأشد تأصلاً ووقاراً، لقد تغلبت روح الشرق على الإسكندر نفسه في أوج ساعات انتصاره، فتزوج ابنة (داريوس) ملك الفرس، و تبنى التاج والكساء الفارسي في الدولة.
وعندما قام الرومان بنهب هلينيا عام (146 ق، م)، وجدوا مذاهب فلسفية شتى تتنازع الميدان، وبما أن الرومان لم تكن لديهم المقدرة والفراغ على التأمل والتفكير أنفسهم، فقد عادوا بهذه الآراء الفلسفية مع جملة مغانمهم إلى روما، واتجه كبار المنظرين منهم إلى الأساليب الرواقية، فكانت الفلسفة السائدة في روما، فلسفة (زينون) الرواقية. لقد بنى (زينون) فلسفته الجامدة على جبرية شرقية، وعندما كان (زينون) الذي لا يؤمن بنظام الرق يضرب عبداً له ارتكب ذنباً، توسّل العبد أن يخفف من ضربه قائلاً إن فلسفته تقول إنه مسيّر لا مخيّر في ارتكاب ذنبه، فأجابه زينون بأنّه هو ايضا مسيّر لا مخيّر في ضربه له.
اعتقد الرواقيون أن عدم الاهتمام الفلسفي هوالنظرة الوحيدة المعقولة للحياة التي يتنازعها الصراع من أجل المعيشة، وأنّ سرّ السلام يكمن في الحد من رغباتنا وطموحنا إلى مستوى مقدرتنا، يقول الرواقي (سينيكا-Seneca) الروماني المتوفى عام (65 ق.م):
"إذا كان ما لديك لا يكفيك، فستكون بائساً وفقيراً حتى لو ملكت العالم".
تدور عجلة التاريخ، ويتحول مسرحه إلى مشاهد جديدة، فتتدهور الزراعة في روما بسبب جفاف الأرض وتعبها، وتتحول ثروتها إلى فقر، وتنظيمها إلى فوضى، وتتعطل الطرق، ولا تعود صالحة للتجارة، وتزحف القبائل الجرمانية العنيفة سنة بعد أخرى عبر الحدود لتهاجم بقايا الإمبراطورية التي أخذ نجمها في الأفول، فتستسلم الإمبراطورية الرومانية تدريجياً إلى البابوية.
لقد دعم الأباطرة الكنيسة في القرون الأولى من قيامها، وامتصت الأخيرة تدريجياً سلطة الملوك والأباطرة، ونمت نمواً كبيراً في عددها، وثروتها، ونفوذها، وأصبحت تمتلك ثلث الأرض في أوروبا حوالي القرن الثالث عشر.
طوقت الكنيسة العقل الأوروبي اليافع بعقيدة محدودة في تلك العصور، وعندما تحرك الغرب، وتنبه بتراث العرب المسلمين في القرن الثالث عشر، كانت سلطة الكنيسة لا تزال قوية لتحمي نفسها عن طريق (توما الأكويني) وغيره بتحويل فلسفة الإغريق إلى فلسفة إلهية للعصور الوسطي.
أما ما ظهر من بعض الأفكار العلمية في عصور الظلام تلك في أوروبا، فقد قُمعت في مهدها من قبل السلطات الكنسية الحاكمة، فأحيل العالم والفلكي (غاليله) الذي قال بدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس إلى ديوان التفتيش في روما، بعد أن أضحى شيخاً متوعك الصحة، وهناك تحت التهديد والتعذيب أجبر على التصريح بأن أفكاره كانت خاطئة، وأنه قد تنازل عنها، ثم عزل في منزل قريب من (فلورنسه)، وكان ممنوعا عليه دخولها، ومنعت قراءة كتبه.
كما أحرق المفكر (جيوردانو برونو) حيا بعد أن أغلق فمه بمسمار لأنه كان يؤمن بتعدد العوالم. يقول برونو في كتابه: "تعدد العوالم والكون اللامتناهي":
"هناك شموس لا عدد لها، وكواكب لا عدد لها تدور حول شموسها تماماً كما تفعل الكواكب السبعة في مجموعتنا الشمسية، إنـا نرى الشموس لأنها مضيئة ولأنها أكبر حجماً، أما الكواكب التي تتبعها فتبقى غير مرئية لأنها أصغر وغير مضيئة..".
هذا التطرف من قبل السلطة الكنسية آنذاك، هوالذي دفع القس (مارتن لوثر) الذي لم يكن ليفقه شيئاً في علم الرياضيات أوالفلك، للحكم على العالم (كوبرنيكوس) بالغباء والتطرف والإلحاد، لقوله بأن الأرض تدور حول الشمس.
في هذه الفترة بالذات، كانت المدنية الإسلامية قد أينعت ثمارها، وبدأت تؤتي أكلها، وكانت حواضر العالم الإسلامي منارات علم ونور للعالم أجمع، وكما يقول (ول ديورانت) في كتابه (قصة الحضارة):
"وبلغ الإسلام في ذلك الوقت أوج حياته الثقافية، وكنت تجد في ألف مسجد منتشرة من قرطبة إلى سمرقند، علماء لا يحصيهم العد، كانت تدوي أركانها بفصاحتهم، وكانت قصور مئة أمير تتجاوب أصداؤها بالشعر والمناقشات الفلسفية، ولم يكن هناك من رجل يجرؤ أن يكون مليونيراً من غير أن يعاضد الأدب والفن. لقد استطاع العرب أن يستوعبوا ما كان عند الأمم الأخرى من ثقافات بما اتصفوا به من سرعة الخاطر وقوة البديهة، حتى أظهر الفاتحون كثيراً من التسامح مع الشعراء والعلماء والفلاسفة الذين جعلوا من اللغة العربية أوسع اللغات علماً وأدباً في العالم، بحيث ظهر العرب الأصلاء وكأنهم قلة بالنسبة إلى الآخرين"
يقول (جورج سارتون) في كتابه "المدخل إلى تاريخ العلوم":
"كتبت أعظم المؤلفات قيمة وأكثرها أصالة وأغزرها مادة باللغة العربية خلال العصور الوسطى، وكانت اللغة العربية منذ منتصف القرن الثامن حتى نهاية القرن الحادي عشر للميلاد لغة العلم الارتقائية للجنس البشري، حتى أنه كان يتوجب على من أراد أن يلم بثقافة عصره بأحدث صورها، أن يلم باللغة العربية"
اتجه العرب والمسلمون إلى ميادين العلوم يحذوهم في ذلك ما ورد في القرآن الكريم من حث للإنسان على النظر في ملكوت السماوات والأرض، وما فضّل به الله العالِم على الجاهل:
{يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات}: المجادلة-11
و: {إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء}: فاطر-28
و: {وقل ربِّ زدني علماً}: طه-114
كذلك حثّ الرسول على طلب العلم فجاء في الحديث الشريف:
{طلب العلم فريضة على كل مسلم}: عن ابن ماجه
{من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجنة}: عن البخاري و مسلم
{العلماء ورثة الأنبياء}: عن البخاري و أبي داوود و ابن ماجه و الدرامي.
إن للتفكير العلمي خصائص لا يستقيم دونها، أهمها أن يبدأ العالم بحثه دون تحيز لأي معلومات سابقة قد تكون خاطئة، و قد حرص على التنبيه إلى ذلك رواد منهج البحث العلمي من الغربيين منذ مطلع العصور الحديثة، فقد أوصى (فرانسيس بيكون)(و1626م/1036هـ) في كتابه (الأداة الجديدة) بتطهير العقل وتنقيته وغسله من التصورات السابقة والآراء المتحيزة.
إنّ مشكلة المنطق الأولى هي تتبع مصادر أخطاء العقل والتصدي لها، هذه الأخطاء يمكن أن تنجم عن التسليم بآراء الآخرين أو عن غموض اللغة كأداة للتفاهم والتعبير عن الأفكار أوالأخطاء التي تغري بها الطبيعة البشريّة، كالميل إلى التسرع في إصدار الأحكام والانسياق مع الأهواء والمصالح، أوالتي تقود إليها الميول الفردية من سماحة أو تعصب وتفاؤل أو تشاؤم، أما مفتاح البحث فهوالتجربة، وهي تدبير لظروف ملائمة للإجابة على تساؤل محدد، أو بمعنى آخر فالتجربة هي توجيه سؤال إلى الطبيعة حول فكرة تتطلب الجواب، وعلى الباحث أن يتخلى عن الفكرة التي جعلها أداة لتفسير الطبيعة متى أثبتت التجربة بطلانها، لقد نزع العلم الحديث إلى الرصد وتحويل الكيفية إلى كمية والتعبير عن وقائع الحس بالرسوم البيانية والجداول الإحصائية، مستعيناً بالتقدم الهائل الذي أحرزته آلات الرصد، كالآلات الحاسبة والمجهرات، وأجهزة التقريب الضوئية والراديوية التي تستعمل في علم الفلك، وأصبح مردّ الدقة في القوانين العلمية يعود إلى صياغتها الرياضيّة، فأين وقفت المدنية العربية الإسلامية من منهج البحث العلمي؟
لقد أوجب العلماء المسلمون على الباحث أن يطهر عقله من كل ما يحويه من أفكار مسبقة حول موضوع البحث متوسلين إلى ذلك بالشك، يقول إبراهيم النظام (و221هـ/840 م) : "لم يكن يقين قط حتى صار فيه شك، ولم ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد حتى يكون بينهما حال شك"، ويقول الجاحظ (و255هـ/869 م): " تعلم الشك في المشكوك فيه تعلماً، فلو لم يكن ذلك إلا تعرف التوقف ثم التثبت، لأوفى بما يحتاج إليه، والعوام أقل شكوكاً من الخواص لأنهم لا يتوقفون عن التصديق ولا يرتابون بأنفسهم، فليس عندهم إلا الإقدام على التصديق المجرد، أوالتكذيب المجرد،"
كذلك فإن الغزالي (و505هـ/1111م) زاول الشك قبل التيقن، قال في (المنقذ من الضلال): "لو لم يكن في هذه الألفاظ إلا ما يشكك في اعتقادك الموروث لكفى بذلك نفعاً فإن من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والحيرة،"
وقد نبه الحسن بن الهيثم(و354هـ/965م) في كتابه (مقدمة الشكوك على بطليموس) إلى "أنّ حسن الظن بالعلماء السابقين مغروس في طباع البشر، وأنّه كثيراً ما يقود الباحث إلى الضلال ويعيق قدرته على كشف مغالطاتهم، وانطلاقه إلى معرفة الجديد من الحقائق، وما عصم الله العلماء من الزلل، ولا حمى علمهم من التقصير والخلل ولو كان ذلك كذلك، لما اختلف العلماء في شيء من العلوم، ولا تفرقت آراؤهم في شيء من حقائق الأمور"،
لقد فطن رواد المدنية الإسلامية إلى التجربة كأداة فعالة في مسالك البحث العلمي، من ذلك أن جابر بن حيان (ت 198هـ/813 م) سماها بالتدريب، يقول في كتاب (السبعين):" فمن كان درباً(مجرّباً)، كان عالماً حقاً، ومن لم يكن درباً لم يكن عالماً، وحسبك بالدربة (إجراء التجارب) في جميع الصنائع، أن الصانع الدرب يحذق، وغير الدرب يعطل".
كما كان البيروني (و362هـ/973 م) من أئمة رواد البحث التجريبي، وقد استطاع من خلال تجاربه تحديد الثقل النوعي لكثير من المواد بدقة تثير الإعجاب، كذلك فقد نزع العلماء المسلمون إلى تكميم النتائج توخياً للدقة، من ذلك أنّ جابر بن حيان جعل الميزان أساس البحث التجريبي، وقد عرّف مفهوم الكمية بقوله:"إنها الحاصرة المشتملة على قولنا الأعداد، مثل عددٍ مساوٍ لعدد، وسائر الأرطال والأعداد والأقدار من الأوزان والمكاييل وما شاكل ذلك".
وقد صنع المسلمون آلاتٍ دقيقة استخدموها في بحوثهم التجريبية، لعلّ أهمها تلك التي استخدمت في علوم الفلك والجغرافيا والطبيعة، كالحلقة الاعتدالية، وهي حلقة تنصب في سطح دائرة المعدل ليعلم بها التحول الاعتدالي للأرض، وذات الأوتار، وهي أربع اسطوانات تغني عن الحلقة الاعتدالية و يعلم بها تحول الليل أيضاً، وذات السمت والارتفاع و يعلم بها السمت والارتفاع، والمشبهة بالناطق، وهي ثلاث مساطر، اثنتان منظمتان ذات شعبتين، ويقاس بها البعد بين كوكبين، والمزاولة (الساعة الشمسية)، والإسطرلاب وهو جهاز يستطيع الفلكي أن يعين به زوايا ارتفاع الأجرام السماوية عن الأفق في أي مكان، وقد استخدم البيروني جهازاً مخروطياً لتحديد الثقل النوعي يعد اليوم من أقدم أجهزة القياس.
لقد وضع علماء المسلمين دراسة مفصلة عن الكواكب وأحجامها، وعرفوا كثيراً عن الأرض وكرويتها وحركتها حول الشمس، يقول الشريف الإدريسي في كتابه (نزهة المشتاق):" إنّ الأرض مدوّرة كتدوير الكرة".
وقد كلف الخليفة العباسي (المأمون)، موسى بن شاكر الذي برز هو وأولاده الثلاثة محمد وأحمد وحسن في الرياضيات والميكانيك (علم الحيل)، بقياس محيط الأرض، وبعد الحساب الطويل والدقيق، توصلت البعثة التي قامت بالقياس إلى أن المحيط يساوي 47356 كيلو متر، وهذه النتيجة قريبة من الحقيقة إذ أن القياس الأخير لهذا المحيط يساوي 40000 كيلو متر تقريباً، ويعزى لبني موسى بن شاكر القول بالجاذبية بين الأجرام السماوية التي قال بها (إسحاق نيوتن) بعدهم بمئات السنين.
كذلك فسر علماء العرب والمسلمين بكثير من الدقة الظواهر الكونية التي تبدو في أوقات الشفق أو كسوف الشمس، وقوانين علم النبات وغيرها كثير.
بأثر من الحضارة الإسلامية بدأ الغرب بتسخير العلم الطبيعي لخدمة الإنسان، حالمين بمدنية لطالما حلم بها المفكرون والحكماء منذ فجر التاريخ.
لعل أول من جسد الرؤى في مثل هذه المدينة الفاضلة الفيلسوف الإغريقي (أفلاطون) الذي صورها بأنها جمهورية فاضلة تحكمها نخبة صارمة من أفراد المجتمع، هذا المجتمع يشبه في رؤى أفلاطون مجتمع إسبارطة الإغريقي، حيث يتخذ كل فرد فيه مكاناً مناسباً تم تأهيله وإعداده له، لكن جمهورية أفلاطون تزدري كما رأينا تسخير العلم في التطبيقات العملية، فليست مهمة علم الفلك مثلاً في هذه الجمهورية تقديم النفع والفائدة للناس في معرفة عدد السنين والحساب ومواعيد الفصول الزراعية، كذلك لا يجد أفلاطون أية ميزة في اختراع الكتابة، إذ أنها، حسب رأيه، تعّود الناس على الكسل، وعلى الفيلسوف أن يلم بما تعلمه عن ظهر قلب، وأن يستظهره عند الحاجة بعد أن يضفي عليه من مقدراته العقلية وسموه الذهني ما يرقى به إلى رفيع المراتب الفلسفية.
هذه اللغة الأفلاطونية بعيدة كل البعد عن روح المدنية الإسلامية، وروح نهضة الغرب في العصر الحديث.
لقد عمرت الأرض مدنيات كثيرة، تركت لنا آثاراً تشهد بمبلغ التطور والرقي الذي وصلته، لكن لم يسبق لأي من هذه المدنيات بلوغ ذرى التقدم العلمي الذي تشهده المدنية المعاصرة، والتي تدين بكثير من الفضل لمنهج البحث الذي اتبعته، فحملها خلال بضع من السنين إلى الكواكب البعيدة، لقد شهدنا دهورا هيمنت فيها الفلسفة الإغريقية على الغرب في العصور الوسطى، و كان خطأ فلاسفة الإغريق الكبير أنهم صرفوا وقتا كبيرا في المناحي النظرية، والقليل من الجهد في الملاحظة والبحث العلمي، فكان على الغرب كي ينهض، أن يضرب عرض الحائط بالجدل والحوار العقيم الذي لا فائدة للناس فيه و بجميع نظريات هذه العصور.
نهج الفلاسفة الإغريق على اعتبار (العلم) نوعاً من الترف العقلي، فذهب (أفلاطون) إلى أن ممارسة الأعمال اليدوية هو من الأعمال الدنيئة التي لا تليق بالأشراف، صحيح أن الفيلسوف وعالم الطبيعة الشهير(أرخميدس) استطاع صنع عدسات ضوئية، سلط بواسطتها أشعة الشمس على الأسطول الروماني الذي هاجم أثينا، فأوقفه عن التقدم في خلجانها ثلاث سنوات، إلا أن هذا المهندس البارع شعر بالذنب لهذه الأعمال اليدوية، واعتبرها نوعاً من الترفيه عن عقله المجهد بالفلسفة والمثل.
إذا توغلنا عمقاً في التاريخ نجد أن الفلسفة الإغريقية لم تقم منعزلة عن العالم، بل تسربت إليها الفلسفات الشرقية القديمة بشكل واسع، ولم يكن استقدام الفلسفة الرواقية، أوالزينونية التي جاء بها التاجر الفينيقي (زينون) إلى أثينا حوالي عام (310 ق،م) سوى وجه واحد للتسرب الشرقي الواسع للفلسفة الذي دخل إلى الإغريق، كذلك فقد ساعدت فتوحات(الإسكندر المقدوني) على تدفق سيل الفلسفات الشرقية على الأراضي الأوروبية، خاصة وأنّ هذه الفلسفات أكثر اتساعاً وأشد تأصلاً ووقاراً، لقد تغلبت روح الشرق على الإسكندر نفسه في أوج ساعات انتصاره، فتزوج ابنة (داريوس) ملك الفرس، و تبنى التاج والكساء الفارسي في الدولة.
وعندما قام الرومان بنهب هلينيا عام (146 ق، م)، وجدوا مذاهب فلسفية شتى تتنازع الميدان، وبما أن الرومان لم تكن لديهم المقدرة والفراغ على التأمل والتفكير أنفسهم، فقد عادوا بهذه الآراء الفلسفية مع جملة مغانمهم إلى روما، واتجه كبار المنظرين منهم إلى الأساليب الرواقية، فكانت الفلسفة السائدة في روما، فلسفة (زينون) الرواقية. لقد بنى (زينون) فلسفته الجامدة على جبرية شرقية، وعندما كان (زينون) الذي لا يؤمن بنظام الرق يضرب عبداً له ارتكب ذنباً، توسّل العبد أن يخفف من ضربه قائلاً إن فلسفته تقول إنه مسيّر لا مخيّر في ارتكاب ذنبه، فأجابه زينون بأنّه هو ايضا مسيّر لا مخيّر في ضربه له.
اعتقد الرواقيون أن عدم الاهتمام الفلسفي هوالنظرة الوحيدة المعقولة للحياة التي يتنازعها الصراع من أجل المعيشة، وأنّ سرّ السلام يكمن في الحد من رغباتنا وطموحنا إلى مستوى مقدرتنا، يقول الرواقي (سينيكا-Seneca) الروماني المتوفى عام (65 ق.م):
"إذا كان ما لديك لا يكفيك، فستكون بائساً وفقيراً حتى لو ملكت العالم".
تدور عجلة التاريخ، ويتحول مسرحه إلى مشاهد جديدة، فتتدهور الزراعة في روما بسبب جفاف الأرض وتعبها، وتتحول ثروتها إلى فقر، وتنظيمها إلى فوضى، وتتعطل الطرق، ولا تعود صالحة للتجارة، وتزحف القبائل الجرمانية العنيفة سنة بعد أخرى عبر الحدود لتهاجم بقايا الإمبراطورية التي أخذ نجمها في الأفول، فتستسلم الإمبراطورية الرومانية تدريجياً إلى البابوية.
لقد دعم الأباطرة الكنيسة في القرون الأولى من قيامها، وامتصت الأخيرة تدريجياً سلطة الملوك والأباطرة، ونمت نمواً كبيراً في عددها، وثروتها، ونفوذها، وأصبحت تمتلك ثلث الأرض في أوروبا حوالي القرن الثالث عشر.
طوقت الكنيسة العقل الأوروبي اليافع بعقيدة محدودة في تلك العصور، وعندما تحرك الغرب، وتنبه بتراث العرب المسلمين في القرن الثالث عشر، كانت سلطة الكنيسة لا تزال قوية لتحمي نفسها عن طريق (توما الأكويني) وغيره بتحويل فلسفة الإغريق إلى فلسفة إلهية للعصور الوسطي.
أما ما ظهر من بعض الأفكار العلمية في عصور الظلام تلك في أوروبا، فقد قُمعت في مهدها من قبل السلطات الكنسية الحاكمة، فأحيل العالم والفلكي (غاليله) الذي قال بدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس إلى ديوان التفتيش في روما، بعد أن أضحى شيخاً متوعك الصحة، وهناك تحت التهديد والتعذيب أجبر على التصريح بأن أفكاره كانت خاطئة، وأنه قد تنازل عنها، ثم عزل في منزل قريب من (فلورنسه)، وكان ممنوعا عليه دخولها، ومنعت قراءة كتبه.
كما أحرق المفكر (جيوردانو برونو) حيا بعد أن أغلق فمه بمسمار لأنه كان يؤمن بتعدد العوالم. يقول برونو في كتابه: "تعدد العوالم والكون اللامتناهي":
"هناك شموس لا عدد لها، وكواكب لا عدد لها تدور حول شموسها تماماً كما تفعل الكواكب السبعة في مجموعتنا الشمسية، إنـا نرى الشموس لأنها مضيئة ولأنها أكبر حجماً، أما الكواكب التي تتبعها فتبقى غير مرئية لأنها أصغر وغير مضيئة..".
هذا التطرف من قبل السلطة الكنسية آنذاك، هوالذي دفع القس (مارتن لوثر) الذي لم يكن ليفقه شيئاً في علم الرياضيات أوالفلك، للحكم على العالم (كوبرنيكوس) بالغباء والتطرف والإلحاد، لقوله بأن الأرض تدور حول الشمس.
في هذه الفترة بالذات، كانت المدنية الإسلامية قد أينعت ثمارها، وبدأت تؤتي أكلها، وكانت حواضر العالم الإسلامي منارات علم ونور للعالم أجمع، وكما يقول (ول ديورانت) في كتابه (قصة الحضارة):
"وبلغ الإسلام في ذلك الوقت أوج حياته الثقافية، وكنت تجد في ألف مسجد منتشرة من قرطبة إلى سمرقند، علماء لا يحصيهم العد، كانت تدوي أركانها بفصاحتهم، وكانت قصور مئة أمير تتجاوب أصداؤها بالشعر والمناقشات الفلسفية، ولم يكن هناك من رجل يجرؤ أن يكون مليونيراً من غير أن يعاضد الأدب والفن. لقد استطاع العرب أن يستوعبوا ما كان عند الأمم الأخرى من ثقافات بما اتصفوا به من سرعة الخاطر وقوة البديهة، حتى أظهر الفاتحون كثيراً من التسامح مع الشعراء والعلماء والفلاسفة الذين جعلوا من اللغة العربية أوسع اللغات علماً وأدباً في العالم، بحيث ظهر العرب الأصلاء وكأنهم قلة بالنسبة إلى الآخرين"
يقول (جورج سارتون) في كتابه "المدخل إلى تاريخ العلوم":
"كتبت أعظم المؤلفات قيمة وأكثرها أصالة وأغزرها مادة باللغة العربية خلال العصور الوسطى، وكانت اللغة العربية منذ منتصف القرن الثامن حتى نهاية القرن الحادي عشر للميلاد لغة العلم الارتقائية للجنس البشري، حتى أنه كان يتوجب على من أراد أن يلم بثقافة عصره بأحدث صورها، أن يلم باللغة العربية"
اتجه العرب والمسلمون إلى ميادين العلوم يحذوهم في ذلك ما ورد في القرآن الكريم من حث للإنسان على النظر في ملكوت السماوات والأرض، وما فضّل به الله العالِم على الجاهل:
{يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات}: المجادلة-11
و: {إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء}: فاطر-28
و: {وقل ربِّ زدني علماً}: طه-114
كذلك حثّ الرسول على طلب العلم فجاء في الحديث الشريف:
{طلب العلم فريضة على كل مسلم}: عن ابن ماجه
{من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجنة}: عن البخاري و مسلم
{العلماء ورثة الأنبياء}: عن البخاري و أبي داوود و ابن ماجه و الدرامي.
إن للتفكير العلمي خصائص لا يستقيم دونها، أهمها أن يبدأ العالم بحثه دون تحيز لأي معلومات سابقة قد تكون خاطئة، و قد حرص على التنبيه إلى ذلك رواد منهج البحث العلمي من الغربيين منذ مطلع العصور الحديثة، فقد أوصى (فرانسيس بيكون)(و1626م/1036هـ) في كتابه (الأداة الجديدة) بتطهير العقل وتنقيته وغسله من التصورات السابقة والآراء المتحيزة.
إنّ مشكلة المنطق الأولى هي تتبع مصادر أخطاء العقل والتصدي لها، هذه الأخطاء يمكن أن تنجم عن التسليم بآراء الآخرين أو عن غموض اللغة كأداة للتفاهم والتعبير عن الأفكار أوالأخطاء التي تغري بها الطبيعة البشريّة، كالميل إلى التسرع في إصدار الأحكام والانسياق مع الأهواء والمصالح، أوالتي تقود إليها الميول الفردية من سماحة أو تعصب وتفاؤل أو تشاؤم، أما مفتاح البحث فهوالتجربة، وهي تدبير لظروف ملائمة للإجابة على تساؤل محدد، أو بمعنى آخر فالتجربة هي توجيه سؤال إلى الطبيعة حول فكرة تتطلب الجواب، وعلى الباحث أن يتخلى عن الفكرة التي جعلها أداة لتفسير الطبيعة متى أثبتت التجربة بطلانها، لقد نزع العلم الحديث إلى الرصد وتحويل الكيفية إلى كمية والتعبير عن وقائع الحس بالرسوم البيانية والجداول الإحصائية، مستعيناً بالتقدم الهائل الذي أحرزته آلات الرصد، كالآلات الحاسبة والمجهرات، وأجهزة التقريب الضوئية والراديوية التي تستعمل في علم الفلك، وأصبح مردّ الدقة في القوانين العلمية يعود إلى صياغتها الرياضيّة، فأين وقفت المدنية العربية الإسلامية من منهج البحث العلمي؟
لقد أوجب العلماء المسلمون على الباحث أن يطهر عقله من كل ما يحويه من أفكار مسبقة حول موضوع البحث متوسلين إلى ذلك بالشك، يقول إبراهيم النظام (و221هـ/840 م) : "لم يكن يقين قط حتى صار فيه شك، ولم ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد حتى يكون بينهما حال شك"، ويقول الجاحظ (و255هـ/869 م): " تعلم الشك في المشكوك فيه تعلماً، فلو لم يكن ذلك إلا تعرف التوقف ثم التثبت، لأوفى بما يحتاج إليه، والعوام أقل شكوكاً من الخواص لأنهم لا يتوقفون عن التصديق ولا يرتابون بأنفسهم، فليس عندهم إلا الإقدام على التصديق المجرد، أوالتكذيب المجرد،"
كذلك فإن الغزالي (و505هـ/1111م) زاول الشك قبل التيقن، قال في (المنقذ من الضلال): "لو لم يكن في هذه الألفاظ إلا ما يشكك في اعتقادك الموروث لكفى بذلك نفعاً فإن من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والحيرة،"
وقد نبه الحسن بن الهيثم(و354هـ/965م) في كتابه (مقدمة الشكوك على بطليموس) إلى "أنّ حسن الظن بالعلماء السابقين مغروس في طباع البشر، وأنّه كثيراً ما يقود الباحث إلى الضلال ويعيق قدرته على كشف مغالطاتهم، وانطلاقه إلى معرفة الجديد من الحقائق، وما عصم الله العلماء من الزلل، ولا حمى علمهم من التقصير والخلل ولو كان ذلك كذلك، لما اختلف العلماء في شيء من العلوم، ولا تفرقت آراؤهم في شيء من حقائق الأمور"،
لقد فطن رواد المدنية الإسلامية إلى التجربة كأداة فعالة في مسالك البحث العلمي، من ذلك أن جابر بن حيان (ت 198هـ/813 م) سماها بالتدريب، يقول في كتاب (السبعين):" فمن كان درباً(مجرّباً)، كان عالماً حقاً، ومن لم يكن درباً لم يكن عالماً، وحسبك بالدربة (إجراء التجارب) في جميع الصنائع، أن الصانع الدرب يحذق، وغير الدرب يعطل".
كما كان البيروني (و362هـ/973 م) من أئمة رواد البحث التجريبي، وقد استطاع من خلال تجاربه تحديد الثقل النوعي لكثير من المواد بدقة تثير الإعجاب، كذلك فقد نزع العلماء المسلمون إلى تكميم النتائج توخياً للدقة، من ذلك أنّ جابر بن حيان جعل الميزان أساس البحث التجريبي، وقد عرّف مفهوم الكمية بقوله:"إنها الحاصرة المشتملة على قولنا الأعداد، مثل عددٍ مساوٍ لعدد، وسائر الأرطال والأعداد والأقدار من الأوزان والمكاييل وما شاكل ذلك".
وقد صنع المسلمون آلاتٍ دقيقة استخدموها في بحوثهم التجريبية، لعلّ أهمها تلك التي استخدمت في علوم الفلك والجغرافيا والطبيعة، كالحلقة الاعتدالية، وهي حلقة تنصب في سطح دائرة المعدل ليعلم بها التحول الاعتدالي للأرض، وذات الأوتار، وهي أربع اسطوانات تغني عن الحلقة الاعتدالية و يعلم بها تحول الليل أيضاً، وذات السمت والارتفاع و يعلم بها السمت والارتفاع، والمشبهة بالناطق، وهي ثلاث مساطر، اثنتان منظمتان ذات شعبتين، ويقاس بها البعد بين كوكبين، والمزاولة (الساعة الشمسية)، والإسطرلاب وهو جهاز يستطيع الفلكي أن يعين به زوايا ارتفاع الأجرام السماوية عن الأفق في أي مكان، وقد استخدم البيروني جهازاً مخروطياً لتحديد الثقل النوعي يعد اليوم من أقدم أجهزة القياس.
لقد وضع علماء المسلمين دراسة مفصلة عن الكواكب وأحجامها، وعرفوا كثيراً عن الأرض وكرويتها وحركتها حول الشمس، يقول الشريف الإدريسي في كتابه (نزهة المشتاق):" إنّ الأرض مدوّرة كتدوير الكرة".
وقد كلف الخليفة العباسي (المأمون)، موسى بن شاكر الذي برز هو وأولاده الثلاثة محمد وأحمد وحسن في الرياضيات والميكانيك (علم الحيل)، بقياس محيط الأرض، وبعد الحساب الطويل والدقيق، توصلت البعثة التي قامت بالقياس إلى أن المحيط يساوي 47356 كيلو متر، وهذه النتيجة قريبة من الحقيقة إذ أن القياس الأخير لهذا المحيط يساوي 40000 كيلو متر تقريباً، ويعزى لبني موسى بن شاكر القول بالجاذبية بين الأجرام السماوية التي قال بها (إسحاق نيوتن) بعدهم بمئات السنين.
كذلك فسر علماء العرب والمسلمين بكثير من الدقة الظواهر الكونية التي تبدو في أوقات الشفق أو كسوف الشمس، وقوانين علم النبات وغيرها كثير.
بأثر من الحضارة الإسلامية بدأ الغرب بتسخير العلم الطبيعي لخدمة الإنسان، حالمين بمدنية لطالما حلم بها المفكرون والحكماء منذ فجر التاريخ.
لعل أول من جسد الرؤى في مثل هذه المدينة الفاضلة الفيلسوف الإغريقي (أفلاطون) الذي صورها بأنها جمهورية فاضلة تحكمها نخبة صارمة من أفراد المجتمع، هذا المجتمع يشبه في رؤى أفلاطون مجتمع إسبارطة الإغريقي، حيث يتخذ كل فرد فيه مكاناً مناسباً تم تأهيله وإعداده له، لكن جمهورية أفلاطون تزدري كما رأينا تسخير العلم في التطبيقات العملية، فليست مهمة علم الفلك مثلاً في هذه الجمهورية تقديم النفع والفائدة للناس في معرفة عدد السنين والحساب ومواعيد الفصول الزراعية، كذلك لا يجد أفلاطون أية ميزة في اختراع الكتابة، إذ أنها، حسب رأيه، تعّود الناس على الكسل، وعلى الفيلسوف أن يلم بما تعلمه عن ظهر قلب، وأن يستظهره عند الحاجة بعد أن يضفي عليه من مقدراته العقلية وسموه الذهني ما يرقى به إلى رفيع المراتب الفلسفية.
هذه اللغة الأفلاطونية بعيدة كل البعد عن روح المدنية الإسلامية، وروح نهضة الغرب في العصر الحديث.