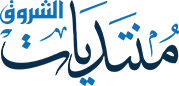تطور الحركة العلمية في الأزهر خلال العصر العثماني
04-10-2018, 03:34 PM

دخل العثمانيون مصر سنة (922هـ= 1517م)، وأضحت مصر ولايةً عثمانية، فتقلَّص هذا الازدهار العلمي؛ حيث قضى الفتح العثماني على مظاهر النشاط الفكري، حين استقطبت الدولة العثمانيَّة العلماء المصريِّين إلى إستانبول، وانتزعوا الكتب من المساجد والمدارس والمجموعات الخاصَّة ليُودِعُوها مكتبات عاصمة الدولة، ولكن الأزهر استمرَّ خلال القرون الثلاثة التي حكم العثمانيُّون فيها مصر يُجاهد لحفظ البقيَّة الباقية من اللغة العربيَّة والعلوم القرآنيَّة، وكان له الفضل على كلِّ حالٍ في الإبقاء على هذا التراث الإسلامي، لقد صار الأزهر أشهر الجوامع في التدريس على الإطلاق، وقصده طلاب العلم من كلِّ ناحية، والعلوم التي كانت تُدرَّس غالبًا بالأزهر حتى منتصف القرن التاسع هي الآداب والفقه والتوحيد؛ فالأزهر إبَّان العهد العثماني كان يحمل عبء الحفاظ على الثقافة الإسلاميَّة ونشرها طوال ثلاثة قرون، ولا سيَّما أنَّه كان قبلة العالم الإسلامي.
أضحت مصر ولايةً عثمانيَّةً منذ سنة (922هـ= 1517م)، وفقدت مصر استقلالها، وتقلَّص ظلُّ الازدهار العلمي، وانصرف الكثير عن العلوم العقليَّة والفلسفة والرياضيَّات والجغرافيا، حين قضت الدولة العثمانيَّة على مظاهر النشاط الفكري التي كانت مزدهرةً في عهد السلاطين؛ حيث عمدت الدولة بتجريد مصر من ذخائرها النفيسة في الآثار والكتب، وحَمْلِ كلِّ ذلك إلى إستانبول، كما بعثوا العلماء الأعلام والزعماء وقادة الفكر جميعًا إلى عاصمة الدولة، وهكذا توقَّفت إلى حين الحركة الفكريَّة الإسلاميَّة، وتضاءل شأن العلوم والفنون وانحطَّ معيار الثقافة، بعد أن كانت مصر موصل الثقافة ومحطَّ العلماء بعد سقوط بغداد على أيدي المغول الغزاة، وانقضاء البقيَّة الباقية من سلطان المسلمين في الأندلس، بعد أن وجد العلماء من المماليك ما أملوا، ووجد الإسلام فيهم حماةً يقفون له، وكان ردُّهم للمغول في موقعة عين جالوت على يد قطز حدثًا تاريخيًّا حفظ الحضارة الإسلاميَّة من معاول التتار، ورفع شأن مصر، وجعلها مهبط الثقافة الإسلاميَّة، والأمينة على تراث الإسلام منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، وقد كان الفضل في ذلك للأزهر؛ حيث اتَّسع صدره للواردين من العلماء والطلاب من كافَّة البلاد، وهيَّأ لهم سبل الدراسة الهادئة والبحث المنظَّم ممَّا أفاد الحضارة الإنسانيَّة بكثيرٍ من الفوائد، بما أخرجوا من الكتب في الفقه والحديث والتفسير واللغة.
وليس معنى ذلك أنَّ الأزهر فقد مكانته العلميَّة كما اعتاد معظم الباحثين في العصر العثماني أن ينعتوا الحياة العلميَّة في مصر إبَّان هذا العصر بالموات، ولم يستثنوا من ذلك إلَّا بصيصًا شاحبًا من الدراسات الشرعيَّة واللغويَّة كانت تضمُّها حلقات الأزهر، غير أنَّ وثائق هذا العصر ومصادره تُعطينا حقائق تُخالف ما تعارف عليه هؤلاء الباحثون.
فالأزهر إبَّان الحكم العثماني لم تخلُ حلقاته من العلوم الرياضيَّة والطب بالاضافة إلى علوم الشريعة واللغة والمنطق والأصول والتاريخ، بل إنَّ بعض علماء الأزهر درسوا الطبَّ ومارسوه عمليًّا في دار الشفاء المنصوري بالقاهرة، ومنهم من بلغ مرتبة رئاسة الأطباء في هذه الدار.
وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها العثمانيُّون في القاهرة إلَّا أنَّهم لم يتقدَّموا إلى اللاجئين المحتمين بالجامع الأزهر الشريف بأيِّ سوءٍ إجلالًا له وتقديسًا لحريَّته، واقتصر عملهم على أخذ الكتب والمخطوطات، وما زالت منها إلى اليوم بقيَّةٌ كبيرةٌ في مكتبات إستانبول، ومنها مؤلَّفاتٌ خطِّيَّةٌ لكثيرٍ من أعلام القرن التاسع الهجري المصريِّين مثل: المقريزي، والسيوطي، والسخاوي، وابن إياس، ممَّا يندر وجوده بمصر صاحبة هذا التراث العلمي، واستقطاب العلماء من الأزهر أغنياءهم وفقراءهم إلى إستانبول.
وقد ذكر ابن إياس لمـَّا دخل السلطان سليم الأوَّل القاهرة في (923هـ= 1517م)؛ صلَّى في الأزهر يوم الجمعة وأمر بتلاوة القرآن فيه، وتصدَّق على فقراء المجاورين.
وإذا كان الأزهر قد انطوى على نفسه في العصر العثماني وذوت أثاره العلميَّة، فقد استطاع بما له من نفوذٍ في نفوس العامَّة والخاصَّة أنْ يحفظ اللغة العربيَّة، وأن يُقاوم لغة الفاتحين، وأن يُبقي بابه مفتوحًا لطلاب العلوم الإسلاميَّة واللغة العربيَّة مدى ثلاثة قرون، حتى خرج عن النفوذ العثماني، وبدأ النور يبزغ من جديدٍ في أوائل القرن التاسع عشر يحمل في طيَّاته الأمل.
وإن كان العصر العثماني في مصر اتَّسم بفتور الهمم عن التأليف والتدوين، واتَّجه العلماء إلى مصنَّفات السلف الصالح وتناولوها بالشرح، ثم عمدوا إلى الشرح فشرحوها، وسمُّوا ذلك حاشية، ثم إلى الحواشي فشرحوها، وسمُّوا ذلك تقريرًا، فتحصَّل عندهم متنٌ هو أصل المصنف، وشروحٌ عديدة، وكانت النتيجة أن تطرَّق الإبهام إلى المعاني الأصليَّة، واضطربت المباحث، واختلَّت التراكيب، وتعقَّدت العبارات، واختفى مراد المصنِّف.
وأضحت العلوم العقليَّة والعلميَّة تتضاءل حتى أخذ القول بحرمة بعض العلوم العقليَّة يتسرَّب شيئًا فشيئًا للأزهر، كما يتسرَّب لغيره من المعاهد الإسلاميَّة الأخرى، حتى انتهى الأمر بهجرها تمامًا، فبقيت تلك العلوم الرياضيَّة والطبيعيَّة والفلسفيَّة مهجورةً من الأزهر يُنْظر إليها بنظر السخط، قال "علي باشا مبارك" في خططه ما نصُّه: "وينهى أهل الأزهر من يقرأ كتب الفلسفة، ويشنُّون عليه الغارة، وربَّما نسبوه للكفر...". فعلوا ذلك مع جميع من اشتُهر عنهم الاشتغال بالعلوم الحكميَّة والفلسفيَّة والرياضيَّة، وخاصَّةً مع السيد جمال الدين الأفغاني؛ الذي ما لبث أن قَدِم على مصر سنة (1288ه= 1871م) ورأى ما آلت إليه حالة العلم فيها حتى وقف جهوده على نشر العلوم الفلسفيَّة والحكميَّة، وإلى مجهوداته ومجهودات تلاميذه من بعده يرجع الفضل في النهضة الأزهريَّة الحديثة، ومع صفوة تلاميذه كالإمام محمد عبده والشيخ عبد الله وافي الفيومي (صاحب المبادئ المنطقيَّة وسوانح الموجهات).
وليس من شَكٍّ في أنَّ الحركة الفكريَّة في مصر تضاءلت إبَّان القرن الثامن عشر الميلادي من الحكم العثماني، كما تضاءل شأن العلوم والآداب، وانحطَّ معيار الثقافة، واختفى جيل العلماء الأعلام الذين حفلت بهم في العصور السالفة، ولم يبقَ من الحركة الفكريَّة الزاهرة التي أظلَّتها دولة السلاطين المصريَّة سوى آثار دراسة يبدو شعاعها الضئيل من وقتٍ إلى آخر، وقد أصاب الأزهر ما أصاب الحركة الفكريَّة كلَّها من الانحلال والتدهور، واختفى من حلقاته كثيرٌ من العلوم التي كانت زاهرةً به من قبل، حتى إنَّ العلوم الرياضيَّة لم تكن تُدرَّس به في أواخر القرن الثاني عشر.
قال الجبرتي يصف ما آلت إليه حال هذه الفترة: "كان الوزير أحمد باشا كور المتولِّي على مصر في سنة (1161هـ= 1748م) من أرباب الفضائل، وله رغبةٌ في العلوم الرياضيَّة، فلمَّا استقرَّ بقلعة مصر قابل صدور العلماء، ومنهم الشيخ عبد الله الشبراوى شيخ الأزهر، فتكلَّم معهم في الرياضيَّات فقالوا: "لا نعرف هذه العلوم"، فتعجَّب وسكت، وكان للشبراوي وظيفة الخطابة بجامع السراية، فكان يطلع يوم الجمعة ويدخل عند الباشا، فقال له الباشا: "المسموع عندنا بالديار التركيَّة أنَّ مصر منبع الفضائل والعلوم، وكنتُ في غاية الشوق إلى المجيء إليها، فلمَّا جئتها وجدتها كما قيل: "تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه"، فقال له الشيخ: "يا مولاي هي كما سمعتم معدن العلوم والمعارف"، فقال: "وأين هي وأنتم أعظم علمائها وقد سألتكم عن بعض العلوم فلم تُجيبوني، وغاية تحصيلكم الفقه والوسائل ونبذتم المقاصد"، فقال الشيخ: "نحن لسنا أعظم علمائها وإنَّما نحن المتصدِّرون لقضاء حوائجهم، وأغلب أهل الأزهر لا يشتغلون بالرياضيَّات إلَّا بقدر الحاجة الموصلة لعلم المواريث".
وورث الأزهر من هذا التعقيد العناية بالمناقشة اللفظيَّة، وتتبَّع كلمات المؤلِّفين في المصنَّفات والشروح والحواشي والتقارير، وتغلَّبت هذه العناية اللفظيَّة على الروح العلميَّة الموضوعيَّة، وصرفت الذهن عن الفكرة الأصليَّة إلى ما يتَّصل بها من ألفاظ وعبارات، واتَّجه العلماء إلى الاشتغال بالفروض والاحتمالات العقليَّة التي لا تقع وما يتَّصل بها من أحكام، وعلى الأخصِّ في العبادات والمعاملات، وبدأوا يُصنِّفون الرسائل في هذه الفروض والاحتمالات، وبذلك انصرفوا عن تنمية الفقه العملي الذي يحتاج إليه الناس في معاملاتهم، وانصرف الأزهر في هذه الحقبة عن دراسة العلوم الرياضيَّة والعقليَّة، ووجد فيه من يُنادي بتحريمها، وهكذا بدت بوادر الانحلال في الأزهر، وانقطعت صلته بماضيه الزاهر، ووقفت حركة التفكير العلمي، وكادت هذه المدرسة الإسلاميَّة الكبرى تفقد مميِّزاتها من حريَّة الفكر والإنتاج الخصب، لولا أن قيَّض الله لها مصلحين أخذوا بيدها، وجنَّبوها عواقب هذه الآفات والعلل حتى تجمَّعت فيها، وأثَّرت في مجرى حياتها.
على أنَّ الجامع الأزهر قام عندئذٍ بأعظم وأسمى مهمَّة أُتيح له أن يقوم بها؛ فقد استطاع خلال المحنة الشاملة أن يستبقي شيئًا من مكانته، وأن يُؤثِّر بماضيه العريق وهيبته القديمة في نفوس الغزاة أنفسهم، فنجد الحاكم العثماني يتبرَّك بالصلاة فيه غير مرَّة، ونجد الغزاة يبتعدون عن كلِّ مساسٍ به، ويحلُّونه مكانًا خاصًّا، ويُحاولون استغلال نفوذ علمائه كلَّما حدث اضطرابٌ أو ثورةٌ داخليَّة، وفي خلال ذلك صار الأزهر ملاذًا أخيرًا لعلوم الدين واللغة، وغدا بنوعٍ خاصٍّ معقلًا حصينًا للغة العربيَّة، يحتفظ في أروقته بكثيرٍ من قوَّتها وحيويَّتها، ويدرأ عنها خاصَّةً التدهور النهائي، ويُمكِّنها من مغالبة لغة الفاتحين ومقاومتها، وردِّها عن التغلغل في المجتمع المصري.
وهكذا استطاع الأزهر أن يُسدي إلى اللغة العربيَّة أجلَّ الخدمات، وإذا كانت مصر قد لبثت خلال العصر العثماني ملاذًا لطلاب العلوم الإسلاميَّة واللغة العربيَّة من سائر أنحاء العالم العربي والعالم الإسلامي، فأكبر الفضل في ذلك عائدٌ إلى الأزهر، وقد استطاعت مصر لحسن الطالع بفضل أزهرها أن تحمي هذا التراث نحو ثلاثة قرون حتى انقضى العصر العثماني، وقُيِّض لها أن تبدأ منذ أوائل القرن التاسع عشر حياةً جديدةً يُمازجها النور والأمل.
وقد كان من بين الأساتذة الذين تولَّوا التدريس بالجامع الأزهر في أوائل العصر العثماني: نور الدين على البحيرى الشافعي المتوفى سنة 944هـ، والعلَّامة شهاب الدين بن عبد الحق السنباطي المتوفَّى سنة 950هـ، وعبد الرحمن المناوي المتوفى سنة 950هـ، وشمس الدين الشيشيني القاهري الشافعي، والإمام شمس الدين أبو عبد الله العلقمي المتوفى سنة 962هـ، والإمام شمس الدين الصفدي المقدسي الشافعي المتوفى في حدود التسعين وتسعمائة.
وكان منهم في أواسط العصر العثماني: عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي المتوفَّى سنة 1099هـ، والعلَّامة شاهين بن منصور بن عامر الأرمناوي المتوفى سنة 1101هـ، والعلَّامة شمس الدين محمد بن محمد الشهير بالشرنبابلي المتوفَّى سنة 1102هـ، والإمام العلَّامة إبراهيم بن محمد شهاب الدين البرماوي المتوفَّى سنة 1106هـ، والشيخ حسن بن علي بن محمد الجبرتي -جد والد الجبرتي المؤرِّخ- وقد تُوفِّي سنة 1116هـ، والعلَّامة عبد الحي بن عبد الحقِّ الشرنبلالي المتوفِّى سنة 1117هـ.
وأيضًا نبغ في هذا العصر عددٌ كبيرٌ من العلماء والأدباء والشعراء، منهم: الشهاب الخفاجي المتوفَّى 1069هـ، والبديعي المتوفِّى عام 1073هـ، وعبد القادر البغدادي المتوفَّى عام 1093هـ صاحب خزانة الأدب، والسيِّد مرتضى الزبيدي (1145- 1205هـ) مؤلِّف تاج العروس، والصبَّان المتوفى عام 1206هـ، ومنهم المحيي (1061- 1111هـ) مؤلِّف خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، والشعراني المتصوِّف المتوفِّى عام 973هـ، وعبد الله الشبراوي المتوفِّى عام 1172هـ، وسواهم، وهؤلاء كانوا من غير شَكٍّ ممَّن أفادوا من الأزهر وتأثَّروا به.
ولقد تميَّز العهد العثماني بالنسبة إلى الأزهر أنَّ العثمانيِّين عيَّنوا رئيسًا للمشايخ بالأزهر وأطلقوا عليه (شيخ الجامع الأزهر)، وكان يُعتبر رئيسًا للعلماء الذين يُدرِّسون في صحن الجامع الشريف، وتعيَّن تبعًا لهذا النظام -كما هو مُجْمَعٌ عليه- الشيخ محمَّد الخرشي كأوَّل شيخٍ للجامع، وكانت مهمَّته الإشراف على سير الدراسة به وإدارته.
و في هذا العهد استمرَّ الأزهر مدى القرون الثلاثة التي حكم العثمانيُّون فيها مصر، يُجاهد لحفظ البقيَّة الباقية من اللغة العربيَّة والعلوم القرآنيَّة التي أصبحت في حالة ذبولٍ أو شبه جفاف، وكان له الفضل على كلِّ حالٍ في الإبقاء على ما بقي من التراث الإسلامي، لقد صار الأزهر أشهر الجوامع في التدريس على الإطلاق، وقصده طلاب العلم من كلِّ ناحيةٍ حتى تركستان والهند وزيلع وسنار، ولكلِّ طائفةٍ منهم رواق باسمهم كرواق الشوام أو المغاربة أو العجم أو الزيالعة أو اليمنيَّة أو الهنديَّة فضلًا عن أروقة الصعيد، وبلغ عدد تلاميذ الأزهر في أوائل القرن التاسع للهجرة أي نحو (818هـ) 750 طالبًا من طوائف مختلفة، وكانوا مقيمين في الجامع ومعهم صناديقهم وخزائنهم يتعلَّمون فيه الفقه والحديث والنحو والمنطق، وزادوا في عصر العثمانيِّين على ذلك زيادةً كبيرة، وفي كتاب التعليم العام في مصر ما يُفيد أنَّ العلوم التي كانت تُدرَّس غالبًا بالأزهر حتى منتصف القرن (التاسع الهجري= الخامس عشر الميلادي) هي الآداب والفقه والتوحيد، وكانت تُدرَّس أحيانًا بصفةٍ استثنائيَّةٍ علومُ الفلك، والعلوم الرياضيَّة، والعلوم الطبيعيَّة والتجريبيَّة، إجمالًا.
وكان الطالب إبَّان العهد العثماني ليلتحق بالأزهر لا بُدَّ وأن يكون قد تعلَّم في كُتَّاب القرية أو في المسجد بعض سور القرآن التي يحفظها عن ظهر قلب علاوةً على إجادته للقراءة والكتابة.
وكان التعليم فيه على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى يبدأ التلميذ فيها بتعلُّم الهجاء والقراءة والكتابة ويحفظ ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب، ليكون هذا الجزء المادَّة التي يستطيع أن يُطبِّق التلميذُ فيها عمليًّا ما أخذ من المعلومات النظريَّة في تعلُّمه قواعد الهجاء والكتابة، فيُطالب التلميذ بكتابة هذا الجزء وقراءته، ثم ينتقل من هذا الجزء إلى غيره كتابةً وقراءةً وحفظًا حتى يُتمَّ القرآن، وهذه أوَّل مراحل التعليم، ويكون التلميذ فيها قد تعلَّم القراءة والكتابة، وتستغرق هذه المرحلة من سنتين إلى ثلاث، ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية ويظلُّ تحت إشراف أستاذه، يُعطيه دروسًا في القراءة والكتابة، وموضوعات إنشائيَّة سهلة تتدرَّج فيها من السهولة إلى الصعوبة، متمشِّيًا في ذلك مع النموِّ العقلي للتلميذ، ويكون التلميذ في هذا السنِّ على أبواب دور المراهقة وكل ما استفاده من هذه البرامج تحصيله للقرآن الشريف؛ فالتلميذ يستطيع أن يستغلَّ ما حفظه منه في تعمير حياته الروحيَّة، وتلاوته تكون سلواه وأنيسه، ويتخيَّر من الآيات ما يتَّفق ونفسه فيستعملها في دعائه وعبادته وصلاته كلَّ يوم، وتكون قواه العقليَّة بهذا التمرين قد نشطت بوجهٍ ما، ويكون لسانه قد تقوَّم واكتسب اللهجة العربيَّة الفصحى، وأظهر ما يبدو في هذا الأسلوب التعليمي أنَّه لا يبدأ بتعليم القواعد والتعاريف والكلِّيَّات في اللغة إلَّا بعد أن يكون التلميذ قد تذوَّق هذه اللغة بنفسه، وتكوَّنت في عقله ملكةً وذوق، وأغلب المتعلِّمين كانوا يقفون عند هذا الحد، ويتخرَّجون في سنِّ الثانية عشرة، وبعضهم كان يخطو إلى المرحلة الثالثة، يدرسون فيها علوم الدين من فقهٍ وحديثٍ وتوحيد... إلخ، وفي الأحوال الاستثنائيَّة كان بعض الأفراد يدرسون العلوم الطبيعيَّة والرياضيَّة.
فالأزهر إبَّان العهد العثماني كان يحمل عبء الحفاظ على الثقافة الإسلاميَّة ونشرها طوال ثلاثة قرون، ولا سيَّما أنَّه كان قبلةَ كلِّ طالب علمٍ في العالم الإسلامي، ولولا وجود الجامع الأزهر وصموده لشتَّى التيَّارات، وإصراره بعزيمةٍ لا تلين على الدراسة داخل أروقته -على الرغم من قِصَرِ الدراسة به على العلوم الدينيَّة واللغويَّة- لكانت اللغة العربيَّة قد تعرَّضت لهزَّاتٍ فكريَّةٍ ضارية.
ومهما يكن من أمرٍ فالأزهر في كلِّ عصوره حتى حكم محمد علي كان مركز التعليم الذي تدور حوله الحركة العلميَّة في البلاد، ولهذا المركز الممتاز أدَّت هذه الجامعة خدمتين من أجلٍّ الخدمات التي لها أثرها الواضح في حياة مصر الاجتماعيَّة والسياسيَّة عامَّة:
الأولى: عمله على نشر اللغة العربيَّة وتوطيدها بالبلاد المصريَّة، وشدِّ أزرها ضدَّ اللغة القوميَّة التي غزاها الإسلام بلغته العربيَّة العريقة، والثانية: دعم أسس الديانة الإسلاميَّة ووقوفها سندًا للإسلام بكلِّ ما انبعث فيها من المجهودات العقليَّة والروحيَّة، وكان من آثار الأزهر فوق هذا أن جعل لمصر مكانةً ممتازةً وسلطانًا أدبيًّا على شعوب الشرق، وأصبحت البلاد الشرقيَّة تنظر إلى مصر نظرة الحائر إلى الهادي المرشد، وتعترف لها بالفضل والعلم.
موقع ذاكرة الأزهر