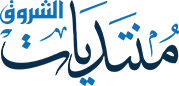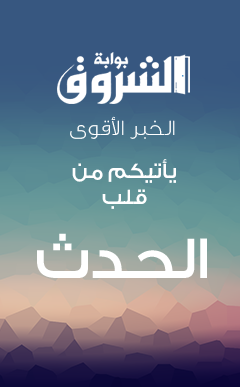تحذيرُ المسلمين مِن نَذْرِ القرابين لقُبُور الصّالحين بقلم : الشَّيخ سمير سمراد
17-02-2013, 08:17 PM
تحذيرُ المسلمين مِن نَذْرِ القرابين لقُبُور الصّالحين
بقلم :
خادم العلم
الشَّيخ سمير سمراد حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم :
خادم العلم
الشَّيخ سمير سمراد حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي المسلم!... يا مَن قطعتَ العهدَ على نفسِكَ وردَّدتَ في كلِّ صلاة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾[الفاتحة:5]، مُقِرًّا على نفسك أنّك تعبدُ الله ولا تعبدُ غيره، هذا هو التَّوحيدُ الّذي يرضاهُ الله تعالى منكَ، لا يُقرِّبُكَ منهُ سبحانه إلَّا أن تكونَ لهُ مُوَحِّدًا ، وعمَّا سواهُ من الخلقِ معرِضًا
مُقبلاً على التّوجُّه بأنواع العبادات إليه سبحانه، مائلاً عن أن تجعَلَ شيئًا منها لغيرِهِ، أو تتوجَّهَ ببعضِها لأحدٍ سواه، لا ينفعُ إلَّا أن تكونَ أفعالُ القُرْبَى وطَلَبُ الزُّلْفَى لواحدٍ، وهو اللهُ تعالى الّذي خلقكَ وحده وأنعمَ عليكَ وحدهُ، ومَنِ الخالقُ سواهُ؟! ومَنِ المُنعِمُ المُحسِنُ إن هو أمسكَ فضلَهُ ومنعَ إحسانَهُ جلَّ وعلا؟!
ومِن العبادات الّتي يجبُ أن نتوجَّهَ بها إلى الله تعالى وحدهُ: عبادةُ النَّذْر، وهو أن يُوجِبَ شخصٌ على نفسِهِ ما ليسَ واجبًا عليهِ، حينمَا يَحْدُثُ لهُ أَمْرٌ يُحبُّهُ مثلًا؛ فيلتزِمُ طاعةً من الطَّاعات كصدقةٍ وتبرُّعٍ يتبرَّعُ بِهِ، كأن يتصدَّقَ بمالِ كذا وكذا، أو يذبحَ كذا وكذا من غنمٍ أو بقرٍ، فيصيرُ ذلكَ واجبًا عليهِ الوفاءُ بهِ لازمًا لهُ.
ومن أمثلةِ ذلك: إنسانٌ كان قد أصابه خوفٌ فجاءهُ من الله تعالى فَرَجٌ وزال ما بهِ من خوفٍ، فنذرَ أن يتصدَّقَ بكذا من المال، صدقةً لله تعالى على ما كان من الأمن بعد الخوف.
ومن الأمثلة: إنسانٌ كان يرجو أن تُقضى له حاجةٌ تعسَّرت عليه وطالَ به الزَّمان لم تحصل لهُ، فجاءَه من اللهِ تعالى التَّيسيرُ وسَهُلَ من أمرِهِ ما عَسُرَ من قبل، فقال شُكرًا: لله عليَّ أن أذبحَ وأُطعمَ البائسَ الفقير.
ويُكرَّهُ لكَ - أيُّها المسلم! - أن تجعلَ نذرَكَ للهِ على سبيلِ المعاوضَةِ والمُجازاةِ؛ فتقولَ على سبيلِ الوَعْدِ: إن شفى اللهُ مريضي أونجَّاني من أمر كذا وكذا، فإنِّي أصومُ يومين أو أصلِّي صلاة أو أتصدَّق بكذا أو أذبحُ كذا، فهذا النَّذرُ المكروهُ المنهيُّ عنه [البخاريُّ(6608) ومسلم(1639)].
ولْتَعْلَمْ! أنَّ النَّذرَ المشروعَ لا يكونُ إلّا لله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: «لا نَذْرَ إلّا فيما يُبْتَغَى بهِ وجهُ الله تعالى»[رواه أبو داود(3275) بإسنادٍ حسنٍ]. فالنَّذر، أو هذا التَّبرُّع الموعودُ بِهِ ، مِثْلُهُ مِثْلُ الرُّكوع والسُّجود والذَّبح، فَمَنْ نَذَرَ لغير اللهِ كمَنْ ركع لغير الله وسجد لغيره وذبحَ لغيره، وهكذا.
وهذه فِعْلُها لغيرِ الله تعالى شِرْكٌ بالله، وهي أكبرُ الكبائر وأعظمُ المعاصي والمحرَّمات، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾[الأنعام:-162-163]، والنُّسُكُ: العبادةُ، وهذه الآيةُ من أدلَّةِ التَّوحيدِ.
* قال الشّيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفيّ (ت: 879هـ): «وأمّا النَّذْرُ الّذي ينذرونه أكثر العوامّ كأن يقول: يا سيّدي فلان ـ يعني به وليًّا من الأولياء أو نبيًّا من الأنبياء : إن رُدّ غائبي أو عُوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذّهب أو الفضّة أو الطّعام أو الشّراب أو الزّيت كذا، فهذا باطلٌ بالإجماع؛ لأنّه نذرٌ لمخلوقٍ، وهولا يجوز؛ لأنّه أي النّذر عبادةٌ فلا تكون لمخلوق، والمنذورُ له ميِّتٌ، والميت لا يملك، وإنّه إن ظنَّ أنّ الميّت يتصرّفُ في الأمور كَفَرَ» ا.هـ[«الفتاوى الخيرية»(1/20)].
حالةُ أكثَرِ العوامِّ مع النَّذْر:
صار لأكثرِ العامَّة - للأسفِ! - افْتِتَانٌ بالأولياء الأموات وتعلُّقٌ شديدٌ بقبورهم وتعظيمٌ وتقديسٌ لأضرحتهم وقبابهم، فصاروا يبعثون إلى عَتَبَاتِهِمْ بالهدايا والذَّبائح، ويَسُوقُونَ إلى مَزَارَاتِهِمْ وزَوَايَاهُمْ ما يتخيَّرونه ويُعيِّنونَهُ قربانًا من البهائم والحيوانات كالبقر، وكلُّ ذلك ضلالٌ في الدِّين، وطَمْسٌ لمعالمِ التَّوحيد، ومشابهةٌ للمشركين والجاهليِّين الأوَّلين.
ماذا تعلمُ عن أعمال المشرِكين الأوَّلين وصنائعِ الجاهليِّين؟!:
اعلم أخي المسلم!...أنَّ الجاهليَّة الأولى والمشركين الأوَّلين كانوا يَسُوقُون القَرَابِين من الحيوانات إلى أنصابهم وأصنامهم وأوثانهم ويذبحونها عندها، وبجوارِها لأجلِها؛ تعظيمًا لها، قال تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾، وقال تعالى:﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾[المائدة:3].
* قال البَغَويُّ –رحمه الله- في «تفسيره»(3/11): «قال مجاهدٌ وقتادة: كانت حول البيت ثلاثمائة وستّون حجرًا منصوبةً، كان أهل الجاهليّة يعبدونها ويُعظِّمونها ويَذبحون لها»اهـ.
* وقال الكلبيُّ –رحمه الله- (ت:146هـ) في «كتاب الأصنام»(ص11): «وكان لحِمْيَر أيضًا بيتٌ بصنعاء يقال له «رِيام»، يُعظِّمونه ويتقرّبون عنده بالذّبائح».
وقال عن صنم (مناة) (ص13): «وكانت العرب جميعًا تعظِّمه وتذبحُ حوله. وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من المواضع يعظِّمونه ويذبحون له ويُهدون له»اهـ.
وقال(ص18و20) عن صنم (العُزَّى): «وكانت أعظم الأصنام عند قريش وكانوا يزورونها ويُهْدُونَ لها ويتقرَّبون عندها بالذّبح...وكان لها مَنْحَرٌ ينحرون فيه هَدَايَاهَا...فكانوا يقسمون لحوم هداياهم فيمَنْ حَضَرَهَا وكان عِنْدَهَا»اهـ.
وقال(ص29) عن صنَمَي (إساف ونائلة): «فكانوا ينحرون ويذبحون عندهما»اهـ.
وقال(ص34): «وكانوا يسمُّون ذبائح الغنم الّتي يذبحون عند أصنامهم وأنصابهم تلك (العتائر)، والعَتيرة في كلام العرب الذَّبيحة»اهـ.
وكانُوا يُعيِّنُونَ هذه الأنعام من الإبل والبقر والغنم ويُسمُّونها لطواغيتِهم وينسبونها إليهم، قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَوَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾[المائدة:103].
جاء في تفسير البحيرة عدَّةُ معانٍ منها: أنّها تُتْرَك ولا تُطْرَد من مَرعى ولا مَوْرِدِ ماء، وجاء في تفسير السَّائبة عدَّةُ معانٍ هِيَ أفعال الجاهليِّن.
منها: «كان الرّجلُ إذا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أو نَذَرَ نَذْرًا أو شَكَرَ نِعْمَةً سَيَّبَ بعيرًا فكان بمنزلة البحيرة»[«البحر المحيط» لأبي حيّان الأندلسيّ(4/33)].
ومنها: «كان الرَّجلُ يُسَيِّبُ مِنْ مالِهِ شيئًا فيجيءُ بِهِ إلى السَّدَّنَةِ وهُمْ خَدَمُ آلهتهم فيُطعمون من لبنها للسَّبِيل» [المصدر السَّابق].
ومنها: «أنَّ الرَّجل من أهل الجاهليَّة كان إذا مرض وغاب له قريب نَذَرَ؛ فقال: إن شفاني الله تعالى أو شُفِيَ مريضي أو عاد غائبي، فناقتي هذه سائبة، ثمَّ يُسيِّبُها فلا تُحبس عن رَعْيٍ ولا ماءٍ ولا يركبها أحدٌ، فكانت بمنزلة البحيرة»[«تفسير البغويّ»(3/107)].
ومنها: «كان الرّجل منهم إذا قُضِيَت حاجَتُهُ سَيَّبَ مِنْ مالِهِ ناقةً أو غيرها لطواغيتهم وأوثانهم»[«تفسير المنار»(7/170)].
ومنها: «ما تُرِكَ لآلهتهم، فكان الرَّجُلُ يجيءُ بماشيته إلى السَّدَنَة فيترُكُهُ عندهم ويُسَبِّلُ لَبَنَهُ»[«اللُّباب في علوم الكتاب» لابن عادل الدّمشقي(7/553)].
فهذه أفعالُ الجاهليَّة الّتي كانوا يلتزمونها، وينذرونها لآلهتهم، وهذا عملُهم الَّذي كانوا يعملونه، وهذا ما ابتدعوه وشَرَعُوهُ لأنفسهم دون أن يشرعه الله لهم، وغَيَّروا به دينَ إبراهيم وإسماعيلَ عليهما السَّلام، ولمَّا نزلَ القرآنُ بالإنكار عليهم: ﴿قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا﴾[المائدة:104]، قال تعالى ردًّا عليهم: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾، قال ابن الجوزي –رحمه الله- في «تفسيره»(2/440): «﴿قَالُوا حَسْبُنَا﴾ أي يكفينا ﴿مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا﴾ من الدِّين والمنهاج ﴿أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ من الدِّين ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ لهُ، أيتبعونهم في خطئهم؟»اهـ.
ماذا يُريدون بسَوْقِ البقر وغيرها من الحيوان إلى صاحب القبر أو صاحب الزَّاوية؟:
إنّهم يُريدون تَعظيمَهُ وإِكْرَامَهُ بمثل هذا الفعل، ولا نظنُّك - أخي المسلم! - قَدْ نَسِيتَ أنَّ أهل الجاهليَّة أيضًا أرادوا تعظيمَ آلهتهم بتلكم النُّذور، وعاملوها بتلك المعاملات الّتي نزَّلوها منزلةَ الشَّرع الّذي يُلْتَزَم، وما هي ممَّا شرعه الله، بل هي ممَّا غيَّروا به الحنيفيَّةَ ملَّةَ إبراهيم، فأدخلوا فيها من الابتداعات الّتي صيَّرتْها وثنيَّةً لا حنيفيَّة.
ابتداعاتٌ غيَّرَتْ معالمَ الشَّريعة:
ابتداعات الجاهليَّة من سَوْقِ قرابين الحيوان من البقر وغيرها إلى آلهتهم لأجل التَّعظيم، قد ضاهَوْا بها تعظيمَ الكعبةِ البيتِ الحرام، فأرادُوا أن يجعلوا هذه من تلك، والفرقُ أنَّ تعظيمَ الكعبةِ مِن شرعِ الله تعالى ووحْيِهِ وأمْرِهِ، وتلكَ مِن شَرْعِهِمْ لأنفسهم ومن أَمْرِ الشَّيطانِ لهم ومن كذبهم على الله تعالى في نسبةِ أعمالهم لأمرِهِ تعالى.
ولا يُفيدُ أن يَقولوا: (إنَّ نيَّتَنَا صالحةٌ! وما أَرَدْنَا إلَّا الخير!)، لأنَّا نقولُ لهم: كذلكَ أهلُ الجاهليَّةِ ما أرادوا بأفعالهم شرًّا بل قصدُوا خيرًا وتقرُّبًا إلى الله تعالى! لكنَّهم ضلُّوا ضلالًا بعيدًا بابتِداعهم، وقد جاء في بعض الأخبار أنّهم ما فعلُوا ذلك إلَّا مِنْ شِدَّة تعلّقهم بالكعبة وتعظيمهم لها، فاتَّخذوا أصنامًا يُعاملونها مُعاملةَ الكعبةِ المعظَّمة مِنَ التّمسُّح بها والطّواف حولها وتقديم الهدايا والزِّيارة لها[«كتاب الأصنام» لابن الكلبي (ص6و33)].
سَوْقُ البقر وغيرها من الهدايا من خصائصِ الكعبةِ المعظَّمة:
اعلم أيُّها المسلم!...أنّه ليس هناك بُقْعَةٌ تُعَظَّم بسَوْقِ البقر وغيرها ممَّا يُهْدَى ويُقدَّمُ قُرْبَانًا إلَّا الكعبةُ المعظَّمة، فمَنْ قَصَدَ تعظيمَ بقعةٍ أو مكانٍ بمثلِ هذه المعاملة من سَوْقِ بقرةٍ إليه ليذبحها فيه أو يُقَسِّمَ لحمها على قاصدي تلك البقعة وزائريها، فعَمَلُهُ ونَذْرُهُ باطلٌ.
* قال الإمام مالك –رحمه الله- في «المدوَّنة»(2/21): «سَوْقُ البُدْنِ إلى غير مكَّة من الضَّلال».
* وذكر الدّسوقي –رحمه الله- (ت:1230هـ) أنَّ مَنْ نَذَرَ (بَعْثَ واسْتِصْحَابَ) حيوانٍ؛ كعِجْلٍ أو خروف لغير مكَّة فهو ضلالٌ، قال: «وكذا بَعْثُ لَحْمِهِ من الضّلال أيضًا»[«حاشية الدّسوقي على الشَّرح الكبير» (2/471)].
* وذَكَرَ الدّردير -رحمه الله- (ت:1201هـ) أنَّ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً يُهْدِيهَا لقَبْرِ الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام أو قَبْرِ وَليٍّ، أنّه يُمْنَعُ ويُمْنَعُ بَعْثُهُ ولو قصدَ الفقراءَ الحاضرين عند القبر، قال: «لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ مَعَالِمِ الشَّريعة»[«الشَّرح الكبير على مختصر خليل»(2/471)].
* قال شَيْخُ المالكيَّة في العراق: أبو بكر الأبهري –رحمه الله- (ت: 375هـ):«لا يجوز أن يُعَظَّم موضعٌ بسَوْقِ البُدْنِ إليه، فيُشْبِهُ ذلك مكّة»، وقال: «ولا يجوز سَوْقها إلى البلد الّذي نذر نحرها فيه، لأنّه لا يجوزُ سَوْق هديٍ إلى غير مكّة، من قِبَلِ أنّه لا يجوز تعظيمُ غير الكعبة كتعظيم الكعبة، وفي سَوْق الهدي إلى غيرها تعظيمٌ لغيرها، وقد قال الله سبحانه: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾[المائدة:95] وقال تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[الحج:33]فلا يجوز نَقْلُ هَدْيٍ مِنْ موضعٍ إلى موضعٍ غيرِ الكعبة لهذه الدّلالة» اهـ [«شرح الأبهري على المختصر الكبير لعبد الله بن عبد الحكم»(مخطوط المكتبة الأزهرية- مصر)/الجزء12/الورقة70/الوجه(أ) والجزء السابع/الورقة: 107/الوجه(ب)].
تحذيرٌ من مشابهة المشركين في أفعالهم:
تَدَبَّر أخي المسلم!... وتَفَكَّرْ، وقَارِنْ بين أحوالِ الكثير مِن قومِنَا وأحوالِ وصنائعِ مَن مضى من المشركين الأوّلين، فهل ما يقوم به كثيرٌ (منَّا)! من التّقرُّبِ بنذور البقر أو العُجُول أو الخرفان إلى صاحب القبر ومن بُنِيَت الزّاويةُ باسمِهِ، هل ذلكَ إلاّ كما صنعت الجاهليَّة بأصنامها وتعاملت به مع أوثانها؟
واجبٌ عليك أيُّها المسلم! أن تبتعد عن أعمال المشركين وأن تكون مُبَايِنًا لهم، امتثالًا لقول الله تعالى لنبيِّه صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِوَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾[يوسف:108].
* قال الإمام ابن باديس –رحمه الله- (ت: 1940م) في تفسيرِ هذه الآيةِ مُؤَكِّدًا على: «البُعْدِ عن الشِّركِ بجميع ِوجوهِهِ وصُوَرِهِ جَلِيَّةً وخَفِيَّةً»، ومُؤكِّدًا: «أَمْرَ مُبَايَنَةِ المشركين» «في جميع مظاهر شركهم، حتَّى في صورة القول...أو في صورة الفعل؛ كَأَنْ يَسُوقَ بقرةً أو شاةً مثلًا إلى ضريحٍ من الأضرحة، فإنَّه ضلالٌ كما قاله الشَّيخ الدّردير في باب النّذر، فضلًا عن عقائدهم..»إلخ [«تفسير ابن باديس =مجالس التّذكير»(ص64)/مطبوعات وزارة الشؤون الدينيّة – الجزائر/الطبعة الأولى: 1982م].
* وقال عند شرحِ حديث ثَوْبَان –رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بالمشركين وَحَتَّى يَعْبُدُوا الأَوْثَانَ ...»[رواه أبو داود(4254) والترمذيّ (2219)]:
تحت عنوان «اللُّحوق بالمشركين»: «مَن اعتقد مثلَ عقيدتهم أو فَعَلَ مثلَ أفعالهم أو قال مثل أقوالهم فقد لَحِقَ بِهِمْ... »، وقال: «مِن أعمال المشركين في الجاهلية أنَّهم يسوقون الأنعام لطواغيتهم فينحرونها عندها طالبين رضاها ومعونتها. وفي النَّاس اليومَ طوائفُ كثيرةٌ تَسُوقُ الأنعام إلى الأضرحة وللمقامات تنحرها عندها إرضاءً لها و طلبًا لمعونتها أو جزاءً على تصرُّفها وما جَلَبَتْ مِن نفعٍ أو دَفَعَتْ مِن ضُرٍّ»اهـ[«آثار الإمام ابن باديس= مجالس التّذكير»(2/96)/مطبوعات وزارة الشؤون الدّينيَّة –الجزائر/الطبعة الأولى: 1983م].
* وقال الشّيخ بلقاسم بن ارْوَاق –رحمه الله- (ت: 1993م) بعد أن ذكر كلامَ الإمام مالك –رحمه الله- في أن يكون النّذر ممّا يُطاعُ اللهُ تعالى بهِ: «هذا حُكْمُ الإمامِ مالكٍ في النُّذور الّذي نَزْعُمُ اتِّبَاعَهُ، وأين هذا ممّا يفعله أدعياء اليوم من سوقهم النّذور والهدايا إلى الأضرحة البعيدة، وإِرَاقَةِ دَمِهَا بين القبور تَزَلُّفًا لأهلها وتَقَرُّبًا لهم من دون الله، ثمَّ بعد هذا كلِّه «أُكْلَةٌ شعبيَّة» وعملُ برٍّ وخيرٍ رُغمَ الإسلام ورغمَ تعاليمه، اللّهمّ إنّ هذا بهتانٌ كبير»اهـ.
* وقال الشَّيخ عمر بن البسكري-رحمه الله- (ت: 1968م) جوابًا عمّن اعترض بقوله: «نحن مالكيَّة لا نريدُ إلاّ مذهب الإمام مالك بن أنس –رحمه الله-»!: «تُرِيدُونَ مذهبَ مالكٍ فما أعظمها سعادة لو تبعتم لنا مذهبَ مالك، مالكٌ –رحمه الله- يقول: سَوْقُ الهدايا لغير مكّة ضلالٌ، وأنتم تسوقونها وتنحرونها عند قبور الصَّالحين...»[مجلَّةُ «الشِّهاب»، جزء صفر1352هـ، (ص271)]
إجاباتٌ عن شُبُهَاتٍ:
سيقول بعض النّاس إنّ هذه عاداتنا وميراثُ آبائنا وأجدادنا، وأنتم تريدون إحداث البلابل والقلاقل بهذا الوطن، بمحاربتكم عوائد وتقاليد المسلمين وإرادَتِكُمْ هَدْمَهَا.
والجوابُ:
أنّ العادات والتّقاليد إن كانت صالحةً، فمن ذا الّذي يُنكرُ الأخذَ بها والاستمرارَ فيها؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنّما بُعِثت لأُتَمِّمَ مكارم الأخلاق. أو قال: صَالِحَ الأخلاق»[البخاريُّ في «الأدب المفرد»(273) وغيرُهُ]. وإن كانت هذه العاداتُ والتّقاليدُ تُصادمُ الدِّين وتعودُ بالنَّقضِ على أحكامِ الملَّةِ والشَّرع المُبين، لا سيَّما الأصول والقطعيَّات كمسائل التَّوحيد، فإنَّها باطلةٌ مردودةٌ، ولا ينبغي لأحدٍ أن يَدَعَ حُجَجَ الشَّرع ويتنكَّبَها بعد إذْ تَبَيَّنَتْ له، وما أَهْلَكَ المشركين الأوَّلين وفيهم مِن قرابات النّبيِّ الكريم صلى الله عليه وسلم وأرحامِهِ إلاّ هذه السّبيلُ الخاسرة والحُجَّةُ الدَّاحضة، فقالوا: قد كان على هذا الدِّين آباؤنا وأجدادنا وأشياخنا ولا سبيل لنا إلى مخالفتهم وتركِ دينهم، مع أنّ حججَ القرآن كانت عليهم تَتْرَى، فسمِعُوهَا وما سَمِعُوهَا حيثُ أَغْرَقُوا أنفسهم في ضلالات التَّقليد، فَأَهْوَتْ بهم في مكانٍ سحيقٍ.
سيقول بعض النّاس إنّنا لم نَسُقْ البقرةَ أو العِجْلَ تقرّبًا إلى صاحب القبر، بل نحنُ نتقرَّبُ إلى الله تعالى.
والجوابُ: ليس بصحيحٍ، بل قصْدُكُم ومُرَادُكُمْ صاحبَ القبر، والقرائنُ الكثيرةُ تُفصحُ عن نيّتكم والكامنِ في أنفسكم، وذلك: أنّ هذه البقرة أو العِجْل تنسبونه إلى الشّيخ الميِّت صاحب الزّاوية، وتُعيِّنونها لهُ، وتذكُرُون اسمَهُ قائلين: «هذا العِجْلُ لكَ يا شيخ فلان»، «هذه ذبيحتُكَ يا شيخ فلان»، هذا ما تريدونهُ وتقصدونه قد ظهر على لسانكم، وكونُكُمْ تذكرون اسمَ الله عليها عند الذَّبح لا يجعلُها لله.
(2) أنتم تفعلون هذا الفعل من سَوْقِهَا والدَّوَرَانِ بها عند قبره وفي جِوَارِهِ، ولا تَرْضَوْنَ لها مكانًا آخر.
(3) إن حصل لكم خيرٌ وفاضت عليكم أرزاقٌ، قُلتم: ذلك حصلَ ببركة الشّيخ، وهو أثرٌ من آثار النَّذْرِ الّذي نَذَرْنَاهُ لَهُ، وقلتُم: إنّ سببَ قضاءِ حاجتِكُمْ هو هذا النَّذر، وترَوْنَ أنّ مَنْ مَنَع ذلك هَلَك....إلخ.
ثمَّ نقول لهذا الّذي يدَّعي ادِّعاءً إنَّهُ لا يقصدُ بالذَّبح لهم والنّذر عليهم عبادَتَهُمْ:
كلَّا! بل الذّبح والنَّذر: عبادتان من جملة العباداتِ الّتي ثَبَتَتْ شرعًا، ولا عبرةَ بادِّعائك سواءٌ اعترفت أو لم تعترف بذلك، فالمعتبَرُ حكمُ الشَّرعِ لا ادِّعاؤُكَ جهلًا منكَ أو عِنادًا.
وسيقولُ بعضُ النّاس نحنُ لا نعتقدُ أنّ سيدي الشّيخ له تأثيرٌ ولا نعتقدُ أنّ حصولَ ما نطلُبُ بتصرّفِهِ، وإنّما التَّأثيرُ بالنّفعِ لله ربِّ العالمين لا للشَّيخ.
والجوابُ:
* قال الشّيخ محمّد يحيى الولاّتي الشّنقيطيّ –رحمه الله- (ت: 1912م): «قلنا لهم: مِعْيَارُ ذلك أن تذبحوا في بيوتكم وتتصدّقوا بلحم الذّبيحة وتَنْوُوا ثَوَابَ الصّدقة لأنفسكم أو لوالِدِيكم وتتوسَّلون إلى اللهِ تعالى في قضاءِ حوائجكم بعملكم الصّالح هذا، الّذي هو الصَّدقةُ المذكورة....فلو كنتُم لا تعتقدُون التَّأثيرَ في الوليِّ لَمَا أتعَبْتُمْ أنفسكم في سَوْقِ الذَّبيحةِ إلى قبرِهِ، فلولا اعتقادُكُم التَّأثيرَ فيهِ ما سُقْتُمُوهَا إليهِ، بل ولا خصَصْتُمُوهُ بها»[«رحلة محمّد يحيى الولاتي»(ص328)].
* وقال: «ومِن علامةِ أنّهم يعتقدون التَّأثيرَ بالنّفع والضّرّ في أصحاب القبور أنّهم...يفرحون لمن يقولُ لهم: الوليّ سيدي فلان لا يَذْبَحُ أحدٌ على قبرِهِ لحاجةٍ إلاّ قُضِيَتْ، ولا مريضٍ إلاّ بَرِئ، ولا مكروبٍ إلاّ فُرج عنه، فيستَبْشِرُون ويَهُشُّون لصاحبِ هذا الكلامِ الباطل»[المصدر السَّابق(ص330)].
ونقولُ لمن يدَّعي أنَّهُ إنَّما ذبحَ ونذَرَ البقرةَ أو العِجْلَ لله تعالى لا للمخلوق: لأَيِّ معنًى صنعتَ هذا الصَّنيع، وعملتَ ما عملتَ عند القبر وفي جوارِهِ؟...إذا كنتَ تذبحُ لله، فلأيِّ معنًى جعلتَ ذلك للميِّت وحَمَلْتَهُ إلى قبره؟
* قال الشّيخ محمّد يحيى بن المختار الولّاتي الشّنقيطي –رحمه الله-: «إذا قلتَ لأحدهم: إن كنتَ لا تقصدُ إلاّ التّقرّب إلى الله تعالى بذبيحتِك على قبر الوليِّ فُلان فاذبَحْهَا في بيتِكَ على اسمِ الله فقط، وتصدَّقْ بلحمها على المساكين، فإنَّهُ لا يُساعدك في ذلكَ أبدًا، ولا يقبل إلاّ ذبحها عند القبر»[«رحلة محمّد يحيى الولاّتي»(ص327)].
* نَقَلَ ابنُ حجر الهيتميّ الشّافعيّ –رحمه الله- في«الفتاوى الفقهيّة الكبرى»( 4/268): «قولَ الأذرعيّ الشّافعيّ[ت:783هـ] في النَّذْرِ للمَشاهِد على قبرِ وليٍّ أو نحوه: مِنْ أنّ النَّاذِرَ إن قَصَدَ تعظيمَ البُقْعَة أو القبر، أو التّقرّبَ إلى مَنْ دُفِنَ فيها أو مَنْ تُنْسَبُ إليه وهو الغالب من العامّة؛ لأنّهم يعتقدون أنّ لهذه الأماكن خصوصيّات لأنفسهم [في مصدرٍ آخر: لا تُفْهَم]، ويَرَوْنَ أنَّ النَّذْرَ لها ممّا يندفعُ به البلاء، فلا يصحُّ النَّذْرُ في صورةٍ من هذه الصُّور؛ لأنَّهُ لم يقصد به التّقرُّبَ إلى الله سبحانه وتعالى...»اهـ.
* ولذلكَ لمّا قال بعضُ فقهاء الشّافعيَّة بأنَّ النَّذْرَ لقبرٍ معروفٍ في ناحيتهم صحيحٌ، ردَّ عليه الأذرعيُّ –رحمه الله- بقوله: «هذا كَلَامُ مَضَلَّةٍ»[نَقَلَهُ ابنُ حجر في المصدر السَّابق(4/286)]؛ أي مُوقِعٌ للنَّاسِ في الضَّلال.
سيقول بعضُ النّاس ـ مُصِرًّا على أنَّهم ما أرادوا التّقرُّبَ إلى صاحب القبر ـ: نحنُ إنّما قصدنا إحياءَ ذِكْرَى الشَّيخِ الصّالحِ، الّذي كان بيتُهُ وزاويتُهُ مأوًى لعابِرِ السَّبيل وفيه إقْرَاءُ الضَّيْف وإطعامُ الطّعام وجَمْعُ النّاس على الذِّكر وتلاوةِ القرآن.
والجوابُ:
قال صلى الله عليه وسلم: «لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا...»[رواه أحمد (8804) وأبو داود(2044) بإسنادٍ حسنٍ].
وهذا الموسم الّذي تُقيمُهُ الزّاوية هو الّذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ومعنى اتّخاذِهِ عيدًا: أن يُزَارَ زيارةً مُؤقَّتةً تجتمعُ لها النَّاس.
وقال صلى الله عليه وسلم: «لَا عَقْرَ في الإسلام»[رواه أبو داود (3224) في (باب كراهية الذَّبح عند القبر)].
قال عبد الرّزّاق –رحمه الله- (ت: 211هـ): «كانوا يَعْقِرُونَ عند القبر بقرةً أو شاةً»اهـ.
* قال الخطّابيُّ –رحمه الله- (ت388هـ): «كان أهلُ الجاهليّة يَعْقِرُون الإبل على قبرِ الرَّجل الجَوَاد، يقولون: نُجازِيهِ على فِعْلِهِ؛ لأنّه كان يعقرها في حياته فيُطعِمُهَا الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السِّباع والطَّير، فيكونُ مُطْعِمًا بعد مماته كما كان مُطْعِمًا في حياته»اهـ[«معالم السُّنن»( )].
* وقال أحمد بن حجر الهيتميّ –رحمه الله- (ت: 974هـ) في كتابِهِ «فتح الجواد بشرح الإرشاد»[ط. البابي الحلبي بمصر، 1347هـ](1/184): «والذَّبح والعَقْرُ عند القبر مَذْمُومٌ للنَّهيِ عنه»اهـ.
* وقال الشَّيخ محمّد يحيى الولاتي الشنقيطي –رحمه الله-: «قد كان من سُنّة الجاهليّة الذّبحُ على القبور وحرَّمَهُ الله تعالى على لسانِ نبيِّه محمّدٍ صلى الله عليه وسلم كما حَرَّمَ الذَّبْحَ على النُّصُب أي الأصنام»[«رحلة محمد يحيى الولاتي»(ص326)].
فهل أعيادُ الزّاوية والمواسم الّتي تُقامُ عند قبر صاحبها إلاّ مشابهةٌ في المعنى لعَتِيرَةِ (ذبيحةِ) الجاهليَّة وعَقْرِهَا عند قبورِ سَادَتِها؟
وأخيرًا: أخي المسلم!...قد بَانَ لكَ أنَّ النَّذرَ لقبورِ الصَّالحين وسَوْقَ الهدايا إليها والذَّبحَ عليها داخلٌ في عُمُومِ الشِّرْكِ ـ أعاذنا اللهُ منهُ ـ، فاحْذَرْ! أن تكونَ ممَّن قالَ اللهُ تعالى فيهم: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾[يوسف:106]
مُقبلاً على التّوجُّه بأنواع العبادات إليه سبحانه، مائلاً عن أن تجعَلَ شيئًا منها لغيرِهِ، أو تتوجَّهَ ببعضِها لأحدٍ سواه، لا ينفعُ إلَّا أن تكونَ أفعالُ القُرْبَى وطَلَبُ الزُّلْفَى لواحدٍ، وهو اللهُ تعالى الّذي خلقكَ وحده وأنعمَ عليكَ وحدهُ، ومَنِ الخالقُ سواهُ؟! ومَنِ المُنعِمُ المُحسِنُ إن هو أمسكَ فضلَهُ ومنعَ إحسانَهُ جلَّ وعلا؟!
ومِن العبادات الّتي يجبُ أن نتوجَّهَ بها إلى الله تعالى وحدهُ: عبادةُ النَّذْر، وهو أن يُوجِبَ شخصٌ على نفسِهِ ما ليسَ واجبًا عليهِ، حينمَا يَحْدُثُ لهُ أَمْرٌ يُحبُّهُ مثلًا؛ فيلتزِمُ طاعةً من الطَّاعات كصدقةٍ وتبرُّعٍ يتبرَّعُ بِهِ، كأن يتصدَّقَ بمالِ كذا وكذا، أو يذبحَ كذا وكذا من غنمٍ أو بقرٍ، فيصيرُ ذلكَ واجبًا عليهِ الوفاءُ بهِ لازمًا لهُ.
ومن أمثلةِ ذلك: إنسانٌ كان قد أصابه خوفٌ فجاءهُ من الله تعالى فَرَجٌ وزال ما بهِ من خوفٍ، فنذرَ أن يتصدَّقَ بكذا من المال، صدقةً لله تعالى على ما كان من الأمن بعد الخوف.
ومن الأمثلة: إنسانٌ كان يرجو أن تُقضى له حاجةٌ تعسَّرت عليه وطالَ به الزَّمان لم تحصل لهُ، فجاءَه من اللهِ تعالى التَّيسيرُ وسَهُلَ من أمرِهِ ما عَسُرَ من قبل، فقال شُكرًا: لله عليَّ أن أذبحَ وأُطعمَ البائسَ الفقير.
ويُكرَّهُ لكَ - أيُّها المسلم! - أن تجعلَ نذرَكَ للهِ على سبيلِ المعاوضَةِ والمُجازاةِ؛ فتقولَ على سبيلِ الوَعْدِ: إن شفى اللهُ مريضي أونجَّاني من أمر كذا وكذا، فإنِّي أصومُ يومين أو أصلِّي صلاة أو أتصدَّق بكذا أو أذبحُ كذا، فهذا النَّذرُ المكروهُ المنهيُّ عنه [البخاريُّ(6608) ومسلم(1639)].
ولْتَعْلَمْ! أنَّ النَّذرَ المشروعَ لا يكونُ إلّا لله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: «لا نَذْرَ إلّا فيما يُبْتَغَى بهِ وجهُ الله تعالى»[رواه أبو داود(3275) بإسنادٍ حسنٍ]. فالنَّذر، أو هذا التَّبرُّع الموعودُ بِهِ ، مِثْلُهُ مِثْلُ الرُّكوع والسُّجود والذَّبح، فَمَنْ نَذَرَ لغير اللهِ كمَنْ ركع لغير الله وسجد لغيره وذبحَ لغيره، وهكذا.
وهذه فِعْلُها لغيرِ الله تعالى شِرْكٌ بالله، وهي أكبرُ الكبائر وأعظمُ المعاصي والمحرَّمات، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾[الأنعام:-162-163]، والنُّسُكُ: العبادةُ، وهذه الآيةُ من أدلَّةِ التَّوحيدِ.
* قال الشّيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفيّ (ت: 879هـ): «وأمّا النَّذْرُ الّذي ينذرونه أكثر العوامّ كأن يقول: يا سيّدي فلان ـ يعني به وليًّا من الأولياء أو نبيًّا من الأنبياء : إن رُدّ غائبي أو عُوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذّهب أو الفضّة أو الطّعام أو الشّراب أو الزّيت كذا، فهذا باطلٌ بالإجماع؛ لأنّه نذرٌ لمخلوقٍ، وهولا يجوز؛ لأنّه أي النّذر عبادةٌ فلا تكون لمخلوق، والمنذورُ له ميِّتٌ، والميت لا يملك، وإنّه إن ظنَّ أنّ الميّت يتصرّفُ في الأمور كَفَرَ» ا.هـ[«الفتاوى الخيرية»(1/20)].
حالةُ أكثَرِ العوامِّ مع النَّذْر:
صار لأكثرِ العامَّة - للأسفِ! - افْتِتَانٌ بالأولياء الأموات وتعلُّقٌ شديدٌ بقبورهم وتعظيمٌ وتقديسٌ لأضرحتهم وقبابهم، فصاروا يبعثون إلى عَتَبَاتِهِمْ بالهدايا والذَّبائح، ويَسُوقُونَ إلى مَزَارَاتِهِمْ وزَوَايَاهُمْ ما يتخيَّرونه ويُعيِّنونَهُ قربانًا من البهائم والحيوانات كالبقر، وكلُّ ذلك ضلالٌ في الدِّين، وطَمْسٌ لمعالمِ التَّوحيد، ومشابهةٌ للمشركين والجاهليِّين الأوَّلين.
ماذا تعلمُ عن أعمال المشرِكين الأوَّلين وصنائعِ الجاهليِّين؟!:
اعلم أخي المسلم!...أنَّ الجاهليَّة الأولى والمشركين الأوَّلين كانوا يَسُوقُون القَرَابِين من الحيوانات إلى أنصابهم وأصنامهم وأوثانهم ويذبحونها عندها، وبجوارِها لأجلِها؛ تعظيمًا لها، قال تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾، وقال تعالى:﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾[المائدة:3].
* قال البَغَويُّ –رحمه الله- في «تفسيره»(3/11): «قال مجاهدٌ وقتادة: كانت حول البيت ثلاثمائة وستّون حجرًا منصوبةً، كان أهل الجاهليّة يعبدونها ويُعظِّمونها ويَذبحون لها»اهـ.
* وقال الكلبيُّ –رحمه الله- (ت:146هـ) في «كتاب الأصنام»(ص11): «وكان لحِمْيَر أيضًا بيتٌ بصنعاء يقال له «رِيام»، يُعظِّمونه ويتقرّبون عنده بالذّبائح».
وقال عن صنم (مناة) (ص13): «وكانت العرب جميعًا تعظِّمه وتذبحُ حوله. وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من المواضع يعظِّمونه ويذبحون له ويُهدون له»اهـ.
وقال(ص18و20) عن صنم (العُزَّى): «وكانت أعظم الأصنام عند قريش وكانوا يزورونها ويُهْدُونَ لها ويتقرَّبون عندها بالذّبح...وكان لها مَنْحَرٌ ينحرون فيه هَدَايَاهَا...فكانوا يقسمون لحوم هداياهم فيمَنْ حَضَرَهَا وكان عِنْدَهَا»اهـ.
وقال(ص29) عن صنَمَي (إساف ونائلة): «فكانوا ينحرون ويذبحون عندهما»اهـ.
وقال(ص34): «وكانوا يسمُّون ذبائح الغنم الّتي يذبحون عند أصنامهم وأنصابهم تلك (العتائر)، والعَتيرة في كلام العرب الذَّبيحة»اهـ.
وكانُوا يُعيِّنُونَ هذه الأنعام من الإبل والبقر والغنم ويُسمُّونها لطواغيتِهم وينسبونها إليهم، قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَوَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾[المائدة:103].
جاء في تفسير البحيرة عدَّةُ معانٍ منها: أنّها تُتْرَك ولا تُطْرَد من مَرعى ولا مَوْرِدِ ماء، وجاء في تفسير السَّائبة عدَّةُ معانٍ هِيَ أفعال الجاهليِّن.
منها: «كان الرّجلُ إذا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أو نَذَرَ نَذْرًا أو شَكَرَ نِعْمَةً سَيَّبَ بعيرًا فكان بمنزلة البحيرة»[«البحر المحيط» لأبي حيّان الأندلسيّ(4/33)].
ومنها: «كان الرَّجلُ يُسَيِّبُ مِنْ مالِهِ شيئًا فيجيءُ بِهِ إلى السَّدَّنَةِ وهُمْ خَدَمُ آلهتهم فيُطعمون من لبنها للسَّبِيل» [المصدر السَّابق].
ومنها: «أنَّ الرَّجل من أهل الجاهليَّة كان إذا مرض وغاب له قريب نَذَرَ؛ فقال: إن شفاني الله تعالى أو شُفِيَ مريضي أو عاد غائبي، فناقتي هذه سائبة، ثمَّ يُسيِّبُها فلا تُحبس عن رَعْيٍ ولا ماءٍ ولا يركبها أحدٌ، فكانت بمنزلة البحيرة»[«تفسير البغويّ»(3/107)].
ومنها: «كان الرّجل منهم إذا قُضِيَت حاجَتُهُ سَيَّبَ مِنْ مالِهِ ناقةً أو غيرها لطواغيتهم وأوثانهم»[«تفسير المنار»(7/170)].
ومنها: «ما تُرِكَ لآلهتهم، فكان الرَّجُلُ يجيءُ بماشيته إلى السَّدَنَة فيترُكُهُ عندهم ويُسَبِّلُ لَبَنَهُ»[«اللُّباب في علوم الكتاب» لابن عادل الدّمشقي(7/553)].
فهذه أفعالُ الجاهليَّة الّتي كانوا يلتزمونها، وينذرونها لآلهتهم، وهذا عملُهم الَّذي كانوا يعملونه، وهذا ما ابتدعوه وشَرَعُوهُ لأنفسهم دون أن يشرعه الله لهم، وغَيَّروا به دينَ إبراهيم وإسماعيلَ عليهما السَّلام، ولمَّا نزلَ القرآنُ بالإنكار عليهم: ﴿قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا﴾[المائدة:104]، قال تعالى ردًّا عليهم: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾، قال ابن الجوزي –رحمه الله- في «تفسيره»(2/440): «﴿قَالُوا حَسْبُنَا﴾ أي يكفينا ﴿مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا﴾ من الدِّين والمنهاج ﴿أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ من الدِّين ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ لهُ، أيتبعونهم في خطئهم؟»اهـ.
ماذا يُريدون بسَوْقِ البقر وغيرها من الحيوان إلى صاحب القبر أو صاحب الزَّاوية؟:
إنّهم يُريدون تَعظيمَهُ وإِكْرَامَهُ بمثل هذا الفعل، ولا نظنُّك - أخي المسلم! - قَدْ نَسِيتَ أنَّ أهل الجاهليَّة أيضًا أرادوا تعظيمَ آلهتهم بتلكم النُّذور، وعاملوها بتلك المعاملات الّتي نزَّلوها منزلةَ الشَّرع الّذي يُلْتَزَم، وما هي ممَّا شرعه الله، بل هي ممَّا غيَّروا به الحنيفيَّةَ ملَّةَ إبراهيم، فأدخلوا فيها من الابتداعات الّتي صيَّرتْها وثنيَّةً لا حنيفيَّة.
ابتداعاتٌ غيَّرَتْ معالمَ الشَّريعة:
ابتداعات الجاهليَّة من سَوْقِ قرابين الحيوان من البقر وغيرها إلى آلهتهم لأجل التَّعظيم، قد ضاهَوْا بها تعظيمَ الكعبةِ البيتِ الحرام، فأرادُوا أن يجعلوا هذه من تلك، والفرقُ أنَّ تعظيمَ الكعبةِ مِن شرعِ الله تعالى ووحْيِهِ وأمْرِهِ، وتلكَ مِن شَرْعِهِمْ لأنفسهم ومن أَمْرِ الشَّيطانِ لهم ومن كذبهم على الله تعالى في نسبةِ أعمالهم لأمرِهِ تعالى.
ولا يُفيدُ أن يَقولوا: (إنَّ نيَّتَنَا صالحةٌ! وما أَرَدْنَا إلَّا الخير!)، لأنَّا نقولُ لهم: كذلكَ أهلُ الجاهليَّةِ ما أرادوا بأفعالهم شرًّا بل قصدُوا خيرًا وتقرُّبًا إلى الله تعالى! لكنَّهم ضلُّوا ضلالًا بعيدًا بابتِداعهم، وقد جاء في بعض الأخبار أنّهم ما فعلُوا ذلك إلَّا مِنْ شِدَّة تعلّقهم بالكعبة وتعظيمهم لها، فاتَّخذوا أصنامًا يُعاملونها مُعاملةَ الكعبةِ المعظَّمة مِنَ التّمسُّح بها والطّواف حولها وتقديم الهدايا والزِّيارة لها[«كتاب الأصنام» لابن الكلبي (ص6و33)].
سَوْقُ البقر وغيرها من الهدايا من خصائصِ الكعبةِ المعظَّمة:
اعلم أيُّها المسلم!...أنّه ليس هناك بُقْعَةٌ تُعَظَّم بسَوْقِ البقر وغيرها ممَّا يُهْدَى ويُقدَّمُ قُرْبَانًا إلَّا الكعبةُ المعظَّمة، فمَنْ قَصَدَ تعظيمَ بقعةٍ أو مكانٍ بمثلِ هذه المعاملة من سَوْقِ بقرةٍ إليه ليذبحها فيه أو يُقَسِّمَ لحمها على قاصدي تلك البقعة وزائريها، فعَمَلُهُ ونَذْرُهُ باطلٌ.
* قال الإمام مالك –رحمه الله- في «المدوَّنة»(2/21): «سَوْقُ البُدْنِ إلى غير مكَّة من الضَّلال».
* وذكر الدّسوقي –رحمه الله- (ت:1230هـ) أنَّ مَنْ نَذَرَ (بَعْثَ واسْتِصْحَابَ) حيوانٍ؛ كعِجْلٍ أو خروف لغير مكَّة فهو ضلالٌ، قال: «وكذا بَعْثُ لَحْمِهِ من الضّلال أيضًا»[«حاشية الدّسوقي على الشَّرح الكبير» (2/471)].
* وذَكَرَ الدّردير -رحمه الله- (ت:1201هـ) أنَّ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً يُهْدِيهَا لقَبْرِ الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام أو قَبْرِ وَليٍّ، أنّه يُمْنَعُ ويُمْنَعُ بَعْثُهُ ولو قصدَ الفقراءَ الحاضرين عند القبر، قال: «لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ مَعَالِمِ الشَّريعة»[«الشَّرح الكبير على مختصر خليل»(2/471)].
* قال شَيْخُ المالكيَّة في العراق: أبو بكر الأبهري –رحمه الله- (ت: 375هـ):«لا يجوز أن يُعَظَّم موضعٌ بسَوْقِ البُدْنِ إليه، فيُشْبِهُ ذلك مكّة»، وقال: «ولا يجوز سَوْقها إلى البلد الّذي نذر نحرها فيه، لأنّه لا يجوزُ سَوْق هديٍ إلى غير مكّة، من قِبَلِ أنّه لا يجوز تعظيمُ غير الكعبة كتعظيم الكعبة، وفي سَوْق الهدي إلى غيرها تعظيمٌ لغيرها، وقد قال الله سبحانه: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾[المائدة:95] وقال تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[الحج:33]فلا يجوز نَقْلُ هَدْيٍ مِنْ موضعٍ إلى موضعٍ غيرِ الكعبة لهذه الدّلالة» اهـ [«شرح الأبهري على المختصر الكبير لعبد الله بن عبد الحكم»(مخطوط المكتبة الأزهرية- مصر)/الجزء12/الورقة70/الوجه(أ) والجزء السابع/الورقة: 107/الوجه(ب)].
تحذيرٌ من مشابهة المشركين في أفعالهم:
تَدَبَّر أخي المسلم!... وتَفَكَّرْ، وقَارِنْ بين أحوالِ الكثير مِن قومِنَا وأحوالِ وصنائعِ مَن مضى من المشركين الأوّلين، فهل ما يقوم به كثيرٌ (منَّا)! من التّقرُّبِ بنذور البقر أو العُجُول أو الخرفان إلى صاحب القبر ومن بُنِيَت الزّاويةُ باسمِهِ، هل ذلكَ إلاّ كما صنعت الجاهليَّة بأصنامها وتعاملت به مع أوثانها؟
واجبٌ عليك أيُّها المسلم! أن تبتعد عن أعمال المشركين وأن تكون مُبَايِنًا لهم، امتثالًا لقول الله تعالى لنبيِّه صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِوَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾[يوسف:108].
* قال الإمام ابن باديس –رحمه الله- (ت: 1940م) في تفسيرِ هذه الآيةِ مُؤَكِّدًا على: «البُعْدِ عن الشِّركِ بجميع ِوجوهِهِ وصُوَرِهِ جَلِيَّةً وخَفِيَّةً»، ومُؤكِّدًا: «أَمْرَ مُبَايَنَةِ المشركين» «في جميع مظاهر شركهم، حتَّى في صورة القول...أو في صورة الفعل؛ كَأَنْ يَسُوقَ بقرةً أو شاةً مثلًا إلى ضريحٍ من الأضرحة، فإنَّه ضلالٌ كما قاله الشَّيخ الدّردير في باب النّذر، فضلًا عن عقائدهم..»إلخ [«تفسير ابن باديس =مجالس التّذكير»(ص64)/مطبوعات وزارة الشؤون الدينيّة – الجزائر/الطبعة الأولى: 1982م].
* وقال عند شرحِ حديث ثَوْبَان –رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بالمشركين وَحَتَّى يَعْبُدُوا الأَوْثَانَ ...»[رواه أبو داود(4254) والترمذيّ (2219)]:
تحت عنوان «اللُّحوق بالمشركين»: «مَن اعتقد مثلَ عقيدتهم أو فَعَلَ مثلَ أفعالهم أو قال مثل أقوالهم فقد لَحِقَ بِهِمْ... »، وقال: «مِن أعمال المشركين في الجاهلية أنَّهم يسوقون الأنعام لطواغيتهم فينحرونها عندها طالبين رضاها ومعونتها. وفي النَّاس اليومَ طوائفُ كثيرةٌ تَسُوقُ الأنعام إلى الأضرحة وللمقامات تنحرها عندها إرضاءً لها و طلبًا لمعونتها أو جزاءً على تصرُّفها وما جَلَبَتْ مِن نفعٍ أو دَفَعَتْ مِن ضُرٍّ»اهـ[«آثار الإمام ابن باديس= مجالس التّذكير»(2/96)/مطبوعات وزارة الشؤون الدّينيَّة –الجزائر/الطبعة الأولى: 1983م].
* وقال الشّيخ بلقاسم بن ارْوَاق –رحمه الله- (ت: 1993م) بعد أن ذكر كلامَ الإمام مالك –رحمه الله- في أن يكون النّذر ممّا يُطاعُ اللهُ تعالى بهِ: «هذا حُكْمُ الإمامِ مالكٍ في النُّذور الّذي نَزْعُمُ اتِّبَاعَهُ، وأين هذا ممّا يفعله أدعياء اليوم من سوقهم النّذور والهدايا إلى الأضرحة البعيدة، وإِرَاقَةِ دَمِهَا بين القبور تَزَلُّفًا لأهلها وتَقَرُّبًا لهم من دون الله، ثمَّ بعد هذا كلِّه «أُكْلَةٌ شعبيَّة» وعملُ برٍّ وخيرٍ رُغمَ الإسلام ورغمَ تعاليمه، اللّهمّ إنّ هذا بهتانٌ كبير»اهـ.
* وقال الشَّيخ عمر بن البسكري-رحمه الله- (ت: 1968م) جوابًا عمّن اعترض بقوله: «نحن مالكيَّة لا نريدُ إلاّ مذهب الإمام مالك بن أنس –رحمه الله-»!: «تُرِيدُونَ مذهبَ مالكٍ فما أعظمها سعادة لو تبعتم لنا مذهبَ مالك، مالكٌ –رحمه الله- يقول: سَوْقُ الهدايا لغير مكّة ضلالٌ، وأنتم تسوقونها وتنحرونها عند قبور الصَّالحين...»[مجلَّةُ «الشِّهاب»، جزء صفر1352هـ، (ص271)]
إجاباتٌ عن شُبُهَاتٍ:
سيقول بعض النّاس إنّ هذه عاداتنا وميراثُ آبائنا وأجدادنا، وأنتم تريدون إحداث البلابل والقلاقل بهذا الوطن، بمحاربتكم عوائد وتقاليد المسلمين وإرادَتِكُمْ هَدْمَهَا.
والجوابُ:
أنّ العادات والتّقاليد إن كانت صالحةً، فمن ذا الّذي يُنكرُ الأخذَ بها والاستمرارَ فيها؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنّما بُعِثت لأُتَمِّمَ مكارم الأخلاق. أو قال: صَالِحَ الأخلاق»[البخاريُّ في «الأدب المفرد»(273) وغيرُهُ]. وإن كانت هذه العاداتُ والتّقاليدُ تُصادمُ الدِّين وتعودُ بالنَّقضِ على أحكامِ الملَّةِ والشَّرع المُبين، لا سيَّما الأصول والقطعيَّات كمسائل التَّوحيد، فإنَّها باطلةٌ مردودةٌ، ولا ينبغي لأحدٍ أن يَدَعَ حُجَجَ الشَّرع ويتنكَّبَها بعد إذْ تَبَيَّنَتْ له، وما أَهْلَكَ المشركين الأوَّلين وفيهم مِن قرابات النّبيِّ الكريم صلى الله عليه وسلم وأرحامِهِ إلاّ هذه السّبيلُ الخاسرة والحُجَّةُ الدَّاحضة، فقالوا: قد كان على هذا الدِّين آباؤنا وأجدادنا وأشياخنا ولا سبيل لنا إلى مخالفتهم وتركِ دينهم، مع أنّ حججَ القرآن كانت عليهم تَتْرَى، فسمِعُوهَا وما سَمِعُوهَا حيثُ أَغْرَقُوا أنفسهم في ضلالات التَّقليد، فَأَهْوَتْ بهم في مكانٍ سحيقٍ.
سيقول بعض النّاس إنّنا لم نَسُقْ البقرةَ أو العِجْلَ تقرّبًا إلى صاحب القبر، بل نحنُ نتقرَّبُ إلى الله تعالى.
والجوابُ: ليس بصحيحٍ، بل قصْدُكُم ومُرَادُكُمْ صاحبَ القبر، والقرائنُ الكثيرةُ تُفصحُ عن نيّتكم والكامنِ في أنفسكم، وذلك: أنّ هذه البقرة أو العِجْل تنسبونه إلى الشّيخ الميِّت صاحب الزّاوية، وتُعيِّنونها لهُ، وتذكُرُون اسمَهُ قائلين: «هذا العِجْلُ لكَ يا شيخ فلان»، «هذه ذبيحتُكَ يا شيخ فلان»، هذا ما تريدونهُ وتقصدونه قد ظهر على لسانكم، وكونُكُمْ تذكرون اسمَ الله عليها عند الذَّبح لا يجعلُها لله.
(2) أنتم تفعلون هذا الفعل من سَوْقِهَا والدَّوَرَانِ بها عند قبره وفي جِوَارِهِ، ولا تَرْضَوْنَ لها مكانًا آخر.
(3) إن حصل لكم خيرٌ وفاضت عليكم أرزاقٌ، قُلتم: ذلك حصلَ ببركة الشّيخ، وهو أثرٌ من آثار النَّذْرِ الّذي نَذَرْنَاهُ لَهُ، وقلتُم: إنّ سببَ قضاءِ حاجتِكُمْ هو هذا النَّذر، وترَوْنَ أنّ مَنْ مَنَع ذلك هَلَك....إلخ.
ثمَّ نقول لهذا الّذي يدَّعي ادِّعاءً إنَّهُ لا يقصدُ بالذَّبح لهم والنّذر عليهم عبادَتَهُمْ:
كلَّا! بل الذّبح والنَّذر: عبادتان من جملة العباداتِ الّتي ثَبَتَتْ شرعًا، ولا عبرةَ بادِّعائك سواءٌ اعترفت أو لم تعترف بذلك، فالمعتبَرُ حكمُ الشَّرعِ لا ادِّعاؤُكَ جهلًا منكَ أو عِنادًا.
وسيقولُ بعضُ النّاس نحنُ لا نعتقدُ أنّ سيدي الشّيخ له تأثيرٌ ولا نعتقدُ أنّ حصولَ ما نطلُبُ بتصرّفِهِ، وإنّما التَّأثيرُ بالنّفعِ لله ربِّ العالمين لا للشَّيخ.
والجوابُ:
* قال الشّيخ محمّد يحيى الولاّتي الشّنقيطيّ –رحمه الله- (ت: 1912م): «قلنا لهم: مِعْيَارُ ذلك أن تذبحوا في بيوتكم وتتصدّقوا بلحم الذّبيحة وتَنْوُوا ثَوَابَ الصّدقة لأنفسكم أو لوالِدِيكم وتتوسَّلون إلى اللهِ تعالى في قضاءِ حوائجكم بعملكم الصّالح هذا، الّذي هو الصَّدقةُ المذكورة....فلو كنتُم لا تعتقدُون التَّأثيرَ في الوليِّ لَمَا أتعَبْتُمْ أنفسكم في سَوْقِ الذَّبيحةِ إلى قبرِهِ، فلولا اعتقادُكُم التَّأثيرَ فيهِ ما سُقْتُمُوهَا إليهِ، بل ولا خصَصْتُمُوهُ بها»[«رحلة محمّد يحيى الولاتي»(ص328)].
* وقال: «ومِن علامةِ أنّهم يعتقدون التَّأثيرَ بالنّفع والضّرّ في أصحاب القبور أنّهم...يفرحون لمن يقولُ لهم: الوليّ سيدي فلان لا يَذْبَحُ أحدٌ على قبرِهِ لحاجةٍ إلاّ قُضِيَتْ، ولا مريضٍ إلاّ بَرِئ، ولا مكروبٍ إلاّ فُرج عنه، فيستَبْشِرُون ويَهُشُّون لصاحبِ هذا الكلامِ الباطل»[المصدر السَّابق(ص330)].
ونقولُ لمن يدَّعي أنَّهُ إنَّما ذبحَ ونذَرَ البقرةَ أو العِجْلَ لله تعالى لا للمخلوق: لأَيِّ معنًى صنعتَ هذا الصَّنيع، وعملتَ ما عملتَ عند القبر وفي جوارِهِ؟...إذا كنتَ تذبحُ لله، فلأيِّ معنًى جعلتَ ذلك للميِّت وحَمَلْتَهُ إلى قبره؟
* قال الشّيخ محمّد يحيى بن المختار الولّاتي الشّنقيطي –رحمه الله-: «إذا قلتَ لأحدهم: إن كنتَ لا تقصدُ إلاّ التّقرّب إلى الله تعالى بذبيحتِك على قبر الوليِّ فُلان فاذبَحْهَا في بيتِكَ على اسمِ الله فقط، وتصدَّقْ بلحمها على المساكين، فإنَّهُ لا يُساعدك في ذلكَ أبدًا، ولا يقبل إلاّ ذبحها عند القبر»[«رحلة محمّد يحيى الولاّتي»(ص327)].
* نَقَلَ ابنُ حجر الهيتميّ الشّافعيّ –رحمه الله- في«الفتاوى الفقهيّة الكبرى»( 4/268): «قولَ الأذرعيّ الشّافعيّ[ت:783هـ] في النَّذْرِ للمَشاهِد على قبرِ وليٍّ أو نحوه: مِنْ أنّ النَّاذِرَ إن قَصَدَ تعظيمَ البُقْعَة أو القبر، أو التّقرّبَ إلى مَنْ دُفِنَ فيها أو مَنْ تُنْسَبُ إليه وهو الغالب من العامّة؛ لأنّهم يعتقدون أنّ لهذه الأماكن خصوصيّات لأنفسهم [في مصدرٍ آخر: لا تُفْهَم]، ويَرَوْنَ أنَّ النَّذْرَ لها ممّا يندفعُ به البلاء، فلا يصحُّ النَّذْرُ في صورةٍ من هذه الصُّور؛ لأنَّهُ لم يقصد به التّقرُّبَ إلى الله سبحانه وتعالى...»اهـ.
* ولذلكَ لمّا قال بعضُ فقهاء الشّافعيَّة بأنَّ النَّذْرَ لقبرٍ معروفٍ في ناحيتهم صحيحٌ، ردَّ عليه الأذرعيُّ –رحمه الله- بقوله: «هذا كَلَامُ مَضَلَّةٍ»[نَقَلَهُ ابنُ حجر في المصدر السَّابق(4/286)]؛ أي مُوقِعٌ للنَّاسِ في الضَّلال.
سيقول بعضُ النّاس ـ مُصِرًّا على أنَّهم ما أرادوا التّقرُّبَ إلى صاحب القبر ـ: نحنُ إنّما قصدنا إحياءَ ذِكْرَى الشَّيخِ الصّالحِ، الّذي كان بيتُهُ وزاويتُهُ مأوًى لعابِرِ السَّبيل وفيه إقْرَاءُ الضَّيْف وإطعامُ الطّعام وجَمْعُ النّاس على الذِّكر وتلاوةِ القرآن.
والجوابُ:
قال صلى الله عليه وسلم: «لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا...»[رواه أحمد (8804) وأبو داود(2044) بإسنادٍ حسنٍ].
وهذا الموسم الّذي تُقيمُهُ الزّاوية هو الّذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ومعنى اتّخاذِهِ عيدًا: أن يُزَارَ زيارةً مُؤقَّتةً تجتمعُ لها النَّاس.
وقال صلى الله عليه وسلم: «لَا عَقْرَ في الإسلام»[رواه أبو داود (3224) في (باب كراهية الذَّبح عند القبر)].
قال عبد الرّزّاق –رحمه الله- (ت: 211هـ): «كانوا يَعْقِرُونَ عند القبر بقرةً أو شاةً»اهـ.
* قال الخطّابيُّ –رحمه الله- (ت388هـ): «كان أهلُ الجاهليّة يَعْقِرُون الإبل على قبرِ الرَّجل الجَوَاد، يقولون: نُجازِيهِ على فِعْلِهِ؛ لأنّه كان يعقرها في حياته فيُطعِمُهَا الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السِّباع والطَّير، فيكونُ مُطْعِمًا بعد مماته كما كان مُطْعِمًا في حياته»اهـ[«معالم السُّنن»( )].
* وقال أحمد بن حجر الهيتميّ –رحمه الله- (ت: 974هـ) في كتابِهِ «فتح الجواد بشرح الإرشاد»[ط. البابي الحلبي بمصر، 1347هـ](1/184): «والذَّبح والعَقْرُ عند القبر مَذْمُومٌ للنَّهيِ عنه»اهـ.
* وقال الشَّيخ محمّد يحيى الولاتي الشنقيطي –رحمه الله-: «قد كان من سُنّة الجاهليّة الذّبحُ على القبور وحرَّمَهُ الله تعالى على لسانِ نبيِّه محمّدٍ صلى الله عليه وسلم كما حَرَّمَ الذَّبْحَ على النُّصُب أي الأصنام»[«رحلة محمد يحيى الولاتي»(ص326)].
فهل أعيادُ الزّاوية والمواسم الّتي تُقامُ عند قبر صاحبها إلاّ مشابهةٌ في المعنى لعَتِيرَةِ (ذبيحةِ) الجاهليَّة وعَقْرِهَا عند قبورِ سَادَتِها؟
وأخيرًا: أخي المسلم!...قد بَانَ لكَ أنَّ النَّذرَ لقبورِ الصَّالحين وسَوْقَ الهدايا إليها والذَّبحَ عليها داخلٌ في عُمُومِ الشِّرْكِ ـ أعاذنا اللهُ منهُ ـ، فاحْذَرْ! أن تكونَ ممَّن قالَ اللهُ تعالى فيهم: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾[يوسف:106]
من مواضيعي
0 التغذية: نصائح وحيل حول الأكل الصحي اهمالها قد يسبب لنا مشاكل صحية لا نعرف اين سببها؟
0 فوضى سينوفاك الصينية.. لقاح واحد و3 نتائج متضاربة
0 "نوع آخر مثير للقلق".. سلالات كورونا المتحورة تنتشر في 50 بلدا
0 إجراء تغييرات إيجابية: نصائح وحيل للتغذية السليمة ولتقوية الاعصاب
0 هل لديك وزن زائد؟ نستطيع مساعدتك
0 يؤثر نظامك الغذائي على صحتك: كيفية الحفاظ على التغذية الجيدة
0 فوضى سينوفاك الصينية.. لقاح واحد و3 نتائج متضاربة
0 "نوع آخر مثير للقلق".. سلالات كورونا المتحورة تنتشر في 50 بلدا
0 إجراء تغييرات إيجابية: نصائح وحيل للتغذية السليمة ولتقوية الاعصاب
0 هل لديك وزن زائد؟ نستطيع مساعدتك
0 يؤثر نظامك الغذائي على صحتك: كيفية الحفاظ على التغذية الجيدة
التعديل الأخير تم بواسطة السني الجزائري ; 17-02-2013 الساعة 08:23 PM