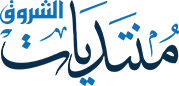مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
25-01-2024, 04:14 PM
مع رواية (الشوك والقرنفل)
لـــــ يحيى السِّنوار
بقلم عبد الله لالي
اللغة والأسلوب:
أسلوب الكاتب جاء متوازنا كما أسلفنا؛ فيه السّرد المباشر وفيه الحوار وفيه الاستذكار، وفيه التصوير الفنّي وفيه التناص أحيانا، وشُحِن بمخزون من الثقافة التراثية الأصيلة، وسنضرب على كلّ عنصر من ذلك أمثلة تبيّنه وتوضّح دوره الفنّي العميق في المتن الروائي.
استخدم الكاتب أسلوب (الرّاوي العليم) كما يقال في الاصطلاح النّقدي، وفيه نوع من القدح المقنَّع، ولكن إذا كان هذا الرّاوي هو أحد أبطال الرّواية فيتحدّث عن الوقائع كما عاشها ورآها فلا منقصة أوعيب في ذلك، فمن العادة أنّ القارئ (المتلقّي) يتفاعل بشكل كبير مع الرّاوي الذي يشارك في الأحداث بخلاف الراوي الذي يكون خارج أحداث النّص، ويُعْتَقَدُ أنّه الكاتب نفسه، يطلّ على أحداث الرّواية من خارجها، فتبدو أحادث كأنّها ميتة..!!
في اللغة: لغة الكاتب لغة جيّدة من حيث قوّة الألفاظ والتعابير، فيها انسيابية وطلاقة وتدفق في السّرد بلا تكلّف أو تعقيد، ونجد الكاتب أحيانا يلجأ إلى إدراج بعض الجمل باللهجة العامية، ليضفي عليها خصوصية ما، كأنها بصمة للمجتمع الفلسطيني تميزه عن غيره، مثل قول الكاتب ص 5:
".. حينها قال محمود هل أحضر السّراج يا أمّي لنشعله (ياما أجيب الضوء نولعه)، اندفع محمود يخرج من الخندق فسبقت إليه يد أمّي لتمسك به وتمنعه من الخروج وهي تقول لا تخرج يا محمود (تطلعش).."
وهذا الأسلوب يسرف فيه بعض الروائيين إلى درجة غمط اللغة الفصحى حقّها، بزعم أنّه يعبّر عن الواقع، وأنّ ذلك الأسلوب هو الأسلوب الأقرب لنقل الحقيقة والتعبير عن مشاعر النّاس بصدق، ولكنّهم ينسون في الوقت نفسه، أنّه أسلوب (سوقي) مبتذل يزري بفنيّة الإبداع، كما أنّه أسلوب محدود في الزمان والمكان، فمن حيث الزمان يخضع لتغييرات جذرية في كلّ جيل، وقد يصبح غير مفهوم تماما بعد جيلين أو ثلاث، ثم هو كذلك من حيث المكان لا يكون مفهوما في بيئة أخرى لا يَشيع فيها ذلك الأسلوب (العاميّ)، لكن التطعيم ببضع كلمات أو جمل قليلة على سبيل الاستطراف أو التندر والتتبيل الفنّي فمقبول ولا شيء عليه..!
وفي الوقت نفسه نجد بعض العبارات القويّة التي تمثل اللّغة في مستوياتها المتينة لتعبر عن أدّق المعاني الإنسانية، مثل قول الكاتب من ص7:"لأوّل مرّة منذ أيّام نستنشق الهواء الطبيعي ولكنّه معبق برائحة البارود وغبار البيوت التي تهدّمت من حولنا، تمكنت من النّظر حولي قبل أن تجرّني أمّي إلى البيت لأرى آثار الخراب من حولنا من جميع الاتجاهات..".
ونجد كذلك تطعيما فنيا بديعا من نوع آخر، يرفد اللغة بألفاظ وكلمات جديدة أو قليلة الاستعمال، تجعل من اللغة أكثر اتساعا وأدقّ تعبيرا عن الحياة الحديثة، دون الوقوع في فخ استخدام الألفاظ الأجنبية بإسراف ودون حاجة لذلك مع وجود البديل المقنع، مثل قول الكاتب: (الـمُدْمِع) وهو تعبير عن الغازات المسيلة للدموع، وفيه إثراء أكثر دقّة لعبارة (الغازات والقنابل المسيلة للدّموع)، وكلمة (ضمّة) من السبانخ، كلمة فصيحة ودقيقة في التعبير عن المعنى المراد، رغم أنّ الكاتب وضعها بين قوسين، وذلك للإشارة – ربما - أنها مستحدثة أو أنّها مأخوذة من الدّارجة.
واستعمل الكاتب أيضا أسلوب الحوار بشكل كبير بحيث أحداث نوعا من التوازن بينه وبن السّرد العادي، وكان الحوار يعالج الأفكار والأحداث ويسهم في نقلها للقارئ في قالب مختلف، بحيث لم يقتصر الحوار على مناقشة الأفكار وتحليلها والجدل فيها، وهذه طريقة تريح القارئ وتجعله يغير وسيلة الإبحار في أعماق الرواية كأنّه ينتقل من وسيلة نقل جويّة إلى وسيلة نقل بريّة أكثر راحة وأكثر هدوءا..!
ويمكن نقل نموذج ذلك الحوار من خلال المثال التّالي ص22:"بدأ أبو حاتم وأبو يوسف يتهامسان، أبو يوسف يسأله: أين كنت؟ والله ظننت أنّك استشهدت أو رحلت إلى مصر؟ أبو حاتم يخبره أنّه قد أصيب في الاشتباكات في منطقة المعسكرات الوسطى وزحف إلى إحدى السيّارات حيث عثرت عليه عائلة بدويّة هناك وأخذوه وداووا جراحه وأطعموه وأخفوه حتى تعافى".
ونلاحظ على الحوار هنا أنّه ليس مجرّد حوار عادٍ، بل يتنقل بنا في بيئة الأحداث ويزوّدنا بالجديد منها، ونكتشف تطوّراتها. وفي الحوار تنويع جميل يضفي على النّصّ المسحة الطبيعية التي تكون في أي قصّة تحدث في الحياة، ولذلك نجد فيه الحوار الذي بين اثنين، أي أنه حوار ثنائي، كما نجد فيه الحوار الذي يدور بين عدّة أطراف، كما نجد فيه الحوار الذّاتي الذي يكون بين الشخص وبين نفسه، مثل ذلك الحديث الذي دار في نفس بطل الرواية أحمد في ص 163:"كنت أراقب ذلك وبداخلي بركان يكاد ينفجر فلابدّ أن أصارحه بأنّني قرأت الورقة وأوضّح له الأمر، لا يصحّ أن أسكت على ذلك، فقد يزعل ويخرج، لا ضير ولكن لابدّ أن أخبره".
المشاهد الفنية:
حفلت الرواية بزخم كبير من الصور الفنيّة الجميلة التي تؤثث أحادث الرواية، وتضفي عليها بعدا إبداعيا خلابا، ولابدّ للقارئ أن يقف عندها طويلا يتملاها ويرتشف من عذب رضابها، ويمكننا انتقاء عدد من تلك المشاهد البديعة وتحليلها ليشاركنا القارئ لذة الاستمتاع بالغوص في أعماقها:
المشهد الأوّل:
يقول الكتب في مفتتح الرّواية وهو بوابة استقبال القارئ بحفاوة من ص 3:"شتاء عام 1967 كان ثقيلا يرفض الرّحيل، ويزاحم الرّبيع الذي يحاول الإطلال بشمسه المشرقة الدافئة، فيدافعه الشتاء بغيوم تتلبّد بالسّماء، وإذا بالمطر ينهمر غزيرا من السّماء فيغرق تلك البيوت البسيطة في مخيّم الشاطئ للجئين بمدينة غزة.."
مشهد ساحر رغم قساوته يعبّر بعمق عن المأساة التي يعيشها الفلسطينيّ، الذي شُرّد من أرضه ووطنه، وعاش حياة التشرّد والشتات، وزادته قسوة الطبيعة ألما ووطأة، ليكون دخول القارئ للرواية من أوسع أبوابها..!
من مواضيعي
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار