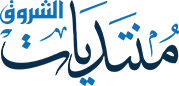لا عُدوان إلا على الظّالمين المعتدين
24-12-2015, 08:57 AM
لا عدوان إلا على الظالمين المعتدين
قرأت موضوعا قيما بقراءة مختلفة تماما عن قراءة شيوخ القتل وقطع الرؤوس وإراقة الدماء في سبيل الله عدوانا على الأبرياء المختلفين في الدين والذي اصطلح الفقهاء عليه باسم [جهاد الطلب [ ، الذي بعنى مطلقا غزو بلاد الكفار لنشر الإسلام فيه عنوة وغصبا .
بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد الله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أما بعد:
فقد حصل النزاع بين بعض الإخوان والمشايخ الكرام في الرسالة المنسوبة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة قتال الكفار، وأن القتال إنما شرع للدفاع عن الدين، وكف أذى المعتدين على المؤمنين، وأن الإسلام يُسالم من يسالمه.
فاستنكر هذا القول واستكبره بعض العلماء المتأخرين، حتى خرج لإنكاره كتابان من عالمين جليلين يحققان فيهما أن هذه الرسالة مكذوبة على شيخ الإسلام، وأنها ليست من كلامه لاعتقادهما أن القتال سببه الكفر. وعلى أثر هذا التكذيب للرسالة ساءت السمعة بسائر رسائل شيخ الإسلام رحمه الله.
ونحن بكلامنا في تحقيق هذه الرسالة لسنا نريد التصدي للانتصار لشيخ الإسلام في كل ما يقوله في الرسالة وغير الرسالة، وإنما نؤم علم الحق متى رُفِعَ لنا لنكون تحت لوائه ومن أنصاره وأعوانه.
°°°لقد عشنا زمانًا طويلاً ونحن نعتقد ما يعتقده بعض العلماء وأكثر العوام من أن قتال الكفار سببه الكفر، وأن الكفار يقاتلون حتى يسلموا، لكننا بعد توسعنا في علم الكتاب والسنة، والوقوف على سيرة الرسول ﷺ وأصحابه في حروبهم وفتوحهم للبلدان، تبدل رأينا وتحققنا بأن القتال في الإسلام إنما شرع دفاعًا عن الدين ودفع أذى المعتدين على المؤمنين، وليس هذا بالظن ولكنه اليقين. قال شيخ الإسلام في رسالته: الصحيح أن القتال شرع لأجل الحرب لا لأجل الكفر، وهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، وهو مقتضى الاعتبار، وذلك أنه لو كان الكفر هو الموجب للقتال لم يجز إقرار كافر بالجزية. انتهى.
°°°فمن زعم أن لشيخ الإسلام كلامًا يخالف هذا في السياسة الشرعية أو في الجواب الصحيح فقد غلط عليه وأدلى بما لم يحط بعلمه.
وقد قال بعض العلماء من المتأخرين: إن دعوى القتال للإكراه على الدين إنما دخل على المسلمين عن طريق النصارى، حيث كانوا يشنعون به دائمًا على الإسلام والمسلمين، ويجعلونه في مقدمة تبشيرهم إلى دينهم، وينشرونه في كتبهم ويلقنونه للطلاب في مدارسهم، لقصد تنفير الناس عن دين الإسلام واحتقاب العداوة لأهله، فهو أكبر مطاعن النصارى على الإسلام وعلى المسلمين. فسرى هذا إلى اعتقاد بعض العلماء وأكثر العامة؛ لظنهم أنه صحيح واقع، ومن طبيعة البشر كراهة اسم الإكراه والإجبار مهما كانت عاقبته، وصاروا يتناقلون هذا القول في كتبهم حتى رسخ في قلوب العامة وبعض العلماء.
°°°وإننا متى قلنا بهذا القول فقد اشتركنا مع القسيسين والمبشرين في التنفير من الدين، وإنه ينبغي لنا متى تصدينا للدعوة إلى دين الإسلام أن نصف الإسلام بما هو أهله، وبما هو معلوم عن محاسنه، واتصافه بالرأفة والرحمة لسائر الناس؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ [الأنبياء: 107]. - أي للخلق أجمعين - بدلاً من أن نصفه بالعقاب والشدة لكل من لقيه من الكفار. فنصفه بأنه دين البشرية كلهم عربهم وعجمهم لا دين لهم سواه؛ لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُ﴾ [آل عمران: 19]. وقال: ﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴾ [البقرة: 85].
°°°فهو دين الله الذي ارتضاه لجميع خلقه، فقال سبحانه: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾ [المائدة: 3]. لأنه دين الرحمة المهداة من الله لجميع الناس بواسطة محمد ﷺ. فهو دين الحق الذي نظم أحوال الناس في حياتهم وبعد وفاتهم أحسن تنظيم. صالح لكل زمان ومكان، وقد سماه الله سلمًا فقال سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ﴾ [البقرة: 208]. فهو يحب السلم ويكره الحرب إلا في حالة الضرورة.
°°°فلا يكره أحدًا على الدخول فيه لكون الدين هداية اختيارية لا إكراه فيها ولا إجبار، يقول الله سبحانه: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ﴾ [البقرة: 256]. وقال: ﴿أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ﴾ [يونس: 99]. ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ﴾ فيؤمن به وبأمره ونهيه، ﴿وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا﴾ [الأنعام: 125]. عن أمره ونهيه وفرائضه ونوافله.
°°°إن الإسلام يُسالم من يسالمه ولا يقاتل إلا من يقاتله أو يمنع نشر دعوته ويقطع السبيل في منع إبلاغها للناس، فإنهم بمنعهم إبلاغها يعتبرون معتدين على الدين وعلى الخلق أجمعين؛ لأن الله سبحانه أمر بإبلاغ هذا الدين وتبشير جميع خلقه به فقال سبحانه: ﴿لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ﴾ [الأنعام: 19]. فمتى أقبل دعاة الإسلام على بلد ليدعوا أهلها إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلوهم بالتي هي أحسن، فإن فُتح لهم الباب وسهل لهم الجناب وأذن لهم بالدخول ونشر الدعوة، فهذا غاية ما يبتغون، وبذلك فليفرح المؤمنون، فلا قتل ولا قتال، وكل الناس آمنون على دمائهم وأموالهم، وقد فتح المسلمون كثيرًا من البلدان بهذه الصفة، مما يسمى صلحًا.
°°°أما إذا نصبت لهم المدافع، ووجهت نحوهم أفواه البنادق، وسلت في وجوههم السيوف، ومنع الدعاة منعًا باتًّا عن حرية نشر دعوتهم وعن الاتصال بالناس في إبلاغهم دين الله الذي فيه سعادتهم وسعادة البشر كلهم، فإنهم يعتبرون حينئذٍ معتدين على الدين وعلى الخلق أجمعين.
فعند ذلك يعتبر المسلمون مكلفين من الله باقتحام كل شدة ومشقة، وخوض كل خطر وضرر في سبيل الله، وفي سبيل إبلاغ دين الله حتى يزول المنع والاضطهاد والفتنة عن الدين، يقول الله سبحانه: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 193]. وقال: ﴿وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِ﴾ [البقرة: 191].
﴿ذَٰلِكَۖ وَلَوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَاْ بَعۡضَكُم بِبَعۡضٖ﴾ [محمد: 4]. فقتالهم والحالة هذه هو في سبيل الله، ولا يبالون بما أصابهم في ذات الله؛ لأن الله سبحانه قد اشترى من المؤمنين أنفسهم في سبيل نشر دين ربهم وإعلاء كلمته، فهم يتمنون الشهادة في سبيل الله كما يتمنى أكثر الناس الحياة؛ لعلمهم أن لهم حياة أخرى هي أبقى وأرقى من حياتهم في الدنيا، وقد باعوا أنفسهم لله في سبيل الحصول عليها، يقول سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴾ [التوبة: 111]. فهذا طريق دعوتنا إلى دين الإسلام.
وقد سئل النبي ﷺ عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى.
°°°يبقى الكلام في البحث عن حقيقة رسالة شيخ الإسلام في قتال الكفار وعدم نسبتها إليه، فقد تحصلت والحمد لله على هذه الرسالة، ووقفت على حقيقة ما تقتضيه من الدلالة، فوجدتها صحيحة في معناها وحسنة في مبناها، ويظهر من دلائل استنباطاته وبراهين بيناته أنها خرجت من مشكاة معلوماته، وكل متخصص بدراسة كتبه فإنه سيعرف منها ما عرفنا؛ لكون عباراته لا يماثلها كلام غيره، وقد وافق العلامة ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية، وحقق أن الإسلام لا يكره أحدًا على الدخول فيه، وأنه يسالم من سالم، كما سيأتي كلامه مستوفى عن قريب إن شاء الله.
فدعوى التزوير بعيدة جدًّا عنها، فلا تحوم التهمة والشك حولها، وقد قال في كتابه السياسة الشرعية ما يوافق قوله في هذه الرسالة حيث قال: إن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، فمن لم يمنع مسلمًا من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. كما سيأتي كلامه مستوفى في موضعه.
وقد قيض الله سبحانه لحفظ رسائل شيخ الإسلام وكتبه علماء جهابذة نقادًا في زمانه يحبهم ويحبونه، فكانوا يعتنون أشد الاعتناء بنقل كتبه ورسائله ثم نشرها في الآفاق، كما قيض الله له أميرًا عدلاً في زمانه، كان يحث العلماء على التحفظ بكتب شيخ الإسلام والاعتناء بنقلها. وأشد من بالغ في هذا الأمر هو العالم الإمام شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي أحد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فقد وجه نداء إلى العلماء في زمانه قرب وفاة شيخ الإسلام قائلاً فيه: لا تنسوا تقريرات شيخنا الحاذق الناقد الصادق قدس الله روحه، فالطريق في حقه هو الاجتهاد العظيم في كتابة مؤلفاته الصغار والكبار على جليتها وحالها من غير اختصار ولا تصرف فيها، ولو وجد فيها كثير من التكرار، ومقابلتها بنظائرها، ثم إشاعتها ونشرها لعموم الانتفاع بها. واحتفظوا بالشيخ أبي عبد الله -يعني ابن القيم- وبما عنده من الذخائر والنفائس، وأقيموا لهذا الأمر المهم الجليل أكثر ما تقدرون عليه؛ لأنه قد بقي وحيدا في فنه، فريدًا في دهره، ولا يقوم غيره مقامه من سائر الجماعات، وكل أحوال الوجود لا بد فيها من العوارض والأنكاد، فاحتسبوا مساعدته عند الله واكتبوا ما عنده وليكتب ما عندكم، وأنا أستودع الله دينه ودينكم، وما عنده وعندكم، والسلام عليكم. انتهى.
وأقول عن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله: إن كل عالم مخلص خلي من الغرض والهوى يعترف بكبر قدره، وغزارة بحره، وتوسعه في العلوم العقلية والنقلية، وفرط ذكائه واجتهاده، وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف.
ولا ينفرد بمسألة كمسألة قتال الكفار أو غيرها بمجرد التشهي بدون دليل، بل يحتج على ما يقول بالقرآن والحديث والقياس.
ولم يسجل التاريخ في مشارق الأرض ومغاربها بعد رسول الله وخلفائه وأصحابه أكثر مما سجل له من قوة الإبداع، وتجلية الحق، والبصيرة في النقد، والعدالة في الحكم، ومطابقة النقل للعقل.
وقد تصدى لمحاربة البدع على اختلاف أنواعها حيث غزاها في عقر دارها وفند آراء المؤيدين لها.
عاش رحمه الله في زمان قد تفرق أهله في النزاعات والمذاهب والآراء، فحمل راية الإسلام بالحجة والبيان، والسنة والقرآن، والسيف والسنان، مما جعله في مقدمة الأبطال الذين جاهدوا في الله حق جهاده، فهو بطل دين، وعلم من أعلام الفكر العالي بآرائه الحرة التي لا تخرج غالبًا عن حدود الحق، ولكنه لم يسلم من أذى الخلق في زمانه وفي هذا الزمان، سنة الله في ابتلاء المجاهدين في سبيله، يقول الله تعالى: ﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتَّىٰ نَعۡلَمَ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبۡلُوَاْ أَخۡبَارَكُمۡ ﴾ [محمد: 31].
إن الناس يستفيدون من المتحررة آراؤهم والمستقلة أفكارهم في حدود الحق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأشباههما، أكثر مما يستفيدون من المقلدة لشيوخهم وعلماء مذاهبهم؛ إذ المستقل بفكره هو من يستفيد من بحث غيره بصيرة وفكرة وزيادة معرفة، ولا يقلدهم في كل قول يقولونه، وإنما يعمل بما ظهر له من الحق، فعدم وجود المستقلين ضار بالإسلام والمسلمين؛ لأنهم حملة الحجة والبرهان. والمقلد لا حجة له، وإنما غاية علمه وعمله أن ينقل حجة غيره، فإذا طرأت شبهة على الدين كهذه لم يجد جوابًا لها منقولاً عمن يقلدهم من الفقهاء، فيبقى حائرًا محجوجًا مبهوتًا، أو يستدل بما لم يحط بعلمه.
ولم يتناول دُرة الحق غائصٌ
من الناسِ إلا بالروية والفكر
°°°إن طريق الانتفاع بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المجتهدين هو أن يفرغ الإنسان قلبه مما يعتقده قديمًا مما قد يظن في نفسه أنه حق، ثم يقدر الاحتمال لعدم صحة ما يعتقده، فينظر من جديد في الأدلة التي يوردها المجتهد بدون أن يتلقاها بالنفرة والكراهية الشديدة لها، فإن الإنسان إذا اشتدت كراهيته للشيء لم يكد يسمعه ولا يبصره، فيفوت عليه مقصوده وثمرته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة قتال الكفار:اختلف العلماء في قتال الكفار وهل سببه المقاتلة أو مجرد الكفر على قولين مشهورين للعلماء.
أحدهما: سبب المقاتلة هو الاعتداء على الدين وأهله، وهذا هو قول الجمهور كمالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم.
والثاني: أن سببه الكفر، وهو قول الشافعي، وربما علل به بعض أصحاب أحمد من أن السبب في القتال مجرد الكفر.
قال: وقول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقَٰاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ﴾ [البقرة:190].
فقوله: ﴿ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ تعليق للحكم بكونهم يقاتلوننا، فدل على أن هذا علة الأمر بالقتال، وقوله: ﴿وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ﴾ فسره بعض العلماء بقتال من لم يقاتل وبالمثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والرهبان والشيوخ وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان، فدل على أن قتال من لم يقاتل عدوان، وهذه الآية هي محكمة وليست منسوخة على قول الجمهور، ثم استدل بقوله: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 193]. قال: والفتنة أن يفتن المسلم عن دينه كما كان المشركون يفتنون كل من أسلم عن دينه بصده عنه، ولهذا قال: ﴿وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِ﴾ [البقرة: 191].
وقوله: ﴿وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ﴾ وهذا يحصل إذا ظهرت كلمة الإسلام وكان حكم الله ورسوله غالبًا، فإنه قد صار الدين لله. وأما قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»([1]). هو ذكر للغاية التي يباح قتالهم إليها بحيث إذا فعلوها حرم قتالهم. وليس المراد منه أني أمرت أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغاية، فإن هذا خلاف النص والإجماع، فإنه لم يفعل هذا قط بل كانت سيرته أن من سالمه لم يقاتله. انتهى.
وقال أيضًا في السياسة الشرعية: وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة، كالنساء والصبيان والرهبان والشيخ الكبير والأعمى والزمنى ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر. والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠﴾ [البقرة: 190]. وفي السنن أن النبي ﷺ مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه وقد وقف عليها الناس، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». وفيها أيضًا عنه ﷺ أنه كان يقول: «لا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلاً صغيرًا ولا امرأة». وذلك أن الله سبحانه أباح من قتل النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق، والفتنة أكبر من القتل، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. انتهى.
إن الإسلام جعله الله رحمة للعالمين، وقد حرم حرب الاعتداء والظلم، وقصر الحرب المشروعة على تقرير المصالح ودفع المفاسد؛ لأن الإسلام هو دين السلم والسلام، ولا يمكن تمتع العالم بالسعادة والراحة والرحمة إلا بهداية الإسلام، وقد أمر الله عباده بأن يؤثروا السلم على الحرب، فقال تعالى: ﴿۞وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ﴾ [الأنفال: 61]. لأن الإسلام يكره إراقة الدماء إلا لضرورة تقتضيها المصالح ودفع المضار، والضرورة تقدر بقدرها. ولهذا أمر الله عباده المؤمنين بأن يشدوا الحملة بالقوة والشدة في حالة قتال عدوهم، وأن يتصفوا بما وصفهم الله به بقوله: ﴿أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡ﴾ [الفتح: 29].
ومتى كان الغلب لهم في القتال واستولوا على عدوهم فإنه ينبغي أن يكفوا عن القتل ويكتفوا بالأسر، ثم ينظروا في أمر الأسرى على سبيل التخيير، إما بالمن عليهم بإطلاقهم بدون فداء كما منّ رسول الله على قريش وأهل مكة فقال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»([2]). وإما بأخذ الفداء منهم كما أخذ النبي من أسرى بدر، قال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَا﴾ [محمد:4]. ولم يقل: فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ولا تطلقوهم حتى يسلموا أو يقتلوا، كما يقوله من يرى أن القتال سببه الكفر.
وقد أذاع أعداء الإسلام فيما تجنوا به على الإسلام أن القرآن يأمر أتباعه بأن يقتلوا الكفار حيثما لقوهم مستدلين بمثل هذه الآية، حتى إن علماء النصارى والمبشرين منهم يلقون هذا الكلام في معرض طعنهم على الإسلام لقصد التنفير عنه وعن المنتسبين إليه.
وإنما المراد من هذه الآية وأمثالها هو لقاء المحاربين للدين وللمسلمين لكون الكفار في شرع الإسلام ثلاثة أصناف: محاربون للمسلمين فيقتلون حيثما ثقفوا كما يفعلون بنا. ومعاهدون ومنهم المسالمون فلا نتعرض لهم مدة عهدهم ما استقاموا عليه. وذميون لهم ما للمسلمين، فالإسلام يسوي بينهم وبين المسلمين في جميع أحكامه القضائية؛ يوجب حمايتهم والدفاع عنهم حتى بالقتال، وحرمة مالهم ودمائهم كحرمة المسلمين ودمائهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
وقد رُفع إلى العلامة ابن القيم رحمه الله مسألة حاصلها هو: أنه تخاصم رجل مسلم مع رجل نصراني في قضية فلم يجد النصراني عند المسلم ما يشفيه، ولا وقع دواؤه على الداء الذي فيه، وظن المسلم أنه بضربه يداويه، فسطا به المسلم ضربًا وقال: هذا جواب مسألتك. فقال النصراني: صدق قومنا إذ يقولون: إنما قام الإسلام بالسيف ولم يقم بالكتاب. فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب، وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب.
قال: فشمر المجيب عن ساعد العزم ونهض على ساق الجد ولم يقل مقالة العجزة الجهال: إن الكفار إنما يعاملون بالجلاد دون الجدال، فإن هذا فرار من الزحف، وإخلاد إلى الضعف. وقد أمر الله بمجادلة الكفار بعد دعوتهم إقامة للحجة وإزاحة للعذر؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة.
ولأجل هذه القضية عمل العلامة ابن القيم عمله في تأليف كتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى وجعله كالجواب للقائلين: إن دين الإسلام إنما قام بالسيف ولم يقم بالكتاب، وكلامه فيه يوافق ويطابق كلام شيخ الإسلام في رسالته قتال الكفار كما تراه مفصلاً فيما يلي:
قال العلامة ابن القيم رحمه الله([3]): أكثر الأمم دخولاً في الإسلام طوعًا ورغبةً واختيارًا لا كرهًا ولا اضطرارًا، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا ﷺ رسولاً إلى أهل الأرض وهم خمسة أصناف قد طبقوا الأرض؛ يهود ونصارى ومجوس وصابئة ومشركون. وهذه الأصناف هي التي كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى مغاربها.
فأما اليهود فأكثر ما كانوا باليمن وخيبر والمدينة وما حولها، وكانوا بأطراف الشام مستذلين مع النصارى، وكان منهم بأرض العرب فرقة، وأعز ما كانوا بالمدينة وخيبر، وكان الله سبحانه قد قطعهم في الأرض أممًا وسلبهم الملك والعز.
وأما النصارى فكانوا أطبق الأرض فكانت الشام كلها نصارى، وأرض المغرب كان الغالب عليهم النصارى، وكذلك أرض مصر والحبشة والجزيرة وأرض نجران وغيرها من البلاد.
وأما المجوس فهم أهل مملكة فارس وما اتصل بها.
وأما الصابئة فأهل حران وكثير من بلاد الروم.
وأما المشركون فجزيرة العرب جميعها وبلاد الهند وبلاد الترك وما جاورها، وأديان أهل الأرض لا تخرج عن هذه الأديان الخمسة. ودين الحنفاء لا يعرف فيهم البتة.
وهذه الأديان الخمسة كلها للشيطان، كما قال ابن عباس وغيره: الأديان ستة واحد للرحمن وخمسة للشيطان، وهذه الأديان الستة هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلۡمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡصِلُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ١٧﴾ [الحج: 17]. فلما بعث الله رسوله ﷺ استجاب له ولخلفائه من بعده أكثر أهل هذه الأديان طوعًا واختيارًا، ولم يكره أحدًا على الدين، وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله، ولم يكرهه على الدخول في دينه؛ امتثالا لأمر ربه سبحانه حيث يقول: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ﴾ [البقرة: 256]. وهذا نفي في معنى النهي؛ أي لا تكرهوا أحدًا على الدين، نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين فنهاهم الله سبحانه عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام، والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر، وهذا ظاهر على قول كل من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار فلا يكرهون على الدخول في الدين. بل إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة، وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان.
وكل من تأمل سيرة النبي ﷺ تبين له أنه لم يكره أحدًا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله وأما من هادنه فإنه لم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته، ولم ينقض عهده بل أمره الله أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال تعالى: ﴿فَمَا ٱسۡتَقَٰمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡ﴾ [التوبة: 7]. ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهدهم وبدؤوه بالقتال قاتلهم، فمنَّ على بعضهم، وأجلى بعضهم، وقتل بعضهم. وكذلك لما عاهد قريشًا عشر سنين لم يبدأهم بالقتال حتى بدؤوا هم بقتاله، نقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديارهم، وكانوا يغزونه قبل ذلك، كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق ويوم بدر.
والمقصود أنه ﷺ لم يكره أحدًا على الدخول في دينه البتة وإنما دخل الناس في دينه اختيارًا وطوعًا، فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدى وأنه رسول الله حقًّا، فهؤلاء أهل اليمن كانوا على دين اليهودية ثم دخلوا في دين الإسلام من غير رغبة ولا رهبة. فلم يسلموا رغبة في الدنيا ولا رهبة من السيف، بل أسلموا في حال ضعف المسلمين وكثرة أعدائهم ومحاربة أهل الأرض لهم من غير سوط ولا نوط، بل تحملوا معاداة أقربائهم وحرمانهم نفقتهم بالمال والبدن، فكان أحدهم يعادي أباه وأمه وأهل بيته وعشيرته، ويخرج من الدنيا رغبة في الإسلام، لا لرياسة ولا لمال، بل ينخلع من الرياسة والمال، ويتحمل أذى الكفار من ضربهم وشتمهم وصنوف أذاهم ولا يصرفه ذلك عن دينه. وهؤلاء نصارى الشام كانوا ملء الشام، ثم صاروا مسلمين إلا النادر، وكذلك المجوس كانت أمة لا يحصى عددهم إلى الله فأطبقوا على الإسلام، ولم يتخلف منهم إلا النادر، وصارت بلادهم بلاد إسلام، وصار من لم يسلم منهم تحت الجزية والذلة.
فرقعة الإسلام إنما انتشرت في الشرق والغرب بإسلام أكثر الطوائف، حيث دخلوا في دين الله أفواجًا. حتى صار الكفار معهم تحت الذلة والصغار، وقد تبين أن الذين أسلموا من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين أكثر من الذين لم يسلموا، وأنه إنما بقي منهم على الكفر أقل القليل. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله.
* * *
-----------------------------------------
[1] متفق عليه من حديث أبي هريرة. [2] سيرة ابن هشام 2/412. [3] من هداية الحيارى (ص22).
قرأت موضوعا قيما بقراءة مختلفة تماما عن قراءة شيوخ القتل وقطع الرؤوس وإراقة الدماء في سبيل الله عدوانا على الأبرياء المختلفين في الدين والذي اصطلح الفقهاء عليه باسم [جهاد الطلب [ ، الذي بعنى مطلقا غزو بلاد الكفار لنشر الإسلام فيه عنوة وغصبا .
بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد الله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أما بعد:
فقد حصل النزاع بين بعض الإخوان والمشايخ الكرام في الرسالة المنسوبة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة قتال الكفار، وأن القتال إنما شرع للدفاع عن الدين، وكف أذى المعتدين على المؤمنين، وأن الإسلام يُسالم من يسالمه.
فاستنكر هذا القول واستكبره بعض العلماء المتأخرين، حتى خرج لإنكاره كتابان من عالمين جليلين يحققان فيهما أن هذه الرسالة مكذوبة على شيخ الإسلام، وأنها ليست من كلامه لاعتقادهما أن القتال سببه الكفر. وعلى أثر هذا التكذيب للرسالة ساءت السمعة بسائر رسائل شيخ الإسلام رحمه الله.
ونحن بكلامنا في تحقيق هذه الرسالة لسنا نريد التصدي للانتصار لشيخ الإسلام في كل ما يقوله في الرسالة وغير الرسالة، وإنما نؤم علم الحق متى رُفِعَ لنا لنكون تحت لوائه ومن أنصاره وأعوانه.
°°°لقد عشنا زمانًا طويلاً ونحن نعتقد ما يعتقده بعض العلماء وأكثر العوام من أن قتال الكفار سببه الكفر، وأن الكفار يقاتلون حتى يسلموا، لكننا بعد توسعنا في علم الكتاب والسنة، والوقوف على سيرة الرسول ﷺ وأصحابه في حروبهم وفتوحهم للبلدان، تبدل رأينا وتحققنا بأن القتال في الإسلام إنما شرع دفاعًا عن الدين ودفع أذى المعتدين على المؤمنين، وليس هذا بالظن ولكنه اليقين. قال شيخ الإسلام في رسالته: الصحيح أن القتال شرع لأجل الحرب لا لأجل الكفر، وهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، وهو مقتضى الاعتبار، وذلك أنه لو كان الكفر هو الموجب للقتال لم يجز إقرار كافر بالجزية. انتهى.
°°°فمن زعم أن لشيخ الإسلام كلامًا يخالف هذا في السياسة الشرعية أو في الجواب الصحيح فقد غلط عليه وأدلى بما لم يحط بعلمه.
وقد قال بعض العلماء من المتأخرين: إن دعوى القتال للإكراه على الدين إنما دخل على المسلمين عن طريق النصارى، حيث كانوا يشنعون به دائمًا على الإسلام والمسلمين، ويجعلونه في مقدمة تبشيرهم إلى دينهم، وينشرونه في كتبهم ويلقنونه للطلاب في مدارسهم، لقصد تنفير الناس عن دين الإسلام واحتقاب العداوة لأهله، فهو أكبر مطاعن النصارى على الإسلام وعلى المسلمين. فسرى هذا إلى اعتقاد بعض العلماء وأكثر العامة؛ لظنهم أنه صحيح واقع، ومن طبيعة البشر كراهة اسم الإكراه والإجبار مهما كانت عاقبته، وصاروا يتناقلون هذا القول في كتبهم حتى رسخ في قلوب العامة وبعض العلماء.
°°°وإننا متى قلنا بهذا القول فقد اشتركنا مع القسيسين والمبشرين في التنفير من الدين، وإنه ينبغي لنا متى تصدينا للدعوة إلى دين الإسلام أن نصف الإسلام بما هو أهله، وبما هو معلوم عن محاسنه، واتصافه بالرأفة والرحمة لسائر الناس؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ [الأنبياء: 107]. - أي للخلق أجمعين - بدلاً من أن نصفه بالعقاب والشدة لكل من لقيه من الكفار. فنصفه بأنه دين البشرية كلهم عربهم وعجمهم لا دين لهم سواه؛ لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُ﴾ [آل عمران: 19]. وقال: ﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴾ [البقرة: 85].
°°°فهو دين الله الذي ارتضاه لجميع خلقه، فقال سبحانه: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾ [المائدة: 3]. لأنه دين الرحمة المهداة من الله لجميع الناس بواسطة محمد ﷺ. فهو دين الحق الذي نظم أحوال الناس في حياتهم وبعد وفاتهم أحسن تنظيم. صالح لكل زمان ومكان، وقد سماه الله سلمًا فقال سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ﴾ [البقرة: 208]. فهو يحب السلم ويكره الحرب إلا في حالة الضرورة.
°°°فلا يكره أحدًا على الدخول فيه لكون الدين هداية اختيارية لا إكراه فيها ولا إجبار، يقول الله سبحانه: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ﴾ [البقرة: 256]. وقال: ﴿أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ﴾ [يونس: 99]. ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ﴾ فيؤمن به وبأمره ونهيه، ﴿وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا﴾ [الأنعام: 125]. عن أمره ونهيه وفرائضه ونوافله.
°°°إن الإسلام يُسالم من يسالمه ولا يقاتل إلا من يقاتله أو يمنع نشر دعوته ويقطع السبيل في منع إبلاغها للناس، فإنهم بمنعهم إبلاغها يعتبرون معتدين على الدين وعلى الخلق أجمعين؛ لأن الله سبحانه أمر بإبلاغ هذا الدين وتبشير جميع خلقه به فقال سبحانه: ﴿لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ﴾ [الأنعام: 19]. فمتى أقبل دعاة الإسلام على بلد ليدعوا أهلها إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلوهم بالتي هي أحسن، فإن فُتح لهم الباب وسهل لهم الجناب وأذن لهم بالدخول ونشر الدعوة، فهذا غاية ما يبتغون، وبذلك فليفرح المؤمنون، فلا قتل ولا قتال، وكل الناس آمنون على دمائهم وأموالهم، وقد فتح المسلمون كثيرًا من البلدان بهذه الصفة، مما يسمى صلحًا.
°°°أما إذا نصبت لهم المدافع، ووجهت نحوهم أفواه البنادق، وسلت في وجوههم السيوف، ومنع الدعاة منعًا باتًّا عن حرية نشر دعوتهم وعن الاتصال بالناس في إبلاغهم دين الله الذي فيه سعادتهم وسعادة البشر كلهم، فإنهم يعتبرون حينئذٍ معتدين على الدين وعلى الخلق أجمعين.
فعند ذلك يعتبر المسلمون مكلفين من الله باقتحام كل شدة ومشقة، وخوض كل خطر وضرر في سبيل الله، وفي سبيل إبلاغ دين الله حتى يزول المنع والاضطهاد والفتنة عن الدين، يقول الله سبحانه: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 193]. وقال: ﴿وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِ﴾ [البقرة: 191].
﴿ذَٰلِكَۖ وَلَوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَاْ بَعۡضَكُم بِبَعۡضٖ﴾ [محمد: 4]. فقتالهم والحالة هذه هو في سبيل الله، ولا يبالون بما أصابهم في ذات الله؛ لأن الله سبحانه قد اشترى من المؤمنين أنفسهم في سبيل نشر دين ربهم وإعلاء كلمته، فهم يتمنون الشهادة في سبيل الله كما يتمنى أكثر الناس الحياة؛ لعلمهم أن لهم حياة أخرى هي أبقى وأرقى من حياتهم في الدنيا، وقد باعوا أنفسهم لله في سبيل الحصول عليها، يقول سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴾ [التوبة: 111]. فهذا طريق دعوتنا إلى دين الإسلام.
وقد سئل النبي ﷺ عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى.
°°°يبقى الكلام في البحث عن حقيقة رسالة شيخ الإسلام في قتال الكفار وعدم نسبتها إليه، فقد تحصلت والحمد لله على هذه الرسالة، ووقفت على حقيقة ما تقتضيه من الدلالة، فوجدتها صحيحة في معناها وحسنة في مبناها، ويظهر من دلائل استنباطاته وبراهين بيناته أنها خرجت من مشكاة معلوماته، وكل متخصص بدراسة كتبه فإنه سيعرف منها ما عرفنا؛ لكون عباراته لا يماثلها كلام غيره، وقد وافق العلامة ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية، وحقق أن الإسلام لا يكره أحدًا على الدخول فيه، وأنه يسالم من سالم، كما سيأتي كلامه مستوفى عن قريب إن شاء الله.
فدعوى التزوير بعيدة جدًّا عنها، فلا تحوم التهمة والشك حولها، وقد قال في كتابه السياسة الشرعية ما يوافق قوله في هذه الرسالة حيث قال: إن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، فمن لم يمنع مسلمًا من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. كما سيأتي كلامه مستوفى في موضعه.
وقد قيض الله سبحانه لحفظ رسائل شيخ الإسلام وكتبه علماء جهابذة نقادًا في زمانه يحبهم ويحبونه، فكانوا يعتنون أشد الاعتناء بنقل كتبه ورسائله ثم نشرها في الآفاق، كما قيض الله له أميرًا عدلاً في زمانه، كان يحث العلماء على التحفظ بكتب شيخ الإسلام والاعتناء بنقلها. وأشد من بالغ في هذا الأمر هو العالم الإمام شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي أحد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فقد وجه نداء إلى العلماء في زمانه قرب وفاة شيخ الإسلام قائلاً فيه: لا تنسوا تقريرات شيخنا الحاذق الناقد الصادق قدس الله روحه، فالطريق في حقه هو الاجتهاد العظيم في كتابة مؤلفاته الصغار والكبار على جليتها وحالها من غير اختصار ولا تصرف فيها، ولو وجد فيها كثير من التكرار، ومقابلتها بنظائرها، ثم إشاعتها ونشرها لعموم الانتفاع بها. واحتفظوا بالشيخ أبي عبد الله -يعني ابن القيم- وبما عنده من الذخائر والنفائس، وأقيموا لهذا الأمر المهم الجليل أكثر ما تقدرون عليه؛ لأنه قد بقي وحيدا في فنه، فريدًا في دهره، ولا يقوم غيره مقامه من سائر الجماعات، وكل أحوال الوجود لا بد فيها من العوارض والأنكاد، فاحتسبوا مساعدته عند الله واكتبوا ما عنده وليكتب ما عندكم، وأنا أستودع الله دينه ودينكم، وما عنده وعندكم، والسلام عليكم. انتهى.
وأقول عن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله: إن كل عالم مخلص خلي من الغرض والهوى يعترف بكبر قدره، وغزارة بحره، وتوسعه في العلوم العقلية والنقلية، وفرط ذكائه واجتهاده، وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف.
ولا ينفرد بمسألة كمسألة قتال الكفار أو غيرها بمجرد التشهي بدون دليل، بل يحتج على ما يقول بالقرآن والحديث والقياس.
ولم يسجل التاريخ في مشارق الأرض ومغاربها بعد رسول الله وخلفائه وأصحابه أكثر مما سجل له من قوة الإبداع، وتجلية الحق، والبصيرة في النقد، والعدالة في الحكم، ومطابقة النقل للعقل.
وقد تصدى لمحاربة البدع على اختلاف أنواعها حيث غزاها في عقر دارها وفند آراء المؤيدين لها.
عاش رحمه الله في زمان قد تفرق أهله في النزاعات والمذاهب والآراء، فحمل راية الإسلام بالحجة والبيان، والسنة والقرآن، والسيف والسنان، مما جعله في مقدمة الأبطال الذين جاهدوا في الله حق جهاده، فهو بطل دين، وعلم من أعلام الفكر العالي بآرائه الحرة التي لا تخرج غالبًا عن حدود الحق، ولكنه لم يسلم من أذى الخلق في زمانه وفي هذا الزمان، سنة الله في ابتلاء المجاهدين في سبيله، يقول الله تعالى: ﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتَّىٰ نَعۡلَمَ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبۡلُوَاْ أَخۡبَارَكُمۡ ﴾ [محمد: 31].
إن الناس يستفيدون من المتحررة آراؤهم والمستقلة أفكارهم في حدود الحق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأشباههما، أكثر مما يستفيدون من المقلدة لشيوخهم وعلماء مذاهبهم؛ إذ المستقل بفكره هو من يستفيد من بحث غيره بصيرة وفكرة وزيادة معرفة، ولا يقلدهم في كل قول يقولونه، وإنما يعمل بما ظهر له من الحق، فعدم وجود المستقلين ضار بالإسلام والمسلمين؛ لأنهم حملة الحجة والبرهان. والمقلد لا حجة له، وإنما غاية علمه وعمله أن ينقل حجة غيره، فإذا طرأت شبهة على الدين كهذه لم يجد جوابًا لها منقولاً عمن يقلدهم من الفقهاء، فيبقى حائرًا محجوجًا مبهوتًا، أو يستدل بما لم يحط بعلمه.
ولم يتناول دُرة الحق غائصٌ
من الناسِ إلا بالروية والفكر
°°°إن طريق الانتفاع بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المجتهدين هو أن يفرغ الإنسان قلبه مما يعتقده قديمًا مما قد يظن في نفسه أنه حق، ثم يقدر الاحتمال لعدم صحة ما يعتقده، فينظر من جديد في الأدلة التي يوردها المجتهد بدون أن يتلقاها بالنفرة والكراهية الشديدة لها، فإن الإنسان إذا اشتدت كراهيته للشيء لم يكد يسمعه ولا يبصره، فيفوت عليه مقصوده وثمرته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة قتال الكفار:اختلف العلماء في قتال الكفار وهل سببه المقاتلة أو مجرد الكفر على قولين مشهورين للعلماء.
أحدهما: سبب المقاتلة هو الاعتداء على الدين وأهله، وهذا هو قول الجمهور كمالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم.
والثاني: أن سببه الكفر، وهو قول الشافعي، وربما علل به بعض أصحاب أحمد من أن السبب في القتال مجرد الكفر.
قال: وقول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقَٰاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ﴾ [البقرة:190].
فقوله: ﴿ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ تعليق للحكم بكونهم يقاتلوننا، فدل على أن هذا علة الأمر بالقتال، وقوله: ﴿وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ﴾ فسره بعض العلماء بقتال من لم يقاتل وبالمثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والرهبان والشيوخ وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان، فدل على أن قتال من لم يقاتل عدوان، وهذه الآية هي محكمة وليست منسوخة على قول الجمهور، ثم استدل بقوله: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 193]. قال: والفتنة أن يفتن المسلم عن دينه كما كان المشركون يفتنون كل من أسلم عن دينه بصده عنه، ولهذا قال: ﴿وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِ﴾ [البقرة: 191].
وقوله: ﴿وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ﴾ وهذا يحصل إذا ظهرت كلمة الإسلام وكان حكم الله ورسوله غالبًا، فإنه قد صار الدين لله. وأما قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»([1]). هو ذكر للغاية التي يباح قتالهم إليها بحيث إذا فعلوها حرم قتالهم. وليس المراد منه أني أمرت أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغاية، فإن هذا خلاف النص والإجماع، فإنه لم يفعل هذا قط بل كانت سيرته أن من سالمه لم يقاتله. انتهى.
وقال أيضًا في السياسة الشرعية: وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة، كالنساء والصبيان والرهبان والشيخ الكبير والأعمى والزمنى ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر. والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠﴾ [البقرة: 190]. وفي السنن أن النبي ﷺ مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه وقد وقف عليها الناس، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». وفيها أيضًا عنه ﷺ أنه كان يقول: «لا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلاً صغيرًا ولا امرأة». وذلك أن الله سبحانه أباح من قتل النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق، والفتنة أكبر من القتل، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. انتهى.
إن الإسلام جعله الله رحمة للعالمين، وقد حرم حرب الاعتداء والظلم، وقصر الحرب المشروعة على تقرير المصالح ودفع المفاسد؛ لأن الإسلام هو دين السلم والسلام، ولا يمكن تمتع العالم بالسعادة والراحة والرحمة إلا بهداية الإسلام، وقد أمر الله عباده بأن يؤثروا السلم على الحرب، فقال تعالى: ﴿۞وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ﴾ [الأنفال: 61]. لأن الإسلام يكره إراقة الدماء إلا لضرورة تقتضيها المصالح ودفع المضار، والضرورة تقدر بقدرها. ولهذا أمر الله عباده المؤمنين بأن يشدوا الحملة بالقوة والشدة في حالة قتال عدوهم، وأن يتصفوا بما وصفهم الله به بقوله: ﴿أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡ﴾ [الفتح: 29].
ومتى كان الغلب لهم في القتال واستولوا على عدوهم فإنه ينبغي أن يكفوا عن القتل ويكتفوا بالأسر، ثم ينظروا في أمر الأسرى على سبيل التخيير، إما بالمن عليهم بإطلاقهم بدون فداء كما منّ رسول الله على قريش وأهل مكة فقال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»([2]). وإما بأخذ الفداء منهم كما أخذ النبي من أسرى بدر، قال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَا﴾ [محمد:4]. ولم يقل: فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ولا تطلقوهم حتى يسلموا أو يقتلوا، كما يقوله من يرى أن القتال سببه الكفر.
وقد أذاع أعداء الإسلام فيما تجنوا به على الإسلام أن القرآن يأمر أتباعه بأن يقتلوا الكفار حيثما لقوهم مستدلين بمثل هذه الآية، حتى إن علماء النصارى والمبشرين منهم يلقون هذا الكلام في معرض طعنهم على الإسلام لقصد التنفير عنه وعن المنتسبين إليه.
وإنما المراد من هذه الآية وأمثالها هو لقاء المحاربين للدين وللمسلمين لكون الكفار في شرع الإسلام ثلاثة أصناف: محاربون للمسلمين فيقتلون حيثما ثقفوا كما يفعلون بنا. ومعاهدون ومنهم المسالمون فلا نتعرض لهم مدة عهدهم ما استقاموا عليه. وذميون لهم ما للمسلمين، فالإسلام يسوي بينهم وبين المسلمين في جميع أحكامه القضائية؛ يوجب حمايتهم والدفاع عنهم حتى بالقتال، وحرمة مالهم ودمائهم كحرمة المسلمين ودمائهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
وقد رُفع إلى العلامة ابن القيم رحمه الله مسألة حاصلها هو: أنه تخاصم رجل مسلم مع رجل نصراني في قضية فلم يجد النصراني عند المسلم ما يشفيه، ولا وقع دواؤه على الداء الذي فيه، وظن المسلم أنه بضربه يداويه، فسطا به المسلم ضربًا وقال: هذا جواب مسألتك. فقال النصراني: صدق قومنا إذ يقولون: إنما قام الإسلام بالسيف ولم يقم بالكتاب. فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب، وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب.
قال: فشمر المجيب عن ساعد العزم ونهض على ساق الجد ولم يقل مقالة العجزة الجهال: إن الكفار إنما يعاملون بالجلاد دون الجدال، فإن هذا فرار من الزحف، وإخلاد إلى الضعف. وقد أمر الله بمجادلة الكفار بعد دعوتهم إقامة للحجة وإزاحة للعذر؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة.
ولأجل هذه القضية عمل العلامة ابن القيم عمله في تأليف كتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى وجعله كالجواب للقائلين: إن دين الإسلام إنما قام بالسيف ولم يقم بالكتاب، وكلامه فيه يوافق ويطابق كلام شيخ الإسلام في رسالته قتال الكفار كما تراه مفصلاً فيما يلي:
قال العلامة ابن القيم رحمه الله([3]): أكثر الأمم دخولاً في الإسلام طوعًا ورغبةً واختيارًا لا كرهًا ولا اضطرارًا، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا ﷺ رسولاً إلى أهل الأرض وهم خمسة أصناف قد طبقوا الأرض؛ يهود ونصارى ومجوس وصابئة ومشركون. وهذه الأصناف هي التي كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى مغاربها.
فأما اليهود فأكثر ما كانوا باليمن وخيبر والمدينة وما حولها، وكانوا بأطراف الشام مستذلين مع النصارى، وكان منهم بأرض العرب فرقة، وأعز ما كانوا بالمدينة وخيبر، وكان الله سبحانه قد قطعهم في الأرض أممًا وسلبهم الملك والعز.
وأما النصارى فكانوا أطبق الأرض فكانت الشام كلها نصارى، وأرض المغرب كان الغالب عليهم النصارى، وكذلك أرض مصر والحبشة والجزيرة وأرض نجران وغيرها من البلاد.
وأما المجوس فهم أهل مملكة فارس وما اتصل بها.
وأما الصابئة فأهل حران وكثير من بلاد الروم.
وأما المشركون فجزيرة العرب جميعها وبلاد الهند وبلاد الترك وما جاورها، وأديان أهل الأرض لا تخرج عن هذه الأديان الخمسة. ودين الحنفاء لا يعرف فيهم البتة.
وهذه الأديان الخمسة كلها للشيطان، كما قال ابن عباس وغيره: الأديان ستة واحد للرحمن وخمسة للشيطان، وهذه الأديان الستة هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلۡمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡصِلُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ١٧﴾ [الحج: 17]. فلما بعث الله رسوله ﷺ استجاب له ولخلفائه من بعده أكثر أهل هذه الأديان طوعًا واختيارًا، ولم يكره أحدًا على الدين، وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله، ولم يكرهه على الدخول في دينه؛ امتثالا لأمر ربه سبحانه حيث يقول: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ﴾ [البقرة: 256]. وهذا نفي في معنى النهي؛ أي لا تكرهوا أحدًا على الدين، نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين فنهاهم الله سبحانه عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام، والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر، وهذا ظاهر على قول كل من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار فلا يكرهون على الدخول في الدين. بل إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة، وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان.
وكل من تأمل سيرة النبي ﷺ تبين له أنه لم يكره أحدًا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله وأما من هادنه فإنه لم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته، ولم ينقض عهده بل أمره الله أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال تعالى: ﴿فَمَا ٱسۡتَقَٰمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡ﴾ [التوبة: 7]. ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهدهم وبدؤوه بالقتال قاتلهم، فمنَّ على بعضهم، وأجلى بعضهم، وقتل بعضهم. وكذلك لما عاهد قريشًا عشر سنين لم يبدأهم بالقتال حتى بدؤوا هم بقتاله، نقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديارهم، وكانوا يغزونه قبل ذلك، كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق ويوم بدر.
والمقصود أنه ﷺ لم يكره أحدًا على الدخول في دينه البتة وإنما دخل الناس في دينه اختيارًا وطوعًا، فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدى وأنه رسول الله حقًّا، فهؤلاء أهل اليمن كانوا على دين اليهودية ثم دخلوا في دين الإسلام من غير رغبة ولا رهبة. فلم يسلموا رغبة في الدنيا ولا رهبة من السيف، بل أسلموا في حال ضعف المسلمين وكثرة أعدائهم ومحاربة أهل الأرض لهم من غير سوط ولا نوط، بل تحملوا معاداة أقربائهم وحرمانهم نفقتهم بالمال والبدن، فكان أحدهم يعادي أباه وأمه وأهل بيته وعشيرته، ويخرج من الدنيا رغبة في الإسلام، لا لرياسة ولا لمال، بل ينخلع من الرياسة والمال، ويتحمل أذى الكفار من ضربهم وشتمهم وصنوف أذاهم ولا يصرفه ذلك عن دينه. وهؤلاء نصارى الشام كانوا ملء الشام، ثم صاروا مسلمين إلا النادر، وكذلك المجوس كانت أمة لا يحصى عددهم إلى الله فأطبقوا على الإسلام، ولم يتخلف منهم إلا النادر، وصارت بلادهم بلاد إسلام، وصار من لم يسلم منهم تحت الجزية والذلة.
فرقعة الإسلام إنما انتشرت في الشرق والغرب بإسلام أكثر الطوائف، حيث دخلوا في دين الله أفواجًا. حتى صار الكفار معهم تحت الذلة والصغار، وقد تبين أن الذين أسلموا من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين أكثر من الذين لم يسلموا، وأنه إنما بقي منهم على الكفر أقل القليل. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله.
* * *
-----------------------------------------
[1] متفق عليه من حديث أبي هريرة. [2] سيرة ابن هشام 2/412. [3] من هداية الحيارى (ص22).
من مواضيعي
0 دواعش كرة القدم ؟!
0 الصراع اللغوي في الجزائر ... قَاطع تُقاطع .
0 إغتيال (جمال غاشقجي) أهو ترهيب للفكر الحر ؟
0 ثورة التحرير وقيم الحرية والتنوع .
0 الأمازيغية ... مرفوضة بين أهاليها ؟؟ !
0 كرة قدم مستفزة !
0 الصراع اللغوي في الجزائر ... قَاطع تُقاطع .
0 إغتيال (جمال غاشقجي) أهو ترهيب للفكر الحر ؟
0 ثورة التحرير وقيم الحرية والتنوع .
0 الأمازيغية ... مرفوضة بين أهاليها ؟؟ !
0 كرة قدم مستفزة !
التعديل الأخير تم بواسطة الأمازيغي52 ; 24-12-2015 الساعة 11:17 AM