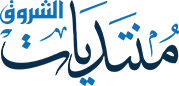لماذا نثق في بعض "الحقائق" المختلقة؟
09-10-2015, 08:09 AM
سيدني فينكلشتين
أستاذ في علوم الإدارة

لماذا يتصرف أناسٌ تبدو عليهم سيماء الذكاء والمقدرة وكأنهم يؤمنون بأن الوقائع الملفقة والوهمية هي حقائق لا يرقى إليها أي شك؟
إذا كانت مسألة بدء عمل تجاري أو إدارة شركة قائمة بالفعل عسيرة بما يكفي حتى دون أن يكبد المرء نفسه عناء اختلاق شيء ما ولو حتى على سبيل المزاح؛ لذا لماذا يصدق المديرون في بعض الأحيان كل هذه الضروب من الأشياء غير الحقيقية، حتى وإن كان ذلك سيلحق بهم أذى؟
مع ذلك، فإن استخدام "حقائق" ووقائع مختلقة يشكل سمة من سمات العمل في المجالين السياسي والاقتصادي، في عدد لا يحصى ولا يعد من المواقف والحالات.
وعلى سبيل المثال، فخلال اجتماع استثنائي لحملة الأسهم في مصرف (بانك أوف أمريكا)، أدى سعي الرئيس التنفيذي للمصرف بريان موينيهان لأن يصبح كذلك رئيسا لمجلس إدارة المصرف، إلى اندلاع معركة طاحنة مع مسؤولي صناديق التقاعد وغيرهم من ممثلي المؤسسات الاستثمارية، المشاركة في المصرف الأمريكي، ممن يعارضون مثل هذه الخطوة.
لكن الجانب المثير للتساؤل من فرط غرابته هنا يكمن في أن الشركات التي يشغل فيها شخص واحد منصبيّ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لا تختلف نتائجها بالسلب أو الإيجاب عن تلك التي يُعطى فيها المنصبان لشخصين مختلفين.
وهنا يُطرح السؤال: لماذا يجلب المرء على نفسه احتجاجات من قبل أطراف عدة بسبب سعيه لإجراء تغيير هيكلي قيادي لن يؤدي حتى إلى إحداث أي فارق؟ ما ذكرناه سلفا ليس سوى مثال واحد من بين أمثلة كثيرة على إقدام مسؤول أو قائد ما على إثارة عشٍ الدبابير دون وجود أي حقائق تعضد تصرفاته أو أفعاله.
رحلة إلى عالم اختلاق الوقائع
لماذا يتصرف أناسٌ تبدو عليهم سيماء الذكاء والمقدرة وكأنهم يؤمنون بأن الوقائع الملفقة والوهمية هي حقائق لا يرقى إليها أي شك؟
يعود هذا إلى السبب نفسه الذي يحدو الساسة الطامحين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري الأمريكي لانتخابات الرئاسة المقبلة للمطالبة - على نحو موحد تقريبا – بخفض معدلات ما يُعرف بـ"الضريبة الهامشية" في البلاد، بدعوى أن ذلك سيعزز النمو الاقتصادي، رغم وجود أدلة تعود إلى فترات إدارة رونالد ريغان وبيل كلينتون وجورج بوش الابن تشير إلى أن اتباع هذه السياسة لا يؤدي سوى إلى تفاقم التفاوت بين الدخول.
كما أنه السبب نفسه الذي يدفع ساسة من أمثال الرئيس فرانسوا أولوند في فرنسا، والزعيم العمالي جيرمي كوربين في بريطانيا، والسياسي اليساري بيرني ساندرز في الولايات المتحدة، إلى الدعوة لاضطلاع حكومات بلدانهم بدور أكثر نشاطا في المجتمع.
جاء ذلك برغم الأدلة التي تفيد بوجود أوجه قصور فادحة وانهيارات تشوب الخدمات والقطاعات التي تديرها الحكومة في هذه الدول، مثل المدارس العامة في فرنسا وخدمة الرعاية الصحية الوطنية في بريطانيا، وكذلك النهج الذي يتم من خلاله إدارة الحروب في الولايات المتحدة.
جواب هذه المعضلة يكمن في تبني هؤلاء الساسة مذهبا فكريا أو بالأحرى أيديولوجية ما تحكم تصرفاتهم ونظرتهم لما حولهم. ويمكن تعريف الأيديولوجية بأنها رؤية يحدد المرء من خلالها ما يراه صوابا أو خطأً، وهي رؤية تكون عادة مفعمة بالقوة لا تتزعزع ولو قيد أنملة، وتكتسي بطابع أصولي متعصب.

الأكثر من ذلك أن تلك الرؤية لا يقلقلها دليل تجريبي أو منطق مضاد محكم البنية ومُصاغ بعناية. وهكذا ففي شؤون الحكم – كما في شؤون الاقتصاد والتجارة – يعوق تبني هذه الرؤى الأيديولوجية تكيف المرء مع المتغيرات من حوله، ويجعل تحركاته تفتقر إلى الرشاقة والخفة.
وعلى هذه الشاكلة، نحاصر أنفسنا بتلك "الحقائق" المختلقة والوهمية.
ويمكن أن تصيب هذه "الحقائق" - التي لا تمت رغم مسماها هذا للحقيقة بصلة - الشركات والمؤسسات في صميم الأنشطة التي تقوم بها. ومن بين الأمثلة على ذلك، ما يحدث لكثير من الشركات الدولية العاملة في مجال المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية.
فالجانب الأكبر من هذه الشركات يعتمد، في تقديمه الخدمات لعملائه، على خريجين جدد من كليات القانون والحقوق نالوا تعليما جيدا للغاية ولكنهم عديمو الخبرة العملية تماما. وتستفيد تلك الشركات من الفارق ما بين الأتعاب التي تتقاضاها والمبالغ التي تدفعها لهؤلاء الخريجين ممن يعملون لديها لتدرّ أرباحا هائلة على الشركاء فيها.
لكن في الوقت الحالي، يوجد تشكيك في مدى قيمة "هذه الخدمة" المقدمة بهذه الصورة إلى العملاء، وهو ما جعل كل الشركات الكبرى العاملة في هذا المضمار تقريبا في مختلف أنحاء العالم تواجه الكثير من المصاعب، لكنها تتمسك - برغم ذلك وبعناد - بنفس النموذج الذي تتبعه في إدارة أعمالها.
فبرغم تغير الواقع المحيط بتلك الشركات التي تواصل تكبد الخسائر، فإن الحقائق التي اختارت مواصلة الاعتقاد في صحتها – وهي تلك المتعلقة باتباع نفس نمط العمل الذي عفا عليه الزمن - لا تزال راسخة وبقوة.
وبطبيعة الحال، نقنع جميعا أنفسنا ما بين الحين والآخر بأن مثل هذه الأوهام حقيقة واقعة. ولكن للأسف، ففي عالم التجارة والأعمال الحافل بالمنافسة، يوجد لدى رجال الأعمال والمستثمرين أسباب قوية وحوافز هائلة للتشكيك بشكل مباشر في صحة هذا العالم الوهمي الذي يخلقه المرء في ذهنه.
وقد صدق ذلك على العديد من الشركات التي عاشت في تلك الحقبة التي سادتها تقنيات البث التناظري، قبل عقد أو عقدين من الزمان، وهي المؤسسات التي عاصرت ظهور التكنولوجيا الرقمية، تلك التي بدلت طبيعة التقنيات ذات الاستخدامات المتعددة (مثل ما حدث مع شركة كوداك فيما يتعلق بإنتاج الكاميرات، وشركة موتورولا فيما يتصل بتصنيع الهواتف النقالة).
كما يصدق هذا أيضا حاليا على الكثير من الشركات التي ضخت مليارات من الدولارات للاستثمار في البنية التحتية وغير ذلك من المصاريف الإدارية والإضافية المتصلة بالخدمات والمنتجات التي تقدمها، وذلك في وقت باتت فيه الشركات الناشئة التي تعتمد على شبكة الإنترنت توفر خدماتها لعملائها على نحو مستمر وبالغ السلاسة وبتكلفة أقل.
ومثال على ذلك، ما يحدث مع الشركات العاملة في مجال التوصيل بسيارات الأجرة في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الشركات التي تقدم بطريقة تقليدية خدمات بث القنوات التليفزيونية عن طريق الكوابل.
عودة إلى عالم الواقع
رغم ذلك فلم يضع كل شيء بعد. فبوسعنا أن نرفع راية التحدي في وجه تلك "الحقائق" المختلقة، ونسميها بأسمائها. حتى أعضاء مجالس إدارات الشركات بوسعهم رفع أصواتهم والحديث دون خوف؛ إذ أن ذلك – على حد علمي – يشكل جزءا كبيرا من المهام المنوطة بهم.
أما المديرون والرؤساء فهم بحاجة إلى دعم ومؤازرة من يجرؤون على المواجهة والحديث الصريح دون تردد، لا السعي لتدميرهم.

فمن الضروري أن يسأل كل منّا نفسه، لماذا يصر على اتباع الأسلوب ذاته في إنجاز ما يقوم به من أشياء وأمور. فربما كان هناك سبب وجيه لتبني مثل هذا الأسلوب قبل سنوات، ولكن لماذا يتم الإبقاء عليه بالرغم من كل ما حدث من تغيرات حول المرء؟
وبينما تراودني هواجسي الخاصة بشأن ما يُعرف بـ"البيانات الكبيرة" (وهو المصطلح الذي يشير إلى ذاك الكم الهائل من البيانات التي يمكن تحليلها حسابيا للكشف عن أنماط وتوجهات بعينها وخاصة بشأن السلوكيات البشرية) وذلك إذا ما كنا بصدد الحديث عن سبل تشجيع روح الابتكار والإبداع، فإنه لا يمكن لأحد أن ينفي فاعلية وقوة الثورة التي يشهدها حاليا عالما إدارة الموارد البشرية وإدارة المسؤولين عن المبيعات، في مختلف المشروعات الحديثة.
فعملية تحليل البيانات لاستنباط السلوكيات البشرية من خلالها تنطوي على إمكانية استخدام ذلك لتفنيد وتقويض هذه "الحقائق" المختلقة التي تعتمد على التفكير الإيديولوجي المحض ليس إلا.
ويتعين على المرء هنا أن يتذكر أنه يمكن مواجهة الأوهام والخرافات هذه باستخدام الاستمالات العاطفية ورواية الحكايات لضرب الأمثلة من خلالها، رغم أن هذين الأسلوبين يشكلان في الوقت نفسه قلب وروح هؤلاء الأشخاص ذوي الانتماءات الإيديولوجية ممن لا يمكنهم الاعتماد على المنطق لإقناع الآخرين.
إذ أن إيصال وجهة نظر مختلفة إلى من يحاورهم كل منّا لا يقتصر فقط على إيضاح مواقفنا، ولكن من الواجب علينا ألا نتجاهل أهمية وفاعلية استخدام أسلوب القصّ وضرب الأمثلة لإيصال رسائلنا.
في النهاية، لست واهما إذا قلت أن مواجهة حتى أكثر الأوهام والخرافات التي يفضل المديرون تبنيها كفيل بتلاشيها تدريجيا إذا جرى ذلك باستخدام المنطق والنقاش بعقل وذهن مفتوحيّن وبالاستعانة بالبيانات الإحصاءات الملائمة في هذا الشأن، حتى عندما يجري التواصل في هذا الصدد على نحو إلزامي أو قهري؛ إذ أن هذا هو كل ما بوسعنا فعله ليس أكثر.
أستاذ في علوم الإدارة

لماذا يتصرف أناسٌ تبدو عليهم سيماء الذكاء والمقدرة وكأنهم يؤمنون بأن الوقائع الملفقة والوهمية هي حقائق لا يرقى إليها أي شك؟
إذا كانت مسألة بدء عمل تجاري أو إدارة شركة قائمة بالفعل عسيرة بما يكفي حتى دون أن يكبد المرء نفسه عناء اختلاق شيء ما ولو حتى على سبيل المزاح؛ لذا لماذا يصدق المديرون في بعض الأحيان كل هذه الضروب من الأشياء غير الحقيقية، حتى وإن كان ذلك سيلحق بهم أذى؟
مع ذلك، فإن استخدام "حقائق" ووقائع مختلقة يشكل سمة من سمات العمل في المجالين السياسي والاقتصادي، في عدد لا يحصى ولا يعد من المواقف والحالات.
وعلى سبيل المثال، فخلال اجتماع استثنائي لحملة الأسهم في مصرف (بانك أوف أمريكا)، أدى سعي الرئيس التنفيذي للمصرف بريان موينيهان لأن يصبح كذلك رئيسا لمجلس إدارة المصرف، إلى اندلاع معركة طاحنة مع مسؤولي صناديق التقاعد وغيرهم من ممثلي المؤسسات الاستثمارية، المشاركة في المصرف الأمريكي، ممن يعارضون مثل هذه الخطوة.
لكن الجانب المثير للتساؤل من فرط غرابته هنا يكمن في أن الشركات التي يشغل فيها شخص واحد منصبيّ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لا تختلف نتائجها بالسلب أو الإيجاب عن تلك التي يُعطى فيها المنصبان لشخصين مختلفين.
وهنا يُطرح السؤال: لماذا يجلب المرء على نفسه احتجاجات من قبل أطراف عدة بسبب سعيه لإجراء تغيير هيكلي قيادي لن يؤدي حتى إلى إحداث أي فارق؟ ما ذكرناه سلفا ليس سوى مثال واحد من بين أمثلة كثيرة على إقدام مسؤول أو قائد ما على إثارة عشٍ الدبابير دون وجود أي حقائق تعضد تصرفاته أو أفعاله.
رحلة إلى عالم اختلاق الوقائع
لماذا يتصرف أناسٌ تبدو عليهم سيماء الذكاء والمقدرة وكأنهم يؤمنون بأن الوقائع الملفقة والوهمية هي حقائق لا يرقى إليها أي شك؟
يعود هذا إلى السبب نفسه الذي يحدو الساسة الطامحين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري الأمريكي لانتخابات الرئاسة المقبلة للمطالبة - على نحو موحد تقريبا – بخفض معدلات ما يُعرف بـ"الضريبة الهامشية" في البلاد، بدعوى أن ذلك سيعزز النمو الاقتصادي، رغم وجود أدلة تعود إلى فترات إدارة رونالد ريغان وبيل كلينتون وجورج بوش الابن تشير إلى أن اتباع هذه السياسة لا يؤدي سوى إلى تفاقم التفاوت بين الدخول.
كما أنه السبب نفسه الذي يدفع ساسة من أمثال الرئيس فرانسوا أولوند في فرنسا، والزعيم العمالي جيرمي كوربين في بريطانيا، والسياسي اليساري بيرني ساندرز في الولايات المتحدة، إلى الدعوة لاضطلاع حكومات بلدانهم بدور أكثر نشاطا في المجتمع.
جاء ذلك برغم الأدلة التي تفيد بوجود أوجه قصور فادحة وانهيارات تشوب الخدمات والقطاعات التي تديرها الحكومة في هذه الدول، مثل المدارس العامة في فرنسا وخدمة الرعاية الصحية الوطنية في بريطانيا، وكذلك النهج الذي يتم من خلاله إدارة الحروب في الولايات المتحدة.
جواب هذه المعضلة يكمن في تبني هؤلاء الساسة مذهبا فكريا أو بالأحرى أيديولوجية ما تحكم تصرفاتهم ونظرتهم لما حولهم. ويمكن تعريف الأيديولوجية بأنها رؤية يحدد المرء من خلالها ما يراه صوابا أو خطأً، وهي رؤية تكون عادة مفعمة بالقوة لا تتزعزع ولو قيد أنملة، وتكتسي بطابع أصولي متعصب.

الأكثر من ذلك أن تلك الرؤية لا يقلقلها دليل تجريبي أو منطق مضاد محكم البنية ومُصاغ بعناية. وهكذا ففي شؤون الحكم – كما في شؤون الاقتصاد والتجارة – يعوق تبني هذه الرؤى الأيديولوجية تكيف المرء مع المتغيرات من حوله، ويجعل تحركاته تفتقر إلى الرشاقة والخفة.
وعلى هذه الشاكلة، نحاصر أنفسنا بتلك "الحقائق" المختلقة والوهمية.
ويمكن أن تصيب هذه "الحقائق" - التي لا تمت رغم مسماها هذا للحقيقة بصلة - الشركات والمؤسسات في صميم الأنشطة التي تقوم بها. ومن بين الأمثلة على ذلك، ما يحدث لكثير من الشركات الدولية العاملة في مجال المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية.
فالجانب الأكبر من هذه الشركات يعتمد، في تقديمه الخدمات لعملائه، على خريجين جدد من كليات القانون والحقوق نالوا تعليما جيدا للغاية ولكنهم عديمو الخبرة العملية تماما. وتستفيد تلك الشركات من الفارق ما بين الأتعاب التي تتقاضاها والمبالغ التي تدفعها لهؤلاء الخريجين ممن يعملون لديها لتدرّ أرباحا هائلة على الشركاء فيها.
لكن في الوقت الحالي، يوجد تشكيك في مدى قيمة "هذه الخدمة" المقدمة بهذه الصورة إلى العملاء، وهو ما جعل كل الشركات الكبرى العاملة في هذا المضمار تقريبا في مختلف أنحاء العالم تواجه الكثير من المصاعب، لكنها تتمسك - برغم ذلك وبعناد - بنفس النموذج الذي تتبعه في إدارة أعمالها.
فبرغم تغير الواقع المحيط بتلك الشركات التي تواصل تكبد الخسائر، فإن الحقائق التي اختارت مواصلة الاعتقاد في صحتها – وهي تلك المتعلقة باتباع نفس نمط العمل الذي عفا عليه الزمن - لا تزال راسخة وبقوة.
وبطبيعة الحال، نقنع جميعا أنفسنا ما بين الحين والآخر بأن مثل هذه الأوهام حقيقة واقعة. ولكن للأسف، ففي عالم التجارة والأعمال الحافل بالمنافسة، يوجد لدى رجال الأعمال والمستثمرين أسباب قوية وحوافز هائلة للتشكيك بشكل مباشر في صحة هذا العالم الوهمي الذي يخلقه المرء في ذهنه.
وقد صدق ذلك على العديد من الشركات التي عاشت في تلك الحقبة التي سادتها تقنيات البث التناظري، قبل عقد أو عقدين من الزمان، وهي المؤسسات التي عاصرت ظهور التكنولوجيا الرقمية، تلك التي بدلت طبيعة التقنيات ذات الاستخدامات المتعددة (مثل ما حدث مع شركة كوداك فيما يتعلق بإنتاج الكاميرات، وشركة موتورولا فيما يتصل بتصنيع الهواتف النقالة).
كما يصدق هذا أيضا حاليا على الكثير من الشركات التي ضخت مليارات من الدولارات للاستثمار في البنية التحتية وغير ذلك من المصاريف الإدارية والإضافية المتصلة بالخدمات والمنتجات التي تقدمها، وذلك في وقت باتت فيه الشركات الناشئة التي تعتمد على شبكة الإنترنت توفر خدماتها لعملائها على نحو مستمر وبالغ السلاسة وبتكلفة أقل.
ومثال على ذلك، ما يحدث مع الشركات العاملة في مجال التوصيل بسيارات الأجرة في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الشركات التي تقدم بطريقة تقليدية خدمات بث القنوات التليفزيونية عن طريق الكوابل.
عودة إلى عالم الواقع
رغم ذلك فلم يضع كل شيء بعد. فبوسعنا أن نرفع راية التحدي في وجه تلك "الحقائق" المختلقة، ونسميها بأسمائها. حتى أعضاء مجالس إدارات الشركات بوسعهم رفع أصواتهم والحديث دون خوف؛ إذ أن ذلك – على حد علمي – يشكل جزءا كبيرا من المهام المنوطة بهم.
أما المديرون والرؤساء فهم بحاجة إلى دعم ومؤازرة من يجرؤون على المواجهة والحديث الصريح دون تردد، لا السعي لتدميرهم.

فمن الضروري أن يسأل كل منّا نفسه، لماذا يصر على اتباع الأسلوب ذاته في إنجاز ما يقوم به من أشياء وأمور. فربما كان هناك سبب وجيه لتبني مثل هذا الأسلوب قبل سنوات، ولكن لماذا يتم الإبقاء عليه بالرغم من كل ما حدث من تغيرات حول المرء؟
وبينما تراودني هواجسي الخاصة بشأن ما يُعرف بـ"البيانات الكبيرة" (وهو المصطلح الذي يشير إلى ذاك الكم الهائل من البيانات التي يمكن تحليلها حسابيا للكشف عن أنماط وتوجهات بعينها وخاصة بشأن السلوكيات البشرية) وذلك إذا ما كنا بصدد الحديث عن سبل تشجيع روح الابتكار والإبداع، فإنه لا يمكن لأحد أن ينفي فاعلية وقوة الثورة التي يشهدها حاليا عالما إدارة الموارد البشرية وإدارة المسؤولين عن المبيعات، في مختلف المشروعات الحديثة.
فعملية تحليل البيانات لاستنباط السلوكيات البشرية من خلالها تنطوي على إمكانية استخدام ذلك لتفنيد وتقويض هذه "الحقائق" المختلقة التي تعتمد على التفكير الإيديولوجي المحض ليس إلا.
ويتعين على المرء هنا أن يتذكر أنه يمكن مواجهة الأوهام والخرافات هذه باستخدام الاستمالات العاطفية ورواية الحكايات لضرب الأمثلة من خلالها، رغم أن هذين الأسلوبين يشكلان في الوقت نفسه قلب وروح هؤلاء الأشخاص ذوي الانتماءات الإيديولوجية ممن لا يمكنهم الاعتماد على المنطق لإقناع الآخرين.
إذ أن إيصال وجهة نظر مختلفة إلى من يحاورهم كل منّا لا يقتصر فقط على إيضاح مواقفنا، ولكن من الواجب علينا ألا نتجاهل أهمية وفاعلية استخدام أسلوب القصّ وضرب الأمثلة لإيصال رسائلنا.
في النهاية، لست واهما إذا قلت أن مواجهة حتى أكثر الأوهام والخرافات التي يفضل المديرون تبنيها كفيل بتلاشيها تدريجيا إذا جرى ذلك باستخدام المنطق والنقاش بعقل وذهن مفتوحيّن وبالاستعانة بالبيانات الإحصاءات الملائمة في هذا الشأن، حتى عندما يجري التواصل في هذا الصدد على نحو إلزامي أو قهري؛ إذ أن هذا هو كل ما بوسعنا فعله ليس أكثر.

من مواضيعي
0 هل ما زلت تعتقد أن لنا 12 سنة لإنقاذ كوكبنا؟ الفترة الحقيقية لا تتجاوز 18 شهرا
0 بالصور: موجة ثانية من الحر الشديد تجتاح أوروبا
0 تعيينات جونسون .. هل هي قفزة نحو المجهول؟
0 العفو عن مدرسة سجلت مكالمة لمديرها "المتحرش"
0 كوريا الشمالية "تطلق صاروخين قصيري المدى" في بحر اليابان
0 فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية
0 بالصور: موجة ثانية من الحر الشديد تجتاح أوروبا
0 تعيينات جونسون .. هل هي قفزة نحو المجهول؟
0 العفو عن مدرسة سجلت مكالمة لمديرها "المتحرش"
0 كوريا الشمالية "تطلق صاروخين قصيري المدى" في بحر اليابان
0 فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية