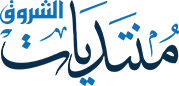“موضوعة” الإرهاب في الرواية الجزائرية: مقاربة في الرؤية، والتوظيف، والآثار الجان
26-11-2011, 05:12 PM
بقلم: أ.د. حبيب مونسي*
قبل البدء :عندما شرعت في جمع المادة لكتابة هذا البحث، تبين لي أنني أمام خيارين: إما أن أنهج السبيل الأكاديمي المعهود، وأن أظل داخل أسوار النقد الجامعي الرسمي، وإما أن أتجاوز ذلك الإطار لأكتب ما يراه عامة المثقفين في مسألة الرواية والإرهاب، بعيدا عن صَنَمِيّة المنهج الأكاديمي، وأن أخرج بأحكام مختلفة تكتسب قوة حقيقتها من الحوار الجاري بين المبدعين والنقاد على هامش كل نص جديد.. ذلك ما اخترته فأهملت الدراسات الأكاديمية، والكتب النقدية، وفتحت نوافذ الشبكة على مصراعيها.
1-الرواية، وظيفة الأدب:
يذهب كثير من فلاسفة الفن إلى أن الوظيفة الأساسية المنوطة بالأدب خاصة،والفن عامة، هي الارتفاع بالموضوع من اليومي الدارج، إلى فضاء المفهوم الذي يكتسب صفة المطلق، والنموذج، في الكتابة والإبداع. فيكون بذلك شارة على قضية تشغل المبدع والفنان، شغلا يتجاوز محض الإخبار والتقرير، إلى دائرة الفهم والفقه. فليس مطلوبا من المبدع الفنان أن يقص خبر الموضوع، ولا أن يصف أحواله، ولا أن يخبر بالتحولات المختلفة التي تعتريه، وإنما مهمته أن يعرضه في كيفيات تتجاوز المطلب الزماني، والحيز المكاني. حتى يتحرر الموضوع من ثقلهما تحررا يجعله دائرا في فلك الإنساني، بعدما كان جرما صغيرا في فلك الإقليمي والمحلي.
ساعتها سيكون للأدب والفن شأن آخر، مختلف عما يسعى إليه كثير من المحسوبين عليه، والذين يسارعون إلى دفع ما خطته أيديهم، وما عملته أناملهم إلى المطابع والمصانع. ثم يأسفون، بل يألمون، حينما لا تجد تجارتهم رواجا ولا قبولا لدى القراء والمشاهدين. .ثم يفتحون ملفات المقروئية، والنفور من الفن، وتدني المستوى، وغيرها من القضايا الهامشية التي لا تقع حقيقة في صلب الأدب والفن، لأنها بكل بساطة ليست من قضاياه، ولا من إفرازاته. وإنما هي ما يتذرَّع به أولئك الذين أفرغوا الأدب من مهمته، ومالوا به إلى جهة لا يزداد فيها الفن والأدب إلا سقوطا وترديا.
كذلك الشأن اليوم في موضوعات هي في غاية الأهمية والخطورة معا: مثل الإرهاب، والدين، والجنس، والسياسة، والأخلاق.. والتي أضحت وقود الرواية وحطب السَّرد فيها. فإنك لا تعدم نصا من النصوص، إلا وفيه شظايا من هذه الموضوعات، تتقاطع، أو تنفرد، إلا أنها حاضرة في كل سطر، حضورها في اليومي الذي يوقِّع أيام الناس ولياليهم، وينسج أحوالهم، ويغذي أحاديثهم، ويطل عليهم من كل حدب وصوب، في مطالع الصحف، وعناوين الجرائد، ومقدمات الأخبار. وكأن الناس قد انتهوا من مسألة الإرهاب، والدين، والجنس، والأخلاق، فهما وفقها، وأدركوا ما لها من حضور وخطر في حياتهم، وما لها من توجيه في قيمهم، ومعاييرهم، وأحكامهم.
وليس من المعقول أن نطالب الفن والأدب بإعادة شرحها للقراء والمشاهدين، فذلك تحصيل حاصل لا طائل وراءه، وليس هو من صميم وظيفة الأدب. فالذين يشرحون الإرهاب، والجنس، والأخلاق.. ويحللونه قوم آخرون تسلحوا بمعارف تقع في حقل الإنسانيات عموما. ولكن المطلوب من الأدب أن يتناول الظاهرة عند آحاد من الناس، في موقف خاص، وفق رؤية محددة تنتهي بالخروج من ربقة المكان والزمان، إلى حكم يرتفع بالظاهرة إلى أن تصير تجربة يعيشها كل قارئ بطريقته الخاصة عبر المكتوب والمشاهد..
إن الأدب من هذه الوجهة دعوة للمشاركة، مفتوحة أمام كل راغب في أن يضيف إلى رصيده الحياتي تجربة جديدة، يحياها -عبر الفن- عامرة بالأحاسيس، طافحة بالمشاعر، مكتظة بالرؤى. يقيم عالمها الخاص في دائرته الخاصة فيجدد طرحها، ويؤثث حوادثها بما يتوافق مع اقتداره الشخصي في الغوص والاستفادة.
2-الرواية، موضوعة الإرهاب:
إننا حين نقدم للقارئ شخصا ننعته بالإرهابي، ونعرض أفعاله، ونبسط دواعيه وأسبابه، ونتفنن في إخراج مواقفه. لا نفعل ذلك لأن رغبتنا الأولى هي التشهير بالإرهاب، وفضح جرائمه، وكشف بشاعة أفعاله.. فكل ذلك ليس مطلبا أدبيا ولا ديدنا فنيا. فإن فعلنا ذلك أخرجنا الأدب عن وظيفته، وأفرغنا طاقته في فضاء ليس له. فهناك معارف أخرى تتولى التشهير، والفضح، الكشف. ولكن الذي يهم الأدب والفن، هو “الإنساني” في هذا كله. فحين العرض، لا ينسى الأديب والفنان أنه يعرض “شخصا”: هو كل إنسان سقط في آتون الإرهاب لسبب أو لآخر. فليس المهم هو السبب بقدر ما تكمن الأهمية في الأحوال المصاحبة للسقوط. حينها يرى القارئُ الُمنزَلَقَ الذي أخذ الفكرَ والبدنَ، وبلَّد الإحساسَ والعاطفةَ، وقتل العقلَ والقلبَ.. وستكون مصاحبة “الشخص” في دوامات المهوى، مصاحبة “المعايشة” التي تُكسب الأدب دورا من أخطر الأدوار على الإطلاق، والتي ربما يقصرُ الخطاب الديني عن الإحاطة بها. لأن المعايشة ضرب من التقمص الذي يفتح العين على حقيقة المزالق التي تلفعت بأثواب الدين، والسياسة، والتضحية… فدور الأدب في هذا الكشف الحميمي المخامر للذات في حيرتها، في غيبة عقلها، وهي تأتي الفظيع من الأفعال، والشنيع من الخصال، والشائن من الأقوال.
قد يكون الإرهابي شخصا “متدينا”، وقد لا يكون البتة. بل تقر الحقائق الميدانية أن الإرهاب يجد ضالته في أشخاص تقل صلتهم بالدين والتدين، فهم أقرب إلى أصحاب الجنح منهم إلى السويَّة من الناس. شديدو الانفعال، كثيرو الصخب، تغيب المشاريع الجادة من حياتهم.. ألجأتهم الحاجة إلى التدين والتشدد على أنفسهم، قبل التشدد على غيرهم.. ولابد أن يفهم القارئ أن نعت “المتدين” لا ينصرف أبدا إلى “المسلم” وحده، بل المتدين هو كل من اعتنق فكرة سماوية كانت أو أرضية، إيمانية أو كفرية.. فتديُّنه في انغلاقه داخل تلك الدائرة، ومحاسبة غيره انطلاقا من منظورها.. وللأدب والفن أن يناقش هذا الضرب من التدين، وأن يكشف هذا اللون من الإيمان، ويجلي كيف ينتهي بصاحبه إلى الإرهاب فكرا وفعلا. ساعتها سنكون أمام وظيفة أخرى تقع على عاتق الأدب، حين يصحح المفاهيم، ويعطي للمصطلحات حقها من الوضوح والبيان.. لا أن يفعل ما فعلته الكتابات المستعجلة، التي تُنسب إلى الأدب، حين قدمت كل متدين “مسلم” ذي لحية وقميص على أنه إرهابي بالقوة، وإن لم يكن بالفعل. ولما:« نشب الصراع في الجزائر، أخذت أصابع الاتهام “الإعلامية” تشير إلى “الإرهابيين الإسلاميين“بأنهم هم الذين يقومون بالقتل، والذبح، وعمليات التفجير، والخطف، وقطع الرؤوس.. وغير ذلك من الفظائع التي هي بعيدة كل البعد عن روح الإسلام وتعاليمه السمحة، ومنهجيته الإنسانية، إلا أن أصابع الاتهام ظلت تشير إلى هذه الناحية دون غيرها. حتى أصبحت وكأنها بديهة من البديهيات.» ([1])
ذلك هو الخطأ الكبير الذي سوف تحاسب عليه على مر الأزمنة.. لأنها لم تجد في تلك الصورة اختيارا دينيا وثقافيا وحضاريا، شاء أن يتقلده بعض من الناس عن يقين وبصيرة. وإنما نظرت إلى الصورة انطلاقا من حيثية تاريخية شديدة الحساسية، كثيرة الأصوات. فكان لها ذلك التطرف في الحكم، والاختزال في النظرة. وعملت على التقريب بين الصورة والمفهوم، فظهر في كتاباتها تلازم شرطي بين التدين والإرهاب.
والغريب أن الرواية التي تصدت لموضوع الإرهاب لم تكتب سوى هذه التهمة، ولم تردد سوى هذا الافتراء، ولم تجد في الإرهاب إلا لحية وقميصا.. وفاتها أن الإرهاب غير ذلك، وأنه ليس فعلا دمويا، وإنما الإرهاب وضع مُعطى، فرضته أوضاع عالمية على العرب والمسلمين، في مقياس ديني/حضاري، بعدما كان الإرهاب لا يتجاوز حدود المقياس السياسي والنضال الاجتماعي. لم تبصر الرواية في الإرهاب ذلك التحول الكبير من السياسي إلى الحضاري، وأن العالم قد انتقل من وعي إلى آخر، وأنه اليوم يدير الصراع لا على مستوى الدويلات والحدود، ولا على مستوى الانتماء والأيديولوجيات، وإنما يُدار الصراع اليوم على مستوى الحضارات. وليس للحضارات من شارات مائزة سوى الدين.
إنك حين تقرأ نصوص الروايات، وتتابع سرد أحداثها، يصمُّ أذنيك ذلك الصراخ العالي الذي ينبعث من مشاهد الخوف والهلع، ويرتفع من صراخ النساء والأطفال، ويتجاوب من قعقعة الرشاشات ودكِّ المدافع.. لقد استحالت اللغة إلى فضاء للضجيج. وكان حريا بها أن تستحيل إلى فضاء للتأمل والسؤال. فإذا كنت أشاهد على الشاشات حقيقة الفجيعة، وأرى لون الدم، وأسمع أنين الجرحى.. فليس للرواية أن تأتيني هي الأخرى بذلك كله.. لأن القتل واحد وإن تعددت أدواته. والموت واحد وإن تعددت أسبابه. والدم واحد وإن تعددت جنسياته.. ولكن عليها أن تفسر الفعل في حقيقته التي تتجاوز المجزرة، وأن تكشف السر في عمقه الذي يتجاوز الحادثة. المهم هو القتل باسم هذا الوثن أو ذاك.. المهم هو تبرير الفعل بهذا الفكر أو ذاك..
3-الرواية،الإرهاب سرديا:
كتب “سعيد بن كراد” في موقعه يقول:« لماذا وقع ما وقع ؟ هو ذا السؤال الذي يجب أن نجيب عنه جميعا ومن مواقعنا المختلفة. أما كيف وقع فتلك مهمة أخرى. فأجهزة الأمن وحدها لا تسأل عن سبب القتل، ولها الحق في ذلك، فمهمتها هي القبض على القاتل لا البحث عن ظروف تخفف أو تفسر ما فعل. أما أنا فلست في وضع من يحاسب أو يحاكم. ليس بوسعي سوى التساؤل عن دوافع ما حدث، لكي لا يحدث مرة أخرى هذا الذي حدث. إن للإرهاب أوجها متعددة، ليس القتل سوى واحد منها، هو اللحظة النهائية التي ينفجر فيها ما علق بالنفس، والذهن، والوجدان على مر السنين: بذرة الشوك أطول عمرا من وخزه، وحمم البركان لا تنسينا أن فوهته تمتد عميقا في الأرض.» ([2])
إن الفكر حين يتحرر من حدود المعطى الإعلامي الإخباري، لا يجد في الظاهرة صورة الدم والفجيعة، وإنما يتخطاها إلى صور أخرى للإرهاب، لا نكاد نعرف عنها شيئا ذا بال. وكأن الإرهاب هو الآخر يتجاوز الفعل التخريبي المشاهد الذي تعرضه وسائل الإعلام، إلى وجه قبيح خفي يبث سمومه في الذات يوما بعد يوما، وساعة بعد ساعة. وإذا كانت صور الدمار هي ما يُعلن بها الإرهابُ عن نفسه، فإن له صورا أخرى صارت من المألوف الدارج الذي لا يلتفت إليه الناس، وإن فعلوا تأففوا وانصرفوا.. غير أنها هي التي تشحن الصدور وتوغرها، وتملأها حقدا وغيضا، حتى يتعتَّم وجه الحقيقة ويكفهر، فلا تكاد تستبين فيها مقدمها وإدبارها. ولا تعرف مدخلها ومخرجها. وقد:« لا نتبين بوضوح حقيقة كل هذا القتل العبثي، ولكن الثابت أن ما وقع هو رد فعل شباب يائس خانه الوعي، وارتمى في أحضان حقد أعمى، حوله إلى أداة تزرع الرعب والموت في كل مكان. إن الحقد لا يبني ولا يعمر، ولا يقود إلى التحرر، إنه طاقة تدميرية مهولة، كراهية منفلتة من عقالها وتضرب في كل الاتجاهات. لهذا لا يستهدف الإرهاب السلطة السياسية فحسب، إنه يروم تقويض دعامات البناء الاجتماعي ذاته، من أجل فرض حقيقة واحدة تلغي الحياة ببساطة، بتعددها واختلافها وتنوعها والنسبي فيها والعرضي. وهذا هو الخطر الداهم.» ([3])
للرواية إذن أن تحدثنا عن خيانة الوعي، وعن الحقد الأعمى، وكيف يتحولان إلى طاقة تدميرية مهولة.. هذا مناطها، وذلك هو مراغها الواسع الذي عليها أن تجوب مجاهله بما أوتيت من خيال ومعرفة، وما تُسعفها به اللغة من بناء وخلق. بيد أن الحديث عن الوعي لا يتأتى من العجلة والاستعراض السريع للأحداث، وإنما ينشأ عن دراسة عميقة تسبق الفعل الإبداعي ذاته، فليست الكتابة بعدُ إلا تسجيلا لمعرفة أنشأها التأمل في الموضوع، تأملا يرتفع بها من دوامات الضجيج واللغط إلى سماء التأمل والتأويل. وما ينقص الرواية اليوم هو هذه الهدأة التي يخلو فيها الأديب والفنان لموضوعه مدارسة ومجالسة، قد تستمر به الشهور والسنوات. تؤرقه، تتعبه، تذهب بلذيذ نومه، وتهدِّد سعادة عشرته أحيانا.. ثم تنتهي به إلى فيض من الرؤى يتكشف من خلالها الموضوع في أثواب إبداعية جديدة.
ترى الناقدة الكويتية “سعاد العنزي” أن ثمة مصطلحا:« يصف حالة الرواية والأدب الجزائري، وهو مصطلح الأدب الاستعجالي الذي يواكب الحدث من دون اختمار للتجربة وتشكيل جيد. من هنا فإننا لا ندين الأدباء والروائيين الجزائريين بقدر ما نصف حالة، ونقيِّم وضعية معينة، وبالتفاتة ثاقبة لأدب ما بعد العشرية الحمراء ستظهر نصوص روائية جيدة اقتربت من فنية العمل الروائي، وخاضت أفق التجريب الحداثي. مثل “حروف الضباب” للخير شوار، ورواية “كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك” لعمارة لخوص، وغيرها كثير» ([4]) وكأن النضج المنتظر الذي ستنعم به الرواية لن يتأتى لها إلا بعد انقشاع سحابة العنف، وتجاوز التسجيل الإعلامي للحوادث التي تكتظ بها الصحف والدوريات. بيد أن النصوص الاستعجالية، لم تمر بين يدي القارئ من دون أن تترك بصمتها، وأن تعمل على زرع كثير من المفاهيم والرؤى المغلوطة في الأذهان. خاصة وأن كتَّابها هم من الصحافيين الذي يشتغلون في الحقل الإعلامي. فليس من فرق لديهم بين كتابة المقال اليومي وبين توسيعه ليغدو رواية أو مجموعة قصصية.
إنها الوضعية التي تفسر هيمنة الأسلوب الصحفي التقريري على الرواية الاستعجالية، وغياب التخييل المبني على إنشاء عالم خاص بالرواية، يقف في مواجهة العالم المُعطى الذي يعاني الظاهرة ويكابدها. فإذا كانت الناقدة تتحاشى إدانة الروائيين الجزائريين باعتبارهم ضحايا فترة حرجة، فإن ذلك لا يعفي الأدب في كل الأحوال من استبعاد الاستعجال من ساحته، لأنه سيفقده وظيفته، ويسويه بالعمل الصحفي الذي يقتات على الخبر المثير، ويحيا بالعناوين الملفتة.
4-الرواية ،النيِّئ والطازج:
إننا نتهم الأديب اليوم حين نشبهه بالطاهي الذي لا يُمهل طبخته فترة النضج على نار هادئة.. كلاهما يقوم بفعل “الاغتصاب” وليس الاغتصاب في أبعد مفاهيمه إلا قطف الثمرة قبل أوانها. وكل مغتصب حين يتذوق ثمرته، لا يجد فيها إلا طعمها الحامض القارص. كذلك كانت ثمرات الرواية وهي تعالج الإرهاب، والجنس، والدين.. والتي لم يجد فيها القارئ ذلك الطعم الشهي لمَطْعَم ناضج، بل وجد ما ينفِّره ويقزِّز مشاعره، فتركها لغيرها. واليوم يجد النقد الأدبي والفني على سواء، أن من مهماته الجديدة هي فضح “الاغتصاب” للموضوعات المهمة، وإرغام الأديب على التريث، وإمهال الفن فترة حضانة قبل الولادة.
لقد عبر “عمارة لخوص” الذي ذكرته الناقدة “سعاد العنزي” من قبل، أنه يرفض مصطلح “الأدب الاستعجالي” على الرغم من أنه يصرح في حوار له مع “جريدة الفجر الجزائرية اليومية” ([5]) قائلا:« كتبت رواية في ستة أشهر فقط، وهو رقم قياسي بالنسبة للكتابة، خصوصا الرواية التي تتطلب نفسا طويلا، في زمن العشرية السوداء، وقبل أن أهاجر إلى إيطاليا سنة1995 أين شرعت في كتابة رواية أخرى اسمها ”خيوط العنكبوت”، ولما بدأت الاشتغال عليها أحسست أنني لن أكملها، وفعلا لم أكلمها إلى اليوم، وتركتها جانبا، لأني كتبتها أثناء قراري بالهجرة إلى إيطاليا، وهذا لا يعني أن تصنف كتاباتي ضمن الأدب الاستعجالي، وشخصيا أرفض التسمية جملة وتفصيلا، لأن الأدب ليس له تسمية.» ([6]) وليس في شهادة الروائي من جديد سوى الحكم الأخير الذي يرفض من خلاله أن يكون للأدب صفة تميزه. صحيح لم يلحق أحد من النقاد – من قبل- بأدب نعتا لاتصال الأدب في نسق مطرد واحد. بيد أن الوضع الجديد للظاهرة فرض على النقاد مثل هذه التسمية. والغريب أن الذي أطلقها هم أهل الإعلام أنفسهم الذين يكتبون الرواية، وكأنهم يتحسسون أثر الاستعجال فيما يأتون من كتابات. إنه الأمر الذي استدعى الناقدة ” سعاد العنزي” لتردف قائلة:« كانت الأعمال الروائية في نسبة كبيرة منها تميل للتقريرية المباشرة، وصورة الصحفي تكررت بها كثيرا لدوره الحساس في كشف أعمال العنف الواقعة على الشعب الجزائري.» ([7])
إن الناقد أو المفكر حين يقول بملء فيه أن الإرهاب:« لا يستهدف السلطة السياسية فحسب، إنه يروم تقويض دعامات البناء الاجتماعي ذاته من أجل فرض حقيقة واحدة تلغي الحياة ببساطة، بتعددها، واختلافها، وتنوعها، والنسبي فيها، والعرضي. وهذا هو الخطر الداهم. » ينفض عن الأدب خدره، ويهزه هزا عنيفا، ليوقظ فيه حاسة الحارس على ثغور المجتمع. فينبهه إلى الخطر الداهم، الذي يأتي على الأخضر واليابس، ويختزل الحياة إلى منظور واحد شديد الضيق. حينها سنكون كلنا هدفا لآلته العمياء.. حينها تتعدد المسؤوليات وتتنوع.. فلا يكاد الواحد منا يخلو من مسؤولية تجاهه. ويعود للأدب والفن دوره الحقيقي في فلسفة الوقائع، وفقه أسرارها. فلا ظالم ولا مظلوم، ما دام التريث قمينا بأن يعطي للظاهرة حقها من الدرس والملاحظة. فلا يتهم طرف على حساب طرف آخر، ولا يحوَّل الفن إلى وثيقة إدانة لجهة دون أخرى .
يُتبع ….
*كلية الآداب والعلوم الإنسانية/جامعة سيدي بلعباس. الجزائر.
[1] – زكي زاز- المدونة – الجزائر وقضية الإرهاب. -4 مارس 2007- مقتبس من كتاب – قضية الإرهاب بين الحق والباطل- للكاتب عبد الرحمان عمار.
[2] -موقع سعيد بن كراد. مقلات. الإرهاب.
[3] -نفس.
[4] – سعاد العنزي لـ “الأمة العربية”:المعرفي فاق الفني حضورا في الرواية الجزائرية لفترة العشرية الحمراء
- حاورها بشير عمري.بعد إصدارها لكتابها “صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية. 12/01/2010.
[5] -جريدة الفجر الجزائرية اليومية- الأربعاء 24 نوفمبر 2010م الموافق لـ 18 ذي الحجة1431هـ.
[6] -نفس.
[7] – سعاد العنزي لـ “الأمة العربية”:المعرفي فاق الفني حضورا في الرواية الجزائرية لفترة العشرية الحمراء
- حاورها بشير عمري بعد إصدارها لكتابها “صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية. 12/
قبل البدء :عندما شرعت في جمع المادة لكتابة هذا البحث، تبين لي أنني أمام خيارين: إما أن أنهج السبيل الأكاديمي المعهود، وأن أظل داخل أسوار النقد الجامعي الرسمي، وإما أن أتجاوز ذلك الإطار لأكتب ما يراه عامة المثقفين في مسألة الرواية والإرهاب، بعيدا عن صَنَمِيّة المنهج الأكاديمي، وأن أخرج بأحكام مختلفة تكتسب قوة حقيقتها من الحوار الجاري بين المبدعين والنقاد على هامش كل نص جديد.. ذلك ما اخترته فأهملت الدراسات الأكاديمية، والكتب النقدية، وفتحت نوافذ الشبكة على مصراعيها.
1-الرواية، وظيفة الأدب:
يذهب كثير من فلاسفة الفن إلى أن الوظيفة الأساسية المنوطة بالأدب خاصة،والفن عامة، هي الارتفاع بالموضوع من اليومي الدارج، إلى فضاء المفهوم الذي يكتسب صفة المطلق، والنموذج، في الكتابة والإبداع. فيكون بذلك شارة على قضية تشغل المبدع والفنان، شغلا يتجاوز محض الإخبار والتقرير، إلى دائرة الفهم والفقه. فليس مطلوبا من المبدع الفنان أن يقص خبر الموضوع، ولا أن يصف أحواله، ولا أن يخبر بالتحولات المختلفة التي تعتريه، وإنما مهمته أن يعرضه في كيفيات تتجاوز المطلب الزماني، والحيز المكاني. حتى يتحرر الموضوع من ثقلهما تحررا يجعله دائرا في فلك الإنساني، بعدما كان جرما صغيرا في فلك الإقليمي والمحلي.
ساعتها سيكون للأدب والفن شأن آخر، مختلف عما يسعى إليه كثير من المحسوبين عليه، والذين يسارعون إلى دفع ما خطته أيديهم، وما عملته أناملهم إلى المطابع والمصانع. ثم يأسفون، بل يألمون، حينما لا تجد تجارتهم رواجا ولا قبولا لدى القراء والمشاهدين. .ثم يفتحون ملفات المقروئية، والنفور من الفن، وتدني المستوى، وغيرها من القضايا الهامشية التي لا تقع حقيقة في صلب الأدب والفن، لأنها بكل بساطة ليست من قضاياه، ولا من إفرازاته. وإنما هي ما يتذرَّع به أولئك الذين أفرغوا الأدب من مهمته، ومالوا به إلى جهة لا يزداد فيها الفن والأدب إلا سقوطا وترديا.
كذلك الشأن اليوم في موضوعات هي في غاية الأهمية والخطورة معا: مثل الإرهاب، والدين، والجنس، والسياسة، والأخلاق.. والتي أضحت وقود الرواية وحطب السَّرد فيها. فإنك لا تعدم نصا من النصوص، إلا وفيه شظايا من هذه الموضوعات، تتقاطع، أو تنفرد، إلا أنها حاضرة في كل سطر، حضورها في اليومي الذي يوقِّع أيام الناس ولياليهم، وينسج أحوالهم، ويغذي أحاديثهم، ويطل عليهم من كل حدب وصوب، في مطالع الصحف، وعناوين الجرائد، ومقدمات الأخبار. وكأن الناس قد انتهوا من مسألة الإرهاب، والدين، والجنس، والأخلاق، فهما وفقها، وأدركوا ما لها من حضور وخطر في حياتهم، وما لها من توجيه في قيمهم، ومعاييرهم، وأحكامهم.
وليس من المعقول أن نطالب الفن والأدب بإعادة شرحها للقراء والمشاهدين، فذلك تحصيل حاصل لا طائل وراءه، وليس هو من صميم وظيفة الأدب. فالذين يشرحون الإرهاب، والجنس، والأخلاق.. ويحللونه قوم آخرون تسلحوا بمعارف تقع في حقل الإنسانيات عموما. ولكن المطلوب من الأدب أن يتناول الظاهرة عند آحاد من الناس، في موقف خاص، وفق رؤية محددة تنتهي بالخروج من ربقة المكان والزمان، إلى حكم يرتفع بالظاهرة إلى أن تصير تجربة يعيشها كل قارئ بطريقته الخاصة عبر المكتوب والمشاهد..
إن الأدب من هذه الوجهة دعوة للمشاركة، مفتوحة أمام كل راغب في أن يضيف إلى رصيده الحياتي تجربة جديدة، يحياها -عبر الفن- عامرة بالأحاسيس، طافحة بالمشاعر، مكتظة بالرؤى. يقيم عالمها الخاص في دائرته الخاصة فيجدد طرحها، ويؤثث حوادثها بما يتوافق مع اقتداره الشخصي في الغوص والاستفادة.
2-الرواية، موضوعة الإرهاب:
إننا حين نقدم للقارئ شخصا ننعته بالإرهابي، ونعرض أفعاله، ونبسط دواعيه وأسبابه، ونتفنن في إخراج مواقفه. لا نفعل ذلك لأن رغبتنا الأولى هي التشهير بالإرهاب، وفضح جرائمه، وكشف بشاعة أفعاله.. فكل ذلك ليس مطلبا أدبيا ولا ديدنا فنيا. فإن فعلنا ذلك أخرجنا الأدب عن وظيفته، وأفرغنا طاقته في فضاء ليس له. فهناك معارف أخرى تتولى التشهير، والفضح، الكشف. ولكن الذي يهم الأدب والفن، هو “الإنساني” في هذا كله. فحين العرض، لا ينسى الأديب والفنان أنه يعرض “شخصا”: هو كل إنسان سقط في آتون الإرهاب لسبب أو لآخر. فليس المهم هو السبب بقدر ما تكمن الأهمية في الأحوال المصاحبة للسقوط. حينها يرى القارئُ الُمنزَلَقَ الذي أخذ الفكرَ والبدنَ، وبلَّد الإحساسَ والعاطفةَ، وقتل العقلَ والقلبَ.. وستكون مصاحبة “الشخص” في دوامات المهوى، مصاحبة “المعايشة” التي تُكسب الأدب دورا من أخطر الأدوار على الإطلاق، والتي ربما يقصرُ الخطاب الديني عن الإحاطة بها. لأن المعايشة ضرب من التقمص الذي يفتح العين على حقيقة المزالق التي تلفعت بأثواب الدين، والسياسة، والتضحية… فدور الأدب في هذا الكشف الحميمي المخامر للذات في حيرتها، في غيبة عقلها، وهي تأتي الفظيع من الأفعال، والشنيع من الخصال، والشائن من الأقوال.
قد يكون الإرهابي شخصا “متدينا”، وقد لا يكون البتة. بل تقر الحقائق الميدانية أن الإرهاب يجد ضالته في أشخاص تقل صلتهم بالدين والتدين، فهم أقرب إلى أصحاب الجنح منهم إلى السويَّة من الناس. شديدو الانفعال، كثيرو الصخب، تغيب المشاريع الجادة من حياتهم.. ألجأتهم الحاجة إلى التدين والتشدد على أنفسهم، قبل التشدد على غيرهم.. ولابد أن يفهم القارئ أن نعت “المتدين” لا ينصرف أبدا إلى “المسلم” وحده، بل المتدين هو كل من اعتنق فكرة سماوية كانت أو أرضية، إيمانية أو كفرية.. فتديُّنه في انغلاقه داخل تلك الدائرة، ومحاسبة غيره انطلاقا من منظورها.. وللأدب والفن أن يناقش هذا الضرب من التدين، وأن يكشف هذا اللون من الإيمان، ويجلي كيف ينتهي بصاحبه إلى الإرهاب فكرا وفعلا. ساعتها سنكون أمام وظيفة أخرى تقع على عاتق الأدب، حين يصحح المفاهيم، ويعطي للمصطلحات حقها من الوضوح والبيان.. لا أن يفعل ما فعلته الكتابات المستعجلة، التي تُنسب إلى الأدب، حين قدمت كل متدين “مسلم” ذي لحية وقميص على أنه إرهابي بالقوة، وإن لم يكن بالفعل. ولما:« نشب الصراع في الجزائر، أخذت أصابع الاتهام “الإعلامية” تشير إلى “الإرهابيين الإسلاميين“بأنهم هم الذين يقومون بالقتل، والذبح، وعمليات التفجير، والخطف، وقطع الرؤوس.. وغير ذلك من الفظائع التي هي بعيدة كل البعد عن روح الإسلام وتعاليمه السمحة، ومنهجيته الإنسانية، إلا أن أصابع الاتهام ظلت تشير إلى هذه الناحية دون غيرها. حتى أصبحت وكأنها بديهة من البديهيات.» ([1])
ذلك هو الخطأ الكبير الذي سوف تحاسب عليه على مر الأزمنة.. لأنها لم تجد في تلك الصورة اختيارا دينيا وثقافيا وحضاريا، شاء أن يتقلده بعض من الناس عن يقين وبصيرة. وإنما نظرت إلى الصورة انطلاقا من حيثية تاريخية شديدة الحساسية، كثيرة الأصوات. فكان لها ذلك التطرف في الحكم، والاختزال في النظرة. وعملت على التقريب بين الصورة والمفهوم، فظهر في كتاباتها تلازم شرطي بين التدين والإرهاب.
والغريب أن الرواية التي تصدت لموضوع الإرهاب لم تكتب سوى هذه التهمة، ولم تردد سوى هذا الافتراء، ولم تجد في الإرهاب إلا لحية وقميصا.. وفاتها أن الإرهاب غير ذلك، وأنه ليس فعلا دمويا، وإنما الإرهاب وضع مُعطى، فرضته أوضاع عالمية على العرب والمسلمين، في مقياس ديني/حضاري، بعدما كان الإرهاب لا يتجاوز حدود المقياس السياسي والنضال الاجتماعي. لم تبصر الرواية في الإرهاب ذلك التحول الكبير من السياسي إلى الحضاري، وأن العالم قد انتقل من وعي إلى آخر، وأنه اليوم يدير الصراع لا على مستوى الدويلات والحدود، ولا على مستوى الانتماء والأيديولوجيات، وإنما يُدار الصراع اليوم على مستوى الحضارات. وليس للحضارات من شارات مائزة سوى الدين.
إنك حين تقرأ نصوص الروايات، وتتابع سرد أحداثها، يصمُّ أذنيك ذلك الصراخ العالي الذي ينبعث من مشاهد الخوف والهلع، ويرتفع من صراخ النساء والأطفال، ويتجاوب من قعقعة الرشاشات ودكِّ المدافع.. لقد استحالت اللغة إلى فضاء للضجيج. وكان حريا بها أن تستحيل إلى فضاء للتأمل والسؤال. فإذا كنت أشاهد على الشاشات حقيقة الفجيعة، وأرى لون الدم، وأسمع أنين الجرحى.. فليس للرواية أن تأتيني هي الأخرى بذلك كله.. لأن القتل واحد وإن تعددت أدواته. والموت واحد وإن تعددت أسبابه. والدم واحد وإن تعددت جنسياته.. ولكن عليها أن تفسر الفعل في حقيقته التي تتجاوز المجزرة، وأن تكشف السر في عمقه الذي يتجاوز الحادثة. المهم هو القتل باسم هذا الوثن أو ذاك.. المهم هو تبرير الفعل بهذا الفكر أو ذاك..
3-الرواية،الإرهاب سرديا:
كتب “سعيد بن كراد” في موقعه يقول:« لماذا وقع ما وقع ؟ هو ذا السؤال الذي يجب أن نجيب عنه جميعا ومن مواقعنا المختلفة. أما كيف وقع فتلك مهمة أخرى. فأجهزة الأمن وحدها لا تسأل عن سبب القتل، ولها الحق في ذلك، فمهمتها هي القبض على القاتل لا البحث عن ظروف تخفف أو تفسر ما فعل. أما أنا فلست في وضع من يحاسب أو يحاكم. ليس بوسعي سوى التساؤل عن دوافع ما حدث، لكي لا يحدث مرة أخرى هذا الذي حدث. إن للإرهاب أوجها متعددة، ليس القتل سوى واحد منها، هو اللحظة النهائية التي ينفجر فيها ما علق بالنفس، والذهن، والوجدان على مر السنين: بذرة الشوك أطول عمرا من وخزه، وحمم البركان لا تنسينا أن فوهته تمتد عميقا في الأرض.» ([2])
إن الفكر حين يتحرر من حدود المعطى الإعلامي الإخباري، لا يجد في الظاهرة صورة الدم والفجيعة، وإنما يتخطاها إلى صور أخرى للإرهاب، لا نكاد نعرف عنها شيئا ذا بال. وكأن الإرهاب هو الآخر يتجاوز الفعل التخريبي المشاهد الذي تعرضه وسائل الإعلام، إلى وجه قبيح خفي يبث سمومه في الذات يوما بعد يوما، وساعة بعد ساعة. وإذا كانت صور الدمار هي ما يُعلن بها الإرهابُ عن نفسه، فإن له صورا أخرى صارت من المألوف الدارج الذي لا يلتفت إليه الناس، وإن فعلوا تأففوا وانصرفوا.. غير أنها هي التي تشحن الصدور وتوغرها، وتملأها حقدا وغيضا، حتى يتعتَّم وجه الحقيقة ويكفهر، فلا تكاد تستبين فيها مقدمها وإدبارها. ولا تعرف مدخلها ومخرجها. وقد:« لا نتبين بوضوح حقيقة كل هذا القتل العبثي، ولكن الثابت أن ما وقع هو رد فعل شباب يائس خانه الوعي، وارتمى في أحضان حقد أعمى، حوله إلى أداة تزرع الرعب والموت في كل مكان. إن الحقد لا يبني ولا يعمر، ولا يقود إلى التحرر، إنه طاقة تدميرية مهولة، كراهية منفلتة من عقالها وتضرب في كل الاتجاهات. لهذا لا يستهدف الإرهاب السلطة السياسية فحسب، إنه يروم تقويض دعامات البناء الاجتماعي ذاته، من أجل فرض حقيقة واحدة تلغي الحياة ببساطة، بتعددها واختلافها وتنوعها والنسبي فيها والعرضي. وهذا هو الخطر الداهم.» ([3])
للرواية إذن أن تحدثنا عن خيانة الوعي، وعن الحقد الأعمى، وكيف يتحولان إلى طاقة تدميرية مهولة.. هذا مناطها، وذلك هو مراغها الواسع الذي عليها أن تجوب مجاهله بما أوتيت من خيال ومعرفة، وما تُسعفها به اللغة من بناء وخلق. بيد أن الحديث عن الوعي لا يتأتى من العجلة والاستعراض السريع للأحداث، وإنما ينشأ عن دراسة عميقة تسبق الفعل الإبداعي ذاته، فليست الكتابة بعدُ إلا تسجيلا لمعرفة أنشأها التأمل في الموضوع، تأملا يرتفع بها من دوامات الضجيج واللغط إلى سماء التأمل والتأويل. وما ينقص الرواية اليوم هو هذه الهدأة التي يخلو فيها الأديب والفنان لموضوعه مدارسة ومجالسة، قد تستمر به الشهور والسنوات. تؤرقه، تتعبه، تذهب بلذيذ نومه، وتهدِّد سعادة عشرته أحيانا.. ثم تنتهي به إلى فيض من الرؤى يتكشف من خلالها الموضوع في أثواب إبداعية جديدة.
ترى الناقدة الكويتية “سعاد العنزي” أن ثمة مصطلحا:« يصف حالة الرواية والأدب الجزائري، وهو مصطلح الأدب الاستعجالي الذي يواكب الحدث من دون اختمار للتجربة وتشكيل جيد. من هنا فإننا لا ندين الأدباء والروائيين الجزائريين بقدر ما نصف حالة، ونقيِّم وضعية معينة، وبالتفاتة ثاقبة لأدب ما بعد العشرية الحمراء ستظهر نصوص روائية جيدة اقتربت من فنية العمل الروائي، وخاضت أفق التجريب الحداثي. مثل “حروف الضباب” للخير شوار، ورواية “كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك” لعمارة لخوص، وغيرها كثير» ([4]) وكأن النضج المنتظر الذي ستنعم به الرواية لن يتأتى لها إلا بعد انقشاع سحابة العنف، وتجاوز التسجيل الإعلامي للحوادث التي تكتظ بها الصحف والدوريات. بيد أن النصوص الاستعجالية، لم تمر بين يدي القارئ من دون أن تترك بصمتها، وأن تعمل على زرع كثير من المفاهيم والرؤى المغلوطة في الأذهان. خاصة وأن كتَّابها هم من الصحافيين الذي يشتغلون في الحقل الإعلامي. فليس من فرق لديهم بين كتابة المقال اليومي وبين توسيعه ليغدو رواية أو مجموعة قصصية.
إنها الوضعية التي تفسر هيمنة الأسلوب الصحفي التقريري على الرواية الاستعجالية، وغياب التخييل المبني على إنشاء عالم خاص بالرواية، يقف في مواجهة العالم المُعطى الذي يعاني الظاهرة ويكابدها. فإذا كانت الناقدة تتحاشى إدانة الروائيين الجزائريين باعتبارهم ضحايا فترة حرجة، فإن ذلك لا يعفي الأدب في كل الأحوال من استبعاد الاستعجال من ساحته، لأنه سيفقده وظيفته، ويسويه بالعمل الصحفي الذي يقتات على الخبر المثير، ويحيا بالعناوين الملفتة.
4-الرواية ،النيِّئ والطازج:
إننا نتهم الأديب اليوم حين نشبهه بالطاهي الذي لا يُمهل طبخته فترة النضج على نار هادئة.. كلاهما يقوم بفعل “الاغتصاب” وليس الاغتصاب في أبعد مفاهيمه إلا قطف الثمرة قبل أوانها. وكل مغتصب حين يتذوق ثمرته، لا يجد فيها إلا طعمها الحامض القارص. كذلك كانت ثمرات الرواية وهي تعالج الإرهاب، والجنس، والدين.. والتي لم يجد فيها القارئ ذلك الطعم الشهي لمَطْعَم ناضج، بل وجد ما ينفِّره ويقزِّز مشاعره، فتركها لغيرها. واليوم يجد النقد الأدبي والفني على سواء، أن من مهماته الجديدة هي فضح “الاغتصاب” للموضوعات المهمة، وإرغام الأديب على التريث، وإمهال الفن فترة حضانة قبل الولادة.
لقد عبر “عمارة لخوص” الذي ذكرته الناقدة “سعاد العنزي” من قبل، أنه يرفض مصطلح “الأدب الاستعجالي” على الرغم من أنه يصرح في حوار له مع “جريدة الفجر الجزائرية اليومية” ([5]) قائلا:« كتبت رواية في ستة أشهر فقط، وهو رقم قياسي بالنسبة للكتابة، خصوصا الرواية التي تتطلب نفسا طويلا، في زمن العشرية السوداء، وقبل أن أهاجر إلى إيطاليا سنة1995 أين شرعت في كتابة رواية أخرى اسمها ”خيوط العنكبوت”، ولما بدأت الاشتغال عليها أحسست أنني لن أكملها، وفعلا لم أكلمها إلى اليوم، وتركتها جانبا، لأني كتبتها أثناء قراري بالهجرة إلى إيطاليا، وهذا لا يعني أن تصنف كتاباتي ضمن الأدب الاستعجالي، وشخصيا أرفض التسمية جملة وتفصيلا، لأن الأدب ليس له تسمية.» ([6]) وليس في شهادة الروائي من جديد سوى الحكم الأخير الذي يرفض من خلاله أن يكون للأدب صفة تميزه. صحيح لم يلحق أحد من النقاد – من قبل- بأدب نعتا لاتصال الأدب في نسق مطرد واحد. بيد أن الوضع الجديد للظاهرة فرض على النقاد مثل هذه التسمية. والغريب أن الذي أطلقها هم أهل الإعلام أنفسهم الذين يكتبون الرواية، وكأنهم يتحسسون أثر الاستعجال فيما يأتون من كتابات. إنه الأمر الذي استدعى الناقدة ” سعاد العنزي” لتردف قائلة:« كانت الأعمال الروائية في نسبة كبيرة منها تميل للتقريرية المباشرة، وصورة الصحفي تكررت بها كثيرا لدوره الحساس في كشف أعمال العنف الواقعة على الشعب الجزائري.» ([7])
إن الناقد أو المفكر حين يقول بملء فيه أن الإرهاب:« لا يستهدف السلطة السياسية فحسب، إنه يروم تقويض دعامات البناء الاجتماعي ذاته من أجل فرض حقيقة واحدة تلغي الحياة ببساطة، بتعددها، واختلافها، وتنوعها، والنسبي فيها، والعرضي. وهذا هو الخطر الداهم. » ينفض عن الأدب خدره، ويهزه هزا عنيفا، ليوقظ فيه حاسة الحارس على ثغور المجتمع. فينبهه إلى الخطر الداهم، الذي يأتي على الأخضر واليابس، ويختزل الحياة إلى منظور واحد شديد الضيق. حينها سنكون كلنا هدفا لآلته العمياء.. حينها تتعدد المسؤوليات وتتنوع.. فلا يكاد الواحد منا يخلو من مسؤولية تجاهه. ويعود للأدب والفن دوره الحقيقي في فلسفة الوقائع، وفقه أسرارها. فلا ظالم ولا مظلوم، ما دام التريث قمينا بأن يعطي للظاهرة حقها من الدرس والملاحظة. فلا يتهم طرف على حساب طرف آخر، ولا يحوَّل الفن إلى وثيقة إدانة لجهة دون أخرى .
يُتبع ….
*كلية الآداب والعلوم الإنسانية/جامعة سيدي بلعباس. الجزائر.
[1] – زكي زاز- المدونة – الجزائر وقضية الإرهاب. -4 مارس 2007- مقتبس من كتاب – قضية الإرهاب بين الحق والباطل- للكاتب عبد الرحمان عمار.
[2] -موقع سعيد بن كراد. مقلات. الإرهاب.
[3] -نفس.
[4] – سعاد العنزي لـ “الأمة العربية”:المعرفي فاق الفني حضورا في الرواية الجزائرية لفترة العشرية الحمراء
- حاورها بشير عمري.بعد إصدارها لكتابها “صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية. 12/01/2010.
[5] -جريدة الفجر الجزائرية اليومية- الأربعاء 24 نوفمبر 2010م الموافق لـ 18 ذي الحجة1431هـ.
[6] -نفس.
[7] – سعاد العنزي لـ “الأمة العربية”:المعرفي فاق الفني حضورا في الرواية الجزائرية لفترة العشرية الحمراء
- حاورها بشير عمري بعد إصدارها لكتابها “صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية. 12/
الديمقراطيه الأمريكيه أشبه بحصان طرواده الحريه من الخارج ومليشيات الموت في الداخل... ولا يثق بأمريكا إلا مغفل ولا تمدح أمريكا إلا خادم لها !