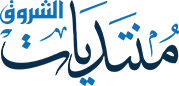مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
21-01-2024, 05:19 PM
مع رواية (الشوك والقرنفل)
لـــــ يحيى السِّنوار
بقلم عبد الله لالي
الحلقة الثالثة (03)
كلّما أوغلت في دهاليز رواية (الشوك والقرنفل) كلّما اكتشفت مزيدا من الأسرار، ومزيدا من الإبداع المدهش، ولا يكفي القراءة الأولى الانطباعية رغم أهميّتها عندي، فالنّبش في التفاصيل يجعلك أكثر اطلاعا على الحقائق الكبيرة بشكليها الموضوعي والبنائي (الإبداعي)، فقد وقر في نفسي أنّ بطل القصّة (الرّاوي) هو الأقرب إلى ملامح الكاتب، لاسيما أنّهما متقاربان في السنّ، لكن بعد التدقيق، وجدت في شخصيّة (إبراهيم) ابن عمّ أحمد (الراوي) ملامح أكثر تطابقا مع شخصيّة الكاتب (السّنوار)، فإبراهيم ظهر في الرواية قائدا فاعلا في الانتفاضة وخصوصا في مجال مطاردته للعملاء، وهذه نقطة كبيرة مشتركة بينه وبين السنوار، وكذلك تخرّجه في (الجامعة الإسلامية) بغزة، وغيرها من التفاصيل الأخرى التي ترسّخ ذلك التقاطع بين الشخصيّتين، وربّما يتضح الأمر أكثر من خلال هذا الحوار الذي دار بين أحمد (الراوي) وبين البطل إبراهيم ابن عمّه، يقول الكاتب:
"كان يتحدّث من أعماق نفسه وروحه، وكأنّه في حالة ولادة بعد المخاض، فتساءلت ألا تعتقد أنّك تبالغ في هذا؟ فحسب علمي أنّ الثوار هم العشاق والأدباء".
وكأنّي بالكاتب (السّنوار) يتحدّث عن نفسه، ويذكر بشيء من الاستحياء تلك الموهبة الأدبيّة التي حباه الله بها، ويثبت للقارئ أو المتلقّي أنّ الثائر أيضا يمكنه أن يكون كاتبا أو أديبا، بل هو أقرب النّاس إلى الكاتب والأديب لأنّه يملك تلك الروح الحرّة التي تأبى التسليم بالواقع المرير الذي يقيّد طاقة الإنسان وتطلعاته..!
والأغرب من هذا الأمر هو شعوري بشكل ما أنّ السارد وزّع نفسه على شخصيّتين، الشخصيّة الأولى والأقرب إليه هي شخصيّة إبراهيم، والشخصيّة الثانية هي شخصيّة أحمد، الذي يقوم بوظيفة (السارد) العليم الذي يعرف كلّ تفاصيل الأحداث، ومشاعر الشخصيّات وكلّ حركاتهم وسكناتهم.
البناء الفنّي الرّواية:
يبدو بشكل جليّ أن الكاتب اختار ما يسمّى بأسلوب (الواقعيّة الإسلاميّة)، الذي عرف به الكاتب الكبير نجيب الكلاني، وهو أسلوب لا يغرق كثيرا في الخيال، لأنّه يجد في الواقع ما يفوق الخيال والتّصور من أحداث ووقائع، وهو يتقاطع في جانب منه مع أسلوب الواقعيّة السّحريّة التي عرف بها كتّاب أمريكا اللاتينية، لكنّه يختلف عنه في أمر جوهريّ وهو تسييج هذا الأسلوب الواقعي بالقيم والضوابط الدينية التي لا تصطدم بالفطرة السليمة، ولا تكون سببا في تشجيع نشر الفاحشة والتحلل في المجتمع بدعوى معالجة الواقع كما هو.
وقد عالج الكاتب أهمّ قضيّة تشغل الكتاب الغربيين وكثيرا من الكتاب العرب في العصر الحديث؛ لاسيما في القصّة والرّواية، وهي قضية العلاقة بين الرّجل والمرأة، عالجها الكاتب بجرأة كبيرة، وبشجاعة تحمد له، لكن في إطار الالتزام بالقيم، يقول في حديثه من ص 168:
"ذات يوم تصادف أن وقع نظري على نظرها فشعرت بقشعريرة تسري في جسدي وبمشاعر جياشة تغزو قلبي، نظرة خاطفة غضّت بصرها على الفور، بدأت أقصد أن ألتقي بها في طريق ذهابها للجامعة أو إيّابها ولو لم أنظر إليها أو تنظر إليّ مجرّد أن تكون في الشارع كان يغمرني بشعور من الرّاحة.."
شعور بشري يمرّ به أغلب النّاس ويتفاعل معه كلّ إنسان بطريقته الخاصّة ووفقا لأخلاقه وتربيته، وعادات وتقاليد بيئته، ولذلك نجد الكاتب يعبّر عن ذلك في إطار الالتزام بمبادئه وأخلاقه الدينية فيقول في ص 169:
"اكتفيت فيما بعد بترقّب خروجها للجامعة لأراها من بعيد غير طامح في أكثر من ذلك، ولا حتّى في النّظرة فيكفيني أنّني أحببت ويكفي أنّها فهمت ذلك جيّدا، وتفهمه كلّما أحسّت بحرصي على رؤيتها كلّ يوم أو يومين، ولابدّ، ولابدّ أن أحرص عليها فلا أطمع بالمزيد في هذه المرحلة قبل أن أتخرّج من الجامعة وأكون قادرا على التقدّم لخطبتها وفق القواعد والأصول كما تربّيت منذ طفولتي".
وكما نرى فالبعد الأخلاقي له اعتباره في معالجة مثل هذه القضيّة الحسّاسة جدا في المجتمع، ولسنا مثل الكتّاب الغربيين ومن تبعهم – وأسفا – شبرا بشبر وذراعا بذراع من بني جلدتنا، ولا علاقة لذلك بقوّة الأسلوب أو ضعفه، أو بوجود الموهبّة أو عدمها، إنما هو أمر متعلّق بالقيم والمبادئ.. !
وأسلوب الواقعيّة هذا هو الذي جعل من الكاتب يؤرّخ بشكل غير مباشر لوقائع المقاومة الفلسطينية، باعتماد شكل زمني متصاعد يثبت الأحداث ويذكر أهمّ تفاصيلها ويعلّق على تفاعل النّاس معها، وقد مهّد الكاتب للحديث عن الانتفاضة الفلسطينية الكبرى، بالحديث عن حالة الشعب الفلسطيني في غزة في مرحلة أواخر الستينيات إلى السبعينيات ثم الثمانينيات التي توجت في ختامها (1987)، بانتفاضة الحجارة الشهيرة، والتي كانت الشرارة الأولى للمقاومة المسلّحة بعد ذلك.
السّرد المتوازن:
في كثير من الروايات تطغى بعض الجوانب الفنيّة على بعضها الآخر، وربما صادف ذلك هوى في نفوس فئة من القرّاء، لكنّه حتما سيزعج قراء آخرين ويصيبهم بالملل، ونجد ذلك في الروايات التي تعتمد على الأسلوب الشعري، أو ما عرف بالشاعريّة، وهي خاصية رائعة لا يتقنها إلا من أوتي موهبة كبيرة في التدفق السّردي مع امتلاك ناصية اللغة، ولكن الإسراف في ذلك يجعل من الرواية أقرب إلى الخاطرة الطويلة منها إلى الأحداث الرّوائية المتفاعلة بحيوية ونشاط، ونجد ذلك عند أحلام مستغانمي، وهي روائية بارعة ومتمكنة بلا شك، إلا أنّ إسرافها في السّرد الشعري، مع الغزارة السرديّة، يجعل القارئ ينسى تفاصيل الأحداث ويخرج في أتون الخواطر النفسيّة المتكررة بنمطية مملّة أحيانا..!
يمكننا القول بثقة تامة أنّ يحيى السّنوار نجا من الوقوع في مثل هذا الفخ السّردي المميت، الذي يشبه انغماس الفَراش في أتون اللهب الساحر (المحرق)، وكانت الواقعيّة الإسلامية قد منحته ذلك التنويع الجميل الذي يحبّه القارئ ويفتن به، فمرّة يعتمد السّرد المباشر الذي يعكس الأحداث بصدق، ومرّة أخرى يلجأ إلى الحوار المثير والمتفجرّ أحيانا، ومرّة ثالثة يلجأ إلى الوصف والتصوير البديع الذي يحبس اللحظة في مشهد مدهش..!
من مواضيعي
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار
0 مع رواية (الشوك والقرنفل) لـــــ يحيى السِّنوار