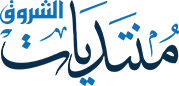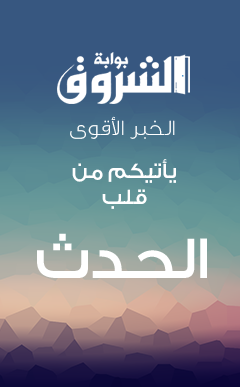تاريخ الأناضول قبل الدولة العثمانية
11-03-2021, 12:17 PM
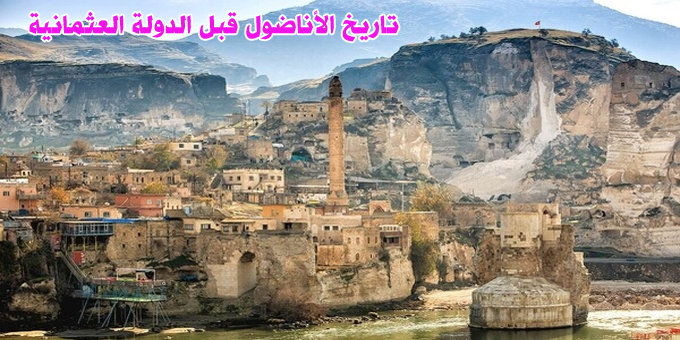
تُعَدُّ منطقة الأناضول من أقدم المناطق في العالم عمرانًا بالسكان، وتُثبت بعض الحفريَّات وجود الإنسان في هذه الأرض منذ أكثر من سبعة آلاف سنة قبل الميلاد[1]، ولعلَّ الأهميَّة الجغرافيَّة، وتَوفُّر المياه، واعتدال المناخ نسبيًّا من العوامل التي ساعدتْ على استيطان المنطقة بالسكان؛ بل جعلتها قِبلةً لكلِّ الحضارات القويَّة؛ حيث قلَّ أن تجد حضارةً قديمةً أو حديثةً إلا وحاولتْ السيطرة على أرض الأناضول؛ ومِنْ ثَمَّ فقد رأينا في التاريخ حضارات الحيثيين، والأكاديين، والأشوريين، واليونانيين، والفارسيين، والأرمن، والمقدونيين[2][3]، كلَّها تُسيطر في فترةٍ من فتراتها على شبه جزيرة الأناضول؛ ولكن انتهى المطاف بالأناضول في فترة العصور القديمة بالوصول إلى حكم الرومانيين، ذلك قبل الميلاد بأكثر من مائة عام، حيث أصبح الأناضول جزءًا مهمًّا من الإمبراطورية الرومانية؛ بل جعل الرومانيون مقرَّ حكمهم في غرب الأناضول في مدينة أفسس Ephesus[4].
وفي تطوُّرٍ مهمٍّ في تاريخ المنطقة أنشأ قسطنطين الأول، أو العظيم Constantine the Great، الإمبراطور الروماني المشهور، مدينة القسطنطينية Constantinople على مضيق البوسفور في سنة 324 بعد الميلاد، ثم نقل إليها العاصمة في عام 330م[5]، أمَّا التطوُّر الأهمُّ في تاريخ الأناضول فكان انقسام الإمبراطورية الرومانية في سنة 395م بعد موت ثيودوسيوس الأول Theodosius I، إلى قسمين شرقي وغربي، فصار القسم الشرقي معروفًا باسم الإمبراطورية الرومانية الشرقيَّة، أو الإمبراطورية البيزنطية، أمَّا القسم الغربي فكان الإمبراطورية الرومانية الغربيَّة، وصارت القسطنطينية بذلك عاصمةً للإمبراطوريَّة الشرقيَّة، بينما صارت روما عاصمةً للإمبراطورية الغربيَّة[6].
ومن النقاط المهمَّة كذلك في تاريخ الأناضول تحوُّل المنطقة إلى الديانة النصرانية، وذلك في عهد قسطنطين الأول (306-337م)[7]، وبذلك اختفت الوثنيَّة إلى حدٍّ كبيرٍ من المنطقة، ومن الجدير بالذكر لفت النظر إلى أنَّ الإمبراطورية الرومانية الشرقيَّة -أي البيزنطيَّة- بشكلٍ عامٍّ، كانت تدين بالمذهب الأرثوذكسي، بينما كانت الإمبراطوريَّة الغربيَّة تدين بالمذهب الكاثوليكي؛ وقد أدَّى هذا الانقسام الديني إلى حروبٍ وعداواتٍ طويلة[8]، لعلَّ آثارها ما زالت باقيةً إلى يومنا هذا.
وإذا كانت الديانة النصرانية هي أشهر الديانات في الأناضول في زمن الإمبراطورية البيزنطية الأوَّل؛ فإنَّ هذا لا يعني أنَّ شعب الأناضول كان بيزنطيًّا أو رومانيًّا؛ إنما في الواقع كان هذا الشعب -من ناحية العرق- مكوَّنًا من خليطٍ من عدَّة شعوب؛ وذلك نتيجة سيطرة عدَّة حضارات على المنطقة في فترات تاريخها المختلفة، ومن هنا فشعب الأناضول عرقيًّا كان ينتمي إلى الحيثيين، والفرنجيين، والغاليين، والفارسيين، والساميين، واليونانيين، وغيرهم، ويرى كثيرٌ من العلماء أنَّ القطع بأغلبيَّة أصلٍ على غيره في شعب الأناضول أمرٌ لا يمكن الجزم فيه بشيء، ولكن على العموم كانت الدولة البيزنطية تعتمد اعتمادًا شبه كاملٍ على هذا الشعب في تكوين الدعامة الرئيسة للدولة؛ خاصَّةً بعد انقسام القسم الشرقي منها عن الغربي، وصار الأناضول بذلك -إلى جوار مدينة القسطنطينية- المعقل الرئيس للدولة البيزنطية[9]، والواقع أنَّ الأناضول لم يكن مصدرًا للرجال فقط بالنسبة إلى البيزنطيين؛ إنما كانت مصدرًا للمال والثراء كذلك؛ وذلك عن طريق الزراعة والتجارة، وإن كان المال والقمح وبقيَّة الإمدادات التموينيَّة كانت تأتي كذلك من الشام ومصر وتونس؛ وغيرها من المستعمرات الرومانيَّة[10].
ولكون الأناضول واقعًا في عمق الإمبراطورية البيزنطية، فجنوبه الشام، وغربه البلقان، وهذه كلُّها أراضٍ بيزنطيَّة، فإنَّ هذا الموقع الجغرافي جعله آمنًا إلى حدٍّ كبيرٍ من الاختراقات من الحضارات الأخرى؛ ومن ثَمَّ غلب على سكانه الطابع البيزنطي كاملًا، فكان الشعب كلُّه نصرانيًّا أرثوذكسيًّا، وكانت لغته الأساسيَّة هي اللغة اليونانيَّة؛ بل كانت ثقافته وفكره وطريقة حياته متأثِّرةً تمامًا بالنسق البيزنطي، خاصَّةً ما ينتمي للمقدونيين الذين حكموا الدولة البيزنطيَّة فترةً طويلةً من الزمن[11].
ومع ظهور الإسلام سنة 610 ميلادية بدأت إرهاصات تغيير كبير في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإمبراطورية البيزنطية، إذ ما لبث المسلمون أن أسَّسوا دولتهم الأولى في الْمَدِينَة سنة 622 ميلاديَّة، وبعدها بسنواتٍ قليلةٍ حدث الصدام مع الإمبراطورية البيزنطية، كانت البداية فيه في عهد الرسول ﷺ في موقعة مؤتة 629م (8 هـ)، ثم تبوك 630م (9 هـ)، وبعدها حدثت عدَّة معارك كبرى؛ كان أهمُّها موقعة اليرموك سنة 636م (15هـ) ثم فتح مصر في سنة 642م (21هـ)، وما لبث البيزنطيون أن فقدوا معظم أراضيهم في الشام وشمال إفريقيا لصالح المسلمين؛ ومن ثَمَّ أصبحت الأناضول هي الحدود الشماليَّة المباشرة للدولة الإسلاميَّة[12].
لم يتوقَّف الأمر عند هذا الحدِّ؛ فانطلق المسلمون في عهد الخلافتين الأموية والعباسية، بعدَّة حملاتٍ عسكريَّةٍ في داخل الأناضول؛ بل وصلت هذه الحملات إلى القسطنطينية نفسها، وهذا يعني اختراق المسلمين لكامل الأناضول من جنوبه الشرقي إلى شماله الغربي، ومع ذلك لم تُؤثِّر هذه الحملات في التركيبة الديموجرافيَّة أو الثقافيَّة أو الدينيَّة للأناضول لأنَّها كانت مؤقَّتةً بشكلٍ كبير، فلم تكن الحملة تتعدَّى أيامًا أو شهورًا قليلةً على الأكثر.
وينبغي الأخذ في الاعتبار أنَّ حديثنا هنا عن الأناضول يشمل المناطق الواقعة شمال جبال طوروس، أمَّا المناطق الواقعة جنوب جبال طوروس فإنها جغرافيًّا وتاريخيًّا تابعةٌ لبلاد الشام، وقد فتحها المسلمون قديمًا؛ ومِنْ ثَمَّ صارت أغلبيَّة سكانها من المسلمين، وأعني بهذه المناطق ديار بكر، وماردين، وعنتاب؛ بل وملطية الواقعة شمالًا داخل جبال طوروس، ومن المعروف أنَّ كلَّ هذه المناطق، ومع كونها من بلاد الشام جغرافيًّا، فإنَّها داخل حدود دولة تركيا الحاليَّة.
إذن لم يُغيِّر المسلمون من التركيبة السكانية للأناضول نفسه، فظلَّ محافظًا على شكله الخاص المنتمي إلى الثقافة البيزنطيَّة القديمة، غير أنَّ هناك تغيُّرًا طفيفًا حدث في هذه التركيبة خلال عهد قسطنطين التاسع Constantine IX وبعده، وقد أدَّى هذا التغيير إلى حدوث بعض الآثار التي تضخَّمت مع الوقت!
حكم قسطنطين التاسع مع زوجته الإمبراطورة زُوي Zoë بداية من سنة 1042م، ثم حكم منفردًا بعد وفاة زوجته سنة 1050م، لمدَّة خمس سنوات حتى سنة 1055م[13]، وقد واجه في هذه الفترة أزمات عسكريَّة كثيرة داخليَّة وخارجيَّة ممَّا دعاه إلى انتهاج سياساتٍ جديدةٍ كانت لها آثارٌ سلبيَّةٌ كبيرةٌ على الإمبراطورية البيزنطية، وكان من هذه السياسات إعفاء نبلاء المحافظات الحدودية في الإمبراطورية من توفير جنود للدولة؛ وذلك في مقابل ضرائب معينة يدفعونها للخزينة؛ وقد أدَّت هذه السياسة إلى فقد خمسين ألف جندي كانت توفِّرها هذه المحافظات، وهذا بدوره أدَّى إلى إضعاف الجيش البيزنطي بشكلٍ ملموس، جدير بالذكر أن هذه الأموال التي تمَّ تحصيلها تم إنفاقها في مظاهر ترفيَّة ما لبثت أن ضاعت[14]!، وهذا التدهور أدَّى إلى تطوُّرٍ سياسيٍّ جديدٍ كان له آثارٌ سلبيَّةٌ أعمق، وهي اتِّجاه قسطنطين التاسع إلى الاعتماد على الجنود المرتزقة من الشعوب الأجنبيَّة المختلفة، مثل الروس، والنورمان، والألمان، والترك[15]، وكلُّ هذه شعوب في الأصل معاديةٌ للدولة البيزنطيَّة، ولا تَكِنُّ أيَّ ولاءٍ لها، وما جاءت إلا من أجل المال، وبالتالي لم يزدد الجيش البيزنطي إلا ضعفًا، وفوق هذا فقد تغيَّرت نسبيًّا التركيبة السكانيَّة المنغلقة للأناضول، وهذا أدَّى إلى ضعف التماسك الاجتماعي للإمبراطوريَّة، وصارت العلاقة ضعيفةً للغاية بين الحاكم والمحكوم[16]، وكلُّ هذا كان يُنذر بكارثةٍ قد تحلُّ بالإمبراطوريَّة إذا ما ظهر عاملٌ جديدٌ قويٌّ مؤثِّر، وقد كان؛ حيث ظهرت الدولة السلجوقية الإسلاميَّة فجأةً على الساحة العالميَّة، وكان لها أكبر الأثر في انهيار الحكم البيزنطي لمعظم الأناضول!
والدولة السلجوقية من أكبر الدول في التاريخ الإسلامي، ومن أهمَّها، وهي من العائلات التركيَّة الكبرى، وقد تأسَّست في سنة 1037م الموافق 429 هجرية[17]، وسيطرت في غضون سنواتٍ قليلةٍ على وسط آسيا، وامتدَّت حتى ضمتْ إيران وشمال العراق، وأخيرًا ضمَّت بغداد عاصمة الخلافة العباسية في سنة 1055م (447هـ)[18]، وصارت هي الدولة الأكبر في الأمَّة الإسلاميَّة، وكذلك صارت هي الجيش الرئيس للخلافة العباسية؛ اصطدم السلاجقة مع الدولة البيزنطية، وتمكنوا من انتزاع إقليمي چورچيا وأرمينيا[19]، ثم كانت بينهم وبين الإمبراطورية البيزنطية أهم معركةٍ في تاريخ المنطقة؛ بل إن شئت فقل: إحدى أهم المعارك في التاريخ الإنساني، وهي معركة ملاذكرد Manzikert؛ وذلك في سنة 1071م (463هـ)[20]، التي كان لها من الآثار ما غيَّر بقوَّةٍ من مجرى التاريخ!
انتصر السلاجقة في موقعة ملاذكرد بقيادة البطل الإسلامي الكبير ألب أرسلان Alp Arslan على البيزنطيين بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع Romanos IV انتصارًا ساحقًا، وأُسِر الإمبراطور البيزنطي ثم أُطْلق مقابل فديةٍ كبيرة[21][22]. أفلستْ خزينة الدولة البيزنطية، ودُمِّر الجيش البيزنطي تمامًا، وأُطلق كلُّ أسارى المسلمين في بلاد الروم[23]، وفُتِحَت أمام الدولة السلجوقية أبواب الأناضول، وتحقَّقت نتائج ضخمة بقيت آثارها حتى يومنا هذا.
قادت موقعة ملاذكرد إلى حدثين كبيرين كان لهما الأثر المباشر على تاريخ الأناضول، كما كان لهما الأثر المباشر كذلك على تغيير التركيبة السكانيَّة لهذه المنطقة؛ أمَّا الحدث الأوَّل فهو حركة السلاجقة لفتح الأناضول وضمّه إلى دولتهم، والحدث الثاني هو هجرة الأرمن من دولتهم المطلَّة على البحر الأسود، التي سيطر عليها السلاجقة قبل موقعة ملاذكرد، إلى منطقة قليقية Cilicia في الأناضول على ساحل البحر الأبيض المتوسط؛ ممَّا قاد إلى تأسيس مملكة أرمينيَّة أخرى عُرِفَت باسم أرمينيا الصغرى Lesser Armenia. هذان الحدثان كان لهما أثرٌ كبيرٌ على تغيير ديموجرافيَّة الأناضول.
لقد استطاع سليمان بن قتلمش Suleiman ibn Qutulmish، أن يُؤسِّس دولةً للسلاجقة في الأناضول استمرَّت حوالي 230 سنة[24]، عُرِفَت باسم سلاجقة الروم، واتَّخذت في البداية إزنيك İznik عاصمةً لها، ثم تحوَّلت العاصمة إلى قونية Konya[25]، وهذه السيطرة السلجوقيَّة على معظم الأناضول أدَّت إلى هجراتٍ تركيَّةٍ متتالية، خاصَّةً إلى شرق الأناضول ووسطه، وأسَّس السلاجقة قرًى خاصَّةً بهم عاش فيها المسلمون جنبًا إلى جنبٍ مع السكان الأصليِّين للمنطقة، وتدريجيًّا تحوَّل عددٌ كبيرٌ من أهل البلاد إلى الإسلام، وبذلك تغيَّرت التركيبة السكانيَّة تغيُّرًا كبيرًا أضفى شكلًا جديدًا على الأناضول[26].
تزامن مع تأسيس دولة سلاجقة الروم حركة الأرمن من مملكة أرمينيا الكبرى في اتجاه الجنوب الغربي إلى منطقة قليقية في الأناضول على ساحل البحر الأبيض المتوسط؛ وذلك في عام 1080م، ليؤسِّسوا بعد ذلك مملكة أرمينيا الصغرى، التي ظلَّت مستقلةً قرابة الثلاثة قرون، متخذةً من مدينة سيس Sis عاصمةً لها، ومغيِّرةً من التركيبة السكانيَّة للأناضول بطريقةٍ أخرى، وهي وجود الأرمن بكثافةٍ في هذه المنطقة الجنوبيَّة، وليُصبح للأرمن وجودٌ في تاريخ الصراع مع الدولة البيزنطيَّة أحيانًا، ومع مسلمي الشام أحيانًا أخرى، ومع مسلمي الأناضول أحيانًا ثالثة، آخذين في الاعتبار أنَّ الكنيسة الأرمينيَّة منفصلةٌ عن الكنيسة الأرثوذكسيَّة التي يتبعها البيزنطيون، وهذا ولَّد صراعًا بين الطرفين، وإن كانوا جميعًا تحت مظلَّة النصرانية[27].
أدَّى وجود الأتراك والأرمن بشكلٍ كبيرٍ في الأناضول إلى اتجاه كثيرٍ من اليونانيين -أهل الأناضول الأصليِّين- إلى غرب الأناضول ليعيشوا في المناطق الخصبة القريبة من ساحل بحر إيجة[28]، التي ما زالت تحت السيطرة البيزنطيَّة[29]، وبذلك صار الوسط الأناضولي تركيًّا مسلمًا؛ بينما الجنوب المطل على الساحل أرمينيًّا، ثم هناك الشمال الغربي أرثوذكسيًّا بيزنطيًّا، وإن كان هذا لم يمنع تداخل الأنواع الثلاثة من السكان في عدَّة مناطق من الأناضول، ولكن بشكلٍ محدود.
ظلَّ الوضع على هذه الصورة خلال القرن الثاني عشر الميلادي (السادس الهجري) وأوائل القرن الثالث عشر الميلادي (السابع الهجري) عندما حدث تطوُّرٌ عالميٌّ جديدٌ أدَّى إلى بعض التغييرات في تاريخ الأناضول؛ ومن ثَمَّ في تركيبته السكانيَّة وموازينه السياسيَّة، وهذا التطوُّر العالمي كان ظهور دولة المغول في شرق آسيا، التي سرعان ما بدأت زحفها الرهيب في اتجاه الغرب.
ظهرت دولة المغول في سنة 1206م في منغوليا على يد چنكيز خان، وسرعان ما توسَّعت هذه الدولة حتى صارت إمبراطوريَّةً ضخمةً تضمُّ مساحاتٍ شاسعةً من الأراضي في آسيا وشرق أوروبا[30]، ومع أنَّ هذه الإمبراطوريَّة نشأت في مناطق بعيدة جدًّا عن الأناضول، فقد كان لها من التأثير المباشر وغير المباشر، على المنطقة ما يجعل ظهورها أحد المنعطفات التاريخيَّة المهمَّة التي ينبغي الوقوف أمامه.
كان لظهور المغول آثارٌ كبيرةٌ على الأناضول نذكر منها ثلاثة؛ أمَّا الأول فهو إزاحة عددٍ كبيرٍ من أتراك آسيا الذين يعيشون في منطقة التركستان وأفغانستان، إلى الغرب؛ حيث هرب هؤلاء الفلاحون إلى أبعد المناطق غربًا ابتعادًا عن المغول، وكان من هذه المناطق الأناضول، فأدَّى هذا إلى زيادة تتريك الأناضول وأسلمته، حيث كان معظم هؤلاء المهجَّرين من الأتراك المسلمين[31].
وأمَّا الأثر الثاني فكان سقوط الدولة الخوارزمية التركيَّة، واجتياحها الكامل من قِبِل المغول، وقد أدَّى هذا السقوط إلى تحرُّك قادتها، وأهمهم جلال الدين خوارزم، إلى اتجاه الغرب، واصطدام هؤلاء عسكريًّا مع سلاجقة الروم حيث كان يبحث جلال الدين خوارزم عن مناطق جديدة يسيطر عليها عوضًا له عن المملكة التي تركها للمغول، وقد هُزم جلال الدين في صدامه مع سلاجقة الأناضول، وقُتِل في عام 1231م (628هـ)[32]، وكان من نتيجة ذلك أن انضمَّ عددٌ كبيرٌ من جنوده إلى السلاجقة في الأناضول، أو إلى الأيوبيين في الشام ومصر[33]، وهذا أدَّى إلى بعض النتائج التي أثَّرت في المنطقة.
أمَّا الأثر الثالث والأخير الذي نُشير إليه فهو تحرُّك المغول أنفسهم غربًا والوصول إلى الأناضول (1259-1260م)، واصطدامهم مع سلاجقة الروم المسلمين، وانتصارهم عليهم، واحتلال شرق الأناضول احتلالًا كاملًا، واضطرار وسط الأناضول وغربه إلى التبعيَّة لهم، وقيام دول مغوليَّة في المنطقة[34]، وهذا بطبيعة الحال سيؤثِّر في شكل الأناضول في الفترة القادمة.
***
وصلت بنا الأحداث إلى النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي (النصف الثاني من القرن السابع الهجري) وهنا يمكن أن نلقي نظرةً على القوى المؤثِّرة الموجودة في الأناضول:
أولًا: قوة دولة سلاجقة الروم:
الواقع أنَّ هذه الدولة قد دخلت في طور الضعف بعد موت قائدها علاء الدين كَيقباد Alā ad-Dīn Kayqubād، وكان قد حكم قطاعًا كبيرًا من الأناضول من سنة 1219 إلى 1237م (616-634هـ)، وكان من أكابر الملوك وأحسنهم سيرة، وقد تولَّى بعده ابنه كيخسرو الثاني Kaykhusraw II، فحكم سبع سنوات من 1237 إلى 1244م (634 إلى 641هـ)، وقد هُزِم هزيمةً قبيحةً من المغول في سنة موته نفسها؛ إذ مات بعد الهزيمة بقليل، وبموته صارت دولة السلاجقة اسمًا بلا قوَّة؛ إذ صارت تابعةً تمامًا لدولة المغول، ولا تملك من أمرها شيئًا، وإن كان المغول قد أبقوا -لأسباب سياسيَّة وإداريَّة- أبناء السلاجقة حكَّامًا صوريِّين على الإمارات المكوِّنة لدولتهم، وقد كانت هذه الإمارات تشغل وسط الأناضول وغربه باستثناء الشمال الغربي الذي كان يتبع الإمبراطورية البيزنطية[35].
ثانيًا: الدولة الإيلخانية:
انقسمت دولة المغول الكبرى بعد موت زعيمها الأكبر منكوخان Möngke Khan سنة 1257م[36] إلى عدَّة دول، وكان من أهمِّ هذه الدول دولة هولاكو أخو منكوخان [37]، وقد تلقَّب بلقب «الإيلخان» أي الخان الأصغر، وقد تسمَّى هكذا تواضعًا لأخيه الخان الأكبر قوبيلاي، فعُرِفت دولته بالدولة الإيلخانية، وكانت تحكم فارس والعراق وأجزاء من الشام وشرق الأناضول[38]، وهم الذين هزموا السلاجقة في أرض الأناضول، وصاروا يتحكَّمون في سياسة الأناضول كلِّه تقريبًا مع تمركزهم في الشرق فقط. كانت الدولة الإيلخانية تتبع الديانات الوثنيَّة التي يدين بها المغول منذ زمن چنكيز خان؛ ولكن في عام 1295م (694هـ) اعتنق قائدها الإيلخان غازان الإسلام، وتسمَّى بمحمود [39]، وصارت الدولة من بعده إسلاميَّةً سُنِّيَّة، وإن كانت قد تشيَّعت في بعض فتراتها؛ ولكنَّها عادت من جديد للالتزام بالمنهج السني[40]، وكان مقرُّ الدولة في تبريز بإيران، وقد سقطت هذه الدولة في سنة 1335م (737هـ)[41].
ثالثًا: الإمبراطورية البيزنطية:
كانت الإمبراطورية البيزنطية قد تعرَّضت لكارثةٍ سنة 1204م؛ حيث غزاها نصارى غرب أوروبا اللاتين، فيما عُرِف بالحملة الصليبية الرابعة، ونتج عن ذلك احتلال القسطنطينية، وتقسيم الإمبراطورية البيزنطية إلى ثلاثة أقسام رئيسة؛ القسم الأوَّل: هو الإمبراطورية اللاتينية وهي تحكم القسطنطينية وقطاعًا كبيرًا من شرق البلقان، بالإضافة إلى الشمال الغربي من الأناضول، والقسم الثاني يُعرف بإمبراطورية نيقية Empire of Nicaea ويشمل جزءًا كبيرًا من غرب الأناضول بالإضافة إلى مملكة طرابزون الواقعة في وسط الأناضول الشمالي على ساحل البحر الأسود، أمَّا القسم الثالث فيُعرف بإمبراطورية إبيروس Empire of Epirus، وكانت تسيطر على غرب البلقان، في مناطق ألبانيا، والجبل الأسود، والبوسنة، وكرواتيا[42].
وقد استطاعت الإمبراطورية البيزنطية أن تتخلَّص من هذا الاحتلال اللاتيني الكاثوليكي في سنة 1261م؛ ولكنَّها خرجت ضعيفةً منهكةً من هذا الصراع، وإن كانت ما زالت تُسيطر على الشمال الغربي من الأناضول، بالإضافة إلى مملكة طرابزون[43].
رابعًا: مملكة أرمينية الصغرى:
تقلَّصت المملكة الأرمينيَّة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي، فكانت تُسيطر على سهل أضنة Adana المطل على البحر الأبيض المتوسط في جنوب الأناضول، وذهب كثيرٌ من الأراضي التي تُسيطر عليها إلى المماليك[44] ثم إلى الدولة الإيلخانية، وكذلك إلى دولة السلاجقة.
خامسًا: دولة المماليك:
بعد انتصار المماليك الكبير على المغول في موقعة عين جالوت سنة 1260م (658هـ) استطاعوا تحرير قطاعٍ كبيرٍ من الشام، ووصلوا في أملاكهم إلى جبال طوروس، وصاروا من القوى المؤثِّرة في سياسة الأناضول بشكلٍ ما[45]، وإن لم تكن لهم سيطرةٌ مباشرةٌ على الأناضول نفسه.
سادسًا: الإمارات الحدودية التركيَّة بين الأناضول والشام:
هذه إمارات يقودها أتراك ليسوا من فروع السلاجقة، وكانوا يدينون بالولاء أحيانًا للمماليك، وأحيانًا أخرى للإيلخانيِّين، وأحيانًا ثالثة للعثمانيِّين الذين سيظهرون لاحقًا، وأحيانًا رابعة يستقلُّون عن كلِّ هؤلاء، وكان أشهر هذه الإمارات، إمارة ذي القادر، وكان مقرُّها الرئيس مدينة البستان، وإمارة أولاد رمضان ومقرُّها الرئيس في مدينة أضنة، وقد ظهرت هذه الإمارة الأخيرة في مكان الأرمن وكانوا سببًا مباشرًا في سقوط المملكة الأرمينيَّة سنة 1375م[46].
سابعًا: الجمهوريَّات الإيطاليَّة:
لم يكن للجمهوريَّات الإيطاليَّة أملاكٌ كثيرةٌ في الأناضول نفسه، وإن كانوا يُسيطرون على بعض المناطق المحيطة به؛ ممَّا جعل لهم دورًا في سياسته، وهذه الجمهوريَّات هي البندقية، وچنوة، فكانت البندقية تُسيطر على أجزاء من اليونان وعلى بعض جزر بحر إيجة[47]، وكانت چنوة تُسيطر على بعض الموانئ الروسيَّة والأوكرانيَّة في البحر الأسود، بالإضافة إلى بعض جزر بحر إيجة[48]، وهذا جعل لأساطيل الجمهوريَّتين وجودًا بشكلٍ دائمٍ في المنطقة ممَّا جعل تأثيرهما مباشرًا في بعض الأحيان.
***
ذكرنا سابقًا أنَّ دولة سلاجقة الروم هُزِمتْ هزيمةً كبيرةً من التتار في سنة 1244م (641هـ)، وقد أدَّى هذا إلى ضعفٍ شديدٍ بالدولة، وإلى تبعيَّةٍ سياسيَّةٍ وعسكريَّةٍ للدولة الإيلخانيَّة المغوليَّة، ولم يقف الأمر عند هذا الحدِّ؛ ولكن بدأت الدولة في التحلُّل التدريجي، وصار من المعتاد أن تفقد كلَّ عدَّة سنوات قطاعًا من أرضها لصالح إحدى العائلات التركيَّة المنضوية تحت رايتها منذ زمن، لتتكوَّن بذلك إمارات تركيَّة متعدِّدة في الأناضول حتى عام 1308م، الذي شهد موت آخر السلاجقة وهو غياث الدين مسعود، فانقرضت بذلك دولة سلاجقة الروم تمامًا، وشهد الأناضول ظهور إمارات تركيَّة عديدة، وكانت معظمها -إن لم يكن كلها- تتبع الدولة الإيلخانية في تبريز، وكانت العلاقات بينها وبين بعضها البعض متوتِّرةً إلى حدٍّ كبير، ومعقَّدةً غاية التعقيد، ويصعب جدًّا على الدارس أن يعرف الحدود الطبيعيَّة الحقيقيَّة بين كلِّ إمارتين لسرعة تغيُّرها من سنةٍ إلى سنة، وبسبب أنَّ ظهور بعض الإمارات كان يصحبه اختفاء إماراتٍ أخرى، وبسبب حدوث انشقاقاتٍ كثيرةٍ في كلِّ إمارةٍ يجعلها إمارتين أو ثلاثًا تنتمي إلى العائلة نفسها؛ ممَّا يقود إلى غموضٍ كبيرٍ في فهم الحدود والعلاقات بين الإمارات، ولهذه الأسباب فإنَّ عدد هذه الإمارات مختلَفٌ فيه بشَّدةٍ بين المؤرِّخين، وعمومًا فإنَّنا نذكر هذه الإمارات في هذا السياق للاطلاع على الظروف التي نشأت فيها الدولة العثمانية، ولسنا معنيِّين بدراسة التفاصيل الكثيرة الدقيقة التي كانت بين هذه الإمارات، ولا قصَّة حياة كلِّ إمارة، ولقد استقيت بعض المعلومات عن هذه الإمارات من كتاب مسالك الأبصار لابن فضل العمري [49]، وكذلك من كتاب تاريخ الدولة العثمانية لأوزتونا [50]، فكانت على النحو الآتي:
(1) إمارة قرمان Karaman: هذه هي أهمُّ الإمارات مطلقًا في هذا التوقيت، وزعماء هذه الإمارة من بني قرمان، وهي عائلةٌ تركيَّةٌ كبيرة، وكانت منضويةً تحت لواء السلاجقة، ومع ذلك فهي لم تكن تشعر بالولاء الكامل لها؛ بل كانت كأنَّها منافسةٌ لها، وكانت بينها ودولة المماليك علاقاتٌ ودِّيَّة، ويمكن لهذه العلاقات أن تقود يومًا إلى سيطرةٍ كاملةٍ على الأناضول بدعم المماليك في القاهرة، لهذا فإنَّ هذه الإمارة كانت من أوائل الإمارات التي انفصلت فعليًّا عن دولة السلاجقة، وقد حدث هذا في عام 1250م، وإن كانت تابعةً لهم اسميًّا حتى اللحظات الأخيرة من عمر الدولة السلجوقية. كانت قرمان إمارةً صاحبةَ كلمة؛ إذ كانت كلُّ الإمارات التركيَّة الأخرى تُقَّدرها وتحترمها؛ بل وتدفع لها أحيانًا شيئًا من الضريبة، وقد بلغ تعداد فرسانهم أكثر من أربعين ألف فارس، وكانوا يُسيطرون على مساحةٍ تزيد على مائة ألف كم2 من وسط الأناضول، وقد اتَّخذوا من قونية عاصمةً لهم بعد سقوط الدولة السلجوقية، ومن المعروف أنَّ السلاجقة كانوا قد اتَّخذوا قونية عاصمةً لهم، ومعني هذا أنَّ بني قرمان كانوا يعتبرون أنفسهم الامتداد الطبيعي للسلاجقة، وأحق الناس بقيادة الأناضول بعد انقراض السلاجقة، وهذه معلوماتٌ في منتهى الأهمِّيَّة؛ حيث ستُفسِّر الصراع المرير الذي سينشأ بين هذه الإمارة وإمارة العثمانيِّين عندما يعلو نجم إمارة بني عثمان، وتُصبح هي المنافس الأوَّل لبني قرمان.
(2) إمارة حميد Hamed: وتعدُّ هذه الإمارة جزءًا منفصلًا من الإمارة السابقة بني قرمان، وقد تأسَّست في سنة1280م، وكانت عاصمتها مدينة إسبرطة Isparta.
(3) إمارة آخي Ahi: وتعدُّ -أيضًا- من أجزاء بني قرمان، وكان مقرُّها أنقرة، وقد تأسَّست سنة 1290م.
(4) إمارة تكة Teke: وهي كذلك من فروع بني قرمان، وقد تأسَّست في سنة 1300م، وسيطرت على المنطقة الجنوبيَّة من إمارة بني قرمان، فكانت مطلةً على البحر الأبيض المتوسط، وتُسيطر على مدينتي أنطاليا والعلايا Alaiye المهمَّتين، وتذكر بعض المصادر أنَّ جنود هذه الإمارة كانوا يبلغون أربعين ألف فارس.
هذه الإمارات الأربع السابقة تخرج كلُّها من إمارة بني قرمان، وتقع كلُّها في وسط الأناضول، وبهذا فهي تُمثِّل كتلةً كبيرةً قويَّةً تتحكَّم إلى حدٍّ كبيرٍ في الحركة داخل الأناضول من شرقه إلى غربه والعكس.
(5) إمارة قزل أحمدلي Qizil Ahmadli: هذه إمارة شماليَّة في وسط الأناضول فهي تقع شمال إمارة بني قرمان، وكانت منقسمةً إلى قسمين هما چاندار Jandar وإسفنديار Isfendiyar، وكانت تُسيطر على مدنٍ مهمَّة، مثل: قسطموني Kastamonu وسينوب Sinop، وقد بلغ عدد فرسانها ثلاثين ألف فارس.
(6) إمارة كرميان Germiyanids: تعدُّ هذه الإمارة هي الإمارة الثانية في الأهمِّيَّة بعد إمارة بني قرمان، وكانت تقع إلى الغرب منها، وهي إمارةٌ مقتدرةٌ تأسَّست سنة 1260م، ويبلغ عدد فرسانها أربعين ألفًا، وكانت قاعدتهم الرئيسة في مدينة كوتاهية Kütahya المهمَّة.
(7) إمارة منتشا Menteshe: وتقع جنوب إمارة كرميان، وقد تأسَّست سنة 1280م، وعلى الرغم من أهميَّتها الاستراتيجيَّة لوقوعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وكذلك بحر إيجة، فإنَّ فرسانها كانوا قليلين، لا يزيدون عن ثلاثة آلاف فارس، وكانت أهمُّ المدن التي سيطروا عليها مُغلا Muğla، وميلاس Milas.
أمَّا أقصى غرب الأناضول فكانت هناك ثلاث إمارات مستقلَّة، وعلى الرغم من ضعفها فإنَّها كانت آمنةً إلى حدٍّ ما، وذلك لبعدها عن بقيَّة الإمارات، وكذلك عن الدولة الإيلخانية، وهذه الإمارات هي من الشمال إلى الجنوب:
(8) إمارة قراسي Karesi: وهي إمارةٌ ضعيفةٌ مركزها مدينة بالكسير Balıkesir، وتذكر بعض المصادر أنَّ جنودها كانوا مائتين فقط! وقد تأسَّست سنة 1303م.
(9) إمارة صاروخان Saruhan: وهذه تأسَّست في سنة 1300م، وكانت قاعدتهم في مدينة مانيسا Manisa المهمة، وبلغ عدد فرسانهم ثمانية آلاف فارس.
(10) إمارة بني آيدن Aydin: وهي أهمُّ الإمارات الغربيَّة؛ إذ كانت تُسيطر على مدينة إزمير المهمَّة للغاية، وكذلك على مدينة آيدن، وقد بلغ عدد فرسان هذه الإمارة عشرة آلاف فارس.
هذه هي الإمارات التي تكوَّنت في الأناضول عند سقوط الدولة السلجوقية، وهذا بالطبع بالإضافة إلى الإمارة الرئيسة وهي الإمارة العثمانية، ونلفت النظر إلى موقع الإمارة العثمانية من هذه الإمارات الكثيرة؛ حيث كانت تقع في الشمال الغربي من الأناضول، وتُحيط بها الإمارات التركيَّة من جانبين، حيث كان بنو كرميان في الجنوب، وإمارة قزل أحمدلي في الشرق، أمَّا في الغرب والشمال فكانت حدودها مع الإمبراطورية البيزنطية، التي كانت تُسيطر على الأراضي الخصبة في هذه المنطقة الشماليَّة الغربيَّة من الأناضول.
تُعطينا هذه التقسيمات التي ذكرناها إحدى عشرة إمارةً في وسط وغرب الأناضول؛ العثمانية، وعشرًا أُخَر، ويمكن فهم تركيباتها الجغرافيَّة إذا نظرنا إليها كثلاث شرائح طوليَّة؛ فتقع الشريحة الأولى في وسط الأناضول، وتتكوَّن من الشمال إلى الجنوب من خمس إمارات هي: قزل أحمدلي، وآخي، وحميد، وقرمان، وتكة في أقصى الجنوب، ثم الشريحة الثانية إلى الغرب منها، وفيها من الشمال إلى الجنوب ثلاث إمارات هي: العثمانية، وكرميان، ومنتشا، ثم أخيرًا الشريحة الثالثة، وهي في أقصى الغرب، وتضمُّ ثلاث إمارات هي من الشمال إلى الجنوب: قراسي، وصاروخان، ثم آيدن.
كانت هذه الإمارات كلها كما يتبيَّن من الشرح الجغرافي لمواقعها تقع في وسط الأناضول وغربه، أمَّا شرق الأناضول فكان في النصف الثاني من القرن الثالث عشر وبعده؛ أي عند سقوط الدولة السلجوقية، مقسمًا إلى ثلاث مناطق رئيسة:
المنطقة الأولى: وهي الأعظم والأكبر، كانت تابعةً للدولة الإيلخانية، حيث كان شرق الأناضول يخضع لإدارةٍ مباشرةٍ من إيلخانات تبريز، وقد ظلَّت هذه السيطرة المباشرة على شرق الأناضول حتى سقوط الدولة الإيلخانية سنة 1335م، أو قبل ذلك بقليل، وبعد هذا السقوط ظهرت عدة إمارات صغيرة مكانها، مثل إمارة أرتنا Eretna في مدينة سيواس، وإمارة تاج الدين أوغللري Tacettinoğulları في نكسار Niksar، وإمارة قوتلو شاهلر Kutluşahlar في أماسيا Amasya، وغير ذلك من الإمارات الصغيرة.
المنطقة الثانية في أقصى الجنوب، وفيها مملكة أرمينيا الصغرى، وقد سبق الحديث عنها.
المنطقة الثالثة في أقصى الشمال، وهي مملكة طرابزون، وكانت تابعةً للإمبراطوريَّة البيزنطيَّة، وقاعدتها في مدينة طرابزون، ومن أهمِّ مدنها مدينة سامسون.
هذه هي الأناضول في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي، آخذين في الاعتبار أنَّنا نَصِفُ ما كان يقع في شمال جبال طوروس الفاصل بين الأناضول والشام، أمَّا شمال الشام حينذاك فكان في معظمه تابعًا للدولة الإيلخانية، بينما كان غربه يشهد تطوُّرًا لدولة المماليك، التي كانت تسعى لحرب المغول في هذه المنطقة، بالإضافة إلى حربها لإمارة أنطاكية الصليبيَّة.
والواقع أنَّ الأناضول في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي كان قد وصل إلى حالةٍ من الفوضى السياسيَّة لم يشهد لها مثيلًا من قبل، وأنَّ حالة تقطيع الأوصال التي كان يُعاني منها كانت حالةً فريدةً تُنبئ أنَّ حدثًا كبيرًا سيتبع هذا الوضع المتردِّي الذي وصلت إليه المنطقة، وقد كان هذا الحدث هو ميلاد الدولة العثمانية[51].
***
[1] أمهز، محمود: في تاريخ الشرق الأدنى القديم، دار النهضة العربية، 2010م. الصفحات 57، 58.
[2] دياكوف، ف.؛ وكوفاليف، س.: الحضارات القديمة، ترجمة: نسيم واكيم اليازجي، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، الطبعة الأولى، (دون سنة طبع). الصفحات 1/190-288.
[3] سنيوبوس، شارل: تاريخ حضارات العالم، تعريب: محمد كرد علي، العالمية للكتب والنشر، الجيزة–مصر، الطبعة الأولى، 2012م. الصفحات 52-67.
[4] ديورانت، ول: قصة الحضارة، ترجمة: زكي نجيب محمود، وآخرين، تقديم: محيي الدين صابر، دار الجيل-بيروت، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-تونس، 1408هـ=1988م. صفحة 11/131.
[5] بينز، نورمان: الإمبراطورية البيزنطية، تعريب: حسين مؤنس، محمود يوسف زايد، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1950م.صفحة 8.
[6] شينيه، جان – كلود: تاريخ بيزنطية، ترجمة: جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، الطبعة الأولى، 2008م.صفحة 35.
[7] رنسيمان، استيڤن: الحضارة البيزنطية، ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد، الهيئة المصري العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية، 1997م (أ). صفحة 125.
[8] Vasiliev, Alexander A.: History of the Byzantine Empire, 324–1453, Madison, 1952., pp. 338–339.
[9] رنسيمان، 1997 (أ) صفحة 214.
[10] ديورانت، 1988 الصفحات 11/21، 97، 341.
[11] سليمان، أحمد عبد الكريم: المسلمون والبيزنطيون فى شرق البحر المتوسط، مطبعة السعادة، القاهرة، 1982م. صفحة 1/214.
[12] رنسيمان، 1997 (أ) الصفحات 39، 40.
[13] بينز، 1950 الصفحات 63، 64.
[14] Finlay, George: A History of Greece from its Conquest by the Romans to the Present Time, B. C. 146 to A. D. 1864, The Clarendon Press, Oxford, UK, 1877., vol. 2, p. 427.
[15] Treadgold, Warren T.: Byzantium and Its Army, 284-1081, Stanford University Press, 1995., p. 116.
[16] محمد، عمر يحيى: الفتح والتوسع السلجوقي في آسيا الصغرى في النصف الثاني من القرن (الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي)، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، المجلد 14، 1427هـ=2006م. صفحة 40.
[17] ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1408هـ=1988م. صفحة 12/54.
[18] الأصبهاني، عماد الدين الكاتب: تاريخ دولة آل سلجوق، قرأه وقدم له: يحيى مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1424هـ=2004م.صفحة 187.
[19] ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري: الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1997م. الصفحات 8/194-197.
[20] ابن الناصر، صدر الدين أبو الحسن علي: أخبار الدولة السلجوقية، تحقيق: محمد إقبال، لاهور، الهند، 1933م.صفحة 49.
[21] ابن الأثير، 1997 صفحة 8/224.
[22] ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر (تاريخ ابن خلدون)، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1988م. صفحة 3/582.
[23] ابن القلانسي، حمزة بن أسد بن علي بن محمد أبو يعلى التميمي: تاريخ دمشق، تحقيق: سهيل زكار، دار حسان للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة الأولى، 1403هـ =1983م، 1983م صفحة 1/167.
[24] طقوش، محمد سهيل: تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى، 2002م.صفحة 53.
[25] ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس: تاريخ ابن الوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1417هـ=1996م. صفحة 2/211.
[26] بارتولد، و.: تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ترجمة: أحمد السعيد سليمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1996م. الصفحات 127، 128.
[27] ديورانت، 1988 صفحة 15/152.
[28] بروي، إداور: تاريخ الحضارات العام «القرون الوسطى»، إشراف: موريس كروزيه، ترجمة: يوسف أسعد داغر، فريد م. داغر، منشورات عويدات، بيروت–باريس، 1986م. صفحة 3/338.
[29] رستم، أسد: الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب، دار المكشوف، بيروت، الطبعة الأولى، 1955م. صفحة 1/133.
[30] لاين، جورج: عصر المغول، ترجمة: تغريد الغضبان، مراجعة: سامر أبو هواش، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، أبو ظبي، الطبعة الأولى، 1433هـ=2012م. الصفحات 34-38.
[31] كوبريلي، فؤاد: قيام الدولة العثمانية، ترجمة: أحمد السعيد سليمان، القاهرة، 1993م. الصفحات 79، 80.
[32] النسوي، محمد بن أحمد: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي، نشر وتحقيق: حافظ أحمد حمدي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1953م.صفحة 385.
[33] ابن واصل، محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق: حسنين محمد ربيع، سعيد عبد الفتاح عاشور، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 137هـ=1957م. الصفحات 4/325، 5/134، 135.
[34] ابن العبري، يوحنا ابن أهرون أو هارون بن توما الملطي أبو الفرج: تاريخ مختصر الدول، تحقيق: أنطون صالحاني اليسوعي، دار الشرق، بيروت، الطبعة الثالثة، 1992م. الصفحات 251-257.
[35] طقوش، 2002 الصفحات 241-275.
[36] الصياد، فؤاد عبد المعطي: المغول في التاريخ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1980م. صفحة 1/216.
[37] السرجاني، راغب: قصة التتار من البداية إلى عين جالوت، شركة أقلام للنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1434هـ=2013م.صفحة 215.
[38] ابن خلدون، 1988 الصفحات 5/614، 615.
[39] ابن تغري بردي، يوسف: النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة، دار الكتب-وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، 1939م.صفحة 8/131.
[40] ابن فضل الله العمري، أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي شهاب الدين: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المجمع الثقافي، أبو ظبي-الإمارات، الطبعة الأولى، 1423هـ=2002م. الصفحات 27/515، 550.
[41] بروكلمان، كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة: نبيه أمين فارس، منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة، 1968م. صفحة 393.
[42] هالدون، جون: بيزنطة في حرب (600 – 1453)، ترجمة وتعليق: فتحي عبد العزيز محمد، دار ناشري للنشر الإلكتروني، الكويت، 2011م. صفحة 79.
[43] رنسيمان، 1997 (أ) صفحة 56.
[44] ابن العبري، 1992 الصفحات 285، 286.
[45] الصفدي، الحسن بن أبي محمد عبد الله بن عمر بن محاسن: نزهة المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1424هـ=2003م. صفحة 149.
[46] رنسيمان، 1997 (ب) الصفحات 3/751، 752.
[47] Brown, Horatio Forbes: Venice: An Historical Sketch of the Republic, Percival And company, London, UK, 1893., pp. 129-133.
[48] Miller, William: Essays on the Latin Orient, Cambridge University Press, 1921., pp. 295-300.
[49] ابن فضل الله العمري، 2002 الصفحات 3/311-315.
[50] أوزتونا، 1988 صفحة 1/76.
[51] دكتور راغب السرجاني: قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط، مكتبة الصفا للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1442ه= 2021م، 1/ 42- 57.