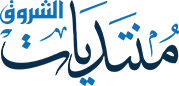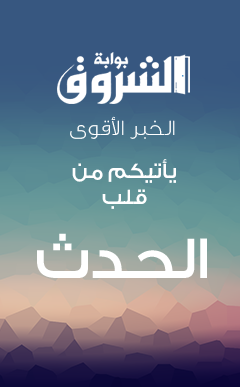بايزيد الأول (الصاعقة)
24-03-2021, 01:03 PM

بايزيد الأول (الصاعقة) (1389- 1402م)
على الرغم من استشهاد الزعيم الكبير مراد الأول في أرض كوسوڤو، وعلى الرغم من اتِّساع أراضي الدولة العثمانية فجأة في حياة الزعيم الشهيد، فإنه لم تحدث أزمةٌ كبرى بسبب هذا الاستشهاد، وبسبب فَقْد الزعامة لهذا الكيان العسكري مترامي الأطراف، والسر في ذلك أنَّ الخليفة لمراد الأول كان الزعيم العسكري الكبير بايزيد الأول. كان بايزيد الأول، وهو الابن الأكبر لمراد الأول، زعيمًا عسكريًّا من الطراز المتميز، وكان يملك ملكات حربية فريدة، وسرعة انقضاض عظيمة، جعلته يحوز لقب «الصاعقة»؛ لذلك فقد استطاع هذا الزعيم الجديد، والذي كان يبلغ من العمر تسعة وعشرين عامـًا[1]، أن يسيطر على الأوضاع بقوة، وأن يمنع المشكلات التي ظهرت في الدولة بعد وفاة أبيه من إحداث أيِّ اضطرابٍ يُؤدِّي إلى تفكُّك الكيان الكبير.
والحقُّ أن بايزيد الصاعقة يُعتبر من النقاط المحيِّرة في تاريخ الدولة العثمانية!
والسبب في هذه الحيرة أنه جمع بين المتناقضات بشكلٍ متكرِّر؛ فعلى الرغم من حبِّه للعلم وإكرامه للعلماء نجد أن له مخالفات شرعيَّة كبيرة في حياته تُبرز عدم اهتمامه بالتوصيف الإسلامي لأعماله، وكذلك نجده يجمع بين قتال الصليبيين والجهاد العظيم ضدَّهم، وبين قتال المسلمين وإحداث الفرقة في الصف الإسلامي، نتيجة هذا القتال الداخلي! إنها متناقضات تُنبئ أن غاية القتال والحكم في حياته لم تكن نقيَّةً تمامًا، وأن منطلقات حركته وهيمنته لم تكن كمنطلقات أبيه وأجداده، ممَّا يُعتبر -في رأيي- نقطة انحرافٍ في مسيرة الدولة العثمانية، وهذا سيُؤدِّي إلى نتائج خطرة في نهاية فترة حكمه، والذي امتدَّ لثلاثة عشر عامًا، من 1389م إلى 1402م.
بدأ بايزيد حكمه بمخالفةٍ شرعيَّةٍ كبرى تتمثَّل في قتله لأخيه يعقوب لمنع المنافسة على الحكم[2]، وإن كان بعضهم يُدافع عنه بأن الذي قتله كان الوزراء؛ وذلك قبل أن يتولى بايزيد دفَّة الأمور، وأنهم فعلوا ذلك لكيلا يتنافس الاثنان على الحكم فتنهار البلاد[3]، حتى لو كان هذا الافتراض الأخير صحيحًا فإن بايزيد لم يُقِم تحقيقًا في هذا الأمر، وسكت عن قتل أخيه، وهذا غير مقبولٍ شرعًا، ولعل سكوته هذا هو الذي أدَّى لنتائج مشابهة لذلك بعد وفاته؛ حيث نرى أن أبناءه سوف يتقاتلون سويًّا بعد وفاته، ويقتل بعضهم بعضًا، وهكذا فإن الجزاء من جنس العمل! إنها كانت الجريمة الأولى من نوعها في تاريخ الدولة العثمانية؛ ولكنها تكرَّرت كثيرًا بعد ذلك، وقد يتحمَّل مَنْ بدأها وزر استمرارها في حياة الدولة بعد ذلك!
عندما تولى بايزيد الأمر عام 1389م، وكان جيشه منشغلًا في المعارك في غرب الدولة العثمانية؛ أي في كوسوڤو، وصربيا، استغلَّ أمير قرمان علاء الدين الأمر، وحاول الانقلاب على الدولة العثمانية في الأناضول، وتهييج الإمارات التركية الأخرى ضدَّ العثمانيين، وكذلك فعل برهان الدين أمير سيواس في شرق الأناضول، فما كان من بايزيد الأول إلا أن انقضَّ «كالصاعقة» من غرب البلاد إلى شرقها، فقمع التمرُّد عام 1390م، وتبع هذا القمع انضمام عددٍ من الإمارات التركية إلى دولته، كإمارة صاروخان، وآيدن، وچرميان، ومنتشه[4]، واستقرَّت الأمور في الأناضول؛ ولكن لم يكن هذا عن قناعةٍ ورضا بزعامة العثمانيين إنما خوفًا من بطش القوي بايزيد الأول.
بعد هذا الاضطراب المؤقَّت تعامل بايزيد مع الأمور بحكمة، وقضى عدَّة سنوات في حُكْمِه، وتحديدًا سبع سنوات كاملة؛ أي من سنة 1390م إلى سنة 1397م، في تثبيت الأقدام ضدَّ أعداء الدولة العثمانية من الصليبيين، والذين كانوا يتمثَّلون في ثلاث مجموعاتٍ كبرى؛ أمَّا المجموعة الأولى فهي الدولة البيزنطية وأعوانها، وأمَّا المجموعة الثانية فهي مجموعة الصليبيين من أهل البلقان، كالبلغار، واليونانيين، والصربيين، وأمَّا المجموعة الثالثة والأخيرة فهي مجموعة الكاثوليك المتمثِّلة في المجر، ومن يدعمها من صليبي وسط وغرب أوروبا.
بدأ بايزيد نشاطه الجهادي ضدَّ الصليبيين بفتحه لمدينة ألاشيهير Alaşehir الأناضولية، وكانت هذه المدينة هي آخر ممتلكات الدولة البيزنطية في الأناضول، وكان ذلك عام 1390م أو 1391م[5]، وتردَّدت العلاقة بينه وبين الدولة البيزنطية، ومقرها الرئيس في القسطنطينية، بين الحرب والسلام، وانتهى الأمر لصالحه عندما قبل الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني بمعاهدة سلام عام 1391م مع الدولة العثمانية، كان من بنودها أن تدفع الدولة البيزنطية جزيةً كبيرةً إلى العثمانيين، وقبول تأسيس حىٍّ خاصٍّ بالمسلمين داخل القسطنطينية، بالإضافة إلى تمركز قوَّةٍ من الجيش العثماني تبلغ ستة آلاف مقاتل شمال القرن الذهبي إلى الغرب من جالاتا Galata شمال القسطنطينية[6]، وهذا كله يُعطي الانطباع الصحيح بأن القسطنطينية البيزنطية صارت تابعةً للدولة العثمانية وليس حليفةً لها، وكان هذا يُنذر بقرب سقوط الإمبراطورية البيزنطية التليدة.
بعد أن اطمئنَّ بايزيد الأول إلى الوضع مع الدولة البيزنطية تفرَّغ للنشاط العسكري في البلقان، فقام بعملٍ استراتيجيٍّ كبيرٍ للغاية، وهو عبور نهر الدانوب إلى الشمال؛ وذلك في عام 1391م، وكانت هذه هي المرَّة الأولى التي يعبر فيها العثمانيون نهر الدانوب، وأدخل بايزيد بذلك رومانيا الجنوبية، والمعروفة بالإفلاق Eflak (الآن والاشيا Wallachia)، إلى تبعيَّة الدولة العثمانية، وهو تغيُّر تاريخي كبير سيستمرُّ قرابة خمسة قرون (أي إلى سنة 1878م)، وكان انتصار بايزيد كبيرًا على الجيش الروماني في موقعة أرچيسو Argeso؛ بل أُسر في الموقعة الأمير الروماني ميرسيا Mircea[7]، وكان تابعًا لملك المجر، وهذا أحدث اضطرابًا كبيرًا في شرق أوروبا؛ بل في أوروبا كلها؛ حيث كان العبور العثماني لنهر الدانوب يُمثِّل نذير خطرٍ كبيرٍ على كامل أوروبا، خاصَّةً أن الدول الواقعة شمال الدانوب هي دول كاثوليكية، ممَّا يعني تطوُّر النزاع العثماني الأوروبي بشكلٍ كبير؛ حيث لم يعد مقصورًا على الأعداء الأرثوذكس التقليديين للدولة؛ بل شمل نصارى وسط وغرب أوروبا، وهؤلاء من الكاثوليك.
وفي عام 1392م فتح بايزيد مدينة سالونيك اليونانية، وهو الفتح الثاني لها؛ حيث كانت تابعةً لمراد الأول عام 1387م، فيبدو أنها رجعت لليونانيين بعد وفاة مراد الأول، فاستردَّها بايزيد الأول في هذا العام؛ بل فتح شمال اليونان كله، وتوغَّل حتى ضمَّ سكوبيه في مقدونيا في العام نفسه[8].
وفي عام 1393م أنهى بايزيد الأول الملكيَّة البلغاريَّة بدخوله مدينة تارنوڤو Tarnovo، ثم نزعه للقيصر البلغاري إيڤان شيشمان Tsar Ivan Shishman من العرش بعد ذلك بعامين[9].
توترت العلاقة من جديد بين الدولة العثمانية والدولة البيزنطية ممَّا دفع بايزيد إلى بناء قلعة أناضولي حصار Anadoluhisarı على الجانب الآسيوي من المضايق في مواجهة القسطنطينية؛ وذلك عام 1394م[10]، ثم حصار القسطنطينية بدايةً من عام 1395م[11]، وهو الحصار الذي سيستمر إلى آخر عهد بايزيد الأول، وفي عام 1395م-أيضًا- بسط العثمانيون سيطرتهم على مناطق واسعة جنوب الدانوب؛ بل وسيطروا على نقاط التحرُّك من الجنوب إلى الشمال عبر النهر، وصار الوجود العثماني في هذه المناطق كثيفًا ممَّا حرَّك مخاوف ملك المجر سيجيسموند Sigismund، والذي بدأ في التحرُّك في اتِّجاهات دبلوماسيَّة كثيرة تهدف إلى تجميع القوى لمواجهة بايزيد الأول صاحب الطموحات الكبيرة في تكوين إمبراطورية ضخمة في شرق أوروبا.
أثمرت جهود سيجيسموند ملك المجر عن نتائج عظمى؛ إذ استجاب البابا الكاثوليكي بونيفاس التاسع Boniface IX لاستغاثة المجر، وبدأ في تجميع الجيوش الصليبية من غرب أوروبا، فكانت أكبر الدول استجابةً هي فرنسا؛ حيث أرسلت عشرة آلاف مقاتل[12]، ولم تكن أهميَّة الجيش الفرنسي في عدده فقط؛ بل في القادة والأمراء الكبار الذين صاحبوه، واستجابت كذلك عدَّة ممالك أوروبية كبرى لهذه الحملة، فجاء الجنود من إنجلترا، وإسكتلندا، وألمانيا، وبولندا، والنرويج، ومملكتي قشتالة Castile وأراجون Aragon الإسبانيتين، وفرسان تيتون Teutonic Order، ورودس Rhodes، وكذلك من عدَّة جمهوريَّات إيطاليَّة، أهمها چنوة، ودولة البابا، بالإضافة إلى الأسطول البندقي[13].
كان مجموع الجيوش الأوروبية الغربية المشاركة في الحملة يصل إلى سبعين ألف مقاتل، بالإضافة إلى ستين ألف جندي مجري، ممَّا يجعل الحملة تصل إلى مائةٍ وثلاثين ألف مقاتل، وهو رقمٌ كبيرٌ للغاية، خاصَّةً إذا نظرنا إلى الطبيعة المهاريَّة العالية لمعظم الفرق المشاركة في الحملة. اكتملت العدَّة الصليبية في صيف 1396م، ودار التنسيق بينها وبين إمبراطور الدولة البيزنطية لضرب الجيش العثماني في أكثر من موضع، ووصلت الأخبار إلى بايزيد الأول، فجهَّز جيشًا من سبعين ألف جندي، واتَّجه من فوره إلى تارنوڤو ببلغاريا؛ حيث أتمَّ استعداده هناك[14]؛ بينما زحفت القوَّات الصليبية جنوبًا حتى تجمَّعت في بودا عاصمة المجر، ثم انطلقت من هناك إلى مدينة نيكوبوليس Nicopolis شمال بلغاريا بعد أن عبروا الدانوب جنوبًا لينقلوا المعركة إلى أرض العثمانيين. تحاول بعض المصادر الغربية تقليل أعداد المقاتلين؛ وذلك للتقليل من أهميَّة المعركة، حتى تُقدِّر جيش الصليبيين بسبعة عشر ألفًا، وجيش المسلمين بخمسة عشر ألفًا[15]، وهذا في الواقع مستحيلٌ نظرًا إلى النتائج الحاسمة التي أفضت إليها المعركة، والتي تؤكد أن الأعداد كانت فيها كبيرةً جدًّا، كما أن هذه المصادر نفسها ذكرت التكوين الأممي للجيش الصليبي، واشتراك عددٍ كبيرٍ من الدول الأوروبية في إعداده، ممَّا يستحيل أن يكون في النهاية مجرَّد سبعة عشر ألف مقاتل!
في 25 سبتمبر 1396م دارت رحى معركة نيكوبوليس[16]، وهي من أهمِّ المعارك في تاريخ أوروبا؛ حيث كان الصدام مروعًا بين الجيش العثماني وأوَّل حملة كاثوليكية صرفة في قصَّة الدولة العثمانية.
لم يكن التنسيق جيِّدًا بين فرق الجيش الصليبي، وكانت الاضطرابات واضحةً بين القيادات المختلفة، ولم يكن الجميع -خاصَّةً الجيش الفرنسي- منصاعًا لقيادة سيجيسموند ملك المجر، كما كانت اللغات الكثيرة للفرق المشاركة في الحملة سببًا في عدم القدرة على التواصل الجيِّد في المواقف الحرجة؛ بينما كان الجيش العثماني متماسكًا ومترابطًا، وكانت إدارته على أعلى درجة من درجات المهارة والكفاية، وسرعان ما بدأت الكفَّة تميل لصالح الجيش العثماني، واستدرج الصليبيين، وخاصَّةً الفرنسيين، في كمائن متعدِّدة[17]، وما هي إلا ساعات حتى لحقت الهزيمة النكراء بالجيش الصليبي.
لقد كان يومًا من الأيَّام التاريخيَّة في قصة أوروبا بشكلٍ عام!
سقط من الجيش الصليبي مائة ألف قتيل! وأُسِر عشرة آلاف، ولم يتمكن من الهرب إلا عشرون ألفًا، كان منهم سيجيسموند ملك المجر، وهنري الرابع Henry IV الذي سيُصبح ملك إنجلترا لاحقًا، والأميرال البندقي موسينجو Mocenigo، الذي سيُصبح رئيسًا لجمهورية البندقية لاحقًا[18]! وصف المؤرخ الإنجليزي بيتر بورتون Peter Purton المعركة بأنها هزيمةٌ كارثيَّةٌ للأوروبيين[19]!
كانت نتائج المعركة وآثارها غير عاديَّة؛ فقد ثبت للجميع أن استئصال الأتراك من أوروبا صار مستحيلًا بعد هذه المعركة، وفقد البيزنطيون الأمل في استرجاع البلقان، وأدرك المجريون أن حربهم مع العثمانيين عسيرةٌ للغاية، فلن يجرءوا على اقتحام الحدود العثمانية في العقود القادمة، وقطعت فرنسا كلَّ أملٍ في أيِّ حربٍ صليبيَّةٍ جديدةٍ على الشرق، وترسَّخت الهيبة للدولة العثمانية في شرق أوروبا؛ بل في أوروبا بكاملها. لم تكن الآثار كبيرة على أوروبا فقط؛ بل وصلت أخبار الانتصار العظيم إلى بقاع العالم الأخرى، وكان من جرَّاء ذلك أن أنعم الخليفة العباسي، والذي كان يعيش في القاهرة في كنف دولة المماليك، على الزعيم العثماني بايزيد الأول بلقب «سلطان»[20]، وهو لقبٌ كبيرٌ لا يُعطى إلا للقائد الذي لا يتبع أحدًا، وبذلك أعطى شرعيَّةً كبرى لبايزيد الأول جعلته -والعثمانيِّين من بعده- يُطالبون بقيادة كلِّ القبائل التركيَّة الموجودة في الأناضول، والعراق، وإيران، بشكلٍ رسميٍّ ومنطقي.
وطَّد هذا الانتصار أركان الحكم العثماني بشكلٍ كبيرٍ في البلقان والأناضول، وظهرت أمارات القوَّة والهيمنة في أرجاء البلاد، وعمَّ الأمن والأمان في كلِّ المدن والقرى حتى كانت تترك البضائع في الشوارع دون حمايةٍ فلا يتعرَّض لها أحد[21]!
ومع أن بايزيد الأول كان مقرِّبًا للعلماء، ومحبًّا لأهل القرآن، إلا أن الرخاء الكبير الذي صار في البلاد بعد هذه الفتوحات الكبرى والتوسُّعات العظمى، أدَّى إلى فتنة الناس في هذه الدنيا، فانتشرت كثيرٌ من الفواحش، حتى ذكرت بعض المصادر أن الناس كانوا لا يستخفون بالزنا أو شرب الخمر! بل طالت السلطانَ نفسه هذه الآثام، واتجه إلى الترف كذلك؛ حيث كان يأكل ويشرب في آنية الفضة[22] مع النهي الواضح عن ذلك في السنة المطهرة.
لم يقف الأمر إلى هذا الحد؛ بل دفع هذا النصر بايزيد الأول إلى الغرور، وعدم تقدير الأمور بقدرها فصعَّد من خلافاته مع الأمراء الأتراك في الأناضول، ودارت بينه وبينهم عدَّة معارك في عامي 1397 و1398م، وألحق إمارة قرمان بشكلٍ كاملٍ في داخل الدولة العثمانية[23]، ممَّا أوغر صدورهم بشكلٍ كبيرٍ تجاهه، وكذلك حدث مع بقيَّة الأمراء الأتراك، والذين صاروا يتربَّصون الفرصة للخروج من قبضة بايزيد الأول.
زاد الطين بِلَّة أن تعدَّى بايزيد الأول على مدينة ملطية التابعة لدولة المماليك في جنوب الأناضول، ممَّا أدَّى إلى توتُّر العلاقة جدًّا بين العثمانيين والمماليك، وقضى على إمكانيَّة التعاون المشترك بين الدولتين، ولم يكتفِ بايزيد بذلك، إنما احتلَّ كذلك عدَّة مدنٍ مملوكيَّةٍ أخرى مثل حصن منصور، والبستان؛ وذلك في عام 1399م[24]؛ ومع أن الوحدة الأناضوليَّة تحت الزعامة العثمانيَّة قد تحقَّقت إلا أنَّ ذلك كان على حساب علاقات متوتِّرة ومضطربة بين الإمارات المختلفة، ممَّا يُنذر بتفكُّكٍ كبيرٍ في الدولة إذا واجهت خطرًا كبيرًا في هذه الظروف، والواقع أن الخطر الكبير سرعان ما جاء، وكان هذا الخطر في صورة زحف عسكري خطر على الأناضول من القائد العسكري الشهير تيمور لنك Tamerlane؛ وذلك في عام 1400م!
كان تيمور لنك فاتحًا عسكريًّا شجاعًا قديرًا من أصول تركيَّة أوزبكستانيَّة، وقد استطاع أن يُكوِّن مملكةً واسعة الأرجاء في غضون سنواتٍ قليلة؛ حيث شملت دولته بلادًا آسيويَّة كثيرة كأوزبكستان، وأفغانستان، وإيران، وأذربيچان، وأرمينيا، وچورچيا، والهند، وامتدَّ ملكه إلى العراق والشام، وصارت دولته بذلك مجاورةً لدولة المماليك في مصر والشام، ودولة الجلائريين في العراق، وكذلك الدولة العثمانية في الأناضول. كان تيمور لنك من أعنف القادة العسكريِّين، وتصل بعض التقديرات بعدد القتلى في معاركه إلى 17 مليون قتيل[25]! وهو عدد مهول بالقياس إلى عدد سكان الأرض آنذاك، واختلف المؤرخون في طبيعة انتمائه الديني والمذهبي، فبعضهم يذكر أنه مسلمٌ سني[26]، وبعضهم يُؤكِّد أنه من غلاة الشيعة[27]؛ بينما يذهب فريقٌ ثالثٌ إلى كونه غير مسلمٍ أصلًا[28]، نظرًا إلى حربه الشديدة ضدَّ المسلمين، وأرى أنه مسلمٌ منحرفٌ كانت شروره في العالم أكثر بكثيرٍ من خيراته.
لم يكن من المتوقَّع أن يقبل قائدان كبيران كتيمور لنك وبايزيد الأول بالتجاور السلمي دون قتال، خاصَّةً مع الغرور الكبير الذي صاحب القائدين نتيجة الانتصارات المتتالية التي حقَّقها كلاهما في الأعوام السابقة، ومِنْ ثَمَّ فبمجرَّد تقارب الحدود بين الدولتين نشبت الخلافات وتصاعدت حتى وصلت إلى الصدام العسكري.
كان الصدام الأول بين الفريقين في عام 1400م، وكان صدامًا سريعًا استطاع فيه تيمور لنك أن يأخذ ملطية وسيواس من يد بايزيد الأول، ثم انسحب بعد ذلك إلى قفقاسيا (القوقاز) Caucasus غرب آسيا[29] ثم تكرَّر الصدام من جديد في عام 1402م؛ ولكنَّه في هذه المرَّة كان صدامًا مروِّعًا؛ بل يُعدُّ أحد أكبر الصدامات العسكريَّة التي تمَّت في القرون الوسطى، وهو الذي حدث على أرض أنقرة في وسط الأناضول في صيف هذا العام.
تبادل القائدان الكبيران عدَّة رسائل قبل الصدام العسكري، وكانت نبرة الاستعلاء والغرور واضحةً في لغة كلٍّ منهما، وكان التوافق الدبلوماسي صعبًا في ظلِّ هذه الأجواء، وسرعان ما أخذ تيمور لنك القرار بغزو الدولة العثمانية، وتوغَّلت قوَّاته بشكلٍ حاسمٍ وسريعٍ في الأناضول، حتى وصلت بسهولة، ودون مقاومةٍ تُذكر، إلى أنقرة. اختلف المؤرخون حول تعداد الجيشين، والأقرب أن الجيش المصاحب لتيمور لنك كان يصل إلى مائةٍ وأربعين ألف مقاتل، على درجةٍ عاليةٍ من التنظيم والقوَّة؛ بينما لم يستطع بايزيد الأول أن يُجمِّع أكثر من خمسة وثمانين ألف مقاتل[30].
لم تكن الأزمة في فَرْقِ الأعداد والتسليح فقط؛ بل تمثَّلت الأزمة بشكلٍ أكبر في أمرين؛ أمَّا الأول فهو اضطراب المخابرات العثمانية، وعدم درايتها بتحرُّكات الجيش المعادي، ممَّا أدَّى إلى مفاجأة الجيش العثماني، فاضطرَّ إلى القتال بعد أن سار ثمانية أيَّامٍ كاملة في الصحراء القاحلة المؤدِّية إلى أنقرة[31]، وعندما وصل إلى هناك وجد أن جيش تيمور لنك قد سيطر على آبار المياه[32]، فاضطرَّ الجيش العثماني إلى القتال وهم في حالةٍ من الضعف الشديد[33] نتيجة العطش وطول المسافة التي قطعوها إلى أرض المعركة. وأمَّا السبب الثاني للأزمة، وهو السبب الأهم والأعظم، فهو أن ولاء الجيش العثماني لم يكن خالصًا لبايزيد الأول؛ فقد انحازت كلُّ الفرق التركية غير العثمانية لتيمور لنك بمجرَّد أن بدأ القتال[34]؛ وذلك لسوء العلاقة بينهم وبين بايزيد الأول؛ حيث كان قد نزعهم من إماراتهم قبل ذلك بالقوَّة، وكان من نتيجة ذلك أن تواصلوا سرًّا مع تيمور لنك، الذي وعدهم بإعادتهم إلى قيادة إماراتهم في حال هزيمة بايزيد الأول، وهكذا بمجرَّد بداية القتال تحرَّكت هذه الفصائل التركية إلى صفِّ تيمور لنك، ممَّا أدَّى إلى اضطرابٍ كبيرٍ في الجيش العثماني.
دارت المعركة العنيفة في الثامن والعشرين من شهر يوليو 1402م[35]، وفيها تحقَّقت أكبر هزيمة في التاريخ العثماني كلِّه، وحدثت إحدى أكبر الكوارث على الدولة العثمانية؛ حيث كانت النتائج أكبر بكثيرٍ من كلِّ توقُّع!
لم تكن الكارثة فقط بسبب انضمام القبائل التركيَّة إلى تيمور لنك؛ بل إن الكارثة تضاعفت لاختلال القيادة العسكريَّة العثمانيَّة؛ حيث كانت هناك خلافات في الرؤية الاستراتيجيَّة والتخطيط بين مختلف القادة العسكريِّين، ولم يبدُ واضحًا أن قيادة بايزيد الأول قادرةٌ على تجميع كلِّ الآراء في اتِّجاهٍ واحد؛ لذلك حدث تخبُّط كبير، وأصابت الضربات التيموريَّة جيش العثمانيِّين في أكثر من موضع، ممَّا دفع سليمان -وهو الابن الأكبر لبايزيد الأول- إلى الانسحاب بفرقته دون الرجوع إلى أبيه في هذا الأمر[36]، فزاد الأمر صعوبة، ومرَّ اليوم طويلًا على العثمانيِّين، وفي نهايته كانت الهزيمة المرَّة التي لم يتوقَّعها أحد! قُتل من الجيش العثماني حوالي أربعون ألف جندي، وهو رقمٌ مماثلٌ لقتلى الجيش التيموري[37]؛ ومع ذلك فالكارثة كانت أفجع للعثمانيين؛ لأن عدد الجيش أقل جدًّا من جيش تيمور لنك، بالإضافة إلى أن الكثير من جنود الجيش العثماني فرُّوا إلى جانب تيمور لنك؛ كما ذكرنا، ممَّا أفقد الجيش العثماني كيانه تقريبًا، أمَّا الكارثة الأكبر فكانت أَسْرَ السلطان بايزيد الأول في نهاية اليوم[38]، وهي المرَّة الوحيدة في التاريخ العثماني كلِّه التي يُؤسر فيها السلطان، وكان هذا الأَسْرُ يعني أن إمكانيَّة النهوض من الكارثة صارت مستحيلة، فضاعت فرصة أيِّ مقاومةٍ للجيش التيموري القادر.
انطلق الجيش التيموري يتتبَّع الفارِّين من الجيش العثماني، وكان سليمان بن بايزيد الأول قد وصل إلى مدينة بورصا في فراره، واستطاع أن يأخذ خزانة الدولة وحريم العائلة العثمانية وينطلق بكلِّ شيءٍ عابرًا البوسفور إلى أوروبا[39][40]، ولم تُدركه جيوش تيمور لنك، فعادت الجيوش إلى بورصا وأحرقتها[41] كما عاثت في الأناضول فسادًا في أكثر من موضع.
انهارت الدولة العثمانية بعد هذه الكارثة؛ إذ إن بايزيد الأول ترك خلفه عدَّة أبناء متصارعين يبغي كلٌّ منهم أن يتولى الحكم، ومِنْ ثَمَّ تعقَّدت الأمور بشكلٍ أكبر، ولم يعد هناك كيانٌ واضحٌ يجمع الشتات الذي نجم عن كارثة أنقرة، ومِنْ ثَمَّ دخلت الدولة العثمانية في فترةٍ حرجةٍ جدًّا في تاريخها ليس لها فيها قائدٌ محدَّد، ولهذا تُعرف هذه المرحلة «بدور الفترة»؛ أي الفترة التي عاشتها الدولة بلا قيادة، واستمرَّت هذه الفترة إحدى عشرة سنةً كاملة؛ أي من سنة 1402م إلى سنة 1413م، وجديرٌ بالذكر أن بايزيد الأول -السلطان المأسور- مات في أسره بعد سبعة شهور فقط من المعركة الأليمة، وتحديدًا في 3 مارس عام 1403م[42]؛ ومع أن المصادر تتضارب في طريقة معاملة تيمور لنك لأسيره العظيم السلطان العثماني؛ حيث تذكر بعض المصادر أنه كان يُهينه بشكلٍ دائمٍ ومتكرِّر[43]؛ بينما تُسهب مصادر أخرى في إظهار احترام تيمور لنك للأسير العثماني الكبير[44]، إلا أنه في كلِّ الأحوال نحن على يقينٍ من أن حالة الحزن والاكتئاب التي عاشها السلطان الكبير كانت أكبر من تحمُّل البشر؛ لذلك لم تطل عليه الأيام في الأسر؛ بل مات ليترك وراءه تركةً مثقلةً بالأحزان والهموم.
ما سرُّ هذا الانهيار الكبير للدولة؟ وكيف لمعركة يومٍ واحدٍ أن تُقوِّض أركان كيانٍ كبيرٍ ككيان الدولة العثمانية؟ ولقد وصلت الدولة العثمانية في آخر عهد بايزيد الأول، وقبيل موقعة أنقرة مباشرة، إلى مساحةٍ تقترب من مليون كيلو متر مربع[45]، فكيف حدث التفكُّك لهذا الكيان الضخم؟ ولماذا حقَّق الجيش العثماني النصر العظيم في موقعة نيكوبوليس على جيوش أوروبا مجتمعةً قبل هذه الموقعة بستِّ سنواتٍ فقط، ثم انهار بهذه الطريقة الدراماتيكيَّة أمام جيوش تيمور لنك؟
إن افتراض أن السبب هو فارق الأعداد بين الفريقين في موقعة أنقرة ليس افتراضًا مقنعًا لتبرير الهزيمة؛ لأن الجيش العثماني الذي انتصر في نيكوبوليس كان أقلَّ كذلك من الجيوش الصليبية آنذاك؛ فالجيوش الصليبيَّة كانت تقريبًا ضعف الجيش العثماني، وهكذا كانت النسبة -أيضًا- في معركة أنقرة، وأكثر قليلًا، ويؤخذ في الاعتبار -أيضًا- أن جيوش أوروبا في موقعة نيكوبوليس كانت قريبةً من امداداتها بالمجر؛ بينما كانت جيوش تيمور لنك بعيدةً تمامًا عن مواقع إمدادها، وهذا يعني أن جيوش تيمور لنك كانت تُعاني هي الأخرى من توغُّلها في أراضي الأناضول؛ ومع ذلك حقَّقت هذا الانتصار الكبير.
ما السر إذن في هذه النهاية الكارثية للمعركة؟
السرُّ عندي يكمن في خمسة أمور:
أمَّا الأول فهذه الفرقة الشديدة في الصف العثماني، وإن كان يبدو في الظاهر واحدًا متماسكًا، ولكنَّه في الواقع تماسكٌ هشٌّ لا يصمد أمام العواصف، والسبب هو سعي بايزيد الأول إلى توسيع رقعة بلاده عن طريق حربه مع المسلمين هنا وهناك، فتوحيد الأناضول تحت رايته كانت غاية تساقطت أمامها غايات الوحدة والألفة والمحبَّة التي يفترض أن تكون بين المسلمين، فقام التنازع بينه وأمراء الأتراك في الأناضول، فحدث الإكراه على الوحدة، والوحدة لا تأتي بالإكراه، إنما ينبغي أن تكون عن قناعةٍ وقبول؛ لأنَّه سيتبعها تضحيَّاتٌ وتنازلات، ولن يقوم بذلك إلا المقتنع حقيقةً بما يفعل، وقد امتدَّ تنازع بايزيد الأول مع المسلمين إلى خارج الأناضول، فكانت علاقاته مضطربة مع العراق؛ بل تنازع عسكريًّا مع دولة المماليك، والتي كانت تعاني هي الأخرى من ضربات تيمور لنك، وكان من الممكن أن تضع يدها في يد العثمانيين لمقاومة العدوِّ المشترك تيمور لنك؛ لكن العداوة التي بدأها بايزيد الأول قضت على فرصة التعاون بين المسلمين، فكان الفشل الذي حذَّر منه ربُّ العالمين بقوله:﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46]، فحدث الفشل، وذهبت الريح، وانتصر تيمور لنك بعد أن انفرد بكلِّ قُطرٍ على حدة.
والسبب الثاني في سقوط الدولة العثمانية في أنقرة هو الغرور الذي أصاب بايزيد الأول بعد انتصاراته المتكرِّرة، وخاصَّةً في نيكوبوليس؛ فهذا الغرور أعماه عن رؤية الحقائق، فلم يُقدِّر قوة جيش تيمور لنك بشكلٍ دقيق، وكان الصواب أن يتجنَّب أصلًا قتال هذا الجيش الضخم في ميدان مفتوح؛ بل كان عليه خوض حرب العصابات ضدَّه، وخاصَّةً أن تيمور لنك بعيد عن قاعدته الرئيسة في سمرقند في وسط آسيا، فلن يتمكن من الصبر طويلًا في أرض الأناضول لو تعرَّض لضربات متفرِّقة؛ لكن الغرور دفع بايزيد الأول إلى صدامٍ شامل، وهو ما كان يبحث عنه تيمور لنك، كما أن الغرور جعل بايزيد لا يقدِّر إمكانات أمراء الأناضول الأتراك، ووجدهم أتباعًا لا وزن لهم، فلما تركوه وانحازوا إلى صفِّ تيمور لنك حدثت الكارثة العسكرية التي شهدناها، وكان من الأولى لبايزيد أن يُعطيهم قدرهم أثناء ولايته، ويُقدِّر تاريخهم وقيمة أسرهم الحاكمة، فإنَّ هذا كان أنفع في استقرار الدولة. والغرور مهلكٌ لا محالة، وفي الحديث ذكر رسولُ الله ﷺ ثلاثًا من المهلكات فقال: «فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ»[46]. فهذا الإعجاب بالنفس يعمي البصر والبصيرة، فتكون الهلكة؛ كما رأينا.
والسبب الثالث هو شيوع الفواحش في الدولة؛ فليس من المقبول لدولة إسلاميَّة مثل الدولة العثمانية أن يَقبل سلطانها وأمراؤها بشيوع الزنا وشرب الخمر، والشرب في أواني الذهب والفضة، فالذنوب مهلكة، وما أكثر ما ورد التحذير من الإهلاك بالذنوب في القرآن الكريم؛ وذلك مثل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ [الأنعام: 6]، وهكذا فبعد أن عمَّ الرخاء البلاد، وكثرت الخيرات، حدثت الهلكة، والسبب -كما قال تعالى- «فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ»، خاصَّةً إذا كانت هناك مجاهرةٌ بهذه الذنوب، والرسول ﷺ يقول: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ»[47].
أمَّا السبب الرابع فهو الفتنة في الدنيا؛ فالمساحات الشاسعة التي وصلت إليها الدولة، والأملاك العظيمة التي حازتها، وكنوز الذهب والفضة التي امتلكتها جعل الجميع يتنافس من أجل امتلاك شيء من هذه الدنيا، ودليل توغُّل الدنيا في قلوب الناس في هذه الفترة ما حدث من صراع عسكري حقيقي بين الأخوة أبناء بايزيد الأول بعد أسره ثم موته، ولقد ضيَّع هذا الصراع على المسلمين خيرات كثيرة، وكان سببًا مباشرًا في الهلكة، وصدق رَسُولُ اللهِ ﷺ حين قال: «فَوَاللَّهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ»[48].
ويأتي السبب الخامس والأخير في رأيي، في وحدة القيادة في جيش تيمور لنك؛ فكلُّ جنوده وفرق جيشه كانت تسمع له وتطيع، وتتحرَّك بأمره حسبما رأى، وهذا الانتظام كان كفيلًا بتحقيق النجاح خاصَّةً إذا كان الصف المقابل لهم متفرِّقًا ومشتَّتًا، وهذا هو وجه الاختلاف الرئيس بين جيش تيمور لنك وجيوش الصليبيين في موقعة نيكوبوليس؛ حيث كانت جيوشهم بلا قيادةٍ موحَّدة؛ بل كانوا متفرِّقين كذلك ممَّا أتاح لبايزيد الأول أن ينتصر عليهم انتصاره التاريخي المعروف، وقد آثرتُ أن أجعل هذا هو السبب الخامس والأخير لأنه لو كان العثمانيون قد أخذوا بالأسباب كاملة، وتجنَّبوا الوقوع في الأخطاء الأربعة التي ذكرناها قبل هذا السبب الخامس ما كان لجيش تيمور لنك -مهما كان منظَّمًا وموحَّدًا- أن يُحقِّق الغلبة عليهم؛ ولكن هكذا تسير الأمور.
إنَّنا بعد هذا التحليل لقصَّة بايزيد الأول أدركنا أنَّه أحد الأشخاص المحيِّرين في تاريخ الدولة العثمانيَّة؛ فالجانب المضيء عنده بارزٌ وواضح؛ فالسخاوي يقول عنه: «وكان ملكًا عادلًا، عاقلًا، شفوقًا على الرعية، كثير الغزو، واتَّسعت مملكته، وأمن الناس في بلاده، وخفَّف عنهم المكس»[49]، ويقول عنه ابن حجر العسقلاني: «كان بايزيد بن عثمان من خيار ملوك الأرض»[50]. ومع ذلك فقد رأينا الانكسار الشنيع يحدث لدولته في نهاية الأمر، والسرُّ في هذا التفاوت هو انقسام حياة بايزيد الأول إلى قسمين متباينين؛ كان القسم الأول شاملًا أول ثماني سنوات في حكمه، من عام 1389م وإلى عام 1397م، وكان فيها مؤثِرًا للجهاد، معظِّمًا للشريعة، منتهجًا نهج آبائه وأسلافه في العمل لله ، ثم كان القسم الثاني من حياته ويشمل السنوات الخمسة الأخيرة، من سنة 1397م إلى سنة 1402م، وفيها حدث التبديل والتغيير فكانت الكوارث والنكبات! إنه ممَّن ينطبق عليهم قول ربنا : ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ [التوبة: 102]، فنسأل الله أن يعفو عنه، وأن يُعوِّضه بجهاده ونشره للإسلام عن سقطاته في آخر حياته[51].
[1] القرماني، أحمد بن يوسف بن أحمد: تاريخ سلاطين آل عثمان، تحقيق: بسَّام عبد الوهَّاب الجابي، دار البصائر، دمشق، الطبعة الأولى، 1405هـ=1985م. صفحة 16.
[2] آرنولد، توماس ووكر؛ وباسيه، رينيه: دائرة المعارف الإسلامية، مركز الشارقة للإبداع الفكري، الشارقة-الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 1418هـ=1998م. صفحة 3/328.
[3] 229. فريد، محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى، 1401هـ=1981م. صفحة 137.
[4] أوزتونا، يلماز: تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة: عدنان محمود سلمان، مراجعة وتنقيح: محمود الأنصاري، مؤسسة فيصل للتمويل، إستانبول، 1988 صفحة 1/103.
[5] رستم، أسد: الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب، دار المكشوف، بيروت، الطبعة الأولى، 1955م. الصفحات 2/255، 256.
[6] Shaw, Stanford Jay: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280–1808, Volume I, Cambridge University Press, New York, USA, 1976., vol. 1, p. 31.
[7] أوزتونا، 1988 صفحة 1/104.
[8] أوزتونا، 1988 صفحة 1/105.
[9] Imber, Colin: The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power, Red Globe press, London, UK, Third edition, 2019., p. 11.
[10] Finkel, Caroline: Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire 1300-1923, John Murray, London, UK, Basic Books, New York, 2006., p. 24.
[11] Mango, Cyril: The Oxford History of Byzantium, Oxford University Press, New York, First published Edition, 2002., pp. 273-274.
[12] Tucker, Spencer C.: A Global Chronology of Conflict: From the Ancient World to the Modern Middle East, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, USA, 2010., vol. 1, p. 316.
[13] Tuchman, Barbara W.: A Distant Mirror: the Calamitous 14th Century, Alfred A. Knopf, New York, USA, 1978., p. 548.
[14] أوزتونا، 1988 صفحة 1/107.
[15] Nicolle, David: Constantinople 1453 The End of Byzantium, osprey publishing, Oxford, UK, 2000, p. 37.
[16] Jaques, Tony: Dictionary of Battles and Sieges, Greenwood Press, Westport, CT, USA, 2007, vol. 2, p. 729.
[17] ديورانت، ول: قصة الحضارة، ترجمة: زكي نجيب محمود، وآخرين، تقديم: محيي الدين صابر، دار الجيل-بيروت، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-تونس، 1408هـ=1988م.صفحة 23/33.
[18] أوزتونا، 1988 الصفحات 1/106، 108.
[19] Purton, Peter Fraser: A History of the Late Medieval Siege, 1200-1500, The Boydell press, Woodbridge, UK, 2010., p. 188.
[20] İnal, Halil İbrahim: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Nokta Kitap, İstanbul, 2007., p. 90.
[21] Boyar, Ebru & Fleet, Kate: A Social History of Ottoman Istanbul, Cambridge University Press, NewYork, USA, 2010., p. 170.
[22] ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد: إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق: حسن حبشي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية-لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر، 1969م. الصفحات 2/226، 227.
[23]سعد الدين، محمد حسن جان بن محمد التبريزي خواجه: تاج التواريخ في تاريخ آل عثمان، إستانبول، 1862-1863م. الصفحات 131، 132.
[24] أوزتونا، 1988 صفحة 1/106.
[25] Saunders, John Joseph: The history of the Mongol conquests, Routledge & Kegan Paul Ltd, 1971, p. 174.
[26] Manz, Beatrice Forbes: The Rise and Rule of Tamerlane, Cambridge University Press, New York, USA, 1999., p. 17.
[27] الغزي، كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البالي الحلبي: نهر الذهب في تاريخ حلب، دار القلم، حلب، الطبعة الثانية، 1419هـ=1998م. صفحة 3/164.
[28] ابن حجر العسقلاني، 1969 صفحة 2/303.
[29] Imber, 2019, p. 12.
[30] Nicolle, 1983, p. 29.
[31] المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر: السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1997م. صفحة 6/81.
[32] ابن عربشاه، أبو محمد أحمد بن محمد: عجائب المقدور في أخبار تيمور، كلكتا، الهند، 1817م. الصفحات 268، 269.
[33] ابن حجر العسقلاني، 1969 صفحة 2/225.
[34] ابن عربشاه، 1817 صفحة 270.
[35] Kia, Mehrdad: Daily Life in the Ottoman Empire, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, USA, 2011., vol. 1, p. 5.
[36] Imber, 2019, p. 12.
[37] Tucker, 2011, p. 141.
[38] Kia, 2017, vol. 1, p. 5.
[39] خليفة، حاجي: فذلكة أقوال الأخيار في علم التاريخ والأخبار (تاريخ ملوك آل عثمان)، حققه وقدمه له وترجم حواشيه: سيد محمد السيد، كلية الآداب–جامعة جنوب الوادي، سوهاج-مصر، (دون سنة طبع).صفحة 167.
[40] القرماني، 1992 صفحة 3/20.
[41] Petersen, Andrew: Dictionary of Islamic Architecture, Routledge, 2002., p. 41.
[42] Ágoston, Gábor: Bayezid I (Yıldırım, or Thunderbolt) (b. 1354–d.1403) (r. 1389–1402), In: Ágoston, Gábor & Masters, Bruce Alan: Encyclopedia of the Ottoman Empire, Infobase Publishing, New York, USA, 2009 (C)., p. 82.
[43] ابن عربشاه، 1817 صفحة 279.
[44] مروذي، جاستن: تيمورلنك - قاهر الملوك والسلاطين وغازي العالم، مراجعة: هاني تابري، ترجمة: مايا إرسلان، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 2011م. الصفحات 338-341.
[45] أوزتونا، 1988 صفحة 1/111.
[46] الطبراني في الأوسط (5754) عن ابن عمر ب، وحسنه الألباني، انظر: صحيح الجامع (3045).
[47] البخاري: كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه (5721) واللفظ له، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (2990).
[48] البخاري: كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (6061) واللفظ له، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق (2961).
[49] السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار الجيل، بيروت، 1412هـ=1992م.صفحة 11/148.
[50] ابن حجر العسقلاني، 1969 صفحة 2/226.
[51] دكتور راغب السرجاني: قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط، مكتبة الصفا للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1442ه= 2021م، 1/ 147- 163.