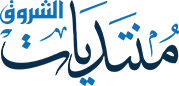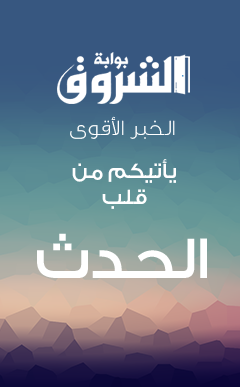محمد اركون . والده شارك في بناء مسجد سنة 1917باحدى قرى الغرب الجزائري.
03-02-2007, 09:05 PM
السلام . محمد أركون يبحث في اخفاق الحداثة الفكرية
الفلسفة تبق العقل في حيوته فلنعد لها.
حث الكاتب الجزائري البارز محمد أركون على ضرورة الاهتمام بالفلسفة مشيرا الى أنه منذ وفاة الفيلسوف العربي ابن رشد عام 1198 ميلادية لم تعتن التيارات الفكرية الاسلامية بالفلسفة في حين كان لافكار ابن رشد تأثير واضح على الفكر الغربي. وأضاف مساء الاربعاء في محاضرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن للفلسفة دورا مهما في الابقاء على العقل في حالة حيوية تدفعه الى الابداع قائلا ان الموقف الفلسفي هو موقف التساؤل عن صحة ما يقدمه العقل وان ما مر بالجزائر على سبيل المثال منذ حرب التحرير في منتصف الخمسينيات الى الان له علاقة بالفكر والفلسفة.
وأشار في المحاضرة التي حملت عنوان (سوسيولوجيا اخفاق الحداثة الفكرية في السياقات الاسلامية) الى أنه كان قريبا من تجربة بلاده بعد تحررها من الاستعمار الفرنسي حيث لم تحظ الثقافة بما يليق بها في بناء الدولة وترتب على ذلك "اخفاق سياسي... كان هناك خطأ أيديولوجي وانحرافات عن تاريخ الفكر الاسلامي."
ولاركون دراسات منها (الاسلام.. أصالة وممارسة) و(تاريخيات الفكر العربي الاسلامي) و(الفكر الاسلامي.. قراءة علمية) و(الاسلام.. نقد واجتهاد) و(العلمنة والدين) و(من الاجتهادات الى نقد العقل الاسلامي) و(من فصل التفرقة الى فصل المقال.. أين هو الفكر الاسلامي المعاصر) و(الاسلام. أوروبا. والغرب.. رهانات المعنى وارادات الهيمنة) و(الفكر الاصولي واستحالة التأصيل) و(من التفسير الموروث الى تحليل الخطاب الديني).
وعمل أركون أستاذا لتاريخ الفكر الاسلامي والفلسفة بجامعة السوربون التي حصل منها على درجة الدكتوراه في الفلسفة بين عامي 1968 و1991 كما كان أستاذا زائرا بجامعات ألمانية وأمريكية وايطالية وهولندية وبريطانية. وكرم في أكثر من محفل علمي كما نال جوائز اخرها جائزة ابن رشد للفكر الحر عام 2003 من مؤسسة عربية بألمانيا.
وفي بداية المحاضرة قال أحمد زايد عميد كلية الاداب بجاعة القاهرة ان كتب أركون جعلت كثيرا من الباحثين العرب أكثر وعيا بتاريخهم حيث توصل الى نتائج منها "نفي مركزية أي حضارة... دافع عن الفهم الاستشراقي ذي الافق الضيق" للتاريخ والتراث العربيين. وقال أركون ان هناك ظاهرة تتكرر في المجتمعات حيث يتم قبول بعض المذاهب مقابل رفض أخرى مستشهدا باثنين من الفلاسفة العرب هما ابن حزم وهو أبرز ممثلي المذهب الظاهري في الفكر الاسلامي وهو مذهب يعتمد على الظاهر فقط مشيرا الى أن ابن حزم واجه صعابا لوجوده في الاندلس التي ساد فيها المذهب المالكي. وأضاف أن المثال الثاني هو ابن رشد الذي كان ينتمي الى عائلة عريقة "وأحاط بتاريخ الفلسفة وقدم لنا ما قدم من أعمال أثرت الفكر الفلسفي وكان قاضي القضاة ولم يشكك أحد في انتمائه للاسلام" قائلا ان الفقهاء غضبوا من اعتنائه بالفلسفة "التي كانت سبة في ذلك الوقت باعتبارها من العلوم الدخيلة." وأشار الى أن مؤلفات ابن رشد همشت في العالم الاسلامي في سياق "الصراعات بين العقل الديني والعقل الفلسفي" قائلا ان البيئة الاسلامية في ذلك الوقت أدت الى "اخفاق ابن رشد" لاسباب منها الخوف من طرح الاسئلة في حين نجحت مؤلفات ابن رشد "في البيئة المسيحية الغربية لانهم يقيمون أهمية للعقل."
وقال أركون ان احتكار السلطة السياسية لا يختلف كثيرا عن احتكار السلطة الفكرية التي تغلق الابواب أمام المختلف عن توجهات أصحابها مشيرا الى أن "أهل السنة والجماعة" وصفوا الشيعة بأنهم "الروافض أي الذين يرفضون أهل السنة" كما وصف الشيعة أنفسهم بأنهم "أهل العصمة والعدالة". وأضاف أن الخوارج اضطهدوا في زمن معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الاموية في القرن السابع الميلادي "اضطهادا مبنيا على العصبية القبيلة." وعلق قائلا ان كل فرقة أو طائفة من المسلمين الان تعيش على تاريخ يقصي الفرق ويستثني منها فرقة واصفا ذلك بأنه من تجليات "سوسيولوجيا الاخفاق". وأشار الى أنه منذ ستة قرون والعلوم الاسلامية متوقفة عن النقد والاعتراف بالتعددية.
وقال انها "ستة قرون من انغلاق الابوب والنوافذ" مشيرا الى تجربة مع تلاميذه الذين جمعوا خطبا لخطباء مساجد في فرنسا وهولندا وبلجيكا وقاموا بتحليل مضمونها "وما تؤدي اليه من تصورات مخيالية للاسلام" قائلا ان كثيرا منها ينطلق من بناء أيديولوجي وليس تصورا نقديا. وعلق أستاذ الادب العربي بجامعة القاهرة سيد البحراوي قائلا ان "المشكلة تنبع من التبعية الذهنية حيث لازال الذهن العربي الحديث غير قادر على التفكير ولهذا يلجأ الى حل جاهز من النموذج الاوروبي أو الاسلاموي."
الفلسفة تبق العقل في حيوته فلنعد لها.
حث الكاتب الجزائري البارز محمد أركون على ضرورة الاهتمام بالفلسفة مشيرا الى أنه منذ وفاة الفيلسوف العربي ابن رشد عام 1198 ميلادية لم تعتن التيارات الفكرية الاسلامية بالفلسفة في حين كان لافكار ابن رشد تأثير واضح على الفكر الغربي. وأضاف مساء الاربعاء في محاضرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن للفلسفة دورا مهما في الابقاء على العقل في حالة حيوية تدفعه الى الابداع قائلا ان الموقف الفلسفي هو موقف التساؤل عن صحة ما يقدمه العقل وان ما مر بالجزائر على سبيل المثال منذ حرب التحرير في منتصف الخمسينيات الى الان له علاقة بالفكر والفلسفة.
وأشار في المحاضرة التي حملت عنوان (سوسيولوجيا اخفاق الحداثة الفكرية في السياقات الاسلامية) الى أنه كان قريبا من تجربة بلاده بعد تحررها من الاستعمار الفرنسي حيث لم تحظ الثقافة بما يليق بها في بناء الدولة وترتب على ذلك "اخفاق سياسي... كان هناك خطأ أيديولوجي وانحرافات عن تاريخ الفكر الاسلامي."
ولاركون دراسات منها (الاسلام.. أصالة وممارسة) و(تاريخيات الفكر العربي الاسلامي) و(الفكر الاسلامي.. قراءة علمية) و(الاسلام.. نقد واجتهاد) و(العلمنة والدين) و(من الاجتهادات الى نقد العقل الاسلامي) و(من فصل التفرقة الى فصل المقال.. أين هو الفكر الاسلامي المعاصر) و(الاسلام. أوروبا. والغرب.. رهانات المعنى وارادات الهيمنة) و(الفكر الاصولي واستحالة التأصيل) و(من التفسير الموروث الى تحليل الخطاب الديني).
وعمل أركون أستاذا لتاريخ الفكر الاسلامي والفلسفة بجامعة السوربون التي حصل منها على درجة الدكتوراه في الفلسفة بين عامي 1968 و1991 كما كان أستاذا زائرا بجامعات ألمانية وأمريكية وايطالية وهولندية وبريطانية. وكرم في أكثر من محفل علمي كما نال جوائز اخرها جائزة ابن رشد للفكر الحر عام 2003 من مؤسسة عربية بألمانيا.
وفي بداية المحاضرة قال أحمد زايد عميد كلية الاداب بجاعة القاهرة ان كتب أركون جعلت كثيرا من الباحثين العرب أكثر وعيا بتاريخهم حيث توصل الى نتائج منها "نفي مركزية أي حضارة... دافع عن الفهم الاستشراقي ذي الافق الضيق" للتاريخ والتراث العربيين. وقال أركون ان هناك ظاهرة تتكرر في المجتمعات حيث يتم قبول بعض المذاهب مقابل رفض أخرى مستشهدا باثنين من الفلاسفة العرب هما ابن حزم وهو أبرز ممثلي المذهب الظاهري في الفكر الاسلامي وهو مذهب يعتمد على الظاهر فقط مشيرا الى أن ابن حزم واجه صعابا لوجوده في الاندلس التي ساد فيها المذهب المالكي. وأضاف أن المثال الثاني هو ابن رشد الذي كان ينتمي الى عائلة عريقة "وأحاط بتاريخ الفلسفة وقدم لنا ما قدم من أعمال أثرت الفكر الفلسفي وكان قاضي القضاة ولم يشكك أحد في انتمائه للاسلام" قائلا ان الفقهاء غضبوا من اعتنائه بالفلسفة "التي كانت سبة في ذلك الوقت باعتبارها من العلوم الدخيلة." وأشار الى أن مؤلفات ابن رشد همشت في العالم الاسلامي في سياق "الصراعات بين العقل الديني والعقل الفلسفي" قائلا ان البيئة الاسلامية في ذلك الوقت أدت الى "اخفاق ابن رشد" لاسباب منها الخوف من طرح الاسئلة في حين نجحت مؤلفات ابن رشد "في البيئة المسيحية الغربية لانهم يقيمون أهمية للعقل."
وقال أركون ان احتكار السلطة السياسية لا يختلف كثيرا عن احتكار السلطة الفكرية التي تغلق الابواب أمام المختلف عن توجهات أصحابها مشيرا الى أن "أهل السنة والجماعة" وصفوا الشيعة بأنهم "الروافض أي الذين يرفضون أهل السنة" كما وصف الشيعة أنفسهم بأنهم "أهل العصمة والعدالة". وأضاف أن الخوارج اضطهدوا في زمن معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الاموية في القرن السابع الميلادي "اضطهادا مبنيا على العصبية القبيلة." وعلق قائلا ان كل فرقة أو طائفة من المسلمين الان تعيش على تاريخ يقصي الفرق ويستثني منها فرقة واصفا ذلك بأنه من تجليات "سوسيولوجيا الاخفاق". وأشار الى أنه منذ ستة قرون والعلوم الاسلامية متوقفة عن النقد والاعتراف بالتعددية.
وقال انها "ستة قرون من انغلاق الابوب والنوافذ" مشيرا الى تجربة مع تلاميذه الذين جمعوا خطبا لخطباء مساجد في فرنسا وهولندا وبلجيكا وقاموا بتحليل مضمونها "وما تؤدي اليه من تصورات مخيالية للاسلام" قائلا ان كثيرا منها ينطلق من بناء أيديولوجي وليس تصورا نقديا. وعلق أستاذ الادب العربي بجامعة القاهرة سيد البحراوي قائلا ان "المشكلة تنبع من التبعية الذهنية حيث لازال الذهن العربي الحديث غير قادر على التفكير ولهذا يلجأ الى حل جاهز من النموذج الاوروبي أو الاسلاموي."
من مواضيعي
0 لن أرجع إلى المنتدى و لن أدخل ملاعب كرة القدم ...
0 الرأي الواحــــــد ...... إلى اللقــاء يا إخوان .
0 المثلث الصعب .
0 عزيزتي البطاطا .....كاين ربي .
0 المهلوس الآخـــــــــر .........
0 التاريخ أيدني و السلفية تجاهلتني ....
0 الرأي الواحــــــد ...... إلى اللقــاء يا إخوان .
0 المثلث الصعب .
0 عزيزتي البطاطا .....كاين ربي .
0 المهلوس الآخـــــــــر .........
0 التاريخ أيدني و السلفية تجاهلتني ....