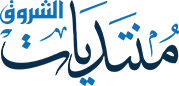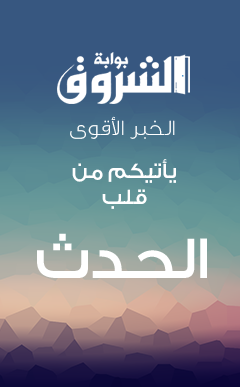موضوع للنقاش خاص بمشروع جمعية العلماء
29-04-2007, 08:46 PM
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:
هل كان مشروعا ناقصا؟
تاريخ المقال 21/04/2007
بقلم: د/مصطفى بن حموش، جامعة البحرين
هل كان مشروعا ناقصا؟
تاريخ المقال 21/04/2007
بقلم: د/مصطفى بن حموش، جامعة البحرين
[email protected]
لا أحد ينكر مدى مساهمة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في حفظ هوية الشعب الجزائري و الدفع به لنيل الاستقلال. فمجرد استقراء ما قامت به من أعمال جبارة في سياق الظروف الاحتلالية الصعبة و الموارد الشحيحة و ضراوة الخصم، تجعل من منجزاتها صرحا كبيرا من التضحيات و الإرادة النافذة، يندر وجودها و تكرارها في العالم المعاصر على الأقل على المستوى العربي و الإسلامي. لكنه من الضروري في مقابل هالة الاحترام و التقدير التي تنالها الجمعية التي تنالها الجمعية بفضل هذه الجهود، أن يخضع مشروعها لنقد موضوعي بهدف البناء المستقبلي و القفز نحو الأفضل.
فالقاعدة الذهبية أنه لا يمنعنا حبنا للجمعية أن نتغاضى عن نقائص فيها، و لا يدفعنا كرهنا لفرنسا التاريخية أن نعمى على محاسن فيها. لقد كان مشروع جمعية العلماء رد الفعل العكسي لسياسة فرنسا الثقافية في الجزائر و المناهض لها. و يكفي دلالة في ذلك اقتران نشأتها سنة 1931 باحتفال فرنسا بمناسبة مرور قرن على احتلالها للجزائر و استتباب الأمن فيها لصالح السلطة العسكرية. و لذلك فمن الإنصاف عند تقييم مجهود الجمعية اعتبار هامش الحرية الضيق الذي أتيح لها في تلك المواجهة التاريخية المفتوحة و غير المتوازنة و الوضع الثقافي في البلاد. إن الإحصائيات المتوفرة بعد قرن من الاحتلال تشير إلى ضآلة عدد الأطفال المتمدرسين خلال الفترة الاستعمارية الذي كان لا يتجاوز الخمسين ألفا، موزعين علي 625 مدرسة حكومية، في حين كان ما يقرب من نصف المليون طفل محرومين من نفس الفرصة نظرا لقلة المقاعد المدرسية (د. عمامرة).
و في مستوى الجامعة كان مجموع الطلبة الجزائريين في كل التخصصات حوالي خمسمائة طالب إلى غاية 1954، في الوقت الذي كان فيه عدد أبناء المعمرين الأوربيين عشرة أضعاف بالضبط. و في حين كان عدد أفراد الشعب الجزائري حوالي 8 ملايين نسمة فلم يكن يتجاوز عدد المعمرين ثمانمائة ألف نسمة.
محدودية السقف العلمي للجمعية و عوامله
ليس من باب التجني أن نذهب في هذا المقال إلى القول أن سقف الجمعية العلمي كان محدودا و ذلك بالمقارنة بالمستوى العلمي السائد آنذاك، و ربط ذلك بالأهداف التي وضعتها الجمعية في سياستها التعليمية، ثم اقتصارها على علوم دون أخرى، ثم تركيبة الجمعية الإدارية و العلمية. لقد تأثر رائدا الجمعية بالرافدين الدينيين الرئيسيين الذين نهلا منه في المشرق العربي خلال إقامتهما هناك و هما: الحركة السلفية الوهابية في الحجاز، و النهضة الإصلاحية في مصر. فالأولى كانت ترمي إلى محاربة الفساد العقائدي و تحرير العقل من الخرافات والبدع المتراكمة عبر القرون و العودة إلى التوحيد، بينما كانت الثانية ترمي إلى تجديد الشريعة و الخطاب الديني و رفع الوعي الاجتماعي وفق رياح الحداثة والتحديات التي كانت تأتي من الغرب المناوئ. و لذلك فإن الالتزام بسقف تلك الحركات هو نفسه قد شكل حدود المطالبة الذي توقفت عنده الجمعية.
أما المظهر الثاني الذي حدد السقف العلمي للجمعية فهي الخطة التربوية التي وضعتها لمتخرجيها. فقد اتفق كل من ابن باديس و الإبراهيمي أثناء وجودهما في المدينة المنورة على سياسة تعليمية تقتضي تربية النشء على "فكرة صحيحة بعلم قليل". لكن المتفحص للبرنامج التكويني يجد أن معظم التكوين كان يقتصر على اللغة و العلوم الشرعية الأساسية بالإضافة إلى التاريخ و الأدب، في حين لم تجد العلوم العصرية الأخرى التي كانت تعج بها أوربا و الغرب طريقها إلى ذلك المنهاج. و قد سرى هذا الاقتصار الأفقي إلى نخبة الجمعية التي حظيت بالدراسات العليا إلى المشرق. فقد التحق معظم المبتعثين الجزائريين مع قلة عددهم لإكمال دراستهم بالمؤسسات العلمية التقليدية هناك. و قد كان لهذا التكوين ثمرته المباشرة بعد الاستقلال في حفظ الهوية الجزائرية و توفير الإطارات لكنه اقتصر في نفس الوقت على السلك الدبلوماسي و التعليمي و الإعلامي، تاركا المجالات الحيوية الأخرى كالاقتصاد و الطب و الإدارة و السياسة و التكنولوجيا للنخبة الجزائرية المتغربة.
و لعل المظهر الآخر الذي لا يقل أهمية عن سابقيه هو التركيبة البشرية لنواة الجمعية سواء خلال مرحلة التأسيس أو في طور العمل الذي امتد إلى ما يقرب من ربع قرن من الزمن (1931-1956) التي انحصرت في الفقهاء و الشيوخ و الأئمة ، و عدم استيعابها المفكرين و الباحثين في العلوم الأخرى. كما يكون البرنامج العملي المكثف الذي طغى على الجمعية و هاجس التوسيع الأفقي المستمر الذي كان يتطلب التنسيق على مستوى التراب الوطني الواسع عاملا رئيسيا في منع الجمعية من تعميق طروحاتها و الاشتغال بالتنظير والتخطيط الاستراتيجي. و لا نستبعد في هذا السياق دور الاعتقاد الإسلامي الذي يقتضي رفعة مكانة المسلم و دناءة الكافر المطلقة في ازدراء كل ما يأتي من فرنسا الصليبية، بما فيه العلوم الكونية.
الوضع العلمي في فرنسا غداة إنشاء الجمعية
لقد كان للبعد الجغرافي لحركات الإصلاح في المشرق عن الغرب المتقدم أثره في طبيعة المنظومة و صبغتها بالإحيائية الداخلية. لكن الوضع في الجزائر كان مختلفا تماما. فلم تكن جمعية العلماء بمعزل عما كان يحدث في أوربا من تطورات، حيث كانت فرنسا في قلب الثورة العلمية. كما كان السفر إلى فرنسا متيسرا و المسافة قصيرة بين ضفتي البحر المتوسط، و قوانين التجنيس سارية. و لذلك فإن التاريخ المقارن يفيدنا بقياس فارق "ضغط المناخ العلمي" بين فرنسا و الجزائر غداة تأسيس جمعية العلماء الجزائريين. فقد عرفت سنوات ما بين 1650 و 1800 في فرنسا قبيل احتلالها للجزائر بعصر الأنوار التي شهدت هيمنة العقلانية و الاهتمام بالإنسان كمحور تفكير و نقد النظام الاجتماعي و زحزحة الدين من السلطة. لقد كان من اهتمام ديكارت (1596-1650) تطوير الفكر المنهجي للارتفاع بالعقل الأوربي و البحث عن حقائق العلوم و تحجيم الفكر الديني الميتافيزيقي. و قد كان من اعتقاد ديكارت أن كل العلوم البشرية تخضع للمنطق البشري العالمي المبني على النظام الرياضي والقياس و منهجية التجربة و الاستنتاج الذهني.
أما في العلوم السياسية والاجتماعية فقد كان لإنتاج الاجتماعي الفرنسي بمنتيسكيو (1689-1755) أثره البالغ في توسيع دائرة الفكر النوراني و زلزلة التركيبة الاجتماعية و السياسية القديمة لإعادة بنائها وفق منطق الطبيعة و السنن الإلهية في الكون ثم العقل و القيم المدنية المشتركة بين بني البشر و احتياجات الإنسان. و قد انتقلت المدرسة الفكرية الفرنسية بعد ذلك إلى مرحلة أخرى ذات معالم أكثر وضوحا عن طريق الفيلسوف أوغست كونت (1789-1857) صاحب المنهج الوضعي الذي وضع أسس المنهج العلمي المبني على التجربة و المعرفة الحدسية للظواهر الطبيعية و هو ما سماه بالإبستمولوجيا. فقد وضعت فلسفته علماء الطبيعة في الإطار المنهجي الصارم و الدقيق الذي استمر إلى يومنا.
و في مجال التاريخ نجد أن الدراسات قد شقت طريقها وفق مناهج جديدة تهدف إلى استنتاج سنن الكون في المجتمعات وتوظيفها في الميدان. فقد عرفت فرنسا بعد منتسكيو اجتهادات كثيرة منها أعمال فرنان برودل (1902-1985) الذي سبق و أن درس في كل من الجزائر و قسنطينة و الذي وضع أسس المدرسة الفرنسية في دراسة التاريخ. فقد وجد أن الأحداث التاريخية تتقاطع مع الكثير من المواضيع الأخرى التي يمكن أن تخدم فهمها. و لذلك فقد كان يشجع العمل الجماعي المتعدد الأطراف في كتابة التاريخ من جهة، و ضرورة توسيع مجال المؤرخ إلى المجالات العلمية الأخرى لفهم أوسع للحادثة التاريخية. و بالموازاة مع هذا التقدم الفكري النظري فقد شهدت فرنسا و أوربا تطورا هائلا في المجال العلوم التطبيقية تتمثل في الصناعة و التقدم التكنولوجي مما أدى إلى ثورة صناعية غير مسبوقة.
كما كان الطب هو المجال التطبيقي الثاني الذي خطت فيه فرنسا كذلك خطوات رائدة. فقد قادت الدراسات المجهرية –الميكروبيولوجيا- لباستور (1822-1895) و أعمال ماري كوري (1867-1934) على الأشعة السينية للوثب بهذا المجال عاليا. لقد عكست هذه الأعمال ظاهرة جديدة من نوعها تمثلت في نشأة نخبة علمية واسعة و متنوعة دفعت بالعلوم نحو التكامل المعرفي وبالمجتمع نحو التقدم الثقافي مما سحب جزء من السلطة من النخب السياسية من جهة و من هيمنة رجال الدين الكنسي من جهة أخرى. و لعل أهم ما يعكس ذلك ما قام به المفكران الفرنسيان ديدرو و دالمبير سنة 1752 بوضع موسوعة علمية شاملة لكل مستجدات العلوم بمختلف فروعها تضم تاريخ الأفكار و المعارف لتسهيل انتشارها بين كافة طبقات المجتمع مما رفع مستوى المجتمع المعرفي.
هل كان الاختراق العلمي ممكنا؟
هل فات جمعية العلماء الاستفادة من هذا المناخ العلمي و الفكري العام الذي ساد فرنسا و الذي امتد إلى الجزائر بفعل الارتباط الإداري و الثقافي و الحضور المكثف للمعمرين فيها؟ ألم تساعد الخطة التربوية لجمعية العلماء الجزائريين في تكريس سياسة الحصار العلمي بالتسليم لفرنسا بعدم تنمية البحث العلمي والعلوم الحديثة و الاكتفاء بالعلوم التقليدية ؟ ألم تكن سياسة "العلم القيل المفيد" التي أعلن عنها البشير الإبراهيمي هي نفسها عامل إضعاف المشروع النهضوي الجزائري؟ ألم يكن الاختراق العلمي ممكنا في ظل السياسة الإندماجية لفرنسا؟ إن هناك مؤشرات تاريخية تفيد بإمكانية ذلك إلى حد معتبر في ظل سياسة الاندماج و حرية الهجرة و الحركة آنذاك، و لعل أدل شيء على ذلك هو القليل من الجزائريين الذين تخرجوا من فرنسا و الذين لم يفقدوا حسهم الوطني العالي، و أهمهم على الإطلاق مالك بن نبي، ثم بعض الأطباء و المهندسين القلائل الذين تخرجوا آنذاك.
و لذلك فإن عدم حدوث الاختراق، كان أغلب الظن لموانع ذاتية أهمها عدم تجاوز رد الفعل الميداني للجمعية في مواجهة المشروع الاستعماري و الاكتفاء بالموقف الدفاعي و تحقيق استرجاع الهوية. و لعل هذا الاستنتاج ينطبق على الكثير من الحركات الإصلاحية التي نشأت في العالم العربي. فرغم النداءات التي قام بها الإصلاحيون التحديثيون أمثال خير الدين التونسي و رفاعة الطهطاوي و محمد عبده، فإن الموقف المحافظ و هاجس التغريب كان يلازم تلك الحركات الإصلاحية مما حرمها من إجراء الخطوة الجريئة في تطعيم المؤسسات التعليمية القديمة بالعلوم و المناهج الحديثة و الاكتفاء بإثارة العلوم التقليدية و تدويرها.
و لعل الأدهى من ذلك هو تلك العلة المستمرة إلى يومنا و التي ورثناها منذ تلك الفترة و المتمثلة في فشلنا في ربط التقدم العلمي و المناهج الحديثة بالفكر الإسلامي و العلوم الشرعية رغم بعض المحاولات المتباعدة التي تقوم هنا و هناك في العالم الإسلامي. فكما أنه في الغالب من لم يسعفه عقله في فهم الرياضيات و الفيزياء من طلاب العلم يتوجهون إلى العلوم الشرعية، فكذلك طلاب العلوم الكونية كثيرا ما يزهدون في العلوم الشرعية لارتباطها بالغيبيات واغترارهم بالمرجعية العلمية الغربية.
www.elkawader-dz.com
من مواضيعي
0 الفيسبوك..... ابعدنا عنكم 11 سنة
0 Je suis Vincent Reynouard مبادرة خاصة
0 هام لمكتتبي عدل 2 وهران
0 كم نحتاج من حاوية لرمي مسؤولينا الفاشليييييييييييين ؟
0 موعد سيارة "سامبول" الفرنسية ...وعودة القروض الاستهلاكية
0 يا بن غبريط:قرار التعيين ولا يوجد منصب تشغيل
0 Je suis Vincent Reynouard مبادرة خاصة
0 هام لمكتتبي عدل 2 وهران
0 كم نحتاج من حاوية لرمي مسؤولينا الفاشليييييييييييين ؟
0 موعد سيارة "سامبول" الفرنسية ...وعودة القروض الاستهلاكية
0 يا بن غبريط:قرار التعيين ولا يوجد منصب تشغيل
التعديل الأخير تم بواسطة كوادر صناع الجزائر ; 11-05-2007 الساعة 03:20 PM