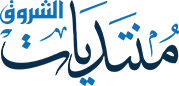الفرصة الثانية: ثلاثة رؤساء وأزمة القوة الأميركية العظمى
27-02-2009, 11:26 AM
الفرصة الثانية: ثلاثة رؤساء وأزمة القوة الأميركية العظمى
زبيغننو بريجنسكي - واشنطن 2007
زبيغننو بريجنسكي - واشنطن 2007
22/11/2007

* يستمد هذا الكتاب قيمته من المكانة والمصداقية الفكرية التي يتمتع بها مؤلف الكتاب. فقد شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس جيمي كارتر من عام 1977 إلى عام 1981. وهو أحد القلة من الذين يمكن أن يطلق عليه اسم "مؤسسة السياسة الخارجية" في واشنطن الذين أعلنوا مبكرا عن انتقاداتهم القاسية لفكرة الذهاب بشكل أحادي إلى حرب ضد صدام حسين.
وقد حذر من العواقب الوخيمة لمثل هذه الحرب إذا لم تأت ضمن خطة استراتيجية أوسع. وقد بدأ تحذيره من مخاطر الحرب قبل أن تحدث بفترة طويلة نسبيا. فكان رأيه منذ عام 2002 بأن الحرب هي أمر جدي لا يمكن التنبؤ بديناميكية عواقبها. وصرح قبل شهر من الحرب بأن أمريكا التي ستذهب للحرب بشكل أحادي ستجد نفسها وحيدة في تحمل الأعباء وتكلفة ما بعد الحرب. من هنا يبدو أن المؤلف كان من القلائل الذين امتلكوا رؤية متكاملة لكيفية صنع وتنفيذ السياسة الخارجية.
ولهذا السبب نجده يحكم على أداء الرئيس بوش بالأداء الكارثي. وخلاصة دراسته هي أنه وعلى الرغم من تعاظم القوة العسكرية الأمريكية في عام 2006 قياسا بما كانت عليه عام 1991، فإن هناك تراجع كبير في مقدرة أميركا للتعبئة والحشد أو الإيماء إلى اتجاه مشترك الهدف. وقلل ذلك من قدرتها على تشكيل الواقع الدولي.
فبعد 15 عاما من الاحتفال وتتويج أميركا كقوة وكقائد كوني للعالم، أصبحت أميركا مليئة بالخوف وديمقراطية معزولة في عالم معاد سياسيا. لماذا هذا التدهور في مكانة الولايات المتحدة؟ هذا ما يجيب عليه الكتاب بتحليل عميق ومتماسك.
ينتمي بريجنسكي إلى المدرسة الواقعية في السياسة الدولية وبالتالي يكتب بفهم للطرق التي تؤثر بها الأعمال السياسية والعسكرية في جزء من العالم في أجزاء أخرى وهذا ما انعكس في توصياته للرئيس الجديد في الفصل الأخير من الكتاب.
يقيّم هذا الكتاب أداء ثلاثة رؤساء للولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب الباردة، وكيف تأثر هذا الأداء بأسلوب القيادة لكل من هؤلاء الرؤساء، وكيف أثر بالتالي في مكانة الولايات المتحدة.
ولا يكتفي مؤلف الكتاب بتقديم تقييم نقدي بل يتعدى ذلك بتقديم دليل لبناء دور أميركي في العالم. وعلى الرغم من أن المؤلف يحمل الرئيس الحالي مسؤولية المستنقع الذي تمر به الولايات المتحدة فإنه أيضا يبين بشيء من التحليل الفرص الضائعة وسوء التقدير الذي ميز أداء كلينتون وبوش الأب. وهو يعطي علامة متقدمة للرئيس بوش الأب على طريقة تعامله مع تفكك الاتحاد السوفيتي والتعامل مع الغزو العراقي للكويت لكنه أخفق في ترجمة الانتصارين إلى نجاح تاريخي مستدام. فلم يتم العمل على تحويل روسيا إلى ديمقراطية حقيقية ولم يستخدم النصر العسكري على صدام حسين والتحول الاستراتيجي في البيئة الشرق أوسطية للضغط على إسرائيل للتوصل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي. ويمتدح الرئيس كلينتون على طريقة التعامل مع الأزمة في البلقان ووضع خطوط عريضة لحل الصراع الفلسطيني والإسرائيلي. إلا أنه يشير إلى أسلوبه الانتهازي في صناعة القرار وقيادة أميركا من وسيط أمين في الصراع العربي الإسرائيلي إلى متحدث باسم إسرائيل. أما الرئيس بوش الابن فكان كارثيا في أدائه مما بدد موارد الولايات المتحدة وشتت انتباهها عن الحرب على الإرهاب في أفغانستان بسبب الأحادية وسيطرة فكر المحافظين الجدد.
يقدم المؤلف في بداية الكتاب اللحظة التاريخية التي شهدت تتويج الرئيس بوش كأول قائد كوني للعالم في التاريخ. ويبين أن هذه التتويج هو ذاتي ولكن هكذا بدأت الصحافة والإعلام الأمريكي بالإشارة إليه وبدا رؤساء الدول الأخرى الرضوخ لهذا الواقع. وقد وصل الأمر لدرجة أن زيارة أي رئيس أو زعيم دولة للبيت الأبيض وبخاصة كامب ديفيد نقطة مهمة في بروفايل هذا القائد أو ذاك. فبروز الولايات المتحدة كأقوى دولة في العالم قد وضع أميركا أمام ثلاث مهام: أولا، إدارة وتوجيه وتشكيل علاقات القوة المركزية في عالم يتميز بتغير التوازنات الجيوبوليتكية. ثانيا، إنهاء واحتواء ومنع الإرهاب وكذلك منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم السلام والاستقرار الدولي والإقليمي. ثالثا، التصدي للمشاكل الكونية مثل مشاكل البيئة التي تؤثر في منفعة البشر بشكل عام وتهدد الكوكب. وعلاوة على ذلك، يتطرق الفصل الأول إلى اختلاف أسلوب القيادة من رئيس إلى آخر وكيف أثر ذلك في فهم وتفسير كل منهم لهذه المرحلة الجديدة. فهناك جوانب شخصية ومؤسسية وعامل الحظ تتفاعل مع بعضها البعض لتنتج نمطا معينا من القيادة.
يقسم الرؤساء إلى قسمين: رئيس مهتم جدا بالسياسة الخارجية وبالتالي يقوي ويرفع من مكانة مستشار الأمن القومي لأنه قريب منه ولأنه الضامن للأمة ومسؤول عن التعامل مع العالم الخارجي. نيكسون وكيسنجر مثالان على هذه الفئة. الفئة الثانية من الرؤساء تعتمد على التركيز على السياسة الداخلية وبالتالي تفوض وزير الخارجية لصياغة وإدارة سياسة أميركا مع العالم. مثال على ذلك فورد وكيسنجر. يقول بان بوش الأب هو الأكثر خبرة في الشؤون الخارجية والأمهر دبلوماسيا لكن لم يكن منقادا برؤية جريئة في لحظة غير تقليدية. وينتمي إلى الصنف الأول. كلينتون كان الألمع والأذكى لكنه لم تكن له استراتيجية متسقة حول استخدام القوة الأميركية وكان ينتمي إلى الصنف الثاني لكن في فترة ولايته الثانية تغير. بوش الابن هو الأكثر جرأة لكنه عديم الخبرة والمعرفة بشؤون العالم وكان له مزاج أميل إلى صياغة المواقف بشكل دوغماتي. في البداية انتمى إلى الصنف الأول لكنه تغير بعد أحداث الحادي عشر.
وعلى العكس مما يقوله المحافظون الجدد، كما يبين الفصل الثاني، فانتصار الغرب في الحرب الباردة لم يكن بفعل عمل أو سياسة رئيس أميركي واحد بل نتيجة مساهمة كل الرؤساء في الجهد الجماعي. فالعملية استمرت لمدة 45 سنة. ويذكر على سبيل المثال لا الحصر كيف اتبع كيندي السياسة لتغيير الانطباع بوجود تفوق سوفيتي تكنولوجي عندما أطلق السوفييت صاروخ الفضاء سبوتنك عام 1957. وتبين الوثائق السوفيتية كيف أن التنافس الفضائي أرهق وجفف مصادر الاتحاد السوفيتي. وكيف أن الرئيس كارتر جعل من حقوق الإنسان قضية دولية الأمر الذي وضع الاتحاد السوفيتي في وضع إيديولوجي دفاعي. ويضيف أن هناك أشخاصا آخرين ساهموا في النتيجة النهائية ويضرب على سبيل المثال جون باول الثاني، رئيس حركة التضامن البولندية وميخائيل غورباتشوف الرئيس الأخير للاتحاد السوفيتي. فقد تمردت حركة التضامن البولندية على الأحكام العرفية لمدة أكثر من عقد، الأمر الذي أجبر الحكم الشيوعي في بولندا للتوصل إلى حلول وسط منهيا بذلك احتكار الشيوعيين للسلطة. وقد أثر ذلك في كل من تشيكوسلوفاكيا وهنغاريا إذ بدأت القلاقل والانتفاضات التي انتهت بسقوط جدار برلين. ولا يمكن إغفال صاحب فكرة البرسترويكا الذي جلب للسطح التناقضات البيروقراطية للشمولية يوم تسامح مع صعود الانشقاقات السياسية بعد أن تراجع الاتحاد السوفيتي عن القمع اللينيني.
يجادل المؤلف بأن فهم التغيرات الاجتماعية الاقتصادية لا يحدث قبل حدوث التغير نفسه وليس مصاحبا له إنما بعده. فبعد انتهاء الحرب الباردة كانت هناك حاجة ماسة إلى وجود منظور منسجم للإحلال محل الافتراضات التي أصبحت بالية مع تفكك الاتحاد السوفيتي والتي قادت سلوك رؤساء الولايات المتحدة. وبالتالي ظهر تعبير "النظام العالمي الجديد"، وهو تعبير متعدد المعاني. فالتقليديون رأوا فيه كعامل استقرار واستمرار بينما رأى الإصلاحيون في هذا التعبير فرصة لإعادة ترتيب الأولويات. وبالتالي ظهرت في هذه المنعطف التاريخي رؤيتان متناقضتان. الأولى ما يطلق عليها العولمة والتي تبناها الرئيس كلينتون. والرؤية الثانية هي رؤية المحافظين الجدد. وكل رؤية تدعي أنها تمثل المعنى الحقيقي للتاريخ. وقد ركزت العولمة على الأثر الكوني للاتصالات والتكنولوجيا والتجارة والتدفق المالي الدولي. ومن العولمة استمدوا فهمهم لدور ومكانة أميركا. وجوهر هذه الفكرة هو الاعتمادية المتبادلة.
أما المحافظون الجدد فقد اختزلوا معركة الحرب الباردة في مواقف ريغان على اعتبار أنها وحدها المسؤولة عن الانتصار. وقد ادعوا أن ريغان جند جون باول بشكل سري لضعضعة الاستقرار في الاتحاد السوفيتي. وتستند فكرة المحافظين الجدد على مبدأين هما الحتمية التاريخية فيما يتعلق بالديمقراطية وقد أخذوا هذا المبدأ من فوكوياما في كتابه "نهاية التاريخ"، والفكرة الثانية هي الاصطدام مع الإسلام وهي أحد تفسيرات صدام الحضارات التي جاء بها صموئيل هنتنغتون. والتقت هذه المجموعة مع فكر حزب الليكود الإسرائيلي. وبدأت كمجموعة في نهاية السبعينيات من القرن الماضي عندما شكلوا ما سمي "لجنة الخطر الراهن" التي طالبت بتبني سياسات تستند إلى القوة العسكرية والسياسية للولايات المتحدة. وتعتقد هذه المجموعة أنه تم استبدال الخطر السوفيتي ببروز خطر الإسلام. وقد نالت هذه المجموعة النخبوية دعم الأصولية المسيحية الأميركية. وقدمت لهم أحداث الحادي عشر من سبتمبر اللحظة التاريخية الحاسمة للإطباق على صياغة السياسة الخارجية الأميركية الأمر الذي جعل بوش الابن يتبنى فكر المحافظين الجدد. وبالتالي التزم بالعمل العنيف للانتصار في عالم تميز بشكل إيديولوجي ودوغماتي بأنه منقسم بين الخير والشر.
ويسلط الفصل الثالث الضوء على كيف أصبح تعبير النظام العالمي الجديد العلامة التجارية لرؤية بوش للعالم بعد انتهاء الحرب الباردة. والحقيقة أن التعبير جاء في الأصل من غورباتشوف. ولم يكن هذا التعبير معبرا عن قيادة بوش للسياسة الخارجية. فهو لم يكن صاحب رؤية ولكنه ممارس محترف لسياسة القوة والدبلوماسية التقليدية. ولم يسع بوش لترجمة هذا الشعار إلى صياغات واضحة في السياسة الخارجية. فقد ظهر وضع جديد غير تقليدي تمثل في ظهور الصراعات الدينية والعرقية والسياسية في البلقان والشرق الأوسط وداخل الكتلة السوفيتية نفسها. في معالجة هذه التحديات الجديدة، تميز بوش بالقوة والضعف في آن واحد. فقد أظهر قدرة على إدارة الأزمات لكنه افتقد المخيلة الاستراتيجية. وعالج موضوعي الاتحاد السوفيتي والغزو العراقي بشكل ممتاز لكنه لم يترجم النصرين أو لم يستغل الحدثين إلى نصر تاريخي مستدام. ولم يستغل التأثير السياسي الأميركي الفريد من نوعه ولا الشرعية الأخلاقية بشكل استراتيجي لتحويل روسيا إلى ديمقراطية أو لتهدئة الشرق الأوسط. وتعامل مع غورباتشوف بحرفنة عالية إذ وافق على توحيد ألمانيا بالشروط الغربية. فقد استدرج غورباتشوف إلى موضوع الشراكة الكونية وشجعه للاستسلام لفكرة انهيار الإمبراطورية السوفيتية وفي نفس الوقت طمأن حلفاءه الفرنسيين والبريطانيين بأن وحدة ألمانيا لن تشكل خطرا على مصالحهما. وواجه الرئيس بوش مشاكل كثيرة منها ما حدث في الصين ومجزرة الطلبة الذين طالبوا بالديمقراطية. فلم يسعى الرئيس إلى المخاطرة في علاقاته مع الصين في الوقت الذي انحاز فيه الكونغرس والشعب الأمريكي لقضية الطلاب. وقد قام مستشاره للأمن القومي بزيارة سرية للصين مطمئنا أن الدعم الأميركي للثورة الديمقراطية في بولندا لا ينطبق على الصين. وحين ظهور القلاقل في الاتحاد السوفيتي والبلقان في أجواء عدم تيقن، سعى بوش الأب لضمان للاستقرار الدولي.
وعلى العكس من الرئيس بوش كان للرئيس كلينتون، كما جاء في الفصل الرابع، نظرة كونية مفادها أن الحتمية التاريخية (ليس بالمفهوم الماركسي) المتجذرة في مفهوم العولمة تنسجم بشكل تام مع معتقدات كلينتون أن على أميركا أن تجد نفسها إن أرادت أن تسمي نفسها الدولة التي لا يمكن الاستغناء عنها. وبالتالي جاءت السياسة الخارجية للرئيس كلينتون وبخاصة في الفترة الأولى كامتداد للسياسة الداخلية. والواقع يشير إلى أن غياب الاتحاد السوفيتي قدم للرئيس كلينتون ثلاث فرص: وضع حد لسباق التسلح مع روسيا، تحقيق أمن جماعي في بيئة استراتيجية أحادية القطبية، إنهاء تقسيم أوروبا وتوسيع الناتو. ومع أن كلينتون نجح في وضع حد لسباق التسلح مع روسيا إلا أن ذلك لم يحدث مع الهند وباكستان وكوريا (خرجت من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية) وحتى فرنسا أجرت تفجيرات وكذلك الصين وبدأ البرنامج الإيراني.
من النقاط التي تسجل في غير صالح كلينتون هي مسألة السلام في الشرق الأوسط. فكانت قدرته على استغلال فرص حقيقية للسلام في الشرق الأوسط في مناسبتين على الأقل: بين عامي 1993-1995 وبعد ذلك في أثناء وبعد قمة كامب ديفيد. فقد انحرفت سياسة أميركا تحت كلينتون من سياسة متوازنة إلى منحازة لإسرائيل. وقد جرى تجنيد طاقم كلينتون من مراكز تفكير ومعاهد موالية ومؤيدة لإسرائيل. من هنا يفهم المؤلف إلقاء اللوم على عرفات والجانب الفلسطيني وبخاصة مع طرح آل غور نفسه مرشحا بحاجة إلى أصوات اليهود ودعمهم. على الرغم من نجاحات كلينتون في العديد من الملفات وبخاصة الاقتصادية إلا أنه لم يترك بصمة واضحة تاريخية على العالم.
ويوجه المؤلف سهام نقده إلى ما أسماه "القيادة الكارثية وسياسة التخويف" التي جاءت كمحور مهم في الفصل الخامس من الكتاب. فمن دون شك فإن لعنوان الفصل "القيادة الكارثية وسياسة التخويف" دلالة واضحة إذ تختصر بالفعل حكم بريجنسكي على إدارة بوش في فترة ست سنوات. فقد جلب بوش معه إصرارا شديدا ورؤية واضحة وإيمانا عميقا إلى مستوى جديد من المواجهة بين الخير والشر. ومن الواضح، غيرت أحداث الحادي عشر من بوش وحولته إلى رئيس آخر. من الآن فصاعدا سيكون القائد الحاسم للأمة في مواجهة تهديد داهم وخطير وستقوم أميركا للعمل لوحدها بصرف النظر عن موقف حلفائها.
وفي مواجهة هذا التهديد الجديد، جاءت استراتيجية بوش كمزيج من الصياغات الامبريالية التي وردت في وثيقة الأمن الوطني لعام 1991 والتي أعدها مسؤولو الدفاع آنذاك في إدارة بوش الأب (الكثير منهم عادوا في إدارة بوش كمستشارين) والأفكار الصدامية الهجومية في نظرة المحافظين الجدد الذين يوجد لهم هوسه في الشرق الأوسط. وقد سميت بـ "الحرب على الإرهاب" عاكسة بذلك الهموم الامبريالية القديمة حول السيطرة على ثروات الخليج وكذلك رغبة المحافظين الجدد في تعزيز أمن إسرائيل من خلال القضاء على نظام صدام حسين.
بيد أن أحداث الحادي عشر غيّرت الوضع وعملت على قدوم الصف الثاني من المحافظين الجدد إلى مواقع مؤثرة في الإدارة. وهنا الحديث تحديدا عن رئيس طاقم نائب الرئيس لويس ليبي ونائب وزير الدفاع باول وولفيتز. ركز الفصل على علاقات توازن القوى في إدارة بوش ومواقفهم المؤيدة لغزو العراق. فالحرب كانت كارثية لأسباب متعددة. ألحقت ضررا بمكانة أميركا ومصداقيتها، كانت كارثة جيوستراتيجية إذ حولت الموارد والانتباه من خطر الإرهاب في أفغانستان ما مكن طالبان من النهوض. وأخيرا أدى الهجوم على العراق إلى زيادة حدة مشكلة تهديد الإرهاب للولايات المتحدة.
يبين المؤلف أن معاداة أميركا في العالمين العربي والإسلامي ليست بسبب كره المسلمين للحرية كما قال بوش وإنما لتماهي سياسة أميركا مع الماضي الامبريالي البريطاني وحاضر السياسة الإسرائيلية. وبالتالي انتقد بريجنسكي أن فكرة الديمقراطية هي الحل لمعضلة أميركا في الإقليم. فعندما يتم تطبيق الديمقراطية بشكل سريع على مجتمعات تقليدية غير مجربة ولم تتعرض إلى ممارسة الحقوق المدنية وظهور حكم القانون بشكل تدريجي فإنها من المحتمل أن تؤدي إلى نزاعات. وهذا يعبر عن قصر النظرة الأمريكية في فكرة الديمقراطية. ويقول إنه لا يمكن دحض الشك بأن أغلب المنادين بالديمقراطية في الشرق الأوسط يعرفون ذلك لكنهم يريدون زعزعة الوضع الراهن ما يؤدي إلى تدخل مسلح يمكن تبريره بفشل التجربة الديمقراطية وصعود التطرف.
النتيجة التي يتوصل لها في هذا الفصل هي أن الرئيس بوش أخفق كقائد كوني في فهم اللحظة التاريخية. وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات قوض من الوضع الجيوستراتيجي لأميركا. ويقول إن اتباع بوش لسياسة مبنية على الوهم "بأننا الآن إمبراطورية وعندما نعمل فإننا نخلق حقيقتنا" يكون بوش قد عرض أميركا للخطر. أوروبا استبعدت، والصين وروسيا أصبحتا أكثر حزما، والشرق الأوسط متشرذم وعلى حافة انفجار، وديمقراطية أميركا الجنوبية أصبحت أكثر شعبوية ومعادية لأميركا. ويقول إن على الرئيس القادم تقع مسؤولية بذل جهد كبير لاستعادة شرعية أميركا كضامن للأمن الكوني.
جاء الفصل الأخير بعنوان ما بعد عام 2008 وفرصة أميركا الثانية. وهو بمثابة تقييم غير مباشر لقدرة أميركا على الاحتفاظ بقيادة مسؤولة للعالم لأجل طويل. ويقتبس المنظر السياسي الفرنسي ريموند آرون عندما يقول "في القرن العشرين، ستتقلص قوة الدولة الكبرى عندما تتوقف عن خدمة فكرة ما". فممارسة قيادة العالم تتطلب وضع اليد على روح العصر.فهناك عواطف موجودة في العالم التي يمكن إثارتها سياسيا يمكن أن توجه بشكل بناء أو تستعمل وتستغل من قبل المتطرفين. يجادل بريجنسكي أنه يمكن لأميركا أن تكون العامل الحاسم في توجيه هذه العواطف بأحد الاتجاهين. وبالتالي من المفيد مراجعة وتقييم أداء أميركا في الخمس عشرة سنة الأخيرة.
على الرغم من النجاحات إلا أن عدم الأمن أصبح أكثر شيوعا، وأن القدرات النووية انتشرت في أربع دول إضافية ولم يكن هناك اهتمام بالقضايا البيئية. هذه ساهم ولو جزئيا في افتقاد أميركا لمصداقيتها وشرعيتها للقيادة. وهذا بدوره قوّض من المكانة الأخلاقية لأميركا. ولو أن استطلاعا للرأي جرى على مستوى العالم في أوائل التسعينيات، لصوتت غالبية العالم لأميركا كدولة مفضلة لقيادة وتوجيه دفة الأمن الكوني. لكن لو جرى استطلاعا في عام 2006 لكانت النتيجة عكسية. ويلقي باللوم على هذه الحالة المتردية على عاتق الرؤساء الثلاثة وإن لم يكن بشكل متساو.
ويتناول بشيء من التفصيل فيما إذا كانت هناك فرصة ثانية للولايات المتحدة للعب الدور الذي عليها القيام به. الجواب هو بكل تكيد نعم والسبب في ذلك هو غياب أي قوة منافسة. فأوروبا ما زالت تفتقد الوحدة السياسية المطلوبة وتفتقد الإرادة لتصبح قوة كونية. روسيا لا تستطيع تحديد ما إذا كانت تريد أن تكون دولة ديمقراطية بالمفهوم الغربي أو دولة تسلطية أو دولة امبريالية. أما الصين فعلى الرغم من النجاحات إلا أنها لن تستطيع معالجة التناقض الناشئ من تحرر الاقتصاد والمركزية البيروقراطية لنظامها السياسي. وهي وإن بدت قوية إلا أنه لا يمكن إغفال أن اليابان تنافسها. الهند ما زال يجب عليها إثبات أنه يمكنها أن تتمكن من الحفاظ على وحدتها والديمقراطية إذا أصبح التنوع السياسي والديني والعرقي واللغوي مشحونا سياسيا.
اختلف الوضع بعد أحداث الحادي عشر إذ أصبح الشرق الأوسط المسرح المركزي للسياسة الأميركية. وهنا فرقت السياسة الأميركية أصدقاءها ووحدت أعداءها. وتم استثمار الخوف للتعبئة والحشد وتميزت بعدم الصبر الاستراتيجي وإقصاء الذات مما ضيّق من خيارات أميركا الدبلوماسية. فالصحوة الكونية الجيوبوليتكية تتمحور حول رفض القيم الامبريالية. فهذه الصحوة هي تاريخيا معادية للإمبريالية ومعادية للغرب سياسيا وعاطفيا ومعادية لأميركا.وهنا تنطلق حركة وتغير جذري في المركز العالمي للقوة. وهذا يغير من توزيع القوة على شكل كوني ما يعكس أثرا كبيرا على الدور الذي ستلعبه أميركا في العالم .
من مواضيعي
0 مقالات الطيب صالح في "المجلة" (3)
0 مقالات الطيب صالح في "المجلة" (2)
0 مقالات الطيب صالح في "المجلة" (1)
0 "أبطال يتحدون الهيمنة الأمريكية: هوغو شافيز، فيدل كاسترو وإيفو موراليس"
0 الحركات الجهادية.. كتاب جديد يسعى لتضليل الرأي العام الأمريكي
0 الفرصة الثانية: ثلاثة رؤساء وأزمة القوة الأميركية العظمى
0 مقالات الطيب صالح في "المجلة" (2)
0 مقالات الطيب صالح في "المجلة" (1)
0 "أبطال يتحدون الهيمنة الأمريكية: هوغو شافيز، فيدل كاسترو وإيفو موراليس"
0 الحركات الجهادية.. كتاب جديد يسعى لتضليل الرأي العام الأمريكي
0 الفرصة الثانية: ثلاثة رؤساء وأزمة القوة الأميركية العظمى