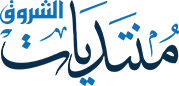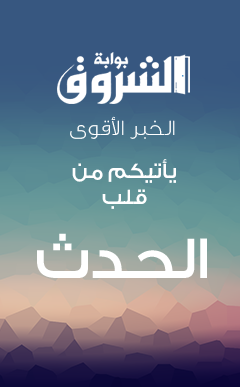من مظاهر عدالة الإسلام في قضايا المرأة
13-03-2016, 02:16 PM
من مظاهر عدالة الإسلام في قضايا المرأة
محاور المقال العلمي:
الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى، وأشهد أنه الله لا إله إلا هو له الخلق والأمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كرم المرأة، وأنقذها من ظلم الجاهلية إلى عدل الإسلام...
وبعد:
فلا يليق بقيمة المرأة ومكانتها: أن يُحتفَل بها في يوم واحد في السنة، ثم تظلم في باقي أيام العام؛ لذلك جاءت مبادئ الإسلام السامية لحفظ كرامة المرأة على الدوام.
وكلما حلَّت مناسبة اليوم العالمي للمرأة: تمَّ الاهتمام بأمر المرأة وحقوقها وواجباتها، وأثيرت جدلية قضايا المرأة بين الخصوصية والكونية... وتم تغليب المنهج الغربي المبالغ في الحرية، المصدِّر لنموذج واحد أحادي الطرح والرؤية باسم:" الحرية وحقوق المرأة!!؟": ضدًّا على خصوصيات الأمم والشعوب...
حقًّا إن ثمة قواسم مشتركة بين جميع الأمم في ضمان حقوق المرأة وكرامتها، تمامًا كأخيها الرجل فيما لا يعود على الفطرة بالهدم والمسخ... ولا سيما حينما يلتزم كل طرف بالوظائف والأدوار التي نيطت به في هذه الحياة، من واجبات وحقوق، تحقيقًا لتكامل دور النصفين:( الذكر والأنثى)، ولكن:" حينما يغرر بالمرأة، ويصور لها أنها مظلومة، وأن آية حريتها أن تتمرد على الأديان، وأن تصبح عدوة لأخيها الذكر"، فهنا يقع الجدال بين الخصوصية والكونية...
إن قضية الخصوصية هي: قضية كل أمة؛ فالأمم كلها تدافع عن هويتها واختياراتها قبل الانصهار في المبادئ الكونية التي لا تعود بالضرر على ما اقتنعت به من توجهات[1].
ومن ثم، فإن المبالغة في الحرية: تعود بالضرر على الاستقرار البشري؛ إذ لا يجوز الطعن في الدين باسم:" حرية الرأي!!؟"، ولا يجوز الانتقاص من عرض الآخرين باسم:" حرية التعبير!!؟"، ولا يجوز خدش الحياء والأخلاق باسم:" التحرر وتقليد الآخر!!؟"؛ لذلك فإن حضور التدين الصحيح، والخُلق القويم: ضروريان لحماية الفرد نفسه من المبالغة في الحرية، وعليه: فللمسلمين خصوصياتهم التي تميزهم، والتي تجعلهم في مأمن من الأخطار التي تهدد الأسرة؛ كالانحرافات الجنسية، فيتم الحفاظ على استقرار الأسرة، وضمان مقصد النسل وحماية العرض والشرف.
ومن ثم، كان لا بد من التحفظ على المبادئ الكونية التي تضاد ثوابت المسلمين، من توحيد أو عبادة، أو قضايا الأسرة التي يشرع فيها خلاف مقررات الدين القويم.
2- تكريم المرأة من خلال الخصوصيات التشريعية: (الأحوال الشخصية نموذجًا):
لقد تقرر أن ثمة قدرًا مشتركًا من التكريم العام للمرأة لا تختلف عليه الأمم الحديثة، من حيث المساواة في الحقوق الديموقراطية: السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والمشاركة الإيجابية في هموم المجتمع، ثم إن لكل أمة خصوصيات تخدم مبادئها، غير أن الخصوصيات التي تنفرد بها المرأة في التشريع الإسلامي، ولا سيما في قضايا الأسرة، تجعلها أكثر نساء العالم ضمانًا لحقوقها، كما قررها الإسلام.
فمن حيث التكريم العام هناك:
كرامة إنسانية: يشترك فيها الذكر والأنثى بوصفهما إنسانين؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾.
وهناك كرامة كسبية تبنى على العمل، لا على وصفَيِ الذكورة والأنوثة؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾، وقال أيضًا: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، وقال ثالثًا: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾.
أما على التفصيل، فنلاحظ تكريم الإسلام للمرأة في نصوص الوحي من خلال هذه الأمثلة الفريدة:
• دخولها في عموم الخطاب القرآني بـ: "يا أيها الناس" الذي يشمل الرجل والمرأة معًا.
• تقديمها في الذِّكْر على الرَّجل في مثل قوله تعالى: ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴾.
• تخصيصها بمزيد البِرِّ في مثل حديث: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مَن أحقُّ الناس بحُسن صحابتي؟ قال: ((أمك))، قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك))، قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك))، قال: ثم من؟ قال: ((ثم أبوك))؛ أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به.
• إفرادها في القرآن الكريم بسورة خاصة هي: سورة النساء، ولا توجد سورة تخص الرجال في الذِّكر الحكيم، أما ورود سورة الإنسان فيه، فيعم الذَّكَر والأنثى.
• حديث القرآن الكريم عن مختلف وظائف ووضعيات المرأة: بدأ من وظيفتها كأم إلى أرقى وظيفة في المجتمع، والتي غالبًا ما يحتكرها الرجال، وهي: كونها ملكة: إشارة إلى ما ورد في سورة النمل من أمر بلقيس ملكة سبأ.
• حديث القرآن العظيم عن المرأة ورفعها إلى مصاف الرجال من خلال ذكر آسية زوج فرعون التي صبرت على مغريات القصر، واختارت ما عند الله من ثواب، ومن خلال نموذج مريم ابنة عمران التي تبوأت مكانة القانتين فوق رتبة القانتات.
• حماية حق المرأة في الحياة من خلال تحريم الوأد الذي كان شائعًا في الجاهلية.
شبهات وردود:
وعند تركيزنا على مظاهر تكريم المرأة من خلال قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، فإننا لا بد أن نرد على الشبهات التالية:
أ- شبهةالقوامة:
لقد أساء البعض فهم القوامة الواردة في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾، فحملوها على معاني التسلط والتحكم والاستبداد، غير أن معناها الحقيقي هو: الإشراف والتنظيم والتوجيه؛ فالأسرة في الإسلام تقوم على التعاون بين الزوجين، فيكمل كل منهما الآخر، كل حسب طبيعته واختصاصاته، فمعنى القوامة معنى شوري، وليس استبدادًا؛ فشأن الزوج في أسرته كالمدير في الإدارة، والرئيس مع مرؤوسيه، فكما أنَّ جَعْلَ الموظف مديرًا أو رئيسًا دون باقي الموظفين: لا ينقص من شأنهم، فكذلك أمرُ جَعْلِ الرجل قوَّامًا ومديرًا للأسرة: لا ينقص من شأن المرأة شيئًا؛ فطاعة المرأة لزوجها من قبيل طاعة الموظف لمديره ورئيسه فيما يرضي الله، و:" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وإنما أعطيَ الزوج حق إدارة الأسرة والإشراف دون الزوجة؛ لكونه يتحمل تبعات الصداق والنفقة والكد من أجل الكسب وحماية الأسرة، (زوجة وأولاد)، ولأن تكوينه الجسمي يُطيق ذلك، كما أنه يحكِّم عقله في عظام الأمور، ولا يتسرع في اتخاذ القرارات بخلاف المرأة؛ فإن العاطفة تحكُمها في الغالب، لا سيما وأنها تتعرض لكثير من التقلبات والاضطرابات الناتجة عن الحيض والحمل والوضع والرضاع واليأس من المحيض؛ ولأجل ذلك كله: كان من مصلحة الأسرة أن تجعل قيادها في يد من لا تعتريه هذه الاضطرابات.
هكذا ينبغي أن تفهم معنى القوامة، لا كما فهمها بعض الأزواج نتيجة الجهل بالدين، فتسلطوا على زوجاتهم، فضربوهن وظلموهن، والعيب هنا: يتحمله الزوج الظالم، والعُرف الفاسد، لا الشرع العادل، فشتان ما بين عدل الإسلام في قضية المرأة، وظلم الإنسان فيها.
بقضية تعدد الزوجات:
كثيرًا ما تثار قضايا هامشية: لصرف النظر عن القضايا الأساسية التي تستدعي النقاش والحل، من ذلك إكثار الكلام عن قضية رفع سن الزواج إلى ما فوق 18 سنة، وإثارتهم من حين لحين قضية تعدد الزوجات، ويزعمون أن في ذلك ظلمًا للمرأة!!؟.
وفي الحالتين معًا: يتم صرف النظر عن مناقشة القضايا ذات الأولوية الملحة؛ كعزوف الشباب عن الزواج، وما ترتب على ذلك من أضرار العزوبة ومخاطر العنوسة، وما رافق ذلك من تفشي ظواهر مخلة بالعفة والحياء، أخطرها: شيوع الزنا واللواط!!؟.
فالملاحظ في الواقع: أن قطار الزواج أصبح يفوت شبابنا وشاباتنا، قبل سن الثامنة عشرة وبعدها، أما حالات التعدد في المجتمع، فهي نادرة، ولا تتجاوز 1% حسب الدراسات المنجزة.
ثم إن التعدد ليس أصلًا ولا فرضًا في الإسلام، وإنما هو: حالة استثنائية يلجأ إليها عند الضرورة: لوجود ظروفها فقط، فهي من قبيل المباح الذي يتساوى فيه الفعل والترك، وقد يكون من الضرورة التي تقدر بقدرها، وآخر الدواء الكي، وقد لا يجوز في حالات بعينها؛ لتخلُّف شروطه؛ كانعدام العدل بين الزوجات مثلًا، بل قد يمنع الشخص من زواج المرأة الواحدة إذا كان ظالما في الحقوق؛ ولذلك ورد التعبير في المدونة بالقول: "الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعًا".
وفي إطار ذلك: ينبغي فهم قوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾؛ فالتعدُّد هنا قُيِّد بالعدل: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾.
ومِن شُبَههم: أن الإسلام اشترط العدل، والعدل مستحيل، بدليل القرآن نفسه، فهم يحتجون زورًا على منع التعدد بالقرآن نفسه في قوله سبحانه: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾.
ورد هذه الشبهة يسير غير عسير: ذلك أنهم لا يميزون بين العدل المادي الذي هو: النفقة والمبيت، وهو مقدور، وهو: المقصود بالعدل الأول، وهناك العدل المعنوي المعبر عنه بالميل القلبي، وعبر عنه بـ: "كل الميل" معناه: أن بعضه جائز، بحكم أن الإنسان لا يستطيع أن يساوي بين زوجاته في الحب والمشاعر، فبحكم الفطرة قد يميل إلى هذه أكثر من هذه...، فالعدل الأول هو المطلوب، وهو المقدور، والعدل الثاني يتعلق بالمشاعر والعواطف، يسدِّد فيه الزوج ويقارب، وبه تتعلق الآية موضوع شُبهتهم.
ثم إن حِكم التعدد بعد ذلك كله كثيرة متعددة، وأمثلتها منطقية معبرة، منها على سبيل المثال:
• وجود ظروف خاصة بين الزوجين، تتعلق بالرغبة الجنسية، والعقم مثلًا...
• كثرة النساء وقلة الرجال؛ فالفائض يستدعي التعدد.
وسنَّة التكاثر في الكون تقرر دائمًا بأن الإناث: أكثر من الذكور، والحكمة كثرة الحروب، ووجود الرجل غالبًا في مواقع الخطر التي تعجِّل بحتفه، كما أن الرجل يخصب أكثر من أنثى، والأنثى لا تخصب من ذكَرين.
بذلك كان الشرع حكيمًا لَمَّا أباح التعدد للرجل، ولم يبحه للمرأة؛ لأن ذلك زنًا، ولا يجتمع رجلان على بُضْعٍ واحد.
فحال المرأة الأولى في التعدد لا يخلو من واحد من خيارين في الحلال، دون اللجوء إلى الثالث المرفوع، وهو: الزنا الحرام:
الخيار الأول: أن تختار الطلاق لتعيش حياتها بعد ذلك في الكبت والحرمان إذا لم يكتب لها الزواج بعد ذلك؛ لقلة فرص زواج المطلقات بحكم العُرف القاسي.
الخيار الثاني: أن تشارك الزوجة الثانية في رجل عادل يحميها ويصونها.
فلا شك أن هذا الخيار أولى وأحسن؛ لتحقيقه مقاصد الزوجين، ومقاصد الأسرة كلها.
كما أن منع تعدد الحليلات: قد يؤدي حتمًا إلى تعدُّد الخليلات!!؟، كما هو واضح في سلوك المجتمع الغربي الذي تأثر به عدد غير قليل من أبناء المجتمع العربي الإسلامي مع الأسف الشديد... الأمر الذي دفع امرأة ألمانية إلى البوح بالحقيقة المرة التي يجادلون فيها، قالت:
" لأن أكون شريكة لرجل مع عشرة نسوة (الزواج)، خير من أن أكون له وحدي، والخليلات فوق المائة".
هذه هي: حكمة الإسلام التي تقي المجتمع قبل أن يستفحل الداء، ويستعصي الدواء، فتقينا عناء الدخول في التجربة المرة، وتلك لعمري هي: عناصر الإصلاح الكبرى التي يتعين الأخذ بها عند وجود أسبابها: حماية لمؤسسة الأسرة، وضمانًا لحقوق أفرادها.
ت- قضية الطلاق:
بداية نقول: إن الطلاق استثناء، لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، على قاعدة:" آخر الدواء الكي"، وبتتبع آيات سورة النساء نجد الإسلام يقترح حلولًا عملية قبل تطبيق أبغض الحلال، ألا وهي:
• الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب غير المبرِّح، فإن أثمرت هذه الإجراءات طاعة واستجابة: فلا تفريط في المرأة وحقوقها؛ قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾، والمقصود بالضرب في الآية: التهديد، وليس الإيجاع والإيلام، أسوة بالرسول عليه السلام الذي لم يضرب زوجاته رضي الله عنهن.
• تحكيم الحكَمين من أهل الزوجين: قَصْدَ الصلح؛ حرصًا على استقرار الأسرة.
• إذا لم تنفع كل هذه الحلول، واستحالت الحياة إلى جحيم لا يطاق: يتم اللجوء إلى الطلاق من باب:" آخر الدواء الكي"، والطلاق بأنواعه يعطي مهلة للتفكير؛ لتعود الحياة إلى حالتها الطبيعية: إذا استفاد الزوجان من أخطائهما.
ورغم وضوح هذه الحجج: يصرُّ أصحاب الشُّبه على التغرير بالمرأة؛ لتتمرد على الإسلام، فيقولون لها:" إن الإسلام جعل الانفصال بينك وبين زوجك بكلمة واحدة عابرة".
وقد رد عليهم الشيخ:" الشعراوي" رحمه الله قائلًا:
" كيف نسيتم كلمة التلاقي، ووقفتم عند كلمة الفِراق!!؟، ألم يكن الزواج بكلمة واحدة؟!، ثم نقول لهم: انطلاقًا مما سبق: الطلاق ليس مجرد كلمة، بل هو كلمات: والطلاق أنواع، وعلى فرض كونه كلمة، فإن المرأة تعرف أن الشريعة تحتاط كثيرًا في أن تضع هذه الكلمة في يد أمين عليها، وذلك هو الرجل الذي يخاف ربه، ويراقبه في كل أموره، فتحتاط هي أيضًا، فتختار الزوج حسب مقاييس الإسلام: "ذو الدين، وذات الدين". انتهى كلامه.
ولما تزوج الناس على غير مقياس الإسلام، وبنَوا حياتهم بعد الزواج بعيدًا عن هَدْيِ الإسلام: كثرت حالات الطلاق في محاكمنا، والعيب عيب الإنسان البعيدِ عن الله.
إن الواقع الغربي أصبح ينحو نحو استيراد حل: "الطلاق" أمام تعدُّد الخليلات، وكثرة النزاعات!!؟...
كما أن الشرع أعطى للمرأة حق طلب الطلاق:(الخلع) إذا تضررت، أضف إلى ذلك حالات التطليق من طرف القاضي للغيبة والنفقة والضرر، والشقاق، والحاجة الإصلاحية تقتضي تقوية الإيمان، واستحضار يوم الحساب، والعودة إلى تشريع القرآن والسنَّة العادلين.
ثالثًا: التمييز الإيجابي في قضية إرث المرأة في الإسلام:
لقد كرم الإسلام المرأة، وضمن لها حقوقها، بل حاباها وأحسن إليها أكثر مما أحسن إلى الرجل: مراعاةً لتكوينها وطبيعتها ووظيفتها...
إن مَن تأمل نصوص القرآن والسنة: يجدها قد رفعت من شأن المرأة:( أمًّا كانت أو زوجة أو بنتًا)، بل عدلت في قضيتها إلى درجة فوق المساواة، وهي: درجة التمييز الإيجابي لصالحها.
إن هذا التمييز الإيجابي لصالح المرأة: يظهر بحق في بعض القضايا التي تثار من حين لحين، ويدعى أن الإسلام قد ظلم المرأة فيها، ولعل أبرزها:" قضية الإرث": التي يراد أن يجعل منها نقطة خصام بين المرأة والرجل الذي يحميها، وبينها وبين الإسلام الذي يكرمها!!؟، وهي:( دعوى لا يراد منها إلا الباطل) الذي هو: المطالبة بتغيير شرع الله في قضايا الأسرة القطعية الثبوت والدلالة، وقد صرح دهاقنتهم بوجوب:" إلغاء قانون الأسرة!!؟".
إن:" شعار المساواة": الذي ينادى به في قضايا المرأة: ليس بريئًا ولا عادلًا في كثير من الأحيان؛ إذ لو كان كذلك: لتم النداء بالمساواة بشكل شمولي يغطي:( قضايا تقديم المهر، والمساواة في النفقة، وفي الحضانة، وشروط وظروف العمل)، فلماذا يتحمل الرجل وحده أعباء تقديم المهر والنفقة وغيرها من الأعباء، ولا يطالب في ذلك بالمساواة!!؟".
إن:" قضية المساواة": قد تضرُّ بالمرأة في أكثر الأحيان؛ ولذلك عدل الإسلام، بل أحسن حينما ميَّزها إيجابيًّا في قضايا الميراث الذي حال الجهلُ المركَّبُ بأحكامه دون فقهها وفهمها.
فقضية إرث المرأة في الإسلام: أعدل من عادلة، وحاشا أن يظلم الشرع فيها: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾؛ لذلك لم يقبل الله العادل المحسن المتفضل: أن يجعل أمر تقسيم التركة لنبي مرسَل، ولا لملَك مقرَّب: دفعًا للظلم البشري في توزيع أموال الميت، فتولى سبحانه بنفسه أمر توزيع الميراث، فخصص لذلك آيات محكمات، قطعية الثبوت والدلالة، في سورة سماها بسورة النساء: تشريفًا للمرأة وتكريمًا لها.
إن مَن يروج لشبهة ظلم الإسلام للمرأة في قضايا الإرث: لا يركز في الغالب إلا على حالة واحدة، وهي: الحالة التي تطبق فيها قاعدة: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾، ويغض الطرف عن الحالات الكثيرة التي ترث فيها المرأة مثل الرجل، أو التي ترث فيها أكثر منه، والتي قد ترث فيها ولا يرث هو؛ إذ النظرة المنصفة الشاملة: تقتضي توضيح تلكم الحالات كما يلي:
1- فمن الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل:( حالة الأب والأم عند وجود الابن)، و:(أحوال الإخوة والأخوات لأم، حيث يستوي الذكور والإناث في الميراث....).
2- ومن الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:( حالة الزوج مع ابنته الوحيدة، أو مع ابنتيه....).
3- ومن الحالات التي ترث فيها، ولا يرث لو وُجد مكانها:( حالة وجود الزوج والأخت الشقيقة والأخت لأب، فللزوج النصف، وللأخت نصفها)، وبما أن الأخت لأب في هذه الحالة: لا يمكن أن تحرم؛ لأن نصيبها هنا محدد بالسدس، فيعاد ترتيب التركة، وتقسم على سبعة أجزاء، للزوج ثلاثة، وللأخت الشقيقة ثلاثة، وللأخت لأب واحد، ففي هذه الحالة لو كان الأخ لأب مكان أخته لا يرث شيئا؛ لأنه عاصب، ولم يبقَ شيء من التركة.
4- تبقى الحالة التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل، وهي: حالة محدودة لا تتجاوز أربع وضعيات:
أ- البنت مع إخوانها الذكور، وحالة بنت الابن مع ابن الابن...
ب- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور.
ج- الأخت لأب مع إخوانها الذكور.
د- الأب والأم، حيث لا يوجد أولاد، ولا زوج أو زوجة..
إذًا فالواقع العملي يرد بقوة على شبهة ظلم المرأة في قضية الإرث؛ لأنه يفيد: أن الحالات التي يفضل الرجل المرأة في الإرث لا تتجاوز في مجموعها:( 16.33 % من أحوال الإرث كلها)، وفي باقي الحالات كما رأينا: قد تتساوى المرأة مع الرجل، وقد تفضله، وقد ترث هي ويحرم هو".
لذلك بطَلت الدعوى، واتضح الصبح لذي عينين، فبطلت شبه المغرضين؛ فهي:( ترث بالنصف، وبالثلثين، وترث بالربع وبالثمن كزوجة، وترث بالسدس والثلث كأم...)، إنها صور متعددة لإرث المرأة، فهي يصِلها رزقها حسب ما قدر الله لها، ولن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، شأنها شأن الرجل في ذلك، بل وأفضل:﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾..
ثم ماذا بعد!!؟:
إن المعيار في تقسيم التركة لا يخضع للنوع، وإنما رُوعي في مقاصد توزيعه الشرعية:
1- درجة القرابة بين الوارث والموروث: فالبنت ترث أكثر من أبيها إذا ماتت أمها؛ لقربها...
2- موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة والأعباء يكون نصيبها أكثر...
3-العبء المالي: وهو المعيار الوحيد الذي يظهر التفاوت في قاعدة: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾.
وهو تفاوت ينصف المرأة ولا يظلمها...كيف ذلك!!؟:
إن المرأة رابحة حتى في هذه القاعدة، فهي حينما تجتمع مع أخيها ستستأثر بنصيبها، وتزيد عليه الصداق، وتعفى من النفقة:( أمًّا وبنتًا وأختًا وزوجة)، أما أخوها، فسيتزوج بنصف حظه، وينفق حظه الثاني، ثم يستمر في رحلة الكدح والعمل: ضمانًا لعيش الزوجة والعيال.
فمن الرابح إذًا، ومن الخاسر في القضية!!؟:
إن المرأة رابحة في جميع الأحوال، وإنما كرمها الإسلام، وميزها تمييزًا إيجابيًّا بعد أن كانت:" تورث ولا ترث!!؟"؛ حتى لا تلجأ لاستعمال أنوثتها كسلاح في الحياة إذا لم تجد ما تأكله، فتخسر بذلك رأس مالها، وأغلى ما عندها، وهو:" عرضها وشرفها وعفتها"؛ فإن:" الحرة تموت، ولا تأكل بثدييها".
وإذا تبين عدل الإسلام وإحسانه في هذه القضية، فليتقِ اللهَ كل مسلم ومسلمة، وليتمسك بتعاليم دينه، وخصوصية مجتمعه وأمته.
وصدق الله رب العالمين لما قال في محكم التنزيل: ﴿ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾، ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾، ﴿ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾.
والذي ينبغي أن يتوجه الإصلاح إليه لإنصاف المرأة: أن تعطى لها حقوقها كما ضمنها لها الشرع، وهي: كافية كما تقرر، لا أن تضاد أحكام الشرع بزعم الدفاع عن حقوق المرأة!!؟، فلا بد من وضع حد للعُرف الفاسد الذي لا زال يورث الرجل ولا يورث المرأة!!؟.
إن:" ظاهرة الانفراد بأكل أموال الورثة التي كانت سائدة في الجاهلية": يوم كانت المرأة تحرم من الميراث، عاد بعض الناس - مع الأسف - في واقعنا إلى أمر الجاهلية الأولى، فمنعوا النساء من الإرث، ففي بعض بوادينا، بل حتى في مدننا، لا زال الذكور ينفردون بتركة الميت دون أخواتهم الإناث، وهذا عرف فاسد وظلم: لا يقبله الشرع بحال من الأحوال في جميع أنواع الأموال ؛ لأن القرآن الكريم قسم وقرر: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ * وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا * وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾، والمقصود بالتراث في الآية: خصوص أكل أموال التركة بعد موت الميت دون إيصالها إلى أهلها: عطفًا على التحذير من البخل وأكل أموال اليتامى، وهذا هو رأي أغلب المفسرين.. وإن كان المقصود بالتراث عمومًا هو: أكل كل مال حرام.
فليس يحق لأي كان: أن يمنع المرأة من حظها في الإرث، ومن فعل ذلك ولم يتب بالتحلل من المظالم، وذلك بإرجاع الحقوق إلى أهلها، أو إلى ورثتهم عند هلاكهم، فسيحاسب يوم القيامة، ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾، يومئذ تقول نادمًا متحسِّرًا، ولا ينفعك الندم والحسرة: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾، وتتذكر... وأنى لك الذكرى!!؟، فالآخرة دار جزاء ولا عمل، فخذ من دنياك لآخرتك، فأبصر وتذكر قول ربك يا من تظلم النساء في الإرث: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ﴾، وقد ختم الله آيات الإرث بالقول: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾، إنه:" العدوان على أموال الغير!!؟".
وهكذا تعلمون - إخوة الإيمان - أن المشكلة ليست في:" نصوص الوحي المعصومة": التي قررت حقوق الذَّكر والأنثى في الإرث بعدل وإحسان، ولا في اجتهادات المدونة المبنية على الشرع، ولكن المشكلة كل المشكلة في التطبيق، وفي ظلم الإنسان للمرأة، فلا يريد إيصال الحقوق إليها، فثمة فرق بين عدل الإسلام في المبادئ، وظلم الإنسان في الفعل والتطبيق... فهذا الذي يجب: أن تتوجه إليه المطالبة، ويركز عليه الإصلاح، وليست المطالبة بتغيير شرع الله في الإرث..
إن قضايا الإسلام التشريعية: رابحة بمنطق الحياتين الدنيا والآخرة.. ومبادئه السامية تضمن السعادتين: سعادة العاجلة والآجلة، ولكن مع الأسف!!؟: وضعت هذه القضايا الرابحة ذات الحجج القوية الدامغة في:" أيدي محامين فاشلين!!؟": لم يعرفوا كيفية إظهار هذه الحجج في السلوك والفعل!!؟.... هذا هو مثلنا مع الإسلام في شتى مناحي الحياة:( نشوهه بأفعالنا، ونروج لعقلية الظلم والخرافة، ثم ننسب ظلمنا إليه)، وهو:" بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام".
نسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى: أن يرد المسلمين إلى دينه الحق ردا جميلا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
منقول بتصرف يسير.
جزى الله راقمه خيرا.
محاور المقال العلمي:
1- جدلية الخصوصية والكونية في قضايا الأسرة والمرأة.
2- تكريم المرأة من خلال الخصوصيات التشريعية: "نماذج عادلة".
3- التمييز الإيجابي لفائدة المرأة في: "قضية الإرث: نموذج الإحسان الذي تجاوز العدل".
1- جدلية الخصوصية والكونية في قضايا الأسرة والمرأة:الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى، وأشهد أنه الله لا إله إلا هو له الخلق والأمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كرم المرأة، وأنقذها من ظلم الجاهلية إلى عدل الإسلام...
وبعد:
فلا يليق بقيمة المرأة ومكانتها: أن يُحتفَل بها في يوم واحد في السنة، ثم تظلم في باقي أيام العام؛ لذلك جاءت مبادئ الإسلام السامية لحفظ كرامة المرأة على الدوام.
وكلما حلَّت مناسبة اليوم العالمي للمرأة: تمَّ الاهتمام بأمر المرأة وحقوقها وواجباتها، وأثيرت جدلية قضايا المرأة بين الخصوصية والكونية... وتم تغليب المنهج الغربي المبالغ في الحرية، المصدِّر لنموذج واحد أحادي الطرح والرؤية باسم:" الحرية وحقوق المرأة!!؟": ضدًّا على خصوصيات الأمم والشعوب...
حقًّا إن ثمة قواسم مشتركة بين جميع الأمم في ضمان حقوق المرأة وكرامتها، تمامًا كأخيها الرجل فيما لا يعود على الفطرة بالهدم والمسخ... ولا سيما حينما يلتزم كل طرف بالوظائف والأدوار التي نيطت به في هذه الحياة، من واجبات وحقوق، تحقيقًا لتكامل دور النصفين:( الذكر والأنثى)، ولكن:" حينما يغرر بالمرأة، ويصور لها أنها مظلومة، وأن آية حريتها أن تتمرد على الأديان، وأن تصبح عدوة لأخيها الذكر"، فهنا يقع الجدال بين الخصوصية والكونية...
إن قضية الخصوصية هي: قضية كل أمة؛ فالأمم كلها تدافع عن هويتها واختياراتها قبل الانصهار في المبادئ الكونية التي لا تعود بالضرر على ما اقتنعت به من توجهات[1].
ومن ثم، فإن المبالغة في الحرية: تعود بالضرر على الاستقرار البشري؛ إذ لا يجوز الطعن في الدين باسم:" حرية الرأي!!؟"، ولا يجوز الانتقاص من عرض الآخرين باسم:" حرية التعبير!!؟"، ولا يجوز خدش الحياء والأخلاق باسم:" التحرر وتقليد الآخر!!؟"؛ لذلك فإن حضور التدين الصحيح، والخُلق القويم: ضروريان لحماية الفرد نفسه من المبالغة في الحرية، وعليه: فللمسلمين خصوصياتهم التي تميزهم، والتي تجعلهم في مأمن من الأخطار التي تهدد الأسرة؛ كالانحرافات الجنسية، فيتم الحفاظ على استقرار الأسرة، وضمان مقصد النسل وحماية العرض والشرف.
ومن ثم، كان لا بد من التحفظ على المبادئ الكونية التي تضاد ثوابت المسلمين، من توحيد أو عبادة، أو قضايا الأسرة التي يشرع فيها خلاف مقررات الدين القويم.
2- تكريم المرأة من خلال الخصوصيات التشريعية: (الأحوال الشخصية نموذجًا):
لقد تقرر أن ثمة قدرًا مشتركًا من التكريم العام للمرأة لا تختلف عليه الأمم الحديثة، من حيث المساواة في الحقوق الديموقراطية: السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والمشاركة الإيجابية في هموم المجتمع، ثم إن لكل أمة خصوصيات تخدم مبادئها، غير أن الخصوصيات التي تنفرد بها المرأة في التشريع الإسلامي، ولا سيما في قضايا الأسرة، تجعلها أكثر نساء العالم ضمانًا لحقوقها، كما قررها الإسلام.
فمن حيث التكريم العام هناك:
كرامة إنسانية: يشترك فيها الذكر والأنثى بوصفهما إنسانين؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾.
وهناك كرامة كسبية تبنى على العمل، لا على وصفَيِ الذكورة والأنوثة؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾، وقال أيضًا: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، وقال ثالثًا: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾.
أما على التفصيل، فنلاحظ تكريم الإسلام للمرأة في نصوص الوحي من خلال هذه الأمثلة الفريدة:
• دخولها في عموم الخطاب القرآني بـ: "يا أيها الناس" الذي يشمل الرجل والمرأة معًا.
• تقديمها في الذِّكْر على الرَّجل في مثل قوله تعالى: ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴾.
• تخصيصها بمزيد البِرِّ في مثل حديث: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مَن أحقُّ الناس بحُسن صحابتي؟ قال: ((أمك))، قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك))، قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك))، قال: ثم من؟ قال: ((ثم أبوك))؛ أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به.
• إفرادها في القرآن الكريم بسورة خاصة هي: سورة النساء، ولا توجد سورة تخص الرجال في الذِّكر الحكيم، أما ورود سورة الإنسان فيه، فيعم الذَّكَر والأنثى.
• حديث القرآن الكريم عن مختلف وظائف ووضعيات المرأة: بدأ من وظيفتها كأم إلى أرقى وظيفة في المجتمع، والتي غالبًا ما يحتكرها الرجال، وهي: كونها ملكة: إشارة إلى ما ورد في سورة النمل من أمر بلقيس ملكة سبأ.
• حديث القرآن العظيم عن المرأة ورفعها إلى مصاف الرجال من خلال ذكر آسية زوج فرعون التي صبرت على مغريات القصر، واختارت ما عند الله من ثواب، ومن خلال نموذج مريم ابنة عمران التي تبوأت مكانة القانتين فوق رتبة القانتات.
• حماية حق المرأة في الحياة من خلال تحريم الوأد الذي كان شائعًا في الجاهلية.
شبهات وردود:
وعند تركيزنا على مظاهر تكريم المرأة من خلال قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، فإننا لا بد أن نرد على الشبهات التالية:
أ- شبهةالقوامة:
لقد أساء البعض فهم القوامة الواردة في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾، فحملوها على معاني التسلط والتحكم والاستبداد، غير أن معناها الحقيقي هو: الإشراف والتنظيم والتوجيه؛ فالأسرة في الإسلام تقوم على التعاون بين الزوجين، فيكمل كل منهما الآخر، كل حسب طبيعته واختصاصاته، فمعنى القوامة معنى شوري، وليس استبدادًا؛ فشأن الزوج في أسرته كالمدير في الإدارة، والرئيس مع مرؤوسيه، فكما أنَّ جَعْلَ الموظف مديرًا أو رئيسًا دون باقي الموظفين: لا ينقص من شأنهم، فكذلك أمرُ جَعْلِ الرجل قوَّامًا ومديرًا للأسرة: لا ينقص من شأن المرأة شيئًا؛ فطاعة المرأة لزوجها من قبيل طاعة الموظف لمديره ورئيسه فيما يرضي الله، و:" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وإنما أعطيَ الزوج حق إدارة الأسرة والإشراف دون الزوجة؛ لكونه يتحمل تبعات الصداق والنفقة والكد من أجل الكسب وحماية الأسرة، (زوجة وأولاد)، ولأن تكوينه الجسمي يُطيق ذلك، كما أنه يحكِّم عقله في عظام الأمور، ولا يتسرع في اتخاذ القرارات بخلاف المرأة؛ فإن العاطفة تحكُمها في الغالب، لا سيما وأنها تتعرض لكثير من التقلبات والاضطرابات الناتجة عن الحيض والحمل والوضع والرضاع واليأس من المحيض؛ ولأجل ذلك كله: كان من مصلحة الأسرة أن تجعل قيادها في يد من لا تعتريه هذه الاضطرابات.
هكذا ينبغي أن تفهم معنى القوامة، لا كما فهمها بعض الأزواج نتيجة الجهل بالدين، فتسلطوا على زوجاتهم، فضربوهن وظلموهن، والعيب هنا: يتحمله الزوج الظالم، والعُرف الفاسد، لا الشرع العادل، فشتان ما بين عدل الإسلام في قضية المرأة، وظلم الإنسان فيها.
بقضية تعدد الزوجات:
كثيرًا ما تثار قضايا هامشية: لصرف النظر عن القضايا الأساسية التي تستدعي النقاش والحل، من ذلك إكثار الكلام عن قضية رفع سن الزواج إلى ما فوق 18 سنة، وإثارتهم من حين لحين قضية تعدد الزوجات، ويزعمون أن في ذلك ظلمًا للمرأة!!؟.
وفي الحالتين معًا: يتم صرف النظر عن مناقشة القضايا ذات الأولوية الملحة؛ كعزوف الشباب عن الزواج، وما ترتب على ذلك من أضرار العزوبة ومخاطر العنوسة، وما رافق ذلك من تفشي ظواهر مخلة بالعفة والحياء، أخطرها: شيوع الزنا واللواط!!؟.
فالملاحظ في الواقع: أن قطار الزواج أصبح يفوت شبابنا وشاباتنا، قبل سن الثامنة عشرة وبعدها، أما حالات التعدد في المجتمع، فهي نادرة، ولا تتجاوز 1% حسب الدراسات المنجزة.
ثم إن التعدد ليس أصلًا ولا فرضًا في الإسلام، وإنما هو: حالة استثنائية يلجأ إليها عند الضرورة: لوجود ظروفها فقط، فهي من قبيل المباح الذي يتساوى فيه الفعل والترك، وقد يكون من الضرورة التي تقدر بقدرها، وآخر الدواء الكي، وقد لا يجوز في حالات بعينها؛ لتخلُّف شروطه؛ كانعدام العدل بين الزوجات مثلًا، بل قد يمنع الشخص من زواج المرأة الواحدة إذا كان ظالما في الحقوق؛ ولذلك ورد التعبير في المدونة بالقول: "الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعًا".
وفي إطار ذلك: ينبغي فهم قوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾؛ فالتعدُّد هنا قُيِّد بالعدل: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾.
ومِن شُبَههم: أن الإسلام اشترط العدل، والعدل مستحيل، بدليل القرآن نفسه، فهم يحتجون زورًا على منع التعدد بالقرآن نفسه في قوله سبحانه: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾.
ورد هذه الشبهة يسير غير عسير: ذلك أنهم لا يميزون بين العدل المادي الذي هو: النفقة والمبيت، وهو مقدور، وهو: المقصود بالعدل الأول، وهناك العدل المعنوي المعبر عنه بالميل القلبي، وعبر عنه بـ: "كل الميل" معناه: أن بعضه جائز، بحكم أن الإنسان لا يستطيع أن يساوي بين زوجاته في الحب والمشاعر، فبحكم الفطرة قد يميل إلى هذه أكثر من هذه...، فالعدل الأول هو المطلوب، وهو المقدور، والعدل الثاني يتعلق بالمشاعر والعواطف، يسدِّد فيه الزوج ويقارب، وبه تتعلق الآية موضوع شُبهتهم.
ثم إن حِكم التعدد بعد ذلك كله كثيرة متعددة، وأمثلتها منطقية معبرة، منها على سبيل المثال:
• وجود ظروف خاصة بين الزوجين، تتعلق بالرغبة الجنسية، والعقم مثلًا...
• كثرة النساء وقلة الرجال؛ فالفائض يستدعي التعدد.
وسنَّة التكاثر في الكون تقرر دائمًا بأن الإناث: أكثر من الذكور، والحكمة كثرة الحروب، ووجود الرجل غالبًا في مواقع الخطر التي تعجِّل بحتفه، كما أن الرجل يخصب أكثر من أنثى، والأنثى لا تخصب من ذكَرين.
بذلك كان الشرع حكيمًا لَمَّا أباح التعدد للرجل، ولم يبحه للمرأة؛ لأن ذلك زنًا، ولا يجتمع رجلان على بُضْعٍ واحد.
فحال المرأة الأولى في التعدد لا يخلو من واحد من خيارين في الحلال، دون اللجوء إلى الثالث المرفوع، وهو: الزنا الحرام:
الخيار الأول: أن تختار الطلاق لتعيش حياتها بعد ذلك في الكبت والحرمان إذا لم يكتب لها الزواج بعد ذلك؛ لقلة فرص زواج المطلقات بحكم العُرف القاسي.
الخيار الثاني: أن تشارك الزوجة الثانية في رجل عادل يحميها ويصونها.
فلا شك أن هذا الخيار أولى وأحسن؛ لتحقيقه مقاصد الزوجين، ومقاصد الأسرة كلها.
كما أن منع تعدد الحليلات: قد يؤدي حتمًا إلى تعدُّد الخليلات!!؟، كما هو واضح في سلوك المجتمع الغربي الذي تأثر به عدد غير قليل من أبناء المجتمع العربي الإسلامي مع الأسف الشديد... الأمر الذي دفع امرأة ألمانية إلى البوح بالحقيقة المرة التي يجادلون فيها، قالت:
" لأن أكون شريكة لرجل مع عشرة نسوة (الزواج)، خير من أن أكون له وحدي، والخليلات فوق المائة".
هذه هي: حكمة الإسلام التي تقي المجتمع قبل أن يستفحل الداء، ويستعصي الدواء، فتقينا عناء الدخول في التجربة المرة، وتلك لعمري هي: عناصر الإصلاح الكبرى التي يتعين الأخذ بها عند وجود أسبابها: حماية لمؤسسة الأسرة، وضمانًا لحقوق أفرادها.
ت- قضية الطلاق:
بداية نقول: إن الطلاق استثناء، لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، على قاعدة:" آخر الدواء الكي"، وبتتبع آيات سورة النساء نجد الإسلام يقترح حلولًا عملية قبل تطبيق أبغض الحلال، ألا وهي:
• الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب غير المبرِّح، فإن أثمرت هذه الإجراءات طاعة واستجابة: فلا تفريط في المرأة وحقوقها؛ قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾، والمقصود بالضرب في الآية: التهديد، وليس الإيجاع والإيلام، أسوة بالرسول عليه السلام الذي لم يضرب زوجاته رضي الله عنهن.
• تحكيم الحكَمين من أهل الزوجين: قَصْدَ الصلح؛ حرصًا على استقرار الأسرة.
• إذا لم تنفع كل هذه الحلول، واستحالت الحياة إلى جحيم لا يطاق: يتم اللجوء إلى الطلاق من باب:" آخر الدواء الكي"، والطلاق بأنواعه يعطي مهلة للتفكير؛ لتعود الحياة إلى حالتها الطبيعية: إذا استفاد الزوجان من أخطائهما.
ورغم وضوح هذه الحجج: يصرُّ أصحاب الشُّبه على التغرير بالمرأة؛ لتتمرد على الإسلام، فيقولون لها:" إن الإسلام جعل الانفصال بينك وبين زوجك بكلمة واحدة عابرة".
وقد رد عليهم الشيخ:" الشعراوي" رحمه الله قائلًا:
" كيف نسيتم كلمة التلاقي، ووقفتم عند كلمة الفِراق!!؟، ألم يكن الزواج بكلمة واحدة؟!، ثم نقول لهم: انطلاقًا مما سبق: الطلاق ليس مجرد كلمة، بل هو كلمات: والطلاق أنواع، وعلى فرض كونه كلمة، فإن المرأة تعرف أن الشريعة تحتاط كثيرًا في أن تضع هذه الكلمة في يد أمين عليها، وذلك هو الرجل الذي يخاف ربه، ويراقبه في كل أموره، فتحتاط هي أيضًا، فتختار الزوج حسب مقاييس الإسلام: "ذو الدين، وذات الدين". انتهى كلامه.
ولما تزوج الناس على غير مقياس الإسلام، وبنَوا حياتهم بعد الزواج بعيدًا عن هَدْيِ الإسلام: كثرت حالات الطلاق في محاكمنا، والعيب عيب الإنسان البعيدِ عن الله.
إن الواقع الغربي أصبح ينحو نحو استيراد حل: "الطلاق" أمام تعدُّد الخليلات، وكثرة النزاعات!!؟...
كما أن الشرع أعطى للمرأة حق طلب الطلاق:(الخلع) إذا تضررت، أضف إلى ذلك حالات التطليق من طرف القاضي للغيبة والنفقة والضرر، والشقاق، والحاجة الإصلاحية تقتضي تقوية الإيمان، واستحضار يوم الحساب، والعودة إلى تشريع القرآن والسنَّة العادلين.
ثالثًا: التمييز الإيجابي في قضية إرث المرأة في الإسلام:
لقد كرم الإسلام المرأة، وضمن لها حقوقها، بل حاباها وأحسن إليها أكثر مما أحسن إلى الرجل: مراعاةً لتكوينها وطبيعتها ووظيفتها...
إن مَن تأمل نصوص القرآن والسنة: يجدها قد رفعت من شأن المرأة:( أمًّا كانت أو زوجة أو بنتًا)، بل عدلت في قضيتها إلى درجة فوق المساواة، وهي: درجة التمييز الإيجابي لصالحها.
إن هذا التمييز الإيجابي لصالح المرأة: يظهر بحق في بعض القضايا التي تثار من حين لحين، ويدعى أن الإسلام قد ظلم المرأة فيها، ولعل أبرزها:" قضية الإرث": التي يراد أن يجعل منها نقطة خصام بين المرأة والرجل الذي يحميها، وبينها وبين الإسلام الذي يكرمها!!؟، وهي:( دعوى لا يراد منها إلا الباطل) الذي هو: المطالبة بتغيير شرع الله في قضايا الأسرة القطعية الثبوت والدلالة، وقد صرح دهاقنتهم بوجوب:" إلغاء قانون الأسرة!!؟".
إن:" شعار المساواة": الذي ينادى به في قضايا المرأة: ليس بريئًا ولا عادلًا في كثير من الأحيان؛ إذ لو كان كذلك: لتم النداء بالمساواة بشكل شمولي يغطي:( قضايا تقديم المهر، والمساواة في النفقة، وفي الحضانة، وشروط وظروف العمل)، فلماذا يتحمل الرجل وحده أعباء تقديم المهر والنفقة وغيرها من الأعباء، ولا يطالب في ذلك بالمساواة!!؟".
إن:" قضية المساواة": قد تضرُّ بالمرأة في أكثر الأحيان؛ ولذلك عدل الإسلام، بل أحسن حينما ميَّزها إيجابيًّا في قضايا الميراث الذي حال الجهلُ المركَّبُ بأحكامه دون فقهها وفهمها.
فقضية إرث المرأة في الإسلام: أعدل من عادلة، وحاشا أن يظلم الشرع فيها: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾؛ لذلك لم يقبل الله العادل المحسن المتفضل: أن يجعل أمر تقسيم التركة لنبي مرسَل، ولا لملَك مقرَّب: دفعًا للظلم البشري في توزيع أموال الميت، فتولى سبحانه بنفسه أمر توزيع الميراث، فخصص لذلك آيات محكمات، قطعية الثبوت والدلالة، في سورة سماها بسورة النساء: تشريفًا للمرأة وتكريمًا لها.
إن مَن يروج لشبهة ظلم الإسلام للمرأة في قضايا الإرث: لا يركز في الغالب إلا على حالة واحدة، وهي: الحالة التي تطبق فيها قاعدة: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾، ويغض الطرف عن الحالات الكثيرة التي ترث فيها المرأة مثل الرجل، أو التي ترث فيها أكثر منه، والتي قد ترث فيها ولا يرث هو؛ إذ النظرة المنصفة الشاملة: تقتضي توضيح تلكم الحالات كما يلي:
1- فمن الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل:( حالة الأب والأم عند وجود الابن)، و:(أحوال الإخوة والأخوات لأم، حيث يستوي الذكور والإناث في الميراث....).
2- ومن الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:( حالة الزوج مع ابنته الوحيدة، أو مع ابنتيه....).
3- ومن الحالات التي ترث فيها، ولا يرث لو وُجد مكانها:( حالة وجود الزوج والأخت الشقيقة والأخت لأب، فللزوج النصف، وللأخت نصفها)، وبما أن الأخت لأب في هذه الحالة: لا يمكن أن تحرم؛ لأن نصيبها هنا محدد بالسدس، فيعاد ترتيب التركة، وتقسم على سبعة أجزاء، للزوج ثلاثة، وللأخت الشقيقة ثلاثة، وللأخت لأب واحد، ففي هذه الحالة لو كان الأخ لأب مكان أخته لا يرث شيئا؛ لأنه عاصب، ولم يبقَ شيء من التركة.
4- تبقى الحالة التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل، وهي: حالة محدودة لا تتجاوز أربع وضعيات:
أ- البنت مع إخوانها الذكور، وحالة بنت الابن مع ابن الابن...
ب- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور.
ج- الأخت لأب مع إخوانها الذكور.
د- الأب والأم، حيث لا يوجد أولاد، ولا زوج أو زوجة..
إذًا فالواقع العملي يرد بقوة على شبهة ظلم المرأة في قضية الإرث؛ لأنه يفيد: أن الحالات التي يفضل الرجل المرأة في الإرث لا تتجاوز في مجموعها:( 16.33 % من أحوال الإرث كلها)، وفي باقي الحالات كما رأينا: قد تتساوى المرأة مع الرجل، وقد تفضله، وقد ترث هي ويحرم هو".
لذلك بطَلت الدعوى، واتضح الصبح لذي عينين، فبطلت شبه المغرضين؛ فهي:( ترث بالنصف، وبالثلثين، وترث بالربع وبالثمن كزوجة، وترث بالسدس والثلث كأم...)، إنها صور متعددة لإرث المرأة، فهي يصِلها رزقها حسب ما قدر الله لها، ولن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، شأنها شأن الرجل في ذلك، بل وأفضل:﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾..
ثم ماذا بعد!!؟:
إن المعيار في تقسيم التركة لا يخضع للنوع، وإنما رُوعي في مقاصد توزيعه الشرعية:
1- درجة القرابة بين الوارث والموروث: فالبنت ترث أكثر من أبيها إذا ماتت أمها؛ لقربها...
2- موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة والأعباء يكون نصيبها أكثر...
3-العبء المالي: وهو المعيار الوحيد الذي يظهر التفاوت في قاعدة: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾.
وهو تفاوت ينصف المرأة ولا يظلمها...كيف ذلك!!؟:
إن المرأة رابحة حتى في هذه القاعدة، فهي حينما تجتمع مع أخيها ستستأثر بنصيبها، وتزيد عليه الصداق، وتعفى من النفقة:( أمًّا وبنتًا وأختًا وزوجة)، أما أخوها، فسيتزوج بنصف حظه، وينفق حظه الثاني، ثم يستمر في رحلة الكدح والعمل: ضمانًا لعيش الزوجة والعيال.
فمن الرابح إذًا، ومن الخاسر في القضية!!؟:
إن المرأة رابحة في جميع الأحوال، وإنما كرمها الإسلام، وميزها تمييزًا إيجابيًّا بعد أن كانت:" تورث ولا ترث!!؟"؛ حتى لا تلجأ لاستعمال أنوثتها كسلاح في الحياة إذا لم تجد ما تأكله، فتخسر بذلك رأس مالها، وأغلى ما عندها، وهو:" عرضها وشرفها وعفتها"؛ فإن:" الحرة تموت، ولا تأكل بثدييها".
وإذا تبين عدل الإسلام وإحسانه في هذه القضية، فليتقِ اللهَ كل مسلم ومسلمة، وليتمسك بتعاليم دينه، وخصوصية مجتمعه وأمته.
وصدق الله رب العالمين لما قال في محكم التنزيل: ﴿ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾، ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾، ﴿ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾.
والذي ينبغي أن يتوجه الإصلاح إليه لإنصاف المرأة: أن تعطى لها حقوقها كما ضمنها لها الشرع، وهي: كافية كما تقرر، لا أن تضاد أحكام الشرع بزعم الدفاع عن حقوق المرأة!!؟، فلا بد من وضع حد للعُرف الفاسد الذي لا زال يورث الرجل ولا يورث المرأة!!؟.
إن:" ظاهرة الانفراد بأكل أموال الورثة التي كانت سائدة في الجاهلية": يوم كانت المرأة تحرم من الميراث، عاد بعض الناس - مع الأسف - في واقعنا إلى أمر الجاهلية الأولى، فمنعوا النساء من الإرث، ففي بعض بوادينا، بل حتى في مدننا، لا زال الذكور ينفردون بتركة الميت دون أخواتهم الإناث، وهذا عرف فاسد وظلم: لا يقبله الشرع بحال من الأحوال في جميع أنواع الأموال ؛ لأن القرآن الكريم قسم وقرر: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ * وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا * وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾، والمقصود بالتراث في الآية: خصوص أكل أموال التركة بعد موت الميت دون إيصالها إلى أهلها: عطفًا على التحذير من البخل وأكل أموال اليتامى، وهذا هو رأي أغلب المفسرين.. وإن كان المقصود بالتراث عمومًا هو: أكل كل مال حرام.
فليس يحق لأي كان: أن يمنع المرأة من حظها في الإرث، ومن فعل ذلك ولم يتب بالتحلل من المظالم، وذلك بإرجاع الحقوق إلى أهلها، أو إلى ورثتهم عند هلاكهم، فسيحاسب يوم القيامة، ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾، يومئذ تقول نادمًا متحسِّرًا، ولا ينفعك الندم والحسرة: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾، وتتذكر... وأنى لك الذكرى!!؟، فالآخرة دار جزاء ولا عمل، فخذ من دنياك لآخرتك، فأبصر وتذكر قول ربك يا من تظلم النساء في الإرث: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ﴾، وقد ختم الله آيات الإرث بالقول: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾، إنه:" العدوان على أموال الغير!!؟".
وهكذا تعلمون - إخوة الإيمان - أن المشكلة ليست في:" نصوص الوحي المعصومة": التي قررت حقوق الذَّكر والأنثى في الإرث بعدل وإحسان، ولا في اجتهادات المدونة المبنية على الشرع، ولكن المشكلة كل المشكلة في التطبيق، وفي ظلم الإنسان للمرأة، فلا يريد إيصال الحقوق إليها، فثمة فرق بين عدل الإسلام في المبادئ، وظلم الإنسان في الفعل والتطبيق... فهذا الذي يجب: أن تتوجه إليه المطالبة، ويركز عليه الإصلاح، وليست المطالبة بتغيير شرع الله في الإرث..
إن قضايا الإسلام التشريعية: رابحة بمنطق الحياتين الدنيا والآخرة.. ومبادئه السامية تضمن السعادتين: سعادة العاجلة والآجلة، ولكن مع الأسف!!؟: وضعت هذه القضايا الرابحة ذات الحجج القوية الدامغة في:" أيدي محامين فاشلين!!؟": لم يعرفوا كيفية إظهار هذه الحجج في السلوك والفعل!!؟.... هذا هو مثلنا مع الإسلام في شتى مناحي الحياة:( نشوهه بأفعالنا، ونروج لعقلية الظلم والخرافة، ثم ننسب ظلمنا إليه)، وهو:" بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام".
نسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى: أن يرد المسلمين إلى دينه الحق ردا جميلا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
منقول بتصرف يسير.
جزى الله راقمه خيرا.