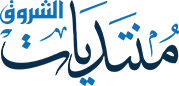الشّيخ البشير الإبراهيمي.. مجدِّد الحركة العلميّة في الجزائر
04-06-2016, 04:22 PM
في الذكــرى 61 لرحيلــــه
الشّيخ البشير الإبراهيمي.. مجدِّد الحركة العلميّة في الجزائر
عبد الحكيم قماز

وُلِدَ الإمام محمّد البشير الإبراهيمي رحمه الله في قصر الطير بدائرة سطيف، وهي قرية تقع على مقربة من بلدة رأس الوادي، فجر يوم الخميس في 13 شّوال 1306هـ، الموافق لـ14 جوان 1889.
تُعرَف قبيلته بأولاد إبراهيم بن يحيى بن مساهل، ويرجِع نسبه إلى إدريس بن عبد اللّه الجدّ الأوّل للأشراف الأدارسة، وكانوا يُسمّونه إدريس الأكبر، وإليه ترجع أنساب الأشراف الحسنيين في المغربين: الأقصى والأوسط.
وبيته إحدى البيوت الّتي حفظت رسم العلم وتوارثته قرونًا من لدن خمول بجاية وسقوطها في القرن التاسع الهجري، وقد كانت بجاية دار هجرة للعلم، وخصوصًا للأقاليم المتاخمة لها، وقد خرج من عمود نسبه بالذات في هذه القرون الخمسة علماءُ في العلوم العربية، ونشروها بهمّة واجتهاد في الأقاليم المجاورة لإقليمه، ومنهم مَن هاجر إلى القاهرة في سبيل الاستزادة من العلم والتوسّع فيه، رغم صعوبة الهجرة إذ ذاك، ومن آثار الاتصال بالقاهرة أنّهم بعد رجوعهم سمَّوا أبناءهم بأسماء كبار مشايخ الأزهر، إذ منهم مَن تَسمّى بالأمير والصاوي والخرشي والسنهوري.
وكان أبوه من الوطنيين المناوئين للاستعمار الفرنسي، ولقد اضطهده المستعمرون، ما اضطرّه إلى مغادرة الجزائر والهجرة إلى المدينة المنورة، تاركًا ابنَه وهو في السادسة عشرة من عمره.
نشأ البشير في بيت والده كما ينشأ أبناء بيوت العلم. وكانت ملامح الذّكاء المتوقّد قد ظهرت مبكّرة لدى البشير، فأظهر منذ صغره ميلاً شديدًا لتحصيل العلم وحبًّا عميقًا للقرآن الكريم. وقد توسَّم الأب والعمّ في البشير علامات التفوُّق والنبوغ، فتعهّده عمُّه.
ولمّا بلغ سبع سنين تولّى عمّه تربيته وتعليمه بنفسه، فكان لا يفارقه لحظة حتى في ساعات النوم، فحفظ فنون العلم المهمة في ذلك السن، مع استمراره في حفظ القرآن، فلمّا بلغ تسع سنين من عمره حفظ القرآن مع فهم مفرداته وغريبه، وحفظ معه ألفية ابن مالك ومعظم الكافية له، وألفية ابن معطي الجزائري، وألفيتي الحافظ العراقي في السير والأثر، وحفظ جمع الجوامع في الأصول، وتلخيص المفتاح للقاضي القزويني، ورقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب، وحفظ الكثير من شعر أبي عبد اللّه بن خميس التلمساني شاعر المغرب والأندلس في المائة السابعة، وحفظ معظم رسائل بلغاء الأندلس مثل ابن شهيد، وابن برد، وابن أبي الخصال، وأبي المطرف بن أبي عميرة، وابن الخطيب، ثمّ أرشده عمّه إلى دواوين فحول المشارقة، ورسائل بلغائهم، فحفظ صدرًا من شعر المتنبي، ثم استوعبه بعد رحلته إلى الشرق، وصدرًا من شعر الطائيين، وحفظ ديوان الحماسة، وحفظ كثيرًا من رسائل سهل بن هارون وبديع الزمان.
وفي عنفوان هذه الفترة، حفظ بإرشاد عمّه كتاب كفاية المتحفظ للأجدابي الطرابلسي، وكتاب الألفاظ الكتابية للهمداني، وكتاب الفصيح لثعلب، وكتاب إصلاح المنطق ليعقوب السكيت، وهذه الكتب الأربعة هي التي كان لها معظم الأثر في ملكته اللغوية.
كما أخذ مختلف فنون العلم عن الشيخ ربيع قري اليعلاوي، والشيخ محمد أبو القاسم البُوجْلِيلِي، والشيخ محمد أبو جمعة القُلِّي، ولم يكن هؤلاء العلماء رحلوا إلى الأمصار الكبرى ذات الجماعات العلمية التاريخية كفاس وتونس والقاهرة، وإنما كانوا يتوارثون العلوم الإسلامية طبقة عن طبقة إلى الأجيال المتخرجة من مدن العلم الموجودة بوطننا كبجاية وقلعة بني حماد وغيرهما.
ولم يزل عمّه رحمه اللّه يتدرّج به من كتاب إلى كتاب تلقينًا وحفظًا ومدارسة للمتون والكتب التي حفظها حتّى بلغ الحادية عشرة من عمره، فبدأ يُدرّسه ألفية ابن مالك دراسة بحث وتدقيق، وقبلها أقرأه كتب ابن هشام الصغير قراءة تفهّم وبحث.
ولمّا بلغ البشير أربع عشرة سنة، مرض عمّه مرض الموت، فكان يُلقّنه ويفيده وهو على فراش الموت، بحيث ختم الفصول الأخيرة من ألفية ابن مالك عليه وهو على تلك الحالة.
توليه التدريس:
لمّا مات عمّه، شرع في تدريس العلوم التي درسها عليه، وأجازه بتدريسها، وعمره أربع عشرة سنة، لطلبته الذين كانوا زملاءه في الدراسة عليه، وانهال عليه طلبة العلم من البلدات القريبة، والتزم والده بإطعامهم والقيام عليهم كالعادة في حياة عمّه، وربّما انتقل في بعض السنين إلى المدارس القبلية القريبة منه لسعتها واستيعابها للعدد الكثير من الطلبة وتيسّر المرافق بها للسكنى.
السفر إلى القاهرة:
ولبث الإمام البشير يُمارِس مهنة التّدريس حتّى بلغَ العشرين من عمره، فتاقت نفسه إلى الهجرة إلى الشرق، واختار المدينة المنورة لأنّ والده سبقه إليها سنة 1908م فرارًا من ظُلم فرنسا، فالتحق به متخفيًا أواخر سنة 1911م كما خرج هو متخفيًا، ومرّ في وجهته هذه بالقاهرة، فأقام بها ثلاثة أشهر، وحضر بعض دروس العلم في الأزهر، وعرف أشهر علمائها.
وممّن عرفه وحضر دروسه، الشيخ سليم البشري، والشيخ محمد بخيت (درس عليه البخاري) في رواق العباسي، والشيخ يوسف الدجوي (درس عليه البلاغة)، والشيخ عبد الغني محمود والشيخ السمالوطي في المسجد الحسيني، والشيخ سعيد الموجي بجامع الفاكهاني. وحضر عدّة دروس في دار الدّعوة والإرشاد الّتي أسّسها الشيخ رشيد رضا في منيل الروضة. وزار الإمام البشير شاعر العربية الأكبر أحمد شوقي وأسمعه عدّة قصائد من شعره من حفظه، فتهلّل رحمه اللّه واهتزّ. كما اجتمع بشاعر النيل حافظ إبراهيم في بعض أندية القاهرة وأسمعه من حفظه شيئًا من شعره كذلك.
وفي أثناء وجود الإمام البشير في القاهرة خلال هذه الفترة من جهاده، انتُخِب عضوًا بمجمع اللغة العربية، وكان قبل ذلك قد انتخِب عضوًا بالمجمع العلمي بدمشق والمجمع العلمي بمدينة بغداد.
في المدينة المنورة:
خرج الإمام البشير من القاهرة قاصدًا المدينة المنوّرة، فركب البحر من بور سعيد إلى حيفا، ومنها ركب القطار إلى المدينة المنورة، وكان وصوله إليها في أواخر سنة 1911م، واجتمع بوالده رحمه اللّه، وطاف بحِلَق العلم في الحرم النّبويّ مختبرًا، فلم يرق له شيء منها، “وإنّما غثاء يلقيه رهط ليس له من العِلم والتحقيق شيء”، ولم يجد علمًا صحيحًا إلاّ عند رجلين هما شيخاه: الشيخ العزيز الوزير التونسي، والشيخ حسين أحمد الفيض أبادي الهندي، فلازمهما ملازمة الظلّ، وأخذ عن الأوّل الموطأ دراية، ثمّ أدهشه تحقيقه في بقية العلوم الإسلامية، فلازم درسه في فقه مالك، ودرسه في التوضيح لابن هشام، ولازم الثاني في درسه لصحيح مسلم.
وأخذ أيّام مجاورته بالمدينة علم التفسير عن الشيخ الجليل إبراهيم الأسكوبي، وأخذ الجرح والتعديل وأسماء الرجال عن الشيخ أحمد البرزنجي الشهرزوري في داره أيّام انقطاعه عن التدريس في الحرم النّبويّ، وأخذ أنساب العرب وأدبهم الجاهلي، والسِّيرة النّبويّة عن الشيخ محمد عبد اللّه زيدان الشنقيطي. وأتمّ معلوماته في علم المنطق عن الشيخ عبد الباقي الأفغاني بمنزله.
وذاكر صاحبه الشيخ أحمد خيرات الشنقيطي سنين عديدة في اللغة والشعر الجاهلي، ومنه المعلّقات العشر، وصاحبه محمد العمري الجزائري، أمّهات الأدب المشهورة خصوصًا الكامل للمبرد، والبيان والتبيين للجاحظ، وختماها مطالعة مشتركة فاحصة متأنية، وكذلك فعلا بكتاب الأغاني من أوّله إلى آخره.
لقاؤه برائد الإصلاح:
وكان لقاء الشّيخين الجليلين عبد الحميد بن باديس ومحمّد البشير الإبراهيمي لقاء تاريخيًا، وهو أوّل لقاء يتمّ بين هذين الرجلين العظيمين، في رحاب الحرم الشّريف، على الرّغم من أنّهما كانا ينتميان لوطن واحد، ويُجاهدان في ميدان واحد هو ميدان العلم، وشاءت الأقدار أن يكون لقاؤهما في مكان مقدَّس ليرسُمَا خُطّة العمل من أجل الجهاد المقدّس لنُصرة الشّعب الجزائري، وسببًا من أهم الأسباب الّتي مهّدت لتفجير ثورة الجزائر الكبرى، وانتصارها الرّائع المجيد على المستعمر، وصيرورتها بعد ذلك من أقوى وأعظم الدول في الأمّة العربية.
وقد لبث هذا اللّقاء التاريخي ثلاثة أشهر، وهي المدّة الّتي قضاها الشّيخ عبد الحميد بن باديس في المدينة المنورة. فكانا يلتقيان كلّ ليلة في المسجد النّبويّ الشّريف، ويؤدّيان سوية صلاة العشاء، ثمّ ينصرفان بعد ذلك من المسجد الطاهر إلى دار الإمام الشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي، ويقضيان اللّيل بطوله في مناقشة الوضع في وطنهما الجزائر من مختلف النّواحي السياسية والدّينية والاجتماعية، حتّى ينتبِها إلى بزوغ أولى أشعة الفجر، ويتوجّها إلى المسجد النّبويّ الشّريف ليؤدّيَا صلاة الفجر، وهما يدعوان الله العزيز القدير أن يبزغ في الجزائر الحبيبة فجر الحرية والكرامة والاستقلال.
في هذا اللّقاء الخالد بين البطلين تمّ التفكير في إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الّتي تمّ إنشاؤها بعد ذلك في سنة 1931م. والّتي لعبت دورًا بطوليًا خالدًا في التّمهيد لتفجّر ثورة الجزائر العظيمة.
مغادرته المدينة:
وقام الشريف حسين بن عليّ بثورته المعروفة سنة 1917م، فأمرت الحكومة العثمانية بترحيل سكان المدينة المنورة كلّهم إلى دمشق. وكان عدد المهجّرين يزيد عن 80 ألفًا، وكان من بينهم الإمام محمّد البشير الإبراهيمي ووالده. أمّا الشّيخ عبد الحميد بن باديس، فكان قد رَحَل قبل ذلك عائدًا إلى وطنه الجزائر، لكي يبدأ فورًا في تنفيذ الأفكار والمخطّطات الّتي رسمها مع الإمام البشير إبّان لقائهما في المدينة المنورة.
في دمشق:
ما لبث شهرًا في حاضرة الشّام حتّى تنافست عليه المدارس الأهلية للتّدريس بها، فاستجاب لبعضها، ثمّ حمله إخوانه على إلقاء دروس في الوعظ والإرشاد بالجامع الأموي بمناسبة حلول شهر رمضان، فامتثل وألقى دروسًا تحت قبة النصر الشهيرة على طريقة الأمالي، فكان الشّيخ البشير يجعل عماد الدرس حديثًا يُمليه من حفظه بالإسناد إلى أصوله القديمة، ثم يمليه تفسيره بما يوافق روح العصر وأحداثه، فسمع النّاس شيئًا لم يألفوه ولم يسمعوه إلاّ في دروس الشيخ بدر الدين الحَسَنِي.
وبعد خروج الأتراك من دمشق وقيام حكومة الاستقلال العربي، دعته الحكومة الجديدة إلى تدريس الآداب العربية بالمدرسة السلطانية (وهي المدرسة الثانوية الوحيدة آنذاك) مشاركًا للأستاذ اللغوي الشيخ عبد القادر المبارك، فاضطلع بما حُمل من ذلك، وتلقّى عنه الطلبة دروسًا في الأدب العربي الصميم، وكانت الصفوف التي يدرّس لها الأدب العربي هي الصفوف النهائية المرشّحة للبكالوريا، وقد تخرّج عليه جماعة من الطلبة هم اليوم عماد الأدب العربي في سوريا منهم: الدكتور جميل صليبا، والدكتور أديب الروماني، والدكتور المحايري، والدكتور عدنان الأتاسي.
ولمّا دخل الأمير فيصل بن الحسين دمشق، اتّصل به وأراده على أن يبادر بالرجوع إلى المدينة ليتولّى إدارة المعارف بها، ولم يكن ذلك في نيته وقصده، لما طرأ على المدينة من تغيّر في الأوضاع المادية والنفسية، فأبى عليه، وما فتئ يلحّ عليه ويأبى إلى أن سنحت الفرصة فكرّ راجعًا إلى الجزائر موطن آبائه وعشيرته.
أعماله بعد رجوعه للوطن:
رجع الشيخ إلى الجزائر من سنته تلك بعد أن أقنع أخاه الشّيخ عبد الحميد بن باديس بأنّه لاحق به، بعد أن أقنع والده أن رجوعه إلى الجزائر يترتّب عليه إحياء للدّين والعربية، وقمع للابتداع والضّلال، وإنكاء للاستعمار الفرنسي، وكان هذا هو المنفذ الوحيد الّذي دخل منه على نفس واله ليسمح له بالرجوع إلى الجزائر.
وحلّ ببلده وبدأ من أوّل يوم في العمل الّذي يؤازر عمل أخيه الشّيخ ابن باديس، حيث بدأ أوّلاً بعقد النّدوات العلمية للطلبة، والدروس الدّينية للجماعات القليلة، فلمّا تهيّأت الفرصة انتقل إلى إلقاء الدروس المنظّمة للطلبة الملازمين، ثمّ تدرّج لإلقاء المحاضرات التاريخية والعلمية على الجماهير الحاشدة في المدن العامرة والقرى الآهلة، وإلقاء دروس في الوعظ والإرشاد الدّيني كلّ جمعة في بلد، ثمّ لمّا تمّ استعداد الجمهور الّذي هزّته صيحاته إلى العلم، أسّس مدرسة صغيرة لتنشئة طائفة من الشبان نشأة خاصة، وتمرينهم على الخطابة والكتابة وقيادة الجماهير بعد تزويدهم بالغذاء الضروري من العلم، وكانت أعماله هذه في التعليم الّذي وقف عنايته عليه فاترة أحيانًا لخوفه من مكائد الحكومة الاستعمارية، إذ ليس له سند يأوي إليه كما لأخيه ابن باديس، وكانت حركاته منذ حلّ بأرض الوطن مثار ريب عند الحكومة ومنبع شكوك، حتّى صلاته وخطبه الجمعية، فكان يتغطى لها بألوان من المخادعة حتّى أنّه تظاهر لها عدّة سنين بتعاطي التجارة وغشيان الأسواق لإطعام من يعولهم من أفراد أسرته، ولكنّها لم تنخدع ولم تطمئن إلى حركته، فكانت الشرطة تلاحقه بالتقارير وتضيّق الخناق على كلّ من يزوره من تونس أو الحجاز.
في هذه الفترة ما بين سنتَي 1920 و1930، كانت الصّلة بينه وبين الشّيخ ابن باديس قويّة وكانا يتلاقيان في كلّ أسبوعين أو كلّ شهر على الأكثر، يزوره في بلده (سطيف) أو يزوره في قسنطينة، فيَزِنان أعمالهما بالقسط ويزنان آثارها في الشعب بالعدل، ليبنيا على ذلك أمرهما، ويضعا على الورق برامجهما للمستقبل بميزان لا يختل أبدًا، وكانا يقرءان للحوادث والمفاجآت حسابها، فكانت هذه السنوات العشر كلّها إرهاصات لتأسيس جمعية العلماء الجزائريين.
التحضير لتأسيس جمعية العلماء:
سار الشّيخ عبد الحميد بن باديس مع صديقه الشّيخ البشير الإبراهيمي على هذه الحالة 10 سنوات، كانت كلّها إعدادًا وتهيئة للحدث الأعظم وهو إخراج جمعية العلماء من حيّز القول إلى الفعل، وأصبح لهم جيش من التلامذة يحمل فكرتهم وعقيدتهم، مسلّح بالخطباء والكتّاب والشعراء، يلتفّ بهم مئات الآلاف من أنصار الفكرة وحملة العقيدة، يجمعهم كلّهم إيمان واحد، وفكرة واحدة، وحماس متأجج، وغضب حادّ على الاستعمار.
وكان من بين الّذين استعان بهم الشّيخ ابن باديس: الطيّب العُقبي، ومبارك الميلي، والعربي التبسي، وتوفيق المدني وغيرهم ممّن كان لهم الفضل الأسنى في بعث روح الجهاد المقدّس، وبذلك عمل هؤلاء المجاهدون في إنشاء مئات المدارس التي تُدرّس اللغة العربية ومختلف العلوم الإسلامية.
وكانت سنة 1930 هي السنة الّتي تمّ بتمامها قرن كامل على احتلال فرنسا للجزائر، فاحتفلت بتلك المناسبة احتفالاً قدّرت له 6 أشهر ببرنامج حافل مملوء بالمهرجانات، ودعت إليه الدّنيا كلّها، فاستطاع الشّيخ وإخوانه الأفاضل بدعايتهم السرّية أن يفسدوا عليها كثيرًا من برامجها، فلم تدم الاحتفالات إلاّ شهرين، واستطاعوا بدعايتهم العلنية أن يجمَعوا الشعب الجزائري حولهم ويلفتوا أنظاره إليهم.
وبعد تكامل العدد الّذي يمكن أن يعلنوا به تأسيس الجمعية، وتلاحق المدد من إخوانهم بالشرق العربي مهاجرين أو طلاب علم، أعلنوا تأسيس الجمعية في شهر ماي 1931م، بعد أن حضّر لها الشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي قانونًا أساسيًا مختصرًا، حيث أداره على قواعد من العلم والدّين لا تثير شكًا ولا تخيف، وكانت الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت تستهين بأعمال العالم المسلم، وتعتقد أنّهم لا يضطلع بالأعمال العظيمة، فخيّبوا ظنّها والحمد للّه.
الدعوة في فرنسا:
تابع الشّيخ البشير الإبراهيمي مراكز الجمعية وفروعها بفرنسا، والّتي كانت أوّل مراكز إسلامية في أوروبا، تعطّلت بسبب الحرب العالمية، فأوفدت الجمعية سنة 1947م مراقبها العام الشّيخ سعيد صالي إلى فرنسا “ليدرس الأحوال ويمهد الأمور”، وسرعان ما عاد النشاط وتوسّع، ولم يقتصر على العمال الجزائريين بل شمل حتّى طلبة الكليات الفرنسية من أبناء الجزائر.
اعتقال الشيخ:
ونظرًا لنشاطه المعادي للاستعمار، اعتُقل من قِبَل الإدارة الفرنسية ونُفي إلى آفلو في الأغواط، ورغم تواجده بالمنفى فقد اختير رئيسًا لجمعية العلماء بعد وفاة الشّيخ عبد الحميد بن باديس.
أُطلق سراحه سنة 1943م، ثمّ أعيد اعتقاله بعد تنديده بمجازر 8 ماي 1945م. وبعد إطلاق سراحه ثانية واصل النّشاط الدعوي على نهج الشّيخ ابن باديس، وكان يكتب افتتاحية جريدة “البصائر” لسان حال جمعية العلماء، كما أصدر جريدة “الشباب المسلم” باللغة الفرنسية.
انتقاله للمشرق العربي:
انتقل الشّيخ البشير الإبراهيمي سنة 1952م إلى المشرق العربي واستقرّ بالقاهرة، وبقي هناك إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية، إذ أصدر بيان جمعية العلماء المسلمين، الدّاعي إلى التفاف الشعب بالثورة التحريرية.
كان الإمام الرّاحل الشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي من أوائل الرواد العرب الّذين نادوا بأهمية وحيوية الوحدة بين مختلف الدول والأقطار العربية. وقد تمكّن الإمام البشير، على الرغم من جميع الصعوبات التي اعترضت طريقه، من إصدار جريدة “البصائر” الّتي ما لبثت أن أصبحت من أعظم منابر الحرية والعروبة، ومن أقوى وسائل الدعوة إلى الإسلام: دين الحقّ، ودين العدالة والإنسانية الكريمة.
حرب العِلم:
كانت الحرب الّتي أعلنتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من أشرف وأعظم الحروب الّتي عهدتها الأمم من عربية وغربية، كانت حربًا لغرس بذور العِلم، والعمل على إنمائه حتّى يؤتي ثماره.
لذلك لا يمكن فصل الثورة التحريرية الّتي اندلعت في أوّل نوفمبر 1954م عن الثورة الإصلاحية والتعليمية الّتي حمل لواءها الرّائدان الشّيخ عبد الحميد بن باديس والإمام البشير الإبراهيمي رحمهما الله.
فلسفته التعليمية:
يقول الشّيخ البشير “إنّ الإصلاح الدّيني القائم على كتاب الله وسُنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم هو الأساس المتين للإصلاح الاجتماعي والسياسي”.
مأساة ضياع فلسطين:
لمّا ضاعت فلسطين العربية، وأُنشِئت على أرضها دولة الصهاينة الّتي ما لَبِثت أن نشَبَت مخالبها في الشعب العربي بأسره، تأثّر الإمام البشير لذلك أبلَغ التأثّر وأعمقه، وحزَّ في نفسه الألم العظيم، وحَزن على فلسطين كأنّها جزء غال من وطنه المحبوب الجزائر، ولا عجب، فقد كان يؤمن إيمانًا راسخًا بأن الأمّة الإسلامية جسم واحد، إذا تألّم عضو منه تداعت له جميع الأعضاء.
وكان رحمه الله يقول:" ما أضاع فلسطين إلاّ العرب! لقد جاءتهم النُّذر فتماروا بها! ثمّ حقّ الأمر وهم ساهون فاندهشوا! ثمّ وقعت الواقعة فأبلسوا! وعمد خطباؤهم إلى الخطب يُنمّقونها، وشعراؤهم إلى القصائد يزوِّقونها، وساستهم إلى الدعاوَى يُلفّقونها، وعامّتهم إلى الخرافات يُصدّقونها! بينما عمَد ملوكهم إلى الإمدادات يعوّقونها، وإلى الأهواء يُنفقونها. وعمد خُصومهم اليهود إلى الغايات يُحقّقونها، وإلى العهود يُمزّقونها. وقُضيَ الأمر، وأوسعناهم سبًّا، وأصبحنا نقول: نحن كنّا أهلَ فلسطين!".
وتوفي الشّيخ البشير الإبراهيمي، وهو رهن الإقامة الجبرية في منزله، يوم الخميس 20 ماي 1965، رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته.
الشّيخ محمّد الغزالي رحمه الله:"الإمام الإبراهيمي كما عرفته".
كانت القاهرة -لأكثر من ثلث قرن مضى- ملتقى عدد من المجاهدين الكبار يفيئون إليها في ظل عقيدة جامعة، وأخوة وثيقة، ولغة مشتركة، وآمال واحدة. وكان المسلمون ينظرون إلى الزعماء القادمين نظرة حب جارف وإعزاز بالغ، كانوا يرون النظر في وجوههم عبادة، والحديث معهم والأنس بهم قربى إلى الله.
أذكر من هؤلاء الحاج محمد الأمين الحسيني مفتي فلسطين الأكبر، وقائد جهادها الأول، زارني يومًا في وزارة الأوقاف –وكنت مسؤولاً عن المساجد- فزكّى بعض المشروعات التي أقوم بها، ورسم لي طريق إنجاحها، وشعرت كأنه يعد نفسه مسؤولا عن مستقبل الإسلام في مصر، فهو يهتم به اهتمامي أنا به أو أكثر، ولا عجب فدار الإسلام واحدة وإن اختلفت منابت الأفراد..
وأذكر من أولئك الزعماء اللاجئين إلى القاهرة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، عرفته أو تعرّفت إليه في أعقاب محاضرة بالمركز العام للإخوان المسلمين.. كان لكلماته دوي بعيد المدى، وكان تمكنه من الأدب العربي بارزا في أسلوب الأداء وطريقة الإلقاء، والحق أن الرجل رُزق بيانا ساحرا وتأنقا في العبارة يُذكِّرنا بأدباء العربية في أزهى عصورها.
لكن هذا ليس ما ربطنا به وشدّنا إليه -على قيمته المعنوية- إنما جذبنا الرجل بإيمانه العميق، وحزنه الظاهر على حاضر المسلمين، وغيظه المتفجر ضد الاستعمار، ورغبته الشديدة في إيقاظ المسلمين ليحموا أوطانهم ويستنقذوا أمجادهم، وخُيّل لي أنه يحمل في فؤاده آلام الجزائريين كلهم وهم يكافحون الاستعمار الفرنسي، ويقدمون المغارم سيلا لا ينقطع حتى يحرروا أرضهم من الغاصبين الطغاة، وكان في خطاباته يزأر كأنه أسد جريح، فكان ينتزع الوجل من أفئدة الهيابين ويهيّج في نفوسهم الحمية لله ورسوله، فعرفتُ قيمة الأثر الذي يقول “إن مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدم الشهداء”.
إن الخطيب أو الكاتب يوم يستمد توجيهاته من قلبه ويصبها في نفوس تلامذته إنما يكوّن فيلق أولي الفداء، ويصنع قذائف حية ورجالا ينسفون الباطل نسفًا، وذلك ما أحسسناه ونحن نستمع إلى الشيخ البشير الإبراهيمي في القاهرة، فعرفنا لماذا ضاق به الفرنسيون وطاردوه، ومن تمّ قرّرنا الالتفاف به والاستمداد منه.
ومن الخطأ تصور أن الشيخ الكبير كان خطيبا ثائرًا وحسب.. لقد كان فقيها ذكي الفكرة بعيد النظرة. ووقع لي معه حوار في مسألتين طريفتين، قال لي مرة: لعلك قرأت في السيرة الشريفة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينصرفون عن مجلسه إلا على ذَوَاقٍ. قلت: نعم، قال: فما الذواق الذي ينالونه في مجلسه؟ فتريثّتُ قليلا ثم أجبت: لعلهم كانوا يتناولون بعض الأطعمة أو الأشربة كما يقع في عصرنا هذا عندما نقدم للأضياف الوافدين أقداحا من الشاي أو غيره.. قال لي: ظننتك أفضل من أن تجيب هذه الإجابة الساذجة، ألك شيء يُنوِّه به الأصحاب الكرام؟ قلت في تلهُّف: فما الذواق الوارد في السنة؟ قال: إنه تذوق أرقى، ألا تذكر الحديث الشريف “ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا”.
إن المجلس النبوي تظلله الحكمة، ومقام النبي فيه ترقيق القلوب، ورفع المستوى، وتخليص الروحانية من شوائب الأرض، وجعل البشر في مصاف الملأ الأعلى.. فما ينصرف أحد عن هذا المجلس الزكي إلا وتذوق نازلاً من السماء، ولا يعود إلى أهله إلا بذخر يعليه ويعليهم.
الحق أن هذا المعنى كان جديدا عليّ، غير أني شعرت بأنه الحق، وأنه أولى كثيرا من تفسير الذواق بأنه طعام وشراب..
وسألني مرة: ما تقول في هذه الذبائح التي تملأ ساحات منى يتحلل بها الحجاج والعامرون من مناسكهم؟ فلم أدري ما أقول، كل ما استعطت أن أجيب به أنها من شعائر الحج والعمرة قربة إلى الله وطعمة للفقراء، وفي الآية {ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير{. قال: ليت الحجيج يفقهون هذه الغاية فيأكلون ويتصدقون ويفرح بصنيعهم البائسون الفقراء، إنهم يذبحون ويدعون ذبائحهم على الثرى لا يقربها إنس ولا وحش، فتضيع سدى، وقد نُهينا عن إضاعة المال. حبذا لو وضعت خطة للإفادة من هذا الخير المبذول وتعميم النفع به.. وما تمنّاه الشّيخ البشير الإبراهيمي نُفِّذ بعد ربع قرن، فقد عرفتُ الآن أن ما يُذبح يكون بقدر حاجة الفقراء، والباقي يوجّه لسد ثغرات الجوع والجفاف في أماكن أخرى.. وهذا هو الفقه الصحيح وحسن التصرف في تنفيذ أحكام الشّرع الشّريف. كان لقاؤنا بالشيخ البشير الإبراهيمي مصدر متعة أدبية وعلمية تجعل أدباء القاهرة وعلمائها يهرعون إليه ويتزاحمون عليه، ولكن الرجل كان يشرُد بين الحين والحين، فنحسّ أنّه معنا وليس معنا، كان جسمه معنا وقلبه معلّقًا بالجزائر يتحسّس أنباءها، يتبع العراك الدائر بين الإسلام والصليبية في هذه القطعة الغالية من دار الإسلام، وكنتُ أشعر بأنه يكتب إلى رجاله أو المسؤولين عن الكفاح الجزائري يشير عليهم بالرأي.. وأستطيع الجزم بأنه ما ضعف يومًا ولا استكان ولا يئس من روح الله، ولا شك في أن الله ناصر جنده، ومعزّ المجاهدين المسلمين. وهناك أمر لا يعرفه الكثيرون، لقد حاول أن يسدّ الفجوة بين جماعة الإخوان ورجال الثورة المصرية، فإن الفريقين يقدّرونه ويصغون إلى نصحه، ولكن الشرّ كان قد تفاقم بين الفريقين وعزّ على العلاج، فتوقّف محزونًا.
وظلّ الشيخ البشير ومعه بعض الجزائريين يرتّبون الأمور بين القاهرة الموالية للمجاهدين، وبين أرض المعركة الّتي احتدم فيه القتال وتضاعف الشّهداء، ولا أنسى من بين أصحاب الشّيخ الأخ الفضيل الورتيلاني الّذي زاملني في الدّراسة وأنا في تخصّص الدعوة والإرشاد قبل مجيء الإبراهيمي ببضع سنين، وكان الشّيخ الفضيل عملاقًا في مبناه ومعناه ورجلاً في وزنه، وكان يتّبع الشّيخ البشير على أنّه تلميذ وفيّ له، ويتعاونان على نصرة القضية الجزائرية بكلّ ما لديهما من طاقة..
قال لي الشّيخ البشير: إنّكم بليتم بالاستعمار مثل ما بُلينا، وشعرتم بضراوته مثل ما شعرنا، لكنّكم لا تعرفون أنّ ما أصابنا نوع شاذ من الاستعمار يشبه السرطان من بين أنواع العلل المهلكة، إنه كان يريد محو شخصيتنا وعقيدتنا ولغتنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، ومن المستحيل الإبقاء عليه أو البقاء معه. إنّ معنى ذلك الموت الخسيس، وأولى بنا أن نموت جميعًا في ميادين الكفاح والتضحية من أن نموت على هذا النحو الّذي يُراد لنا..
والجزائري إذا غضب تحوَّل إلى شخص آخر، وقد كنتُ ألمح تغيّرًا عضويًا في وجهه بل في كيانه كلّه عندما يتحدث عن ضرورة الجهاد إلى آخر رمق، وعن ضرورة بقاء الجزائر مسلمة تتكلّم بلغة الوحي وتحلّ العربية محل الفرنسية. (وها قد نصر الله الجزائر، ونضر وجوه المجاهدين وعاد الدخيل من حيث جاء، واندحر أتباعه وأعوانه).
فأدبروا ووجوهُ الأرض تلعنهم÷ كباطل من خلال الحقّ منهزم
لا تقطعنّ ذنب الأفعى وترسلها ÷ إن كنتَ شهمًا فأتبع رأسها الذنبَا